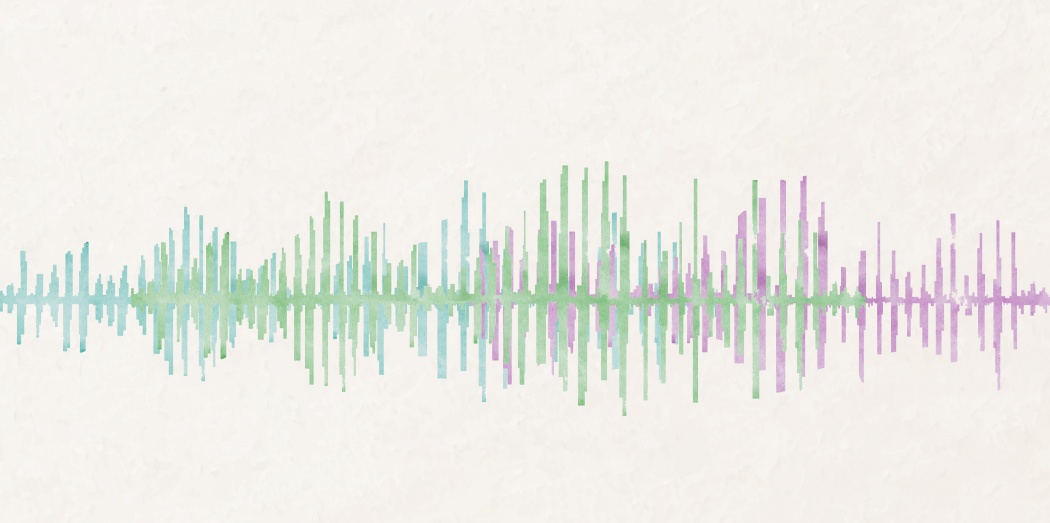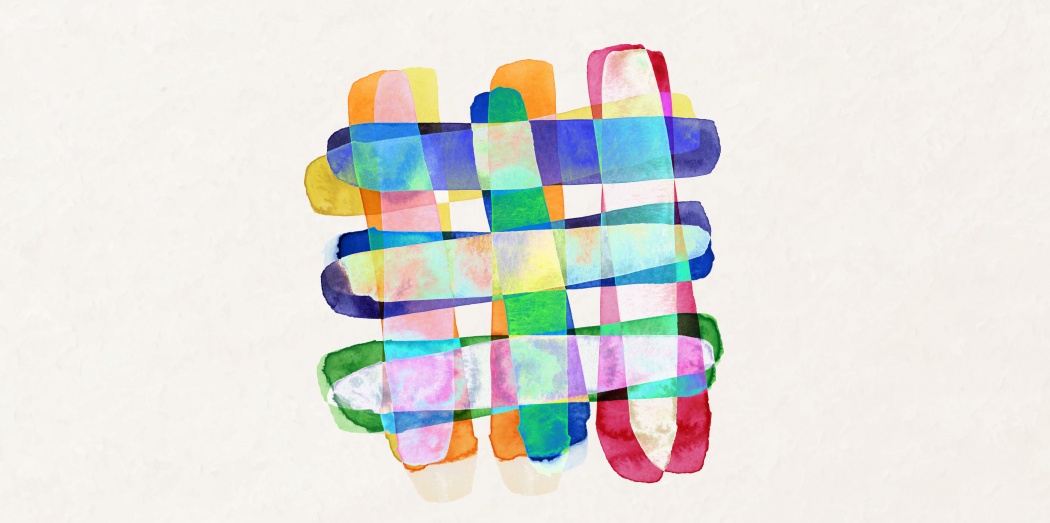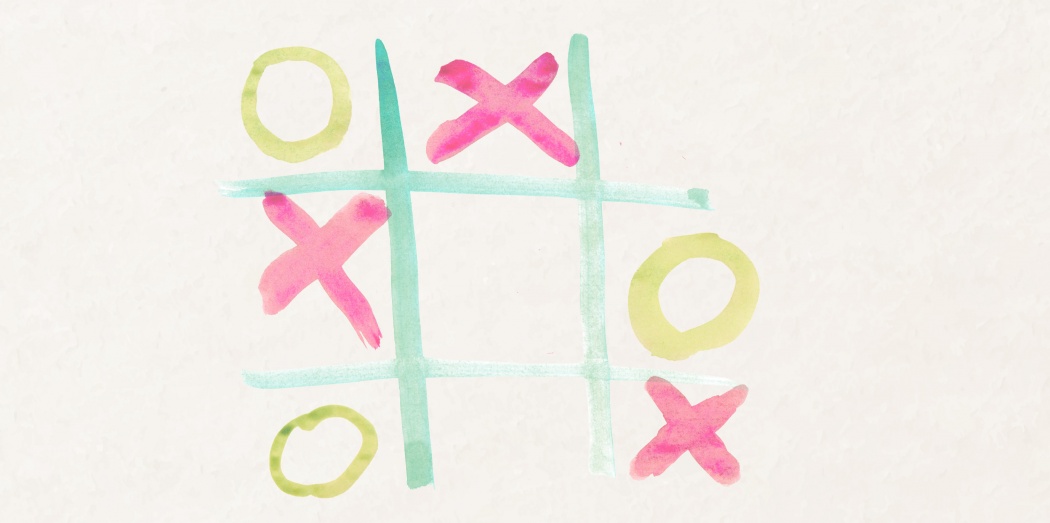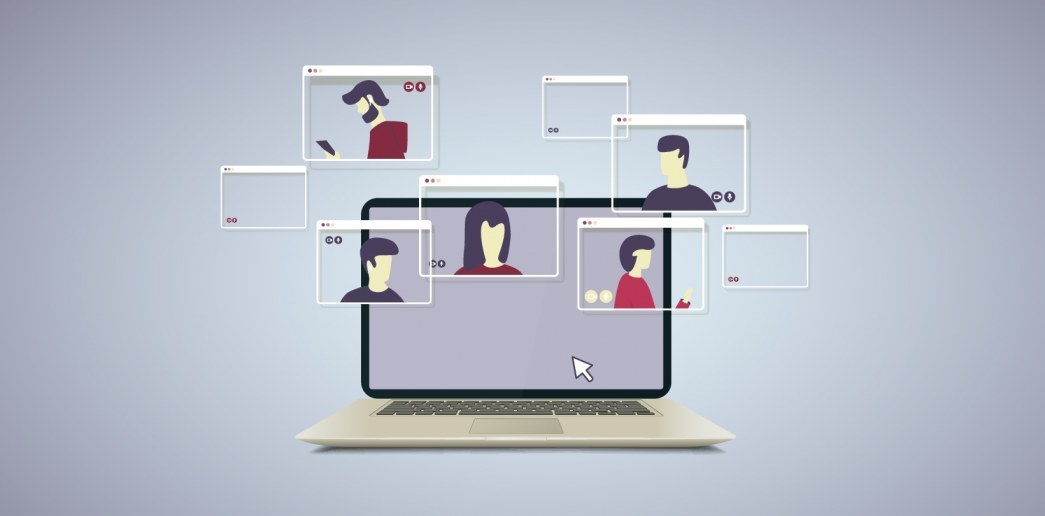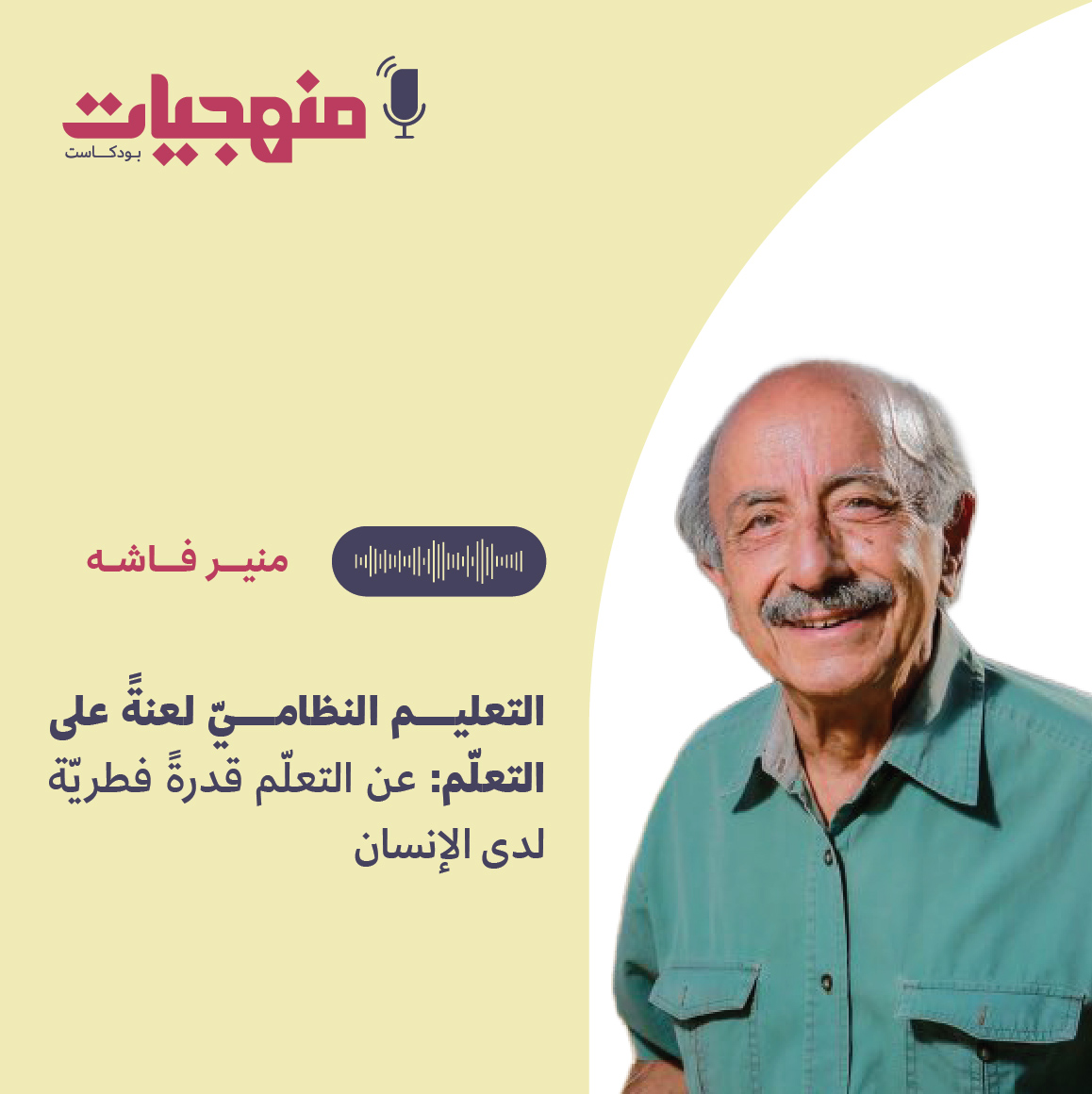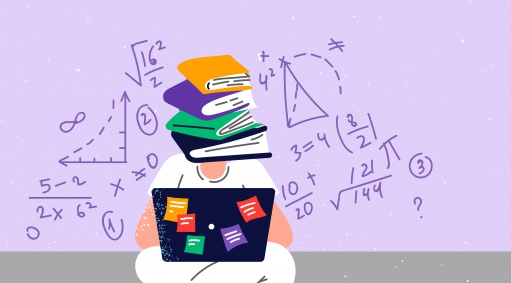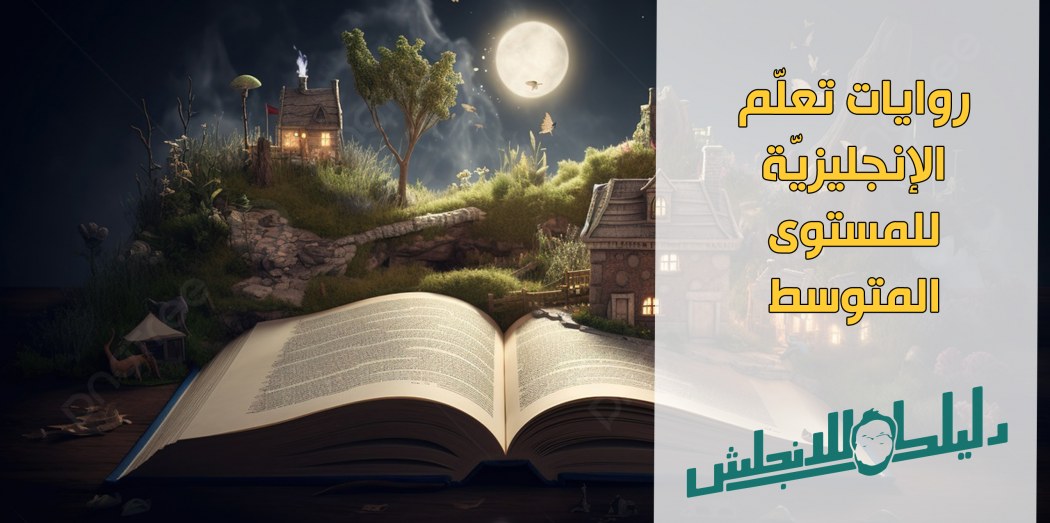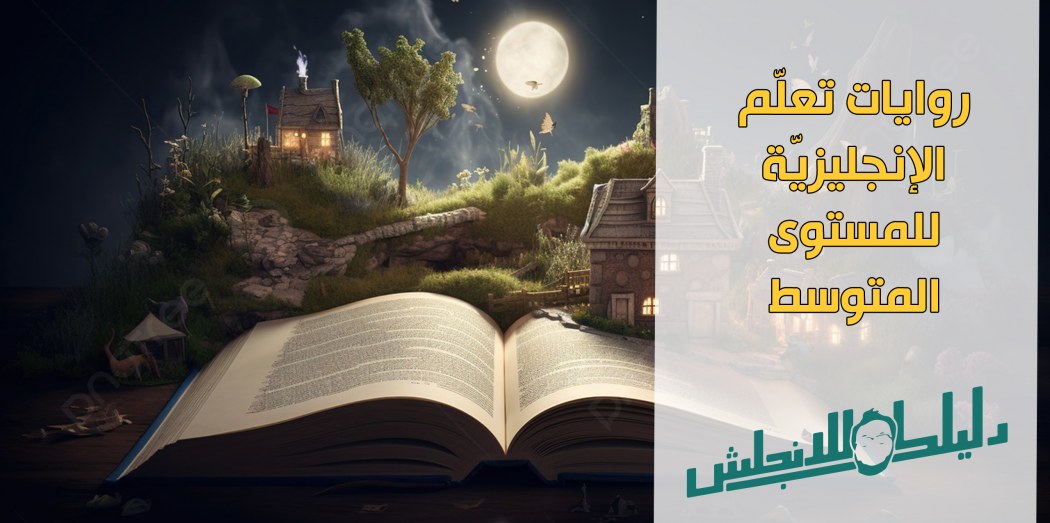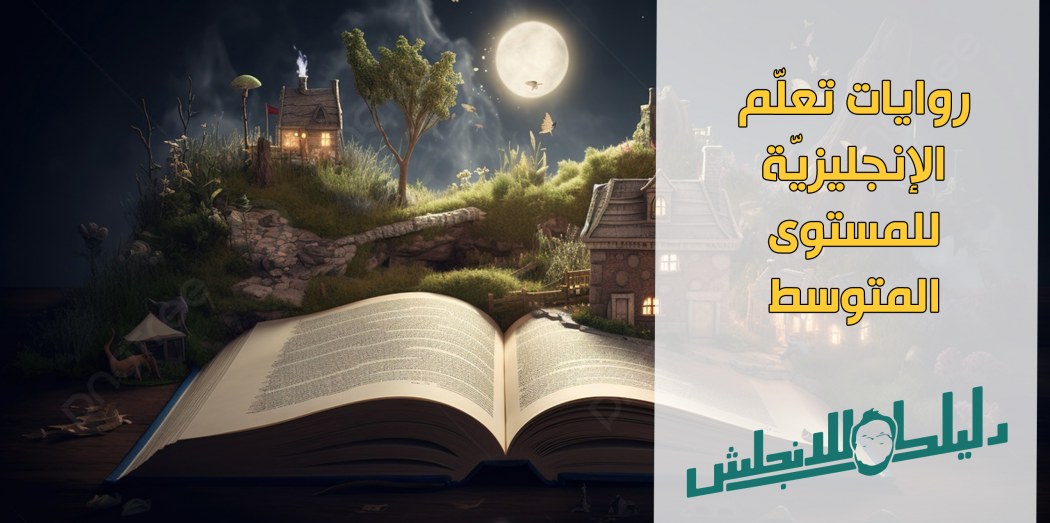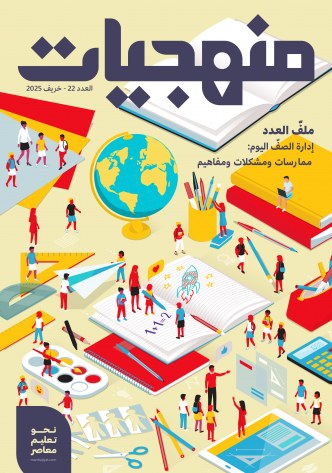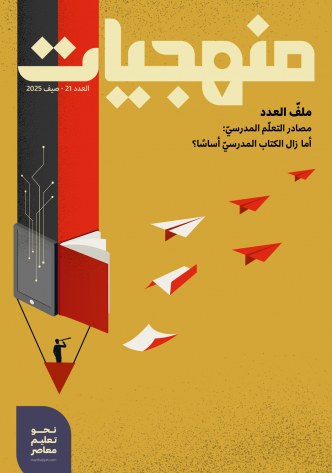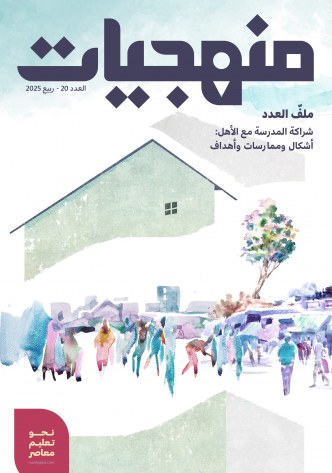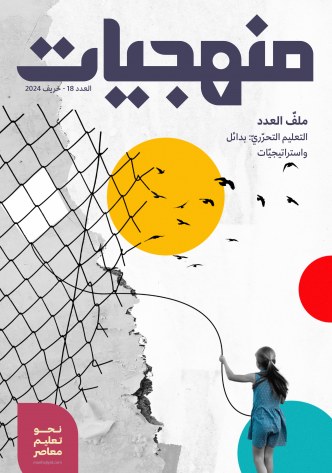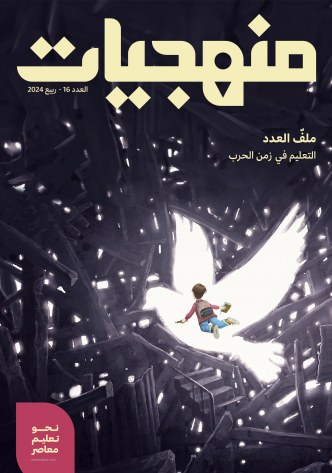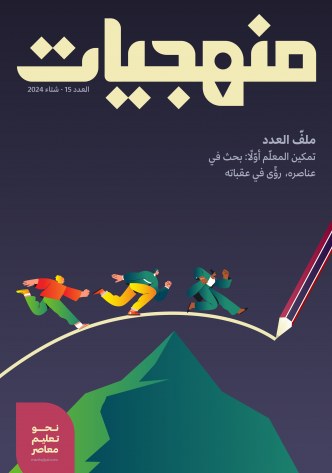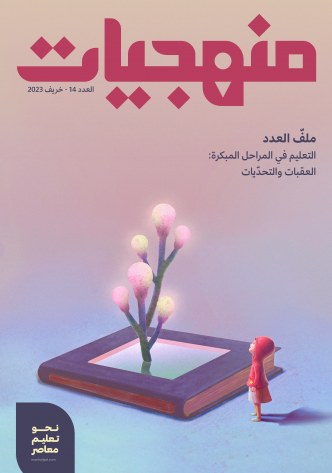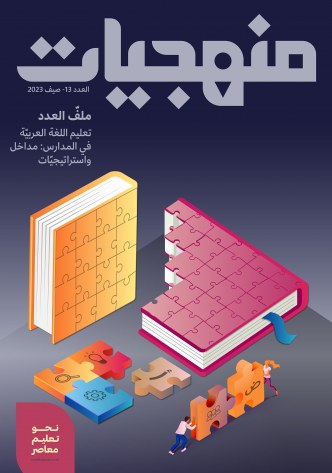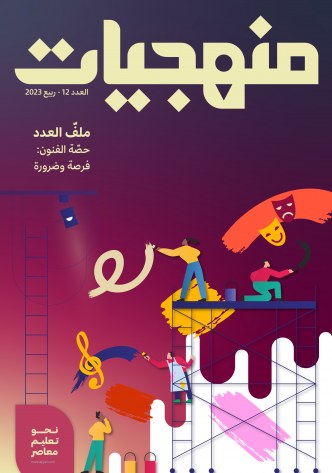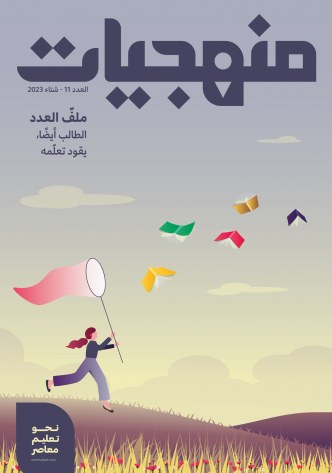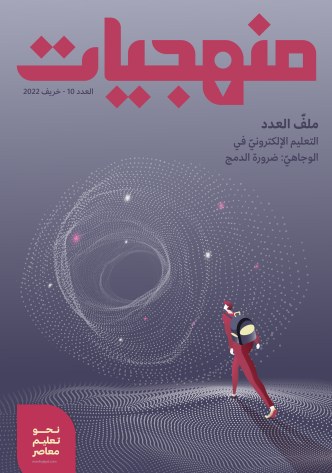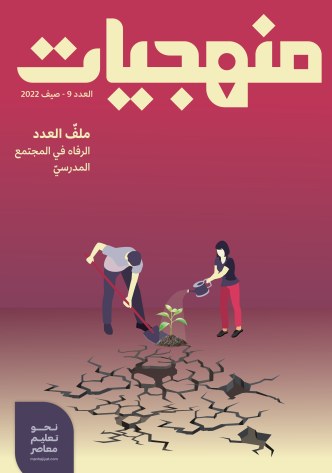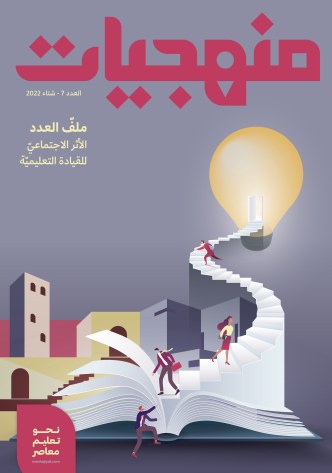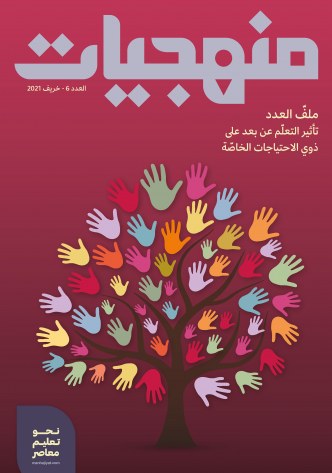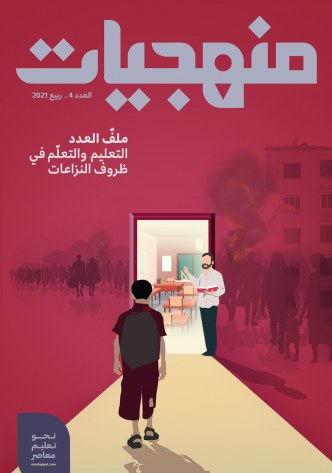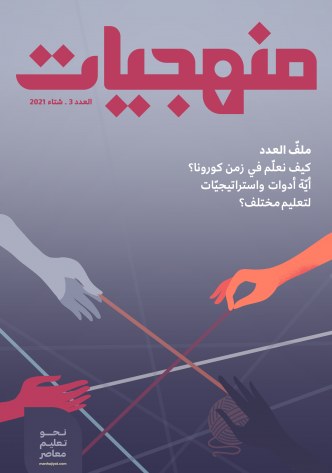الرئيسية
العدد (23) شتاء 2026
ملفّ العدد القادم
دعوة للكتابة في الأعداد القادمة
أخبار تربويّة
انطلاق أعمال النسخة 12 من قمّة "وايز" في الدوحة بمشاركة قادة التعليم العالميّين
منهجيّات تُشارك في مؤتمر المعلّمين السنويّ في الأردن
منهجيّات تعقد دورتها التدريبيّة التاسعة في مجال كتابة المقال المهنيّ
في كلّ عدد تختار منهجيّات قضيّة أو مفهومًا تربويًّا تخصّص له ملفًّا يشارك فيه خبراء وأكاديميّون ومعلّمون في مقالات وتجارب وتحليلات، تتناول الموضوع من جوانبه المختلفة. يشكّل الملفّ رافدًا مهمًّا للمعلّمين والباحثين والمهتمّين.
مقالات عن تجارب وتأمّلات وتقنيّات تعلّميّة – تعليميّة، غير مرتبطة بموضوع أو قضيّة محدّدة، ومفتوحة للمُشاركة دائمًا.
الندوة القادمة
دعوة إلى ندوة: حول تجربة الاعتماد.. استيراد أعمى أم تجربة تعلّم؟
ندوة منهجيّات الشهريًّة مساحة نقاش مفتوح يتناول موضوعًا يتجدّدُ، يشارك في الندوة مختصّون تربويّون ومعلّمون خبراء في موضوع الندوة.
ندوة: الرؤية التربويّة الحديثة إلى التعليم الشامل.. ممارسات وتحدّيات
ندوة: تمدّد مهنة التعليم خارج الصفّ: الأعباء الوظيفيّة للمعلّم، مشكلات واقتراحات
مساحة تعبيريّة مفتوحة للمعلّمين والمختصّين، تتمحور حول عرض أفكار ووجهات نظر نقديّة وأحلام شخصيّة انطلاقًا من تجربة تعليميّة، ولا تتوقّف عند ذلك.
حوار مباشر مع معلّمات ومعلّمين، يتمّ بالإجابة عن مجموعة أسئلة عن الحياة في المدارس، وتجارب مختلفة وتحدّيات يوميّة. كلّ المعلّمين مدعوّون إلى المشاركة في الدردشة لنقل آرائهم ومقارباتهم الخاصّة.
أسماء سليمان العبد الرحمن- معلّمة- الأردنّ
عبد الجبّار جاوي - أستاذ التعليم الابتدائيّ - الجزائر
محمّد جمال محمّد- عضو هيئة تدريس في كلّيّة التربية- مصر
تتوجّه مقالات الوالديّة الى أهالي المتعلّمين المهتمّين بتعليم أبنائهم وتأمين نموّ سليم لهم على كلّ الصعد، حيث تتناول المقالات معظم القضايا المرتبطة بالتربيّة والسلوك والمواقف المختلفة.