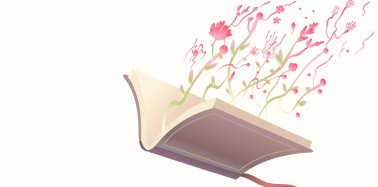في ظلّ عالم يتّسم بالتغيّر المتسارع، والتداخل المستمرّ بين المعارف والعلوم، لم تعد المعرفة محصورة في أطر التخصّصات المنفصلة. ولا يكفي أن يتقن الطالب مفاهيم كلّ مادّة بمعزل عن الأخرى، ليكون مستعدًّا لمواجهة تحدّيات العالم الحقيقيّ. ومع تطوّر فلسفات التعليم نحو تكامل أعمق بين الفروع المعرفيّة، يبرز التعليم متداخل التخصّصات بوصفه نهجًا تربويًّا حديثًا، يسعى لتجاوز الحواجز بين الموادّ الدراسيّة، ويفتح أمام المتعلّم آفاقًا لفهم أعمق وأشمل، يجمع بين التفكير النقديّ، والربط المنطقيّ، والإبداع في حلّ المشكلات.
يأتي برنامج السنوات المتوسّطة في البكالوريا الدوليّة ليقدّم نموذجًا واضحًا لهذا التوجّه، إذ يُشجّع المعلّمين على تصميم تجارب تعليميّة تدمج بين الفروع المعرفيّة، وتحفّز الطلّاب على استكشاف المفاهيم من زوايا متعدّدة. هذا النوع من التعلّم لا يهدف فقط إلى إثراء المحتوى، بل إلى بناء المعنى، وتنمية مهارات الربط بين المعارف، وتطبيقها في سياقات واقعيّة وذات صلة بحياة الطالب.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، يسعى هذا المقال لعرض تجربة ميدانيّة في تخطيط وحدة تعليميّة متداخلة التخصّصات بين مادّتَيّ "اللغة والأدب" و"العلوم" وتطبيقها وتقييمها، نُفّذت في صفوف المرحلة المتوسّطة في مدارس الظهران الأهليّة؛ حيث خاض الطلّاب تجربة الدمج بين المادّتَين، لفهم أجهزة الجسم والعلاقة الوظيفيّة بينها، والذي به يتحقّق التوازن الصحّيّ عبر تعزيز أدواتهم اللغويّة، للتعبير الدقيق والواضح عن هذا المحتوى.
المرحلة الأولى: التخطيط
خُطّطت هذه الوحدة بعناية، بالعمل المشترك بين معلّمي اللغة العربيّة والعلوم، ووفق رؤية تربويّة شموليّة تُراعي عمق التداخل بين المادّتَين. بُنيت الوحدة على مفهوم "العلاقات"، بوصفه مدخلًا إلى فهم التفاعل بين مكوّنات الجسد البشريّ من جهة، والتفاعل بين المتعلّم والنصّ والمعنى من جهة أخرى. كما انطلقت الوحدة من مفاهيم ذات صلة في كلّ تخصّص، فجاء "التوازن" في العلوم مفهومًا أساسيًّا لفهم طبيعة عمل الأنظمة الحيويّة في جسم الإنسان، وكيف أنّ الخلل في هذا التوازن قد يؤدّي إلى اضطرابات صحّيّة. أمّا في اللغة والأدب، فقد ظهرت مفاهيم "الأسلوب وضروريّات الجمهور" محورَين رئيسَين في بناء المقال العلميّ أو المعلوماتيّ، إذ يُدرّب الطالب على كيفيّة مخاطبة القارئ بلغة دقيقة وواضحة ومراعية للسياق والهدف. وقد نُسجت هذه المفاهيم جميعها ضمن سياق عالميّ يتمثّل في "الهويّات والعلاقات"، مكوّنة جملة التقصّي: "إنّ العلاقة بين أجهزة الجسم والترابط الوظيفيّ يحقّق الاستقرار والاتّزان الصحّيّ، ويؤثّر في أساليبنا، وهويّاتنا الغذائيّة التي تحدّ من الأمراض"، عبر صياغة أسئلة استقصائيّة: مثلًا في العلوم، سُئل الطلّاب عن "مدى ملاءمة التركيب مع وظيفة أجهزة الجسم". بينما ناقشوا في اللغة كيفيّة "كتابة مقال بأسلوب مميّز يراعي ضرورات الجمهور".
المرحلة الثانية: التنفيذ
كانت هذه الوحدة جسرًا معرفيًّا حيًّا بُني بين العالم المادّيّ للجسم الإنسانيّ، والعالم الرمزيّ للغة. بدأ الفريق التربويّ من موضوع يتّصل بحياة الطلّاب اتّصالًا مباشرًا: أجهزة جسم الإنسان. وفي غضون أسابيع من التعلّم المدمج، استكشف الطلّاب تركيب الجهاز الهضميّ والدوريّ والتنفسيّ ووظائفها، وتأمّلوا كيفيّة عملها معًا بانسجام للحفاظ على الصحّة، ووُظّف ذلك في إنتاج معرفيّ لغويّ؛ فكان على الطالب أن يعبّر عمّا تعلّمه بكتابة مقال علميّ أو معلوماتيّ، يتقن فيه استخدام اللغة بوصفها أداة تواصل وتفسير وإقناع. وتدرّب الطلّاب على تحليل نماذج لمقالات متنوّعة، واكتساب مهارات بناء الحجّة، وتوظيف أدوات لغويّة تناسب جمهورهم، وتطوير أسلوب شخصيّ يُراعي الدقّة والوضوح والجاذبيّة. وقد أصبح الطالب هنا وسيطًا بين العلم واللغة، يُترجم المعارف البيولوجيّة إلى نصوص يمكن للآخرين فهمها والتفاعل معها، ومنتجًا للمعرفة، لا مجرّد متلقٍّ لها.
ركّزت الوحدة على إشراك الطلّاب في تعلّم حيّ ومحسوس وتشاركيّ. فبدلًا من الاكتفاء بالشرح النظريّ، نُظّمت مراكز تعلّم مثّلت أجهزة الجسم المختلفة، يتنقّل بينها الطلّاب في مجموعات تعاونيّة، يجمعون فيها المعلومات، ويحلّلون النماذج، ويقارنون ويناقشون ويجرّبون، وصولًا إلى بناء معرفيّ عميق ناتج عن البحث والاستقصاء. ورافق هذا الجهد العلميّ تنظيم أنشطة لغويّة متعدّدة، من بينها تحليل بنية المقال وتطبيق استراتيجيّات مثل: أخذ الملاحظات، واستخدام المنظّمات البيانيّة، ومقارنة الأساليب التعبيريّة، بما يُتيح بناء نصّ مؤسّس على تفكير تحليليّ ونقديّ.
وفي نهاية الوحدة، أنجز الطلّاب مخرجًا نهائيًّا جمع بين البعد التخصّصيّ واللغويّ، تمثّل في كتابة مقال علميّ معلوماتيّ يُعبّر عن فهمهم لمفهوم الاتّزان الصحّيّ، والعلاقة بين أجهزة الجسم والغذاء، باستخدام لغة سليمة وواضحة تراعي بنية المقال ومتطلّبات القارئ، مستندين إلى معايير الأداء في برنامج السنوات المتوسّطة (MYP) للوحدات المتداخلة، والتي تركّز على التقييم والتركيب والتأمّل. وقد تلقّوا تدريبًا يمكّنهم من الجمع بين المهارة العلميّة والدقّة اللغويّة في تجربة متكاملة.
في تقييم الوحدة المتداخلة
وفي مرحلة التقييم، برزت خطواته عنصرًا بنائيًّا مدمجًا في صلب عمليّة التعلّم؛ إذ يُوجّه المتعلّمين، ويعزّز إدراكهم الذاتيّ، ويزوّدهم بمؤشّرات واضحة نحو تحقيق الأهداف المعرفيّة والمهاريّة. وقد انطلق التقييم منذ اللحظة الأولى باختبار تشخيصيّ، كما ذُكر سابقًا، هدفه قياس المعرفة القبليّة؛ فتمكّن المعلّمون من رصد الفجوات، وتحديد نقاط القوّة والضعف لدى الطلّاب. وأظهرت نتائج هذا التقييم أنّ لدى بعض الطلّاب تصوّرات غير دقيقة حول العلاقة بين أجهزة الجسم؛ فمثلًا خلط أحدهم بين وظائف هذه الأجهزة، ما قاد المعلّم إلى تخصيص أنشطة توضيحيّة تراعي هذا الخلط المفاهيميّ. أمّا في مادّة اللغة، فقد أظهر التقييم أنّ عددًا من الطلّاب غير متمكّنين من بناء مقال علميّ موجّه يراعي ضرورات الجمهور؛ لذلك، نُظّمت ورش عمل تدريبيّة مصغّرة اطّلع فيها الطلّاب على نماذج متنوّعة من المقالات، بعد تحليل بنيتها وأسلوبها، وهو ما انعكس لاحقًا على جودة المسوّدات الأولى.
ولم يقتصر التقييم على المرحلة التمهيديّة، بل تواصل بشكل تكوينيّ عبر مراحل متعدّدة من الوحدة، فتنوّعت أدواته بين الملاحظات الصفّيّة، وتحليل المسوّدات، والعروض الشفهيّة، ومهامّ التفكير النقديّ. وكانت كلّ خطوة من خطوات التعلّم متبوعة بتغذية راجعة مباشرة ومنظّمة. فعندما كتب أحد الطلّاب مقالًا افتقر فيه إلى الحُجج العلميّة، تلقّى ملاحظات بنّاءة أشارت إلى مواضع الضعف، واقتُرح عليه إدراج أدلّة من الدروس أو تجارب علميّة مرّت في الصفّ. استجاب الطالب لهذه الملاحظات، وأعاد بناء مقالته مستعينًا برسم توضيحيّ يشرح العلاقة بين الجهاز الهضميّ ونمط التغذية. وفي حالة أخرى، تبيّن أنّ إحدى الطالبات تميل إلى الكتابة الوصفيّة العامّة، فكُلّفت باستخدام مخطّط بيانيّ لتنظيم الأفكار، وتوجيهها نحو انتقاء معلومات دقيقة مدعومة بالأمثلة.
وتمثّلت المهمّة الختاميّة في كتابة مقال علميّ يُظهر مدى فهم الطالب للتوازن الصحّيّ، بوصفه ناتجًا عن تفاعل أجهزة الجسم والغذاء، وذلك باستخدام لغة علميّة دقيقة تراعي بنية المقال ومتطلّبات القارئ. وقد أبدع الطلّاب في توظيف المهارات المكتسبة، إذ تضمّنت بعض المقالات رسومات مرافقة، وتعريفات دقيقة للمصطلحات العلميّة أظهرت وعيًا بأسلوب الكتابة الأكاديميّة. كما عبّر بعض الطلّاب عن تجربتهم الشخصيّة في تغيير أنماطهم الغذائيّة بعد التعمّق في فهم وظائف الجهاز الهضميّ، ما منح مقالاتهم بعدًا إنسانيًّا متّصلًا بالواقع.
وقد قُيّمت المقالات النهائيّة وفق معايير برنامج السنوات المتوسّطة (MYP) الخاصّة بالوحدات المتداخلة، وهي التقييم والتركيب والتأمّل. وطُلب إلى المتعلّمين استخدام هذه المعايير لتقييم أنفسهم وزملائهم قبل التقييم النهائيّ، ما أسهم في تنمية مهارات التقييم الذاتيّ والتفكير الناقد. ونتيجة لهذا النهج المتكامل، أظهرت تقارير التقييم تطوّرًا ملموسًا في قدرات الطلّاب، إذ انتقلوا من التعلّم القائم على التلقين إلى التعلّم القائم على الاستقصاء والتطبيق الواقعيّ، ما يعكس تحقّق الأهداف التربويّة لهذه الوحدة بفاعليّة وعمق. كما أظهرت نتائج التقييم النهائيّ ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الأداء مقارنة بالتشخيص الأوّليّ، ما أكّد أثر التعلّم البنائيّ والتقييم المرحليّ في تعميق الفهم، وتعزيز ثقة الطالب بدوره بصفته متعلّمًا واعيًا.
تأمّلات في التجربة
عند الانتقال من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ الأهداف بممارسات حيّة في غرفة الصفّ، لم يكن المقصود من تنفيذ هذه الوحدة أن تُدرّس مفاهيم العلوم واللغة كلًّا على حدة، بل أن يعيش الطلّاب تجربة تعليميّة متكاملة، تتناغم فيها المعرفة العلميّة مع التعبير اللغويّ، في سياق إنسانيّ مرتبط بحياتهم اليوميّة. وقد اتّخذ التنفيذ شكلًا تفاعليًّا قائمًا على استراتيجيّات التعلّم النشط، فوظّفت استراتيجيّات مثل التعلّم التعاونيّ والترميز وأخذ الملاحظات والتلخيص، إلى جانب البحث والتقصّي الذي دفع الطلّاب إلى طرح الأسئلة، والبحث عن الأجوبة في مصادر متنوّعة. ففي حصص العلوم، كان التعلّم يدور حول الفهم التطبيقيّ لأنظمة الجسم؛ إذ صُمّمت أنشطة عمليّة تعتمد على النمذجة، والرسم التوضيحيّ، ومجسّمات للأجهزة باستخدام خامات متعدّدة، كما استُخدمت الاستبانات الغذائيّة مدخلًا إلى تحليل أنماط التغذية الحقيقيّة للطلّاب، وربطها بما درسوه حول وظائف الجسم وعلاقتها بالصحّة.
أمّا في حصص اللغة، فقد عومل الطالب بوصفه كاتبًا وباحثًا، لا مجرّد متلقٍّ لقواعد الكتابة. خاض الطلّاب تجربة تحليل مقالات متعدّدة، مستكشفين سماتها من حيث البنية والأسلوب وملاءمة الجمهور. ثمّ كتبوا مسوّداتهم الأولى، مستخدمين منظّمات بيانيّة لتنظيم أفكارهم، ومطبّقين مهارات الترميز لاستخراج الفكرة الرئيسة والأدلّة الداعمة. وقد صاحبت كلّ خطوة من هذه الخطوات تغذية راجعة موجّهة؛ لترشد المتعلّم إلى كيفيّة الكتابة بعمق، والتعبير بأسلوب أكثر تأثيرًا.
ما يميّز تنفيذ هذه الوحدة تعدّد أنشطة المشاركة؛ فالفصل أصبح ساحة مفتوحة لتبادل الآراء والنقاشات وتفسير التجارب والاحتكام إلى الأدلّة. ونُفّذت أركان متنوّعة يمثّل كلّ منها جهازًا من أجهزة الجسم، قدّمت للطلّاب سيناريوهات حقيقيّة وأسئلة مفتوحة مثل: "كيف سيؤثّر ضعف التنفّس في توزيع الغذاء في الجسم؟"، أو "هل يمكن لنمط غذائيّ أن يُحدث خللًا في التوازن الداخليّ؟". هكذا بدأ الطالب يرى العلم في نفسه، ويدرك اللغة بوصفها جسرًا للتعبير عن هذا الفهم.
شكّل تنفيذ هذه الوحدة لحظة تحوّل في إدراك الطالب لدوره في التعلّم؛ فلم يعد متفرّجًا، بل أصبح مشاركًا: يسأل ويبحث ويُعيد الصياغة ويناقش ويتأمّل. وعندما طُلب إلى المتعلّمين في نهاية الوحدة كتابة مقال علميّ (معلوماتيّ) يجمع بين الفهم البيولوجيّ لأجهزة الجسم والوعي بأساليب التعبير المؤثّرة، كانت هذه المهمّة الختاميّة نتاجًا لرحلة من التجريب والتفكير، ظهرت فيها قدرة كلّ طالب على دمج المعرفة بالتعبير في موقف تعلّميّ يعكس واقعه، ويخاطب اهتماماته، ويقوده إلى فهم أعمق لذاته وعلاقته بالعالم.
***
يتّضح لنا بهذه التجربة التربويّة أنّ الدمج بين الموادّ الدراسيّة، وتحديدًا اللغة والأدب من جهة، والعلوم من جهة أخرى، قد أوجد بيئة تعليميّة محفّزة وثريّة، جعلت الطالب باحثًا ومفكّرًا ومبدعًا. فقد وُضعت المفاهيم في سياق حياتيّ واقعيّ، فتحقّقت الفائدة، وبرز المعنى، وازداد الحافز للتعلّم. يعزّز هذا النوع من التعلّم المتكامل المعرفة، ويبني مهارات التفكير النقديّ وحلّ المشكلات والتواصل، وهو ما تحتاج إليه مجتمعاتنا اليوم لتواكب المجتمعات المتطوّرة.
يُعدّ ما أُنجز في هذه الوحدة نموذجًا لتعلّم حقيقيّ يرتبط بالحياة، ويجعل الطالب صانعًا للمعرفة، وناقدًا لنفسه، ومشاركًا في مجتمعه. من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في تصميم المناهج التعليميّة، بحيث تتجاوز الحواجز بين التخصّصات، وتعتمد على التعلّم القائم على المفاهيم والتكامل والاستقصاء. فالتعليم متداخل التخصّصات ضرورة في زمن تتداخل فيه القضايا، وتتعاظم الحاجة إلى جيل مفكّر ومبدع، وقادر على الربط بين ما يتعلّمه وما يعيشه.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025