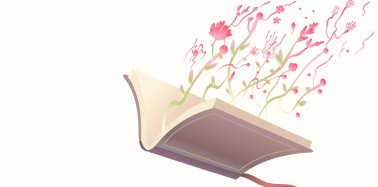في ظلّ العولمة، تتداعى أغلب الأنشطة الإنسانيّة في اتّجاه تسليعها وتشييئها، وطرحها باعتبارها بضاعة خاضعة لقانون العرض والطلب، فتغدو موضوع استهلاك سريع لمنتوج لا نكلّف أنفسنا وقتًا لمعرفة مكوّناته، ولا درجة أصالته، ولا حدود منفعته. فالبضائع المعروضة على رصيف الاستهلاك عديدة ومختلفة؛ نعثر فيها على السلعة الغذائيّة والدينيّة والتقنيّة والبيداغوجيّة، ونتكالب عليها، ونعجّل باستعمالها في مواقف مهنيّة، معتقدين نجاعتها، ومستبشرين بقلّة كلفتها وسرعة الحصول عليها عبر بوّابات الإنترنت. ترانا نبحث على عجل عن تقنيّات التنشيط، وحين نعرف عنها، نجرّبها في الفصول في عمليّة إسقاط بيداغوجيّ، قبل أن ندرك الفلسفة التي تحتضنها، ونتشبّع من معينها النظريّ ومن التجارب الرائدة التي اعتمدتها وأظهرت قيمتها. فأن نتحدّث عن التنشيط في التربية الحديثة من دون أن نعرف جان جاك روسّو، أو نطّلع على تجارب فريني وديكروليه ومونتسوري وجون ديوي، أو من دون أن ندرك أثر الفعل النشيط في كيفيّة البناء المعرفيّ لدى الطفل، وقدرته على إحداث قطائع إبستيميّة بين معارفه العفويّة والمعارف العلميّة التي سيبنيها في جدله المعرفيّ والثقافيّ مع أترابه ومعلّمه في الفصل، سيكون كلّ هذا مجرّد سرد بلا معنى.
نسمع من عديد المدرّسين حديثًا عن تقنيّات "فيليبس"، و"العصف الذهنيّ"، و"تقنيّة المحادثة"، و"حلّ المشاكل"، و"المحاكاة ولعب الأدوار" وغيرها، وكأنّها وجبات سريعة تُقدَّم في كلّ الأوقات والحالات، من دون فهم سياق كلّ منها، ولا أهدافها القريبة والبعيدة. لذا، فإنّ وعيًا تربويًّا فلسفيًّا (يهتمّ بالمبادئ والغايات) يُعدّ اليوم مطلبًا مُلحًّا في فكر المدرّسين وفي تكوينهم، من أجل بناء قناعة راسخة بما يحتاج إليه التعليم التحويليّ. فللفلسفة الحقّ في التفكير في معنى التربية ورهانها، طالما أنّ "الطفل–الإنسان" عصبها، حتّى لا تُصاب بالعمى، وتتحوّل إلى أداة طيّعة لإنتاج نماذج سلبيّة من البشر.
فالزمن المعولم، في علاقته بسوق التعليم، يفرض على المربّين لهفة الاستهلاك وإيقاعه المتسارع، لكنّه يخشى التفكير في بضاعته قبل استعمالها، لأنّ التفكير عادة ما يطرح أسئلة حول المنشأ والتركيبة والنجاعة. ولنا أن نتساءل: هل للعمل بتقنيّات تنشيطيّة معنى في فصول أرهقها التعليم البنكيّ واستنزفها التطبيق؟ وهل يمكن لبعض التقنيّات أن تنجح، بينما عقليّة الفاعل التربويّ ما تزال أسيرة المحتويات والمضامين؟ وأين موقع مهارات الحياة في عقليّة تربويّة ترتدّ في لا وعيها إلى التلقين، أكثر ممّا تذهب بإرادتها الواعية إلى الخلق والبناء؟
الخلفيّة الفلسفيّة للتنشيط التربويّ
يتصوّر العديد من الفاعلين التربويّين أنّ التعلّم النشيط أمر بسيط، مرهون ببعض السلوكيّات الانفتاحيّة نمارسها على الطفل وعلى مشاركاته في الفصل، في حين أنّه يختلف بنيويًّا عن هذا التصوّر، إذ يُعدّ نمطًا من التعلّم المؤسّس على خلفيّة فكريّة كاملة، في مواجهة ومقاومة للنموذج "الوضعيّ" (positif) للمدرسة، ولطابع التعليم البنكيّ فيها. وهو مفهوم عميق في ثوريّته وجرأته وإنسانيّة مقاصده، ويتغذّى من ينابيع فلسفة التربية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس والأخلاق.
حين يعتمد المدرّس تعليمًا نشيطًا، فإنّه في حقيقة الأمر يدشّن أولى خطوات التغيير الحقيقيّ في إدارة فعل التعلّم، وبداية تحرّره من النمطيّة. فمن أهمّ المداخل "لإصلاح منظومة التربية والتعليم، والحدّ من أزماتها الخانقة، وتجديدها بيداغوجيًّا وديداكتيكيًّا، الاعتماد -بشكل أساسيّ- على فلسفة التنشيط، بتمثّل مبادئها النظريّة، والاستعانة بتقنيّاتها العمليّة (حمداوي، 2015).
وحين يبحث التنشيط لنفسه عن معنى ومشروعيّة ليتأسّس باعتباره مقاربة، فإنّه يجذّر التوجّه نحو الأبعاد الاجتماعيّة والثقافيّة والسيكولوجيّة للطفولة. وحتّى يوفّق المربّون في مسعاهم، حريٌّ بهم أن يعاملوا الأطفال وفق أمزجتهم ورغباتهم، وتركهم يسلكون الطريق الذي تمليه عليهم طباعهم بكلّ حرّيّة، حتّى يروا ما هي عليه أنفسهم أو جوهرها، كما يذهب في ذلك روّاد التربية الحديثة (ج.ج. روسو وجون ديوي وغيرهما). فللطفولة طريقها الخاصّ في الإحساس والتفكير واستكشاف العالم. وإذا تأصّل هذا الإدراك السليم قناعةً راسخة في العقل البيداغوجيّ للمدرّسين، فذلك يقتضي منهم تغيير موقع الطفل في أذهانهم: من كونه مجرّد متقبّل، إلى كونه مكتشفًا ومشاركًا في إنتاج المعرفة والقيمة، ضمن إدارة صفّيّة نشيطة يكون فيها الطفل فاعلًا، ويكون المدرّس مؤطّرًا. والحرص على بلوغ هذا الأفق من الحداثة في الرؤية والممارسة البيداغوجيّة، لا يحجب عنّا أهمّيّة الجهد الكبير الذي يبذله المعلّمون في تأمين المهمّة التربويّة، على الرغم من قسوة الظروف، وضآلة الأجور، وتقادم البنى التحتيّة، وتواضع تكوينهم الأساسيّ والمهنيّ، وهذه مسؤوليّة تتحمّلها وزارات التربية والتعليم. يترجم المدرّسون هذا التوجّه نحو الحداثة في التربية بمقاربات وطرائق أُقرّت ضمنًا في مناهج بلدانهم التربويّة، أو بما يتماشى مع توجّهاتها العامّة. ويمكن لهم أن يجدّدوا ممارساتهم ويطوّروها ضمن إطار أهدافها وغاياتها. ولا تتجاوز مسؤوليّة المدرّس حدود ما يخطّط له وينجزه وفق توجّهات المنهاج التربويّ في بلده ومقارباته. ويُعدّ المدرّس عاملًا من جملة عوامل موضوعيّة أخرى تؤثّر في وضع التعليم ومخرجاته في بلداننا، سلبًا أو إيجابًا.
وُلدت المقاربة النشيطة من رحم خطاب الحداثة الذي آمن بالذات وتجلّياتها، فأنتجت مداخل متنوّعة للعناية بالذوات الطفوليّة، مثل التعلّم الذاتيّ، والتعلّم باللعب، والتعلّم بالوضعيّة المشكلة، والتعلّم بالمشروع. وسيكون لها مكانة ودور في خلق القابليّات ورعايتها لتتحوّل إلى مهارات ذاتيّة تتطوّر وتنمو، وتشكّل شخصيّات متوازنة وفاعلة. ومن المطلوب أن يكون وعي المدرّسين وممارساتهم البيداغوجيّة ضمن هذا الأفق، تحرّرًا من التلقين والتخزين.
ماهيّة التنشيط التربويّ
في إحالة إلى المعجم، وتحديدًا إلى الجذر المعجميّ (نشط) الذي تتفرّع منه ينشط/ نشاط، ونشّط/ينشّط/ تنشيط... ويفيد معنويًّا: طابت نفسه له بما يفيد التحفيز والرغبة والعزم على فعل الشيء. أمّا اصطلاحًا، فهو "مجموعة من التصرّفات والإجراءات التربويّة المنهجيّة والتطبيقيّة التي يشارك فيها كلّ من التلميذ والمدرّس قصد العمل على تحقيق أهداف مسطّرة لدرس أو جزء من درس ما" (سعيدة وآخرون، 2009)، ويكون فيها التلميذ الفاعل، بمساعدة مدرّس يؤمن أنّ الطفل هو المعنيّ بإنتاج المعنى وتوظيف المعرفة.
ويتميّز التعليم النشيط بقصديّته، فهو "فعل هادف ممتع ومرن ذو تأثير على الأفراد والفِرَق والجماعات. يعتمد على الطرق الحيّة في التنشيط، ويوظّف مجموعة من الموارد التنشيطيّة باعتبارها وسائل وأدوات تحقّق غايات تربويّة وثقافيّة واجتماعيّة وصحّيّة يمكن قياسها" (ناعم، 2020). وهو، إلى جانب كلّ هذا، ذو طبيعة بيداغوجيّة تفاعليّة منظّمة، يأبى أن يغرق في ما هو معرفيّ صرف وينغلق فيه. ويصير المدرّس ضمنه منشّطًا بيداغوجيًّا ومديرًا جيّدًا للتواصل والتفاعل مع الأطفال، ومثمّنًا لأدوارهم، ومعالجًا لصعوباتهم، ويتكفّل بتوجيه قدراتهم وتطويرها بما يقترحه من تدريبات ومهمّات، وما يبثّه من شعور بالراحة والغبطة لدى منظوريه، وما يقوم به من تعزيز إيجابيّ لمجهوداتهم.
تُحدِث استراتيجيّة التنشيط رجّات في معتقدات العقل البيداغوجيّ الذي سيطر عليه التعوّد (L’habitus)، وسجنته الروتينات التعليميّة؛ فهي حركة في صلب الساكن، ترمي بالمتعلّم في أتون الاكتشاف وإنتاج الأفكار ومماحكتها (منازعتها) في الواقع، وتمكين قدراته الكامنة من الخروج إلى الضوء، وتجربة نفسها في أشكال تعبيريّة متنوّعة حسّ - حركيّة وذهنيّة وفنّيّة. "فالنشاط ضدّ الثبات والسكون والانطواء والتقاعس (...)، إذ هو بمثابة الدينامو المحرّك لطاقات الفرد، والمحفّز الإيجابيّ لقوى الجسد والذهن والفكر" (حمداوي، 2015). إنّه يرفع من دافعيّة الأطفال ومردودهم، ويخفّض من نزعاتهم العدوانيّة، كما يُضعف هيمنة بيداغوجيا الإلقاء والتلقين، لصالح بيداغوجيا الاكتشاف والبناء والإبداع، والميل نحو المشاركة الجماعيّة، والاشتغال ضمن فريق.
التنشيط التربويّ في مؤسّساتنا: بين الموجود والمنشود
لحظة نرصد التنشيط باعتباره ممارسات تخترق سكون الجدران وخَرَس الطاولات، ونبحث عن بعض آثاره في مهارات الأطفال، ندرك أنّ الموضوع الذي تحدّثت عنه فلسفة التربية وتعمّقت في بيان وجاهته، غير مُؤسّس ولا مُعمّم، ولا نجده إلّا لدى نسبة محدودة من المدرّسين، يصعب أن نثبت بها تأثيرًا دالًّا في تطوير مهارات الفكر الناقد والتواصل والإبداع لدى الأطفال. إذ لا تزال مدارسنا رهينة التلقين والضبط في ممارساتها، ولا تزال تلهث خلف المحتوى وكيفيّات تخزينه واستعادته أكثر من توظيفه، خلافًا للخطاب البيداغوجيّ المختصّ (خطاب الخبراء) الذي يرتمي في المستقبل، ويتابع أحدث الاختصاصات العلميّة والمعرفيّة ذات العلاقة بمداخل التعلّم والتكيّف.
فهذا الانفصام بين ما تدركه "النخبة" الخبيرة علميًّا، وبين ما ينجزه الفاعلون ميدانيًّا، هو علّة العلل؛ إذ لم يتمكّن تشرُّب المدرّسين للمعرفة الفلسفيّة والبيداغوجيّة من أن يغيّر بشكل دالّ روتيناتهم البيداغوجيّة. ولنا أن نتساءل: كم أُنجِز من درس إيقاظيّ أو جغرافيّ أو تاريخيّ أو قيميّ خارج الجدران، بشكل مباشر أو افتراضيّ في مؤسّسة ما؟ كم من تجربة في إنتاج جريدة مدرسيّة ورقيّة أو رقميّة في مدرسة ما، يؤثّثها الأطفال بتقاريرهم وكتاباتهم ورسوماتهم المتنوّعة؟ كم من تَراسُل عبر المكتوب ورقيًّا أو رقميًّا بين مدرستين أو أكثر، للتعريف بمناطقهم وما تحويها من ثقافة وعادات؟
تنخفض وتيرة هذه الأنشطة الحيّة في مدارسنا، والتي ضمنها يعيش الطفل إرهاصات فكرة المشروع، وصعوبات التخطيط لها، والابتهاج والرضا عنها حين تصير مُنجَزًا طفوليًّا متحقّقًا. وتعوّضها أنشطة التعليم البنكيّ، لتدفع شخصيّة الطفل الثمن من جرّاء قصف التلقين لها، وضمور العناية بالموهبة والرغبة والعاطفة فيها؛ فيكون الحاصل أنّنا ننتج ما يشبه روبوتات من دون وعي ولا إحساس.
***
لعلّنا وُفّقنا بدرجة معيّنة في إظهار تهافت الاعتماد على تقنيّات بيداغوجيّة تنشيطيّة، من دون الارتكاز إلى خلفيّتها الفلسفيّة التربويّة ووَعي مقاصدها بشكل معمّق. إذ لا يتجلّى جوهر التربية والتعليم في تطبيق حرفيّ لتقنيّات معروضة في سوق التداول البيداغوجيّ، وإنّما يظهر في وضوح الرؤية لدى المعلّم بعد أن يتشرّب مرجعيّاتها الفلسفيّة. فنحن في حاجة أكيدة إلى إحياء تجارب التربية النشيطة وإثرائها، ليتشكّل بها تعلّم أطفالنا، ويتصيّر خارج الجدران وفي أحضان الطبيعة المفتوحة، محميّة كانت أو غابة أو مَعلَمًا تاريخيًّا أو فضاء رقميًّا افتراضيًّا، في رحلة حيّة بضجيج الأجساد والأفكار، حيث تنمو "إيتيقا" الصداقة والتواصل والنقاش البنّاء والعمل التعاونيّ. هذا بعض من الوهج الذي تمنحه إيّانا تجارب فرينيه وديكروليه وجون ديوي البيداغوجيّة، وتفتحه أمام التنشيط التربويّ ليكشف لنا أبعد المسافات التي سيطويها، من أجل التأسيس لتعلّم ذاتيّ متحرّر.
المراجع
- - حمداوي، جميل. (2015). التنشيط التربويّ: مفهومه وتقنيّاته ووسائله. (ط1، 2015). (ص. 4): https://shamela.org/pdf/d4161adacce00e6c31aeedeac3418
- - سعيدة، ملحقة وشنان، فريدة وهجرسي، مصطفى. (2009). المعجم التربويّ: مفاهيم ومصطلحات تربويّة. المركز الوطنيّ للوثائق التربويّة - الجزائر.
- - ناعم، محمّد. (2020). بيداغوجيا التنشيط. النافذة التربويّة.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025