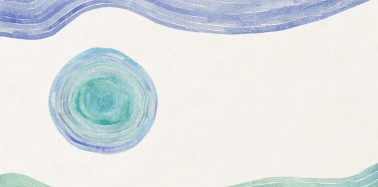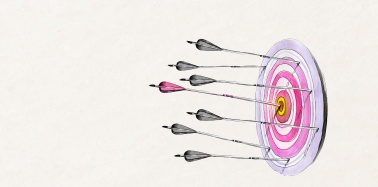يكاد الكتاب المدرسيّ يكون الأداة الأولى التي يتعامل معها المعلّم عندما ينخرط في مهنة التدريس. ما إن يعرف الصفوف التي سيدرّسها، حتّى نجده يسأل عن الكتب المنهجيّة لتلك الصفوف، ثمّ يبدأ التخطيط وتصميم الأنشطة، والمهمّات التعليميّة المرتبطة بها. وفي الغالب، لا يضع المعلّمون والمعلّمات متطلّبات العام الدراسيّ من الخطط الفصليّة، والخطط العلاجيّة، وغيرها من الوثائق المطلوبة، إذا تأخّر الكتاب المنهجيّ: أي ترتبط مهمّات المعلّمين والمعلّمات ارتباطًا وثيقًا بالكتاب المدرسيّ، وغياب الكتاب يُربك الأداء ويؤثّر فيه.
لكن، حان الوقت لإعادة النظر في الارتباط الوثيق بين المعلّم والكتاب. وهذه الإعادة الضروريّة لا تعني بأيّ حال من الأحوال نسْف تلك العلاقة والتخلّي عنها، بل محاولة تطويرها ووضعها في سياق التغيّرات الطبيعيّة التي يفرضها الزمن ومتطلّباته. فما كان صالحًا قبل عشر سنوات ليس بالضرورة صالحًا لعصرنا الحاليّ، وهذا الأمر يجب أن يُدركه المعلّم، بالدرجة نفسها التي يجب أن يُدركها الأهل والطلبة.
في هذا المقال سأطرح أسئلة حول كون الكتاب المدرسيّ الأداة الأولى بيد المعلّمين والمعلّمات، وهو يجب أن يبقى كذلك، لكن ضمن شروط ومتطلّبات يفرضها التطوّر الحاصل في أساليب التدريس، واختلاف المهارات التي ينبغي إكسابها للطلبة. كما يجب أن نتحوّل في مضامين الكتب المنهجيّة إلى التركيز على المهارات أكثر من الاقتصار على المعارف. ومن زاوية أخرى، يبرز سؤال حول كيفيّة التخفيف من أثر استخدام الكتاب المدرسيّ أداة بيد السلطات التي تتحمّل مسؤوليّة التأليف، وتوظّفه لفرض توجّهاتها وأفكارها في المؤسّسات التعليميّة. وفي سياق متّصل، تبرز دعوة إلى دعم صمود الكتاب المدرسيّ في سباق الزمن المُحتدم، أمام التحدّيات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، والتي تطرق أبواب قطاعات الحياة كلّها، بما فيها التعليم، وتُنافس الإنسان في مجالاته وفرصه.
الأداة الأولى
لا أظنّ أنّه يمكننا الاستغناء عن الكتاب المدرسيّ، وإن كان المعلّم هو قائد العمليّة التعليميّة والعنصر الأوّل فيها؛ فالكتاب مُساعد القائد، ومُستشاره الذي يقدّم إليه النصيحة والمشورة. كما أنّه سهل الاستخدام ومألوف ومُتاح. وحين يتعلّق الأمر بالحفظ والتوثيق، يبقى الكتاب الوسيلة الأولى التي تخطر في البال.
بقاء الكتاب المدرسيّ مُرشدًا يعني ضمان المحاسبة والمُساءلة، ويعني قياس قدرة النظام التعليميّ على تحقيق أهدافه ورؤاه. ويعني كذلك جمع المعلّمين وتنظيم جهودهم وتطويرها بأقلّ التكاليف والجهود؛ ذلك أنّ ترك ما سيُقدّم إلى الطلبة من معارف ومعلومات لاختيارات المعلّمين والمعلّمات ولاجتهادهم الشخصيّ، ينطوي على قدر كبير من الخطورة. كما أنّ امتزاج الأفكار الشخصيّة للمعلّمين بما يجب أن يمتلِكه الطلبة من المعارف والمهارات، يَحول دون التنشئة المطلوبة للأجيال التي يقع على عاتقها بناء المستقبل.
بقاء الكتاب المدرسيّ مُرشدًا يعني المحافظة على أركان النظم التعليميّة النظاميّة، ويكون -الكتاب- المرجع الرسميّ لها في عمليّات التعليم والتقييم والتدريب والتطوير. ولأنّ الكتب تُبنى عادة على تنظيم يستند إلى دراسات علم نفس النموّ، فإنّ الطالب يستطيع التعامل والتفاعل معه. كما أنّ وجود الكتاب يعني حصول الطلبة جميعهم على الفرص نفسها في التعليم والتعلّم، وهذا يعني التخلّص من المزاجيّة التي تطرّقتُ إليها في الفقرة السابقة. ومن جهة أخرى، فإنّ بناء البرامج اللازمة لتأهيل المعلّمين والمعلّمات وتدريبهم سيكون أفضل، وستصبح هذه الجلسات لقاءً يشتركون فيه عند نقطة معيّنة، ألا وهي الكتاب المنهجيّ، وكيفيّة تقديمه إلى الطلبة بأفضل الممارسات، وأكثرها قدرة على إحداث الفرق.
أهمّيّة بقاء الكتاب، لا تُقلّل منها اعتراضاتُ الأهالي وانتقاداتهم المناهجَ الجديدة عند صدورها، والاتّهامات التي تنال الكتاب الرسميّ بأنّه أداة من أدوات السلطة؛ إذ من الطبيعيّ أن تلجأ السلطة في أيّ مكان في العالم إلى أيّ أداة تدعمها، وتنقل وجهة نظرها، والكتاب المدرسيّ أحد أهمّ الأدوات للتأثير في أفكار الأجيال وميولهم، وإيصال الرسائل التي تريد السلطة نشرها بين الناس. فتجد أفكار الكتب تدعم ما تريده السلطة، وتتجاهل ما لا ترغب فيه. وهنا يأتي الدور المحوريّ للأهل والمعلّمين في إكساب الطلبة مهارات التأمّل والتحليل والتفكير النقديّ، وإثارة اهتمامهم، وتنمية وعيهم الذاتيّ بأهمّيّة الهويّة الوطنيّة في قراءة التاريخ والأحداث، والقدرة على تشكيل موقف فرديّ يستند إلى العقل والمنطق، في مواجهة رغبة السلطة في إنتاج كتب منهجيّة تنقل وجهة نظرها حصرًا.
الكتاب ينمو ويكبر
بقاء الكتاب المدرسيّ يعني بالضرورة تطويره، وجعله متوائمًا مع متطلّبات العصر واشتراطاته. فالدنيا تتغيّر، ومن الضروريّ للكتاب المدرسيّ أن يواكبها ليبقى صامدًا أمام موجات التغيير المتلاحقة التي لا تترك مجالًا أو فرصة: فإمّا أن تواكب التطوّر وتجاريه، وإمّا أن يترككَ الزمان خلفه فلا يُقبل عليك الناس، وتُهجَر كأيّ شيء قديم لم يعد ينفع.
الكتاب المدرسيّ الذي نريده لم يعد مجرّد نصوص وأسئلة وأنشطة وصور ومهمّات، بل يجب أن يصبح أداة شاملة متكاملة تدعم الطالب في تطوير نواحي شخصيّته كلّها؛ يراعي الفروقات بين الطلّاب، فيكون داعمًا للطالب المتفوّق بالدرجة نفسها التي يدعم فيها الطالب المبتدئ: فالكتاب الذي نريده يطرح الأسئلة المفتوحة التي يتفاعل الطالب معها، ويربطها بسياق حياته الواقعيّ، وفيه من الأنشطة التطبيقيّة ما يُعينه على الاستكشاف، ويجعله شريكًا في تعلّمه. ومثلما يتضمّن الأسئلة، فإنّه يتضمّن الرموز والروابط التي تنقل الطالب إلى ميادين أخرى مرتبطة بما يتعلّمه. فرمز QR هو الجسر الذي يربط الطالب بعالم الإنترنت، ويختصر المسافات التي توصله إلى معلومات إضافيّة انطلقت من الكتاب، ولم تتوقّف عنده.
الكتاب المدرسيّ الذي نريده لا يكلّف الطالب بالحفظ، بل يعلّمه كيف يحلّ مشكلات تواجهه بالتعاون مع زملائه ومعلّميه، وكيف يتواصل مع الناس والدنيا بطريقة تفكير فيها لمسات من الإبداع والأخلاق تدلّ على اقتناعه بما يريده الكتاب، فيكون هذا الكتاب حلقة الوصل الموثوقة بين المدرسة والحياة. الكتاب المدرسيّ الذي نريده ينمو كما يكبر الطالب، نُحدّثه باستمرار وفق التغيّرات التقنيّة والاجتماعيّة، ونُضمّنه أدوات التقويم المتنوّعة التي تعين كلّ طالب على الحكم على أدائه بدقّة وواقعيّة ورغبة حقيقيّة في التطوير.
أين المعلّم من الكتاب الذي نريده؟
الكتاب المدرسيّ الذي نريده لن يكون كافيًا بحدّ ذاته؛ فما يجعله حيًّا في غرفنا الصفّيّة هو مَن يقوده: المعلّم.
تفرض هذه النوعيّة من الكتب على المعلّمين والمعلّمات التنمية المهنيّة الذاتيّة المستمرّة، والسعي الدؤوب للبقاء على اتّصال بالمهارات الحديثة التي تضمّنتها الكتب، وسيكون من النافع أن يُجرّب المعلّم بنفسه التعامل مع الأنشطة التفاعليّة، والدخول إلى الروابط الإلكترونيّة قبل طلبته، فيكون قادرًا على امتلاك الأدوات المناسبة لقياس تعلّمهم، والتأكّد من أنّهم اكتسبوا ما يجب أن يكتسبوه.
الكتاب الذي نريده يحتاج إلى معلّم ديناميكيّ مُتطوّر بسرعة، ليس همّه إنهاء الكتاب كاملًا. معلّم يعرف الأمور التقنيّة، ويتعامل مع الأجهزة والفيديوهات والواقع الافتراضيّ، ومُرتبط بالمصادر الرقميّة، ومُتجدّد يمتلك قدرًا كبيرًا من المرونة التي تسمح له بتغيير طرائقه في شرح مادّة الكتاب وفق حاجات الطلبة، ضمن بيئة داعمة تسمح لهم بالاكتشاف والتجريب، وطرح الأسئلة من دون تردّد.
يحرص هذا المعلّم على إشراك الطلبة كلّهم في تقسيم زمنيّ يقضي على الملل، ويُراوح بين الشرح والأنشطة، وبين العمل الفرديّ والمهمّات الجماعيّة التي تضمن قدرًا كافيًا من الإرشاد والتوجيه بعيدًا عن الإجابات الجاهزة، ويرسل الطلبة إلى الفيديوهات التعليميّة والألعاب البنّاءة التفاعليّة التعليميّة، والمصادر الرقميّة التفاعليّة التي تجعلهم يعثرون على الإجابات.
تُعدّ المرونة والقابليّة للتغيير والتطوير والتحسين والإضافة، من أهمّ الصفات التي تُطرح عند المقارنة أو المفاضلة بين الكتاب الورقيّ والكتاب الإلكترونيّ. ومع ذلك، يمكن للكتاب الورقيّ أن يكتسب هذه الصفات بفضل المعلّمين المدرّبين والمؤهّلين، الذين يُغدقون عليه من معارفهم وخبراتهم، فيطوّرون أنشطته، ويحوّلونها إلى أنشطة حديثة وجاذبة تواكب التطوّرات والمستجدات التربويّة. وإن كان من الطبيعيّ أن تتفاوت مستويات المعلّمين والمعلّمات من حيث الثقافة والانفتاح، فإنّ مسؤوليّة النظام التعليميّ، سواء كان مركزيًّا أم غير مركزيّ، تقتضي وضع مؤشّرات أداء واضحة ودقيقة، بحيث يتولّى قائد كلّ مدرسة رصدها في أداء المعلّمين والمعلّمات، ويبني حكمه على ممارساتهم استنادًا إلى ما يرصده من أداء فعليّ.
الأهل والكتاب
سلّط عدد منهجيّات السابق الضوء على العلاقة بين المدرسة والأهل، وفي هذا المقال، أدعو بوضوح إلى أن يكون الكتاب الذي نريده جسرًا إضافيًّا يوثّق هذه العلاقة. ويكتسب هذا الجسر متانة إضافيّة عندما تُصمّم النظمُ الرسميّة الكتبَ المدرسيّة بطريقة تسمح للأهل بتقديم دعم فعّال في تعليم أبنائهم، بأنشطة بسيطة وسهلة، لا تقتصر على مراقبة الأبناء أثناء تأدية واجباتهم أو تسميع المحفوظات، بل تتيح لهم دورًا تفاعليًّا تشاركيًّا مؤثّرًا، بعيدًا عن الضغوط التي قد تُنفّر الطالب من التعلّم، مثل إصرار الأهل على إنهاء متطلّبات الكتاب الكثيرة، وربط ذلك بحوافز آنيّة، مثل قولهم: "لك حرّيّة استخدام الهاتف إذا أكملت الواجبات المطلوبة منك".
غير أنّ هذا التصوّر قد يصطدم أحيانًا بواقع تركيز السلطات في مضامين الكتب المنهجيّة على ترسيخ فكرها ورؤيتها، أكثر من اهتمامها بجوهر العمليّة التعليميّة. وهنا تفرض الحاجة إلى التعاون مع الأهل نفسَها من جديد، للوصول إلى طالب يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، والمرتبطة بالتفكير والتحليل وحلّ المشكلات، وبناء الآراء المستندة إلى الأدلّة.
الكتاب المنهجيّ الذي نريده سيجد في الموارد التي توفّرها الأسرة، مثل الإنترنت والمساحة الخاصّة للطفل في غرفته، داعمًا إضافيًّا لتطبيق المهارات المطلوبة، وسيجد في الأهل شركاء تعلّم يتحاور معهم ويتناقش، ويجعلهم على صلة وثيقة بما يتعلّمه ابنهم في المدرسة، بينما يغطّي الأهل دور الرقابة الإيجابيّة خارج المدرسة في ما يتعلّق بالاستخدام الآمن للأدوات الرقميّة، ومصادر الإنترنت المفتوحة. يضبط المعلّمون هذه الأدوار ويوجّهونها، إذ يحدّدون للأهل ما يعزز تعلّم أبنائهم في البيوت، ضمن إطار بنّاء يقوم على تقاسم الأدوار والمسؤوليّات.
سباق مُحتدم
السباق المُحتدم مع التكنولوجيا وأدواتها يفرض علينا أن ندعم الكتاب المدرسيّ، ونضمن صموده في مواجهة الآلات التي تُزاحم الإنسان في صفاته البشريّة، ذلك أنّ ميزة التفاعل والتعاطف والتضامن التي يمتلكها الإنسان تفرض علينا جعل المعلّم موجودًا دائمًا في غرفنا الصفّيّة، يقود التعلّم، وما سواه من تدريب وتطوير وأدوات، تمثّل دعائم تسانده في تأدية مهمّته بالصورة التي تُحدث فرقًا في حياة الطالب.
صحيح أنّ للتكنولوجيا ميزات تغري بالتخلّص من الكتب الورقيّة، لكنّها في الوقت نفسه تواجه تحدّيات كثيرة، لعلّ أبرزها عدم ملاءمة البنية التحتيّة لاستيعاب المصادر الإلكترونيّة والتفاعليّة والرقميّة؛ إذ لا يمكننا توفير جهاز ومساحة لكلّ طالب، لما يتطلّبه ذلك من تكاليف هائلة وتمويلات ضخمة، إضافة إلى أنّ الكوادر التدريسيّة تحتاج إلى وقت طويل للتدرّب على استخدام التقنيّات الحديثة، فضلًا عن الحاجة إلى أدوات رقابة صارمة تضمن توظيف هذه الأدوات بالشكل الصحيح الآمن.
***
يقتضي الإنصاف، وتفرض الموضوعيّة أن أقول إنّ الاختيار بين التخلّص من الكتاب الورقيّ في المدارس، وإدخال الأدوات الرقميّة التكنولوجيّة، ليس مسألة حدّيّة: إمّا هذا أو ذاك. وليس هذا المقصود من طرح هذا الموضوع في ملفّ منهجيّات، بل إنّ سياق التطوّر الطبيعيّ للأشياء في حياتنا يدفعنا إلى التفكير بالمواءمة بين المسارين، فلا نغالي أو نتطرّف لصالح جهة على حساب الأخرى. في تقديري، المنفعة ستكون أعظم عندما نراوح بين المسارين، وتكون حرّيّة الاختيار بينهما متاحة للفرد ضمن إمكانيّاته وميوله، فتجد الطالب يشاهد الفيديو التعليميّ المتعلّق بمهارة محدّدة، ويذهب لتطبيقها مع مجموعة العمل بعد قراءة التعليمات في الكتاب الورقيّ.







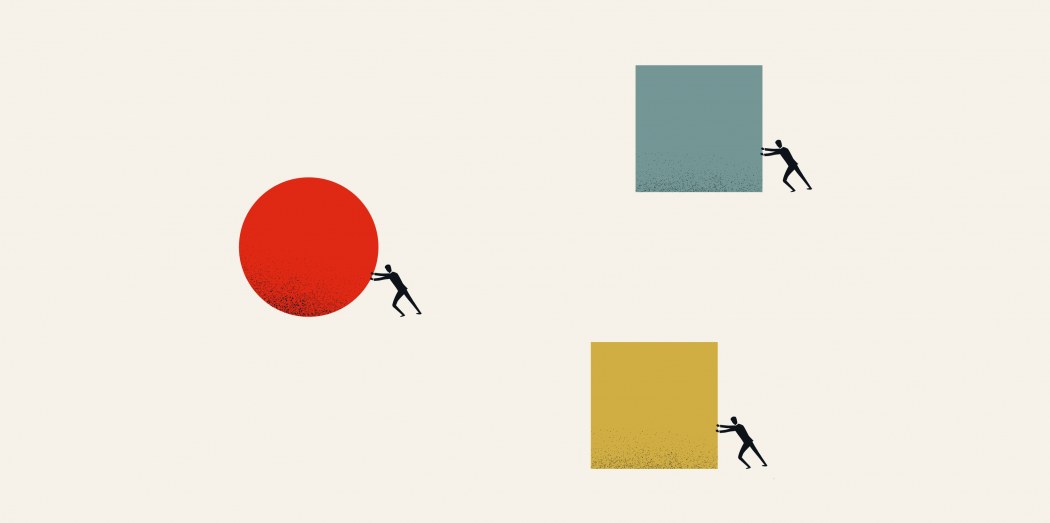





 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025