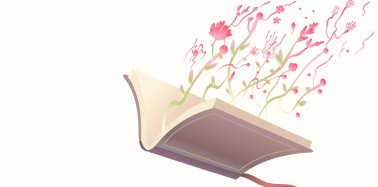على مرّ التاريخ وتطوّر الحياة، عاش الناس في تجمّعات تُعرف بالعائلات، وهي أصغر الفِرَق وأهمّها. وقد أصبحت هذه الفِرَق من ركائز النجاح في بيئة العمل، لما تمثّله من هيكل منظّم، وتعاون فعّال، ودعم متبادل يسهم في تحقيق الأهداف الشخصيّة والمؤسّسيّة. تُشير نظريّة أدوار فِرَق العمل التي قدّمها بيلبين إلى أنّ تكامل الأدوار يتحقّق من خلال استثمار نقاط القوّة الفرديّة، ويعزّزه كلّ من التماسك والكفاءة الجماعيّة. وفي السياق نفسه، حدّد ماسلو في هرم الاحتياجات الذي قدّمه سنة 1943، تحقيق الذات بوصفه أعلى دافع تحفيزيّ لدى الإنسان. ومن هذا المنطلق، يسعى الأفراد لتحقيق ذواتهم عندما يشعرون بالتقدير، ويواجهون تحدّيات حقيقيّة، وينخرطون بعمق في العمل (Chen, 2016). ومع ذلك، عندما تفتقر فِرَق العمل إلى هياكل فعّالة، وقيادة تتمتّع بالذكاء العاطفيّ، ووعي الأفراد بأدوارهم، فإنّ أعضاء الفريق يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم النفسيّة وتحقيق التقدير الذاتيّ. ويؤدّي ذلك إلى انخفاض الرضا، ومن ثمّ إلى الشعور بالاحتراق الوظيفيّ. وفي هذا السياق، يشير ليبرمان (2013) إلى أنّ "تكويننا البيولوجيّ مصمّم توّاقًا للتواصل، لأنّنا مرتبطون باحتياجاتنا الأساسيّة". ويُسهم العمل ضمن فِرَق فعّالة في تعزيز هذه الروابط، ما ينعكس في نتائج منتجة تقوم على التعاون والتكامل. فالتواصل هنا لا يقتصر على تبادل المعلومات، بل يشمل بناء فِرَق تعزّز الترابط والانسجام والتفاعل الاجتماعيّ (Kozlowski & Bell, 2013).
ظاهرة عالميّة
يواجه قطاع التعليم أزمة صحّيّة متفاقمة، إذ أبلغ المعلّمون حول العالم عن ارتفاع ملحوظ في مستويات الاحتراق الوظيفيّ (García-Carmona et al., 2018). وفي مؤشّر رفاهيّة المعلّم الصادر عن مؤسّسة الدعم التعليميّ (Education Support Partnership, 2018)، أظهرت النتائج أنّ 76% من المعلّمين والمتخصّصين في التعليم في المملكة المتّحدة، ظهرت لديهم سلوكيّات سلبيّة بمعدّلات تفوق أولئك العاملين في مهن أخرى.
وتشير البحوث النفسيّة إلى تضمّن الاحتراق الوظيفيّ ثلاثة أبعاد مترابطة:
البعد الأوّل: الإرهاق، إذ يشعر المعلّم بضغط شديد نتيجة عبء العمل واحتياجات الطلّاب، ويشعر بحالة من الإنهاك التدريجيّ، ونفاد الطاقة، والاستنزاف الجسديّ والعاطفيّ.
البعد الثاني: الشعور بالتشاؤم، إذ ينفصل عضو الفريق عن الطلّاب والزملاء، ويتجرّد من شخصيّته، ويميل إلى الانفعال.
البعد الثالث: انعدام الكفاءة المهنيّة، وتتمثّل مؤشّراته في الشعور بعدم التقدير، وانخفاض الإنتاجيّة والروح المعنويّة، وتدنّي مستوى الإنجاز (Maslach & Leiter, 2016).
لذا، يُعدّ الاحتراق الوظيفيّ ظاهرة معقّدة تُشبه الوباء، إذ يواجه الموظّفون تقلّبات نفسيّة، وإرهاقًا عاطفيًّا، وفقدانًا للمشاعر، وتدنّيًا في الشعور بالإنجاز الشخصيّ. وإذا لم يُعالَج هذا الوضع بطريقة فعّالة، فقد يؤدّي إلى ضغط وظيفيّ مزمن وحالة مستمرّة من عدم اليقين.
التعاطف الفريقيّ في مواجهة الاحتراق
عادةً ما يُعرّف التواصل بأنّه نقل الرسائل بواسطة اللغة اللفظيّة وغير اللفظيّة، إضافة إلى القرارات والأفعال. ومع ذلك، اقترح تشوي (2006) ثلاث قيم أساسيّة للقيادة الكاريزميّة: استشراف المستقبل والتعاطف والتمكين. يمثّل التعاطف قدرة الفرد على تحديد مشاعر الآخرين وفهمها وتجربتها (Mehrabian & Epstein, 1972). ويُعتقد أنّ السلوكيّات التعاطفيّة تُرسّخ الثقة بين أعضاء الفريق، وتعزّز الروابط العاطفيّة، وتُمكّنهم من تولّي زمام الأمور وقيادة عملهم. وعندما تُرسّخ هذه الروابط، تتشكّل بيئة عمل متناغمة وتعاونيّة، يُكمل فيها أعضاء الفريق بعضهم بعضًا. وتكمن القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين في جوهر الذكاء العاطفيّ، بغضّ النظر عن النماذج النظريّة المحدّدة. ومنذ أن صاغ تيتشنر مصطلح "التعاطف" قبل نحو قرن، أصبح هذا المفهوم إشارة إلى مجموعة من القدرات والعمليّات التي يستخدمها الأفراد في تعاملهم مع الآخرين. ويُعدّ التعاطف عنصرًا أساسيًّا في القيادة التحويليّة، إذ يمكّن القادة من فهم أعضاء فريقهم بشكل أفضل، وتعزيز المشاعر الإيجابيّة، وزيادة تماسك الفريق. وغالبًا ما يُستخدم مصطلح التعاطف بالتبادل مع مفهومات مثل الرحمة والشفقة والمشاعر الجماعيّة.
تظهر الحاجة الملحّة إلى إجراء بحث حول النهج التعاطفيّ في المجال التعليميّ، حيث اعتبر بيركوفيتش وإيال (2014) التعاطف كفاءة محوريّة، إذ يُعدّ وسيلة يستخدمها أعضاء الفريق والقادة لكسب الثقة، وإرساء التماسك، وتحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنيّة. تُعدّ القيادة التغييريّة نموذجًا مؤثّرًا وموضوعًا للبحث على نطاق واسع في إدارة التعليم، إذ تعزّز التخصيص والقدرات التفاعليّة بين أعضاء الفريق؛ ما يمكّنهم من تجاوز إمكاناتهم الفرديّة وبناء بيئة عمل متناغمة. يعتبر وعي القائد وقدرته على نقل كفاءات الذكاء العاطفيّ أمرَين في غاية الأهمّيّة، يمكّنان أعضاء الفريق من المراقبة والتنظيم، والتحكّم في تجاربهم العاطفيّة (Avery, 2011). كما يعتبران القادة قدوة لفِرَقهم: يقودون بالمثال والثقة، ويظهرون تأثيرًا مثاليًّا يُحتذي به أعضاء الفريق. في السياق ذاته، تعدّ أفعال القائد مصدر إلهام تحفيزيّ، يُشعر المعلّمين بارتباط عاطفيّ مع المدرسة. ومن التعاطف، تُستمدّ صفة أساسيّة هي "الاعتبار الفرديّ"، تتجسّد في تقديم القائد دعمًا مخصّصًا بناءً على احتياجات الموظّفين. إذًا، يتطلّب التدريس بيئة آمنة تتيح للمعلّمين الابتكار والاستقلاليّة، ويصبح القائد رائدًا في الابتكار الفكريّ داخل هذه البيئة المرتبطة بالعاطفة. وبالتالي، فإنّ التعاطف لا يُعتبر مجرّد "مهارة ناعمة"، بل له تأثير مباشر في تحفيز الموظّفين ورفاهيّتهم وثقتهم، وحلّ نزاعاتهم، وفي تحقيق النجاح الجماعيّ للمدرسة.
نماذج الاختلالات في عمل الفِرَق
يقدّم نموذج باتريك لينسيوني "الاختلالات الخمس للفِرَق"، إطارًا مناسبًا لربط التعاطف بنجاح الفريق. يمكن أن يُعتبر التعاطف أداة قويّة لمعالجة الاختلالات على مستوى القيادة (من الأعلى إلى الأسفل) وعلى مستوى الفريق (من الأسفل إلى الأعلى)، لتعزيز بيئة عمل صحّيّة (Parker et al., 2017). يمكن دمج التعاطف في نموذج لينسيوني لمكافحة الاحتراق الوظيفيّ داخل الفرقة. يبدأ ذلك بمعالجة "غياب الثقة"، إذ يُعتبر التعاطف أساسًا جوهريًّا لذلك.
في سياق المدارس المعتمدة في البكالوريا الدوليّة، يتطلّب برنامج السنوات المتوسّطة من المعلّمين التعاون في تخطيط وحدات دراسيّة متعدّدة التخصّصات وتنفيذها؛ ما يمكّنهم من سدّ الفجوات المعرفيّة، وتبادل الأفكار بشكل منفتح، وبناء روابط ذات معنى بين الموادّ الدراسيّة. على سبيل المثال، عندما يعمل معلّمو مادّتَيّ العلوم والأفراد والمجتمعات معًا على وحدة تعليميّة متكاملة حول الاستدامة البيئيّة، فإنّهم يناقشون نقاط القوّة في الموادّ والمجالات التي قد يشعرون فيها بضعف الثقة؛ ما يؤدّي إلى وحدة متماسكة وأكثر ثراء.
أمّا الخلل الثاني، وهو "الخوف من الصراع"، فيمكن تخفيفه باستخدام التعاطف الذي يعزّز النقاش الصحّيّ والمناقشات البنّاءة. القادة الذين يقدّرون اختلاف الآراء ووجهات النظر، يهيّئون المساحة اللازمة للمناقشة، ويتيحون فرصًا للنموّ بدلًا من الهجوم الشخصيّ. وفي الوقت ذاته، يُمكّن التعاطف الفريق من تبنّي نهج قائم على الاحترام وحلّ المشكلات؛ ما يقلّل من اللوم، ويعزّز التعاون بين الزملاء والقيادة. أثناء تخطيط المناهج، يشارك المعلّمون في برنامج السنوات المتوسّطة في نقاشات بنّاءة حول تصميم الوحدات الدراسيّة واستراتيجيّات التقييم ومعايير التقدير، فيعملون على وضع قواعد تنظّم التعامل مع الخلافات، وتركّز على مناقشة الأفكار بدلًا من الأفراد.
يمثّل "غياب الالتزام" الخلل الثالث الذي يعالجه التعاطف؛ إذ يضمن القادة إيصال القرارات بفعّاليّة، مع مراعاة الاحتياجات العاطفيّة والمهنيّة لفريقهم (Atkinson et al., 2020). يعكس المعلّمون الذين يظهرون التزامًا بقرارات القيادة تفانيهم في تحقيق أهداف المدرسة، ويسهم التعاطف في تمكين الفريق من إدراك الرؤية الأوسع، وتوحيد جهودهم وفقًا لذلك. يتقاسم المعلّمون في برنامج السنوات المتوسّطة رؤية مشتركة، تظهر في جميع النقاشات والقرارات الجماعيّة، مع التزام بقيم البرنامج الأساسيّة، مثل التعلّم المبنيّ على الاستقصاء وتطوير سمات متعلّم البكالوريا الدوليّة. يضع المعلّمون أهدافًا واضحة للمهارات التي ينبغي أن يكتسبها الطلّاب، والسياقات العالميّة التي يجب عليهم استكشافها؛ ما يضمن التزام الجميع بالهدف العامّ للمدرسة.
الخلل الرابع الذي يعالجه التعاطف هو "تجنّب المساءلة"؛ إذ يحافظ على التوازن بين المسؤوليّة والتعاطف. يبذل القادة المتعاطفون جهدًا لمساءلة فِرقتهم، من دون خلق بيئة من الخوف والاستياء، بمراعاة الظروف الفرديّة وتعزيز المسؤوليّة الفرديّة (Chen, 2016). بالمثل، يركّز أعضاء الفريق الذين يتقبّلون المساءلة بشكل بنّاء على التحسين الجماعيّ بدلًا من تبادل اللوم؛ ما يعزّز تماسك الفريق وقدرته على التكيّف. في برنامج السنوات المتوسّطة، تتجسّد المساءلة بين الزملاء عندما يتّفق المعلّمون على الحفاظ على معايير التقييم، عن طريق إعداد أدوات تقييم موضوعيّة، ومعايير واضحة تتماشى مع متطلّبات التقييم في البرنامج، بالإضافة إلى تنظيم جلسات منتظمة للتغذية الراجعة والتأمّل، لمتابعة تقدّم الطلّاب ومشاركتهم الفاعلة. يمثّل "عدم الاهتمام بالنتائج" الخلل الأخير، ويمكن التخفيف منه بالتعاطف عندما يركّز الموظّفون على تحقيق الأهداف الجماعيّة، بدعم من قيادة متعاطفة تُوائم الأهداف النهائيّة للمدرسة، ورفاهيّة الفريق وقيمه. عندما يُهيّئ القادة بيئة داعمة عاطفيًّا، ينمّي جميع أعضاء الفريق شعورًا مشتركًا بأهمّيّة الهدف يحفّزهم على النجاح الجماعيّ، إذ يمكّن التعاطف من مواءمة الأهداف والقيم. على سبيل المثال، يركّز المعلّمون على الطالب لتحسين نتائج تعلّمه باستخدام بيانات التقييم، لتحليل تقدّمه الأكاديميّ وتوجيه التعديلات المستقبليّة في التعليم والمناهج الدراسيّة. لذلك، يعدّ التعاطف أداة لبناء الثقة، ويشكّل حجر الأساس في نموذج لينسيوني؛ إذ يؤدّي مباشرة إلى بناء ثقة الفريق والحفاظ عليها، بسدّ الفجوة وكسر الحواجز الهرميّة بين القيادة والموظّفين (Rudolph et al., 2020).
***
يُعدّ الاحتراق الوظيفيّ تحدّيًا تنظيميًّا يؤثّر في رفاهيّة العاملين، لا سيّما في قطاع التعليم، ويتأثّر بعوامل متعدّدة مثل نهج القيادة، وديناميكيّات الفريق، والذكاء العاطفيّ، وخصوصًا التعاطف. يبرز دور التعاطف أداة قياديّة تسهم في بناء فِرَق متماسكة وآمنة نفسيًّا، فيشعر الأعضاء بأنّهم مسموعون ومُقدّرون؛ ما يقلّل من الإرهاق العاطفيّ والتبلّد النفسيّ.
تستعرض المقالة دور نماذج العمل الجماعيّ، مثل بلبين وماسلو وتكمان، في التخفيف من الاحتراق الوظيفيّ، وتدمج بين نموذج جولمان للذكاء العاطفيّ ونموذج لينسيوني للاختلالات الخمسة، لتوضيح كيف يمكن تعزيز الثقة والتحفيز والمساءلة والالتزام داخل الفِرَق. وتؤكّد المقالة على أنّ القيادة الفعّالة تتطلّب فهم البُعد الإنسانيّ للفِرَق، وأنّ تبنّي التعاطف من القادة وأعضاء الفريق يسهم في خفض معدّلات الاحتراق الوظيفيّ، وتعزيز النجاح الجماعيّ، ويؤسّس لبيئة عمل مستدامة وشاملة.
المراجع
- - Atkinson, C., Beck, V., & Brewis, J. (2020) Menopause and the workplace: New directions in HRM research and HR practice. Human Resource Management Journal, 31(1), 49–64.
- - Avery, D. R. (2011). Support for diversity in organizations: A theoretical exploration of its origins and offshoots. Organizational Psychology Review, 1(3), 239–256.
- - Education Support Partnership. (2018). Teacher wellbeing index 2018.
- - Lieberman, Matthew D. Social: Why Our Brains Are Wired to Connect. Crown Publishers, 2013.
- - García-Carmona, M., Marín, M.D. & Aguayo, R. (2018) Burnout syndrome in secondary school teachers: a systematic review and meta-analysis. Social Psychology of Education, 22(1), 189–208.
- - Berkovich, I., & Eyal, O. (2014). Educational leaders and emotions: An international review of empirical evidence 1992–2012. Review of Educational Research, 85(1), 129–167.
- - Chen, P.Y. (2016). Editorial. Journal of Occupational Health Psychology, 21(1), 1–2.
- - Choi, J. (2006) A motivational theory of charismatic leadership: Envisioning, empathy, and empowerment. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(1), 24-43.
- - Kozlowski, S. W. J., & Bell, B. S. (2013). Work groups and teams in organizations. In N. W. Schmitt, S. Highhouse, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology (2nd ed., pp. 412–469). John Wiley & Sons, Inc.
- - Lieberman, M. D. (2013). Social: Why our brains are wired to connect. Crown Publishers.
- - Leiter, M.P. & Maslach, C. (2016). Latent burnout profiles: A new approach to understanding the burnout experience. Burnout Research, 3(4), 89–100.
- - Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of Personality, 40(4), 525–543.
- - Parker, S. K., Morgeson, F. P., & Johns, G. (2017). One hundred years of work design research: Looking back and looking forward. Journal of Applied Psychology, 102(3), 403–420.
- - Rudolph, C. W., Katz, I. M., Ruppel, R., & Zacher, H. (2020). A systematic and critical review of research on respect in leadership. The Leadership Quarterly, 32(1), Article 101492.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025