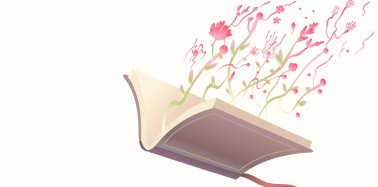لا يأتي نجاح اكتساب اللغات بطريقة فائقة من تعلّمها، وإنّما من التعلّم بها. وأعتقد واثقًا أنّ كلمة السرّ في تغيير واقع اللغة العربيّة وتدريسها معلّموها. فاللغة - بوصفها هويّة وثقافة - تبقى في جوهرها وسيلة للفكر والمعرفة. ومن هنا، فإنّ أرقى النظم التعليميّة تأخذ بمبدأ أنّ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة"، ومعنى هذا أنّ تعلّم اللغة ليس مسؤوليّة معلّمي اللغة وحسب، بل جزءًا لا يتجزّأ من تدريس جميع الموادّ الدراسيّة؛ لأنّ اللغة تمثّل الأداة الأساسيّة لاكتساب المعرفة والتواصل الفعّال. وعندما يستخدم المعلّمون الأنشطة اللغويّة المتخصّصة نموذجًا، فإنّهم يساعدون الطلّاب في رؤية اللغة بوصفها أداة أساسيّة لفهم محتواهم الدراسيّ وإتقانه، وليس مجرّد مادّة منفصلة.
يتجذّر هذا المبدأ في عدّة نظريّات تربويّة ولغويّة، من أبرزها:
- نظريّة اكتساب اللغة الثانية (Second Language Acquisition – SLA): يرى ستيفن كراشن (Stephen Krashen) أنّ تعلّم اللغة يحدث بشكل أفضل عندما تقدّم في سياقات حقيقيّة وذات مغزى. ويدعم مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة" هذا التصوّر، بالتأكيد على أنّ الطلّاب يطوّرون مهاراتهم اللغويّة بشكل أفضل عند استخدام اللغة في سياق المحتوى الأكاديميّ الذي يهمّهم.
- النظريّة الاجتماعيّة الثقافيّة (Sociocultural Theory) التي طوّرها فيغوتسكي (Lev Vygotsky)، والتي تؤكّد أنّ التعلّم يحدث عن طريق التفاعل الاجتماعيّ. وفقًا لهذا المنظور، يتعلّم الطلّاب اللغة بشكل أكثر فاعليّة عند استخدامها أداة للفهم والتواصل في الموادّ الدراسيّة المختلفة، وهو ما يجعل جميع المعلّمين مسؤولين عن تطوير مهارات طلّابهم اللغويّة.
- نظريّة التعلّم بالممارسة (Situated Learning Theory): وفيها يؤكّد جان لاف وإتيان فينجر (Jean Lave & Etienne Wenger) أنّ التعلّم يحدث بشكل أفضل عندما يكون مضمّنًا في سياق عمليّ وواقعيّ. يدعم هذا فكرة أنّ تدريس اللغة لا ينبغي أن يقتصر على معلّمي اللغة فقط، بل يجب أن يكون جزءًا من جميع الموادّ الدراسيّة.
تطوّر هذا المفهوم في الممارسات التربويّة في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي، وبات مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة" يطبّق على نطاق واسع في المدارس في بريطانيا وأوروبّا، إذ أدرك الباحثون والتربويّون أنّ ضعف مهارات الطلّاب اللغويّة يؤثّر في أدائهم الأكاديميّ في جميع الموادّ، ما أدّى إلى تطوير استراتيجيّات تدريس اللغة في المناهج الدراسيّة.
وفي التسعينيّات وبداية القرن الحادي والعشرين، تبنّت أنظمة تعليميّة عدّة هذا المبدأ، لا سيّما ضمن برنامج البكالوريا الدوليّة (IB) الذي أكّد أنّ مهارات اللغة يجب أن تُدمج في تدريس جميع الموادّ، لضمان تعلمّ أكثر شموليّة واستدامة. وتضمّ وثيقة المجال والتسلسل للغات لبرنامج السنوات الابتدائيّة (2011) إشارة إلى أفكار كثيرة، منها فكرة تجاوز اللغة للموادّ الدراسيّة؛ إذ "تدخل اللّغة في جميع مناحي التعلّم في المدرسة في كلّ من المجالات الانفعاليّة والفعليّة. فالمتعلّمون يستمعون ويتحدّثون ويقرؤون ويكتبون حسبما يرتؤون، في سعيهم لاستنباط معانٍ جديدة وإدراك مفاهيم جديدة. واللغة ضمن نطاق "المعرفة" المتعلّقة ببرنامج السنوات الابتدائيّة أكثر العناصر أهمّيّة في تحقيق التماسك ضمن المنهاج المدرسيّ، وذلك داخل برنامج البحث المتجاوز للموادّ الدراسيّة وخارجه".
تؤكّد الوثيقة دور اللغة وسيلة للبحث والتساؤل التفكير، مشيرة إلى أنّ اللغة "توفّر وسيلة للبحث والتساؤل. ففي صفّ يرتكز على البحث، يستمتع المدرّسون والطلّاب باستخدام اللغة، حيث يقدّرونها من الناحية الوظيفيّة ومن الناحية الجماليّة". وتؤكّد الوثيقة أنّ تعليم اللغة مسؤوليّة جميع المعلّمين، إذ "توفّر المدرسة البيئات الحقيقيّة لتعليم اللغة وتعلّمها في جميع مجالات المنهاج الدراسيّ، والتي تمثّل انعكاسًا لمجتمع من المتعلّمين وللنظريّات التربويّة التي يقوم عليها البرنامج". وهذا يشير إلى أنّ تعلّم اللغة ليس مقتصرًا على معلّمي اللغة فقط، بل هو جزء لا يتجزّأ من جميع الموادّ الدراسيّة. مع التأكيد على توفير بيئة حقيقيّة لتطوير اللغة في مختلف الموادّ، بحيث "يوفّر برنامج البحث للمتعلّمين بيئة حقيقيّة لتطوير اللغة واستخدامها. وينبغي قدر المستطاع أن تُدرّس اللغة في البيئة الحقيقيّة المتّصلة بوحدات البحث". وهذا يؤكّد أنّ جميع المعلّمين، بغضّ النظر عن تخصّصاتهم، يؤدّون دورًا في تطوير المهارات اللغويّة لدى الطلّاب.
المعلّمون ودعم اللغة العربيّة بتخصّصاتهم
اللغة العربيّة أحوج ما تكون إلى كلّ جهد، وحريّ بهذا الجهد ألّا يقتصر على معلّمي اللغة العربيّة، بل الواجب أن يسهم فيه جميع المعلّمين. فكلّ معلم يمتلك - بغضّ النظر عن تخصّصه - فرصة كبيرة للإسهام في تطوير مهارات الطلّاب اللغويّة. لنتأمّل في بعض الأمثلة:
- معلّمو العلوم يسهمون بشكل فعّال في تعزيز مهارات الاستقصاء والتعبير اللغويّ، عن طريق التقارير العلميّة التي يكتبها الطلّاب، والعروض التقديميّة التي تتطلّب استخدام مصطلحات علميّة دقيقة وتواصلًا فعّالًا.
- معلّمو الرياضيّات يساعدون في تطوير اللغة العربيّة بشرح المفاهيم الرياضيّة بأسلوب واضح، ومناقشة استراتيجيّات حلّ المسائل، ما يعزّز قدرة الطلّاب على التعبير المنطقيّ والمنظّم. وتؤكّد هذه الفكرة على أنّ تطوير تعلّم اللغة الإنجليزيّة في الوطن العربيّ – والقياس هنا على دولة الإمارات تحديدًا وبعض دول الخليج العربيّة – شهد تطوّرًا وقفزة كبيرة، حين قرّرت الجهات المسؤولة عن التعليم تدريس هاتين المادّتَين تحديدًا باللغة الإنجليزيّة. وفي المقابل، شهد تعليم اللغة العربيّة تدهورًا وتراجعًا.
- في مجال الفنون، تتوسّع قدرة الطلّاب اللغويّة بمناقشة الأعمال الفنّيّة، والنقد الفنيّ الذي يشجّع الطلّاب على استخدام لغة وصفيّة غنيّة ودقيقة، والتعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل إبداعيّ، موظّفين ما درسوه في البلاغة العربيّة والنقد.
- في التربية الإسلاميّة، يسهم المعلّمون في إثراء اللغة العربيّة بدمج أنشطة تحليل النصوص القرآنيّة، ومناقشة الأحاديث النبويّة، وتفعيل الحوار والنقاش باللغة العربيّة الفصيحة ضمن الأنشطة الصفّيّة اليوميّة، ما يعزّز مهارات الطلّاب اللغويّة، ويقوّي علاقتهم بلغتهم وثقافتهم.
- تمثّل اللغة العربيّة فرصة لمعلّمي الدراسات الاجتماعيّة التي تتضمّن الثقافة والهويّة الوطنيّة، حيث يمكنهم إعداد أنشطة صفّيّة دوريّة تركّز على البحث والتحليل والنقاش لموضوعات تاريخيّة واجتماعيّة متنوّعة، ما يطوّر لدى الطلّاب مهارات التفكير النقديّ والتحليليّ، ويعزّز قدراتهم على التعبير اللغويّ بوضوح ودقّة.
- معلّمو التربية الرياضيّة يمكنهم استخدام الأنشطة البدنيّة باعتبارها فرصًا فعّالة لتنمية مهارات الاستماع والتحدّث، وذلك عن طريق إعطاء تعليمات واضحة وصريحة، والتأكيد على دقّة وصف الحركات والأنشطة، وتشجيع الطلّاب على وصف أدائهم وأداء زملائهم وتقييمه، ما يسهم في تطوير لغتهم العربيّة ومفرداتهم التواصليّة في المواقف الحياتيّة الحقيقيّة.
ومع اتّساع نطاق المدارس التي تعتمد لغات أجنبيّة لتدريس الموادّ العلميّة، كما هو الحال في كثير من المدارس العالميّة أو ثنائيّة اللغة، تزداد الحاجة إلى اتّخاذ موقف تربويّ يعزّز مكانة اللغة العربيّة بوصفها لغة تعليم ومعرفة، لا مجرّد لغة تواصل أو مادّة مستقلّة. فحين تُدرّس العلوم والرياضيّات بلغة أجنبيّة، تفقد العربيّة حضورها العمليّ في حياة الطالب اليوميّة، ما يضعف ارتباطه بها، ويحدّ من قدرته على استخدامها في التفكير العلميّ والتحليل المنهجيّ. ولهذا، فمن الضروريّ الدعوة إلى إدماج اللغة العربيّة في تدريس مختلف الموادّ كلّما أمكن، أو على الأقلّ تقديم أنشطة داعمة ضمن هذه الموادّ، تعزّز الفهم والتعبير باللغة العربيّة، حتّى في المدارس التي تدرّس بلغات أخرى. وهذا ينسجم مع التوجّهات العالميّة التي ترى في التعدّد اللغويّ فرصة لا تهديدًا، شريطة أن تظلّ اللغة الوطنيّة حاضرة وفاعلة في سياقات التعليم والمعرفة.
إجراءات عمليّة لتطبيق مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة" في المدرسة
لتطبيق مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة" بشكل يستهدف تطوير اللغة العربيّة في مدارسنا، يجب أن تتكاتف الجهود وتتعدّد الإجراءات، لضمان تبنّي هذا المفهوم جزءًا لا يتجزّأ من الثقافة المدرسيّة اليوميّة. يبدأ ذلك بتوفير تدريب عمليّ مكثّف لجميع المعلّمين من مختلف التخصّصات، وليس لمعلّمي اللغة العربيّة وحسب، بحيث يتعرّفون إلى أبرز استراتيجيّات تدريس اللغة العربيّة، وطرق دمجها في تخصّصاتهم بأسلوب عمليّ ومبسّط. كما أنّ تنظيم ورش العمل التدريبيّة بشكل دوريّ يضمن استمرار تطوير كفاءة المعلّمين، وتعزيز قدرتهم على توظيف هذه الاستراتيجيّات في ممارساتهم اليوميّة.
إضافة إلى التدريب، فإنّ تطبيق "استراتيجيّات القراءة والكتابة عبر المنهاج" يمثّل خطوة جوهريّة لتحقيق التكامل اللغويّ في المدرسة، فما اللغة العربيّة إلّا قراءة وكتابة. تمكّن هذه الاستراتيجيّات الطالب من تعزيز مهاراته اللغويّة بصورة طبيعيّة وسلسة أثناء تعلّمه الموادّ المختلفة، فتصبح القراءة والكتابة جزءًا أساسيًّا من العمليّات التعليميّة اليوميّة.
كما يجدر بالمدارس أن تخصّص جزءًا ثابتًا من اجتماعات الهيئة التدريسيّة، لمناقشة قدرة الطلّاب على التواصل باللغة العربيّة في مختلف الموادّ، وليس في مادّة اللغة العربيّة فقط. تتيح هذه المناقشات المستمرّة الفرصة للمعلّمين لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافيّ في تطوير لغتهم العربيّة، بالإضافة إلى تعزيز الشعور المشترك بالمسؤوليّة تجاه تطوّر اللغة العربيّة باعتبارها رمزًا للهويّة.
ومن الممارسات المهمّة أيضًا، تصميم مهامّ دراسيّة مشتركة بين المعلّمين من مختلف التخصّصات، تركّز بشكل خاصّ على تنمية الكفاءة اللغويّة للطلّاب، كأن يتعاون معلّم الرياضيّات مع معلّم العلوم لإعداد مشروع مشترك، يُطلب فيه إلى الطلّاب تقديم عرض تقديميّ، أو إعداد تقرير تحليليّ مكتوب بإشراف معلّم اللغة العربيّة.
ومن الإجراءات الحاسمة التي تعزّز فاعليّة مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّم لغة"، اعتماد اللغة العربيّة الفصحى لغة تدريس رئيسة في الصفوف التي تُدرّس بالعربيّة، مع الالتزام باستخدامها في الشرح والحوار والتقييم. إنّ استخدام اللهجات المحلّيّة، وإن كان يسيرًا على المعلّمين والطلّاب، يُضعف التواصل الأكاديميّ، ويحول دون بناء ملكة لغويّة سليمة تؤهّل الطلّاب للقراءة المتعمّقة والكتابة الواعية والتعبير المنهجيّ. وقد برزت في هذا السياق تجربة رائدة قدّمها الدكتور عبد اللّه الدنّان، صاحب نظريّة "تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة"، والتي استثمرها تربويًّا حين عمل على تدريب المعلّمين على استخدام الفصحى في حديثهم داخل الصفّ، وذلك بهدف خلق بيئة لغويّة تعليميّة متكاملة، تساعد الطلّاب في اكتساب الفصحى عبر التلقين السمعيّ والممارسة اليوميّة. وتُظهر نتائج هذه التجربة أنّ تعرّض الطفل بشكل منتظم إلى اللغة الفصحى في حياته الدراسيّة يدعم اكتسابها بطلاقة، ويعزّز ارتباطه بها بوصفها أداة فكر وعلم وهويّة (الدنّان. 2014). لذا، فإنّ الدعوة إلى التزام الفصحى داخل الصفّ ليست فقط التزامًا لغويًّا، بل خيارًا تربويًّا واعيًا، يصبّ في صميم تطوير اللغة العربيّة، وتعزيز مكانتها التعليميّة والثقافيّة.
مبدأ "كلّ معلّمٍ معلّمُ لغة" ليس مجرّد شعار تربويّ، بل فلسفة تعليميّة أثبتت نجاحها في العديد من الأنظمة التعليميّة حول العالم، واستُثمرت أفضل استثمار في جعل اللغة الإنجليزيّة لغة أولى ومفضّلة للتعليم. عندما يتبنّى جميع المعلّمين العرب هذا المبدأ، يتحوّل تعلّم اللغة العربيّة إلى عمليّة حيّة وتفاعليّة، تتجاوز حدود الفصل الدراسيّ التقليديّ، وتحقّق نتائج إيجابيّة وملموسة، ما يجعل تعلّم اللغة العربيّة تجربة متكاملة وعمليّة، ومتّصلة بحياة الطالب المهنيّة المستقبليّة.
المراجع
- - الدنّان، ع. (2014). نظريّة تعليم اللغة العربيّة الفصحى بالفطرة والممارسة. دار البشائر.
- - لجنة تحديث تعليم اللغة العربيّة. (2012). العربيّة لغة حياة. تقرير لجنة تحديث تعليم اللغة العربيّة الصادر عن رئاسة الوزراء في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.
- - منظّمة البكالوريا الدوليّة. (2011). وثيقة المجال والتسلسل للغات لبرنامج السنوات الابتدائيّة. المملكة المتّحدة.
- - Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.
- - International Baccalaureate Organization. (2018). Language and learning in IB programmes. IB Continuum.
- - Vygotsky, L. (1999). Thought and Language. The MIT Press.
- - Krashen, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press.
- - Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. University Press.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025