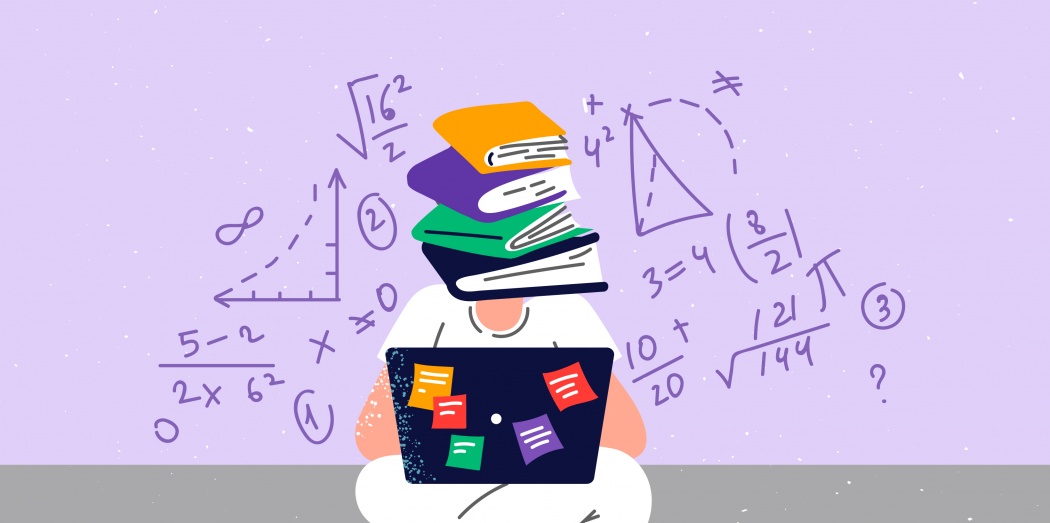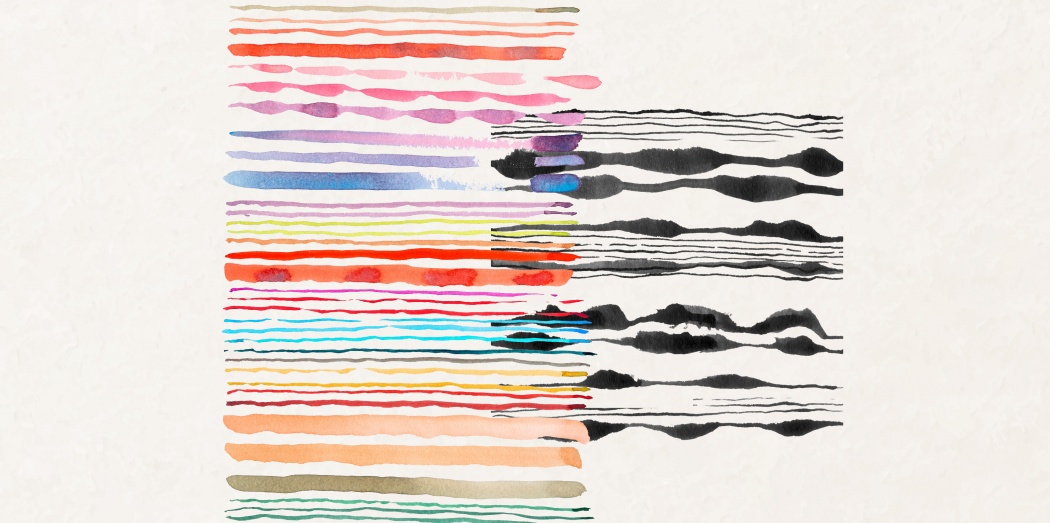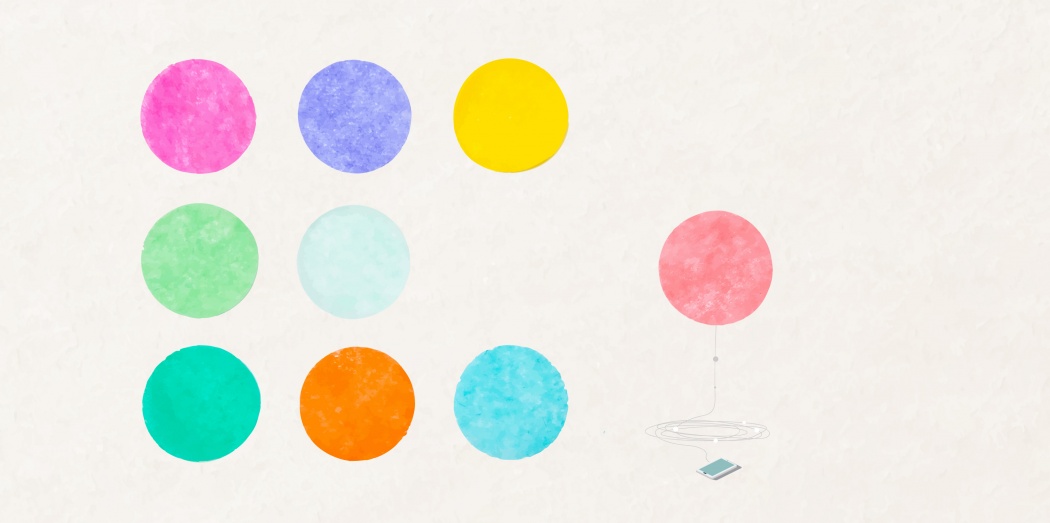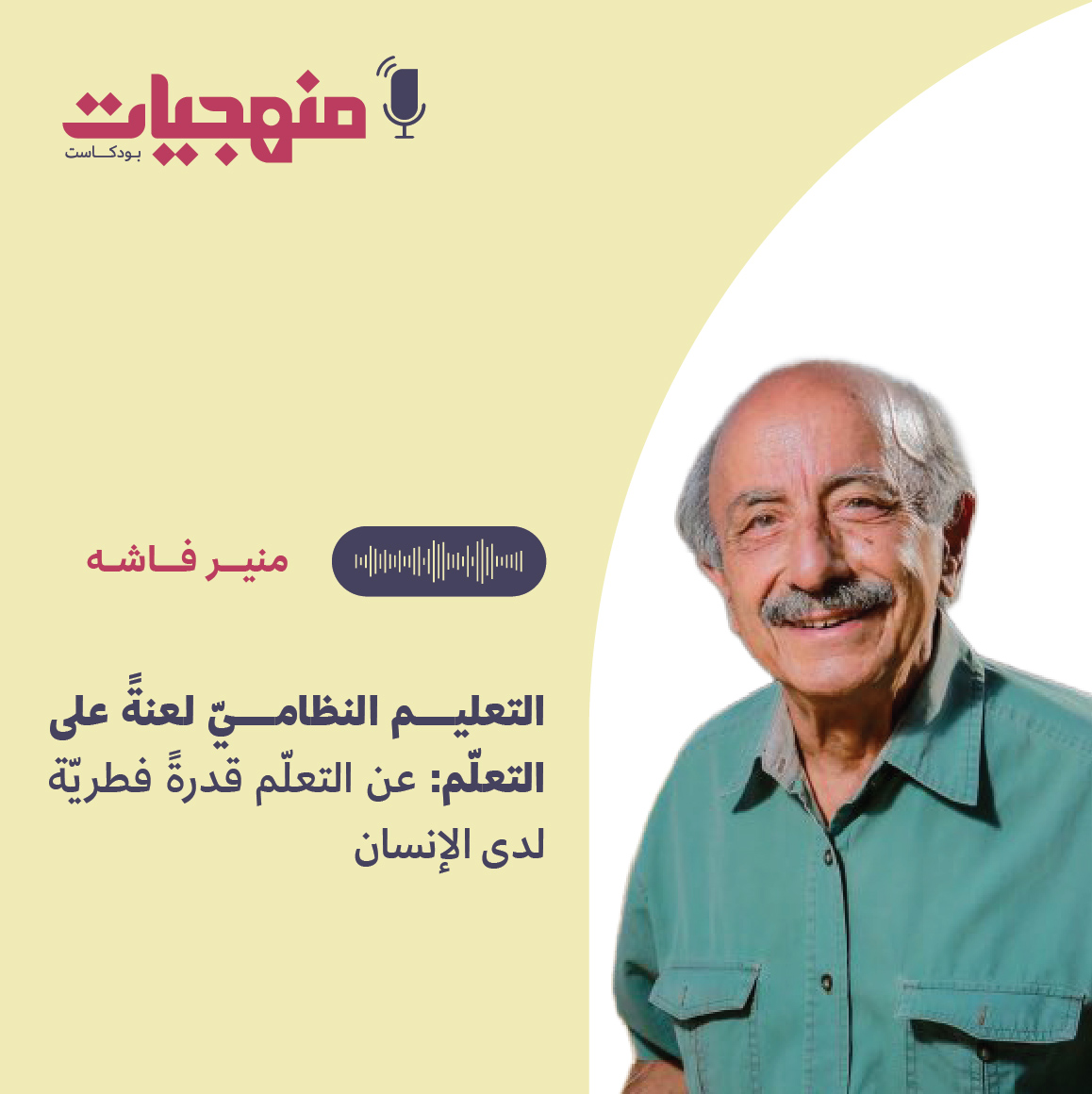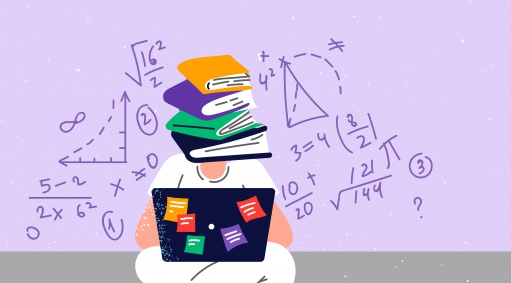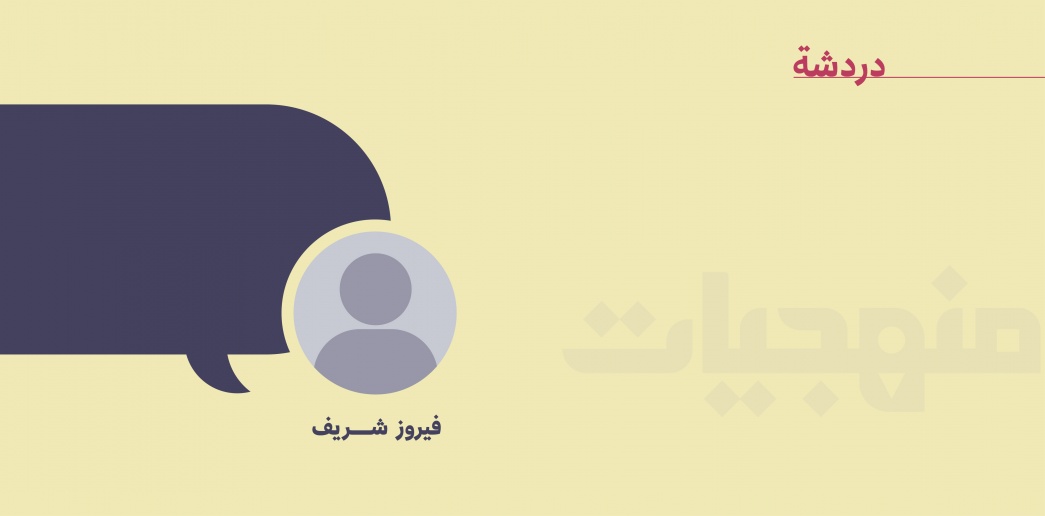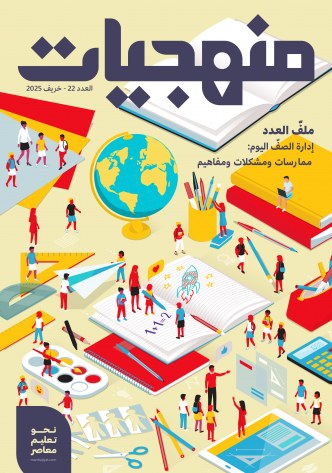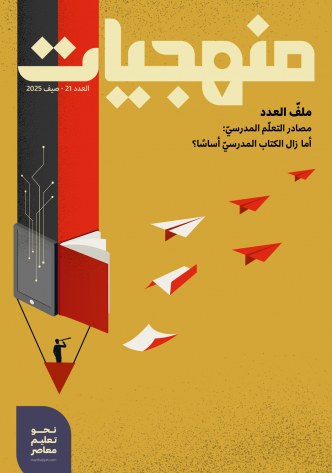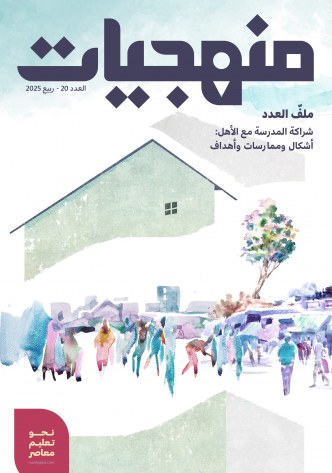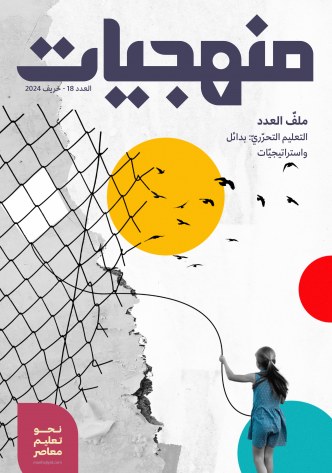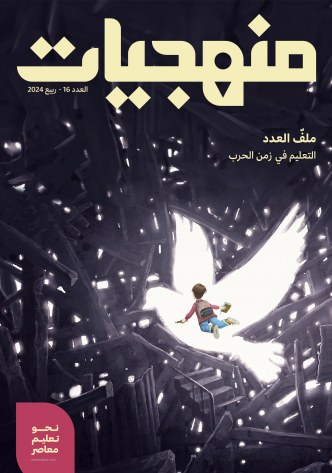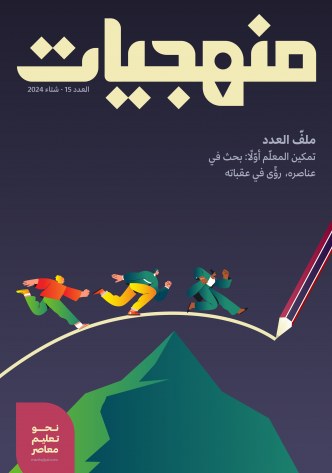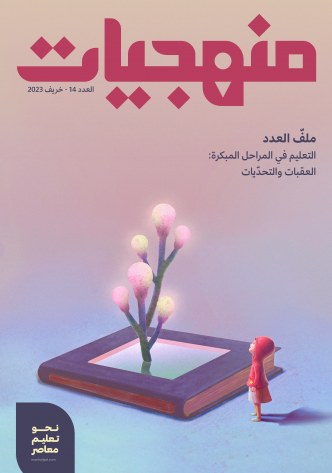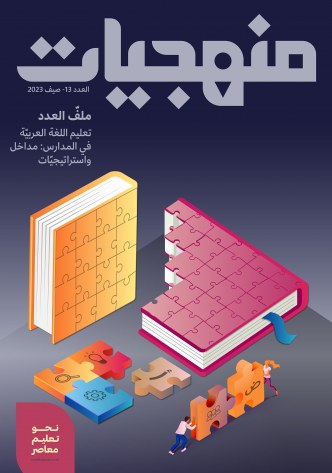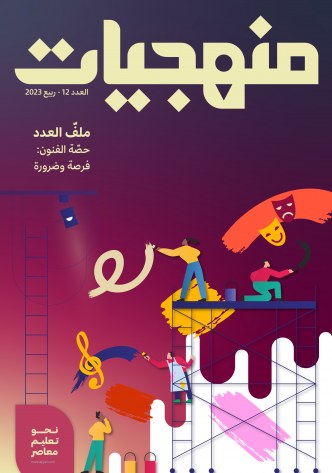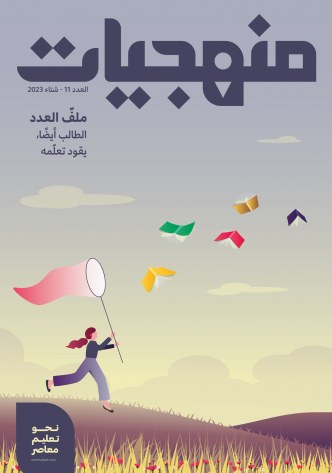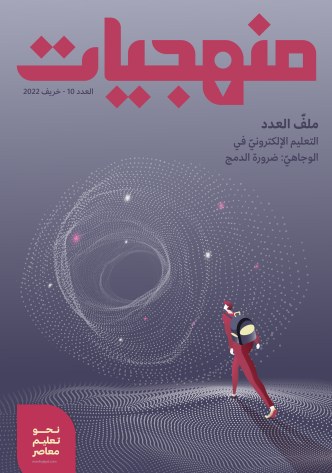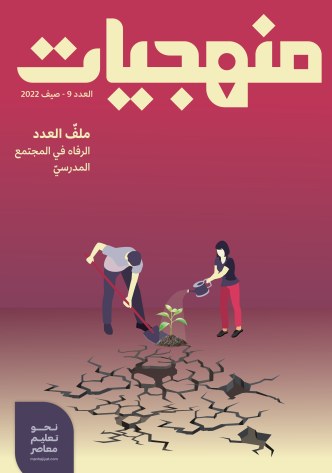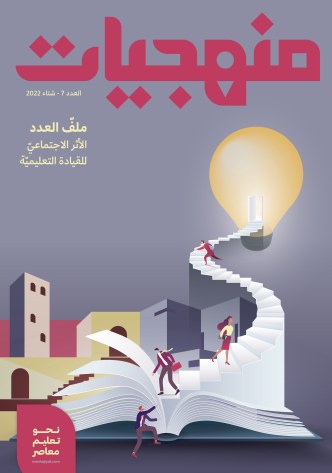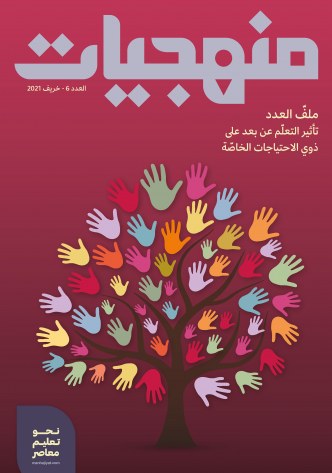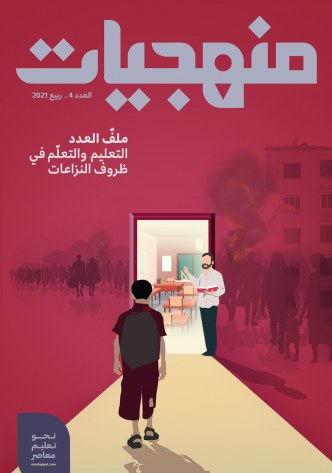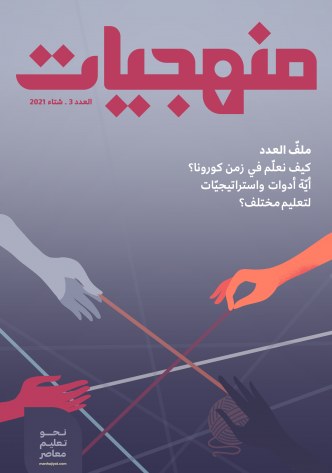تُعدّ تربية الأبناء من أعظم المسؤوليّات التي تقع على عاتق الإنسان، وغالبًا ما تُوصف بأنّها الوظيفة الأهمّ في العالم. وهذا وصف دقيق إلى حدّ كبير؛ إذ لا يقتصر تأثيرها على تشكيل الفرد فحسب، بل يمتدّ ليصوغ ملامح المجتمعات ومستقبلها. وعلى مرّ العصور، ارتبطت الأمومة ارتباطًا وثيقًا بتنشئة الأطفال، حتّى باتت صورة الأمّ الحنون، الحاضرة دومًا، راسخة في الوعي الجمعيّ، مدعومة بتوقّعات ثقافيّة واجتماعيّة، بل وقانونيّة، تُحمّل النساء دون سواهنّ عبء الرعاية.
لكن في عالم اليوم، ومع التحوّلات الجذريّة في أدوار النوع الاجتماعيّ، وازدياد مشاركة الآباء في التربية، وتغيّر أنماط الأسرة، يبرز سؤال جوهريّ: هل الأمّهات أفضل بطبيعتهنّ في تربية الأطفال، أم أنّ هذا التصوّر مجرّد نتاج تقاليد راسخة، أكثر منه حقيقة بيولوجيّة؟
نسعى في هذا المقال للغوص في الأبعاد العلميّة والنفسيّة والاجتماعيّة الكامنة وراء هذا الاعتقاد المتوارث، بهدف تقديم رؤية متوازنة، تفتح باب النقاش حول الأدوار المتجدّدة للوالدين في تربية الأجيال.
التصوّر التقليديّ أنّ تربية الأمّ "أفضل"
ترتكز الفكرة الشائعة بأنّ الأمّهات أكثر كفاءة في تربية الأطفال، على خليط من العوامل البيولوجيّة والتقاليد الثقافيّة. فمنذ اللحظات الأولى للولادة، تنشأ رابطة فطريّة بين الأمّ ورضيعها، تتعزّز غالبًا بالرضاعة الطبيعيّة التي لا تقتصر على توفير الغذاء، بل تسهم أيضًا في تعميق الارتباط العاطفيّ والجسديّ. هذا القرب المستمرّ يجعل من الطبيعيّ أن تقضي الأمّ وقتًا أطول مع الطفل، ما يخلق انطباعًا بأنّها الأقدر على فهم احتياجاته والاستجابة لها بمرونة.
كما أنّ كثيرًا من الثقافات - تاريخيًّا وحتّى يومنا هذا- أسندت إلى المرأة دور مقدّمة الرعاية الأساسيّة في الأسرة، بينما حُصر دور الأب في الإعالة وتوفير الموارد، مع مشاركة محدودة في تفاصيل الحياة اليوميّة للأطفال. هذا التقسيم التقليديّ رسّخ الاعتقاد بأنّ الأمومة تمثّل الدور التربويّ "الطبيعيّ"، بينما الأبوّة دور داعم أو ثانويّ.
لكنّ الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك. فقد أثبتت التجربة والأبحاث الحديثة أنّ القدرة على الرعاية ليست محصورة بجنس دون آخر، بل هي مهارة تنمو بالممارسة والثقة والدعم المجتمعيّ. وعندما يُمنح الآباء الفرصة للمشاركة الكاملة في تربية أطفالهم، يظهر الكثير منهم آباء حنونين وواعين وفاعلين، لا يقلّون كفاءة عن الأمّهات.
ماذا تقول الأبحاث عن الأمّهات والآباء بوصفهم مربّي أطفال؟
تشير الأبحاث في مجالات نموّ الطفل وعلم النفس وعلم الاجتماع، إلى أنّ الأمّهات والآباء يسهمون في تربية الأبناء بطرق متكافئة، ولكن متمايزة، بحيث يُقدّم كلّ منهما خصائص فريدة تكمّل الأخرى في بناء شخصيّة الطفل ونموّه السليم.
الروابط العاطفيّة والتعلّق
أظهرت الدراسات أنّ الأطفال قادرون على بناء روابط آمنة مع كلا الوالدين، طالما كانت العلاقة تتّسم بالدفء والتجاوب والاتّساق. ووفقًا لنظريّة التعلّق التي صاغها عالم النفس جون بولبي، فسواء كان المُربّي الأب أو الأمّ، فهذا ليس العامل الحاسم في تكوين علاقة آمنة، بل قدرته على الحضور العاطفيّ والاستجابة الحسّاسة لاحتياجات الطفل.
وفي دراسة نُشرت في Journal of Infant Mental Health، تبيّن أنّ الآباء الذين أظهروا حساسيّة وتفاعلًا إيجابيًّا مع أطفالهم الرضّع، أسّسوا روابط عاطفيّة قويّة وفعّالة، لا تقلّ جودة أو تأثيرًا عن تلك التي أسّستها الأمّهات.
التأثير في النموّ المعرفيّ والاجتماعيّ
تُظهر الأدلّة العلميّة أنّ مشاركة الآباء النشطة في حياة أطفالهم، تعود بنتائج إيجابيّة على مستويات متعدّدة من النموّ، بما في ذلك تطوّر اللغة، ومهارات حلّ المشكلات، والسلوك الاجتماعيّ. فقد كشفت دراسة أجراها تحالف أبحاث مشاركة الأب Father Involvement Research Alliance، أنّ الأطفال الذين يحظون بآباء مشاركين بانتظام في التربية، يميلون إلى تحقيق نتائج أكاديميّة أعلى، ويظهرون معدّلات أقلّ من السلوكيّات السلبيّة مقارنة بأقرانهم.
في الوقت نفسه، غالبًا ما تُعدّ الأمّ المحور العاطفيّ الأساس في السنوات الأولى من حياة الطفل، إذ تؤدّي دورًا محوريًّا في تنمية التعاطف، وتنظيم المشاعر، وتعزيز التواصل اللفظيّ؛ وهي جوانب أثبتت الأبحاث أهمّيّتها الكبرى في تشكيل الذكاء العاطفيّ لدى الطفل.
بالتالي، تشير النتائج بوضوح إلى أنّ كلًّا من الأمّ والأب يقدّمان دعائم مختلفة، ولكن متكاملة في رحلة تنشئة الطفل. فبينما قد يتميّز أحدهما بجانب معيّن، يُعوّل على الآخر في إغناء جوانب أخرى لا تقلّ أهمّيّة. وبذلك، فإنّ النجاح في التربية لا يُبنى على تفضيل جنس على آخر، بل على التكامل بين الأدوار، والالتزام المشترك، والحضور الواعي في حياة الطفل.
نقاط القوّة الفريدة للأمّهات والآباء في تربية الأطفال
بدلاً من التساؤل عن الأفضل، فالأنسب النظر إلى نقاط القوّة الفريدة التي يتمتّع بها كلّ والد، مع مراعاة التداخل والمرونة.
نقاط القوّة المرتبطة عادة بالأمّهات:
- انسجام عاطفيّ قويّ وتواصل لفظيّ.
- القيام بمهامّ متعدّدة في مسؤوليّات الرعاية.
- ترابط جسديّ وعاطفيّ عميق منذ الولادة.
- دعم مجتمعيّ، وخبرة أكبر في تقديم الرعاية بفضل الأدوار التقليديّة.
نقاط القوّة المرتبطة عادة بالآباء:
تشجيع المخاطرة واللعب البدنيّ.
الإسهام في بناء الثقة والاستقلاليّة.
المساعدة في تطوير المهارات الاجتماعيّة.
المشاركة في حلّ المشكلات والتأديب بطرق مميّزة.
من المهمّ ملاحظة أنّ هذه اتّجاهات عامّة، وليست أدوارًا ثابتة. فالعديد من الآباء يتميّزون بطبيعتهم بالرعاية والتعبير العاطفيّ، بينما تتميّز العديد من الأمّهات بالحزم والمرح والمغامرة. تعتمد التربية الفعّالة على مجموعة واسعة من المهارات التي لا يفرضها الجنس، بل الشخصيّة والالتزام والمشاركة الفعّالة.
تغيّر ديناميكيّات الأسرة وصعود مفهوم التربية المشتركة
تشهد هياكل الأسرة المعاصرة تحوّلات جذريّة، تعكس تنوّع الأدوار والمسؤوليّات داخل البيت الواحد. لم تعد الصورة التقليديّة للأسرة، حيث تُعنى الأمّ وحدها بالتربية بينما يعمل الأب خارج المنزل، هي القاعدة، فقد أصبحت الأمّهات العاملات، والآباء المقيمون في المنزل، والآباء العازبون، والأسر المشتركة بعد الانفصال أو الطلاق، مشاهد شائعة في مجتمعات اليوم.
في العديد من الأسر الحديثة، يتقاسم الأب والأمّ مهامّ الرعاية اليوميّة، بدءًا من تغيير الحفّاضات ومرافقة الطفل إلى الطبيب، إلى متابعة الدراسة وتنظيم الروتين اليوميّ. هذا التعاون العمليّ والتربويّ يعكس فهمًا أعمق لدور كلّ من الوالدين في النموّ المتوازن للطفل.
فوائد التربية المشتركة
تشير الدراسات إلى أنّ التربية المشتركة التي يكون فيها كلا الوالدين منخرطين بشكل متكافئ، تُسهم في تحسين نوعيّة الحياة الأسريّة، وتنعكس إيجابًا على الجميع. من بين أبرز الفوائد:
- ارتفاع مستوى رفاهيّة الطفل نفسيًّا وعاطفيًّا.
- تعزيز رضا الوالدين عن علاقتهما وشراكتهما الأسريّة.
- تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة لكلّ من الأمّ والأب.
- الحدّ من أعباء الأمّ النفسيّة والجسديّة، وتخفيف مشاعر الإرهاق والتوتّر.
إنّها مقاربة تُعيد توزيع الأدوار بطريقة أكثر عدالة وإنسانيّة، وتمنح الطفل بيئة أكثر استقرارًا واحتواء.
مخاطر الصور النمطيّة الجندريّة في التربية
الاستمرار في ترسيخ فكرة أنّ الأمّهات "أفضل بطبيعتهنّ" في التربية لا يضرّ بالآباء فحسب، بل يُثقل كاهل الأمّهات أيضًا بأعباء غير منصفة. فهذه النظرة التقليديّة تُنتج جملة من الآثار السلبيّة:
- شعور الأمّ بالذنب حين تعجز، أو تختار، ألّا تكون الراعي الوحيد أو الرئيس لأطفالها.
- تهميش دور الأب، حتّى عندما يسعى جدّيًّا للانخراط في حياة أطفاله بشكل فعّال وعاطفيّ.
- إغفال المجتمع لأهمّيّة مشاركة الأب العاطفيّة والتربويّة، وتقديمها على أنّها "مساعدة" لا "أبوّة".
الأخطر من ذلك، أنّ الأطفال بدورهم يمتصّون هذه الصور النمطيّة ويتشرّبونها، ما قد يؤثّر في تصوّرهم هويّاتهم الجندريّة، وأدوارهم المستقبليّة في العلاقات الأسريّة والشخصيّة.
ما الذي يجعل الأب أو الأمّ والدين جيّدين؟
بعيدًا عن مسألة الجنس أو الأدوار التقليديّة، فإنّ الوالديّة الناجحة تقوم على مجموعة من المبادئ الإنسانيّة العالميّة التي يمكن لأيّ شخص، سواء كان أبًا أو أمًّا أو مقدّم رعاية، أن يتبنّاها ويُجيد ممارستها. هذه المبادئ لا تتطلّب صفات بيولوجيّة، بقدر ما تتطلّب النيّة والوعي والحضور الحقيقيّ في حياة الطفل.
صفات الوالد الجيّد:
- الحضور العاطفيّ: أن يكون الوالد قريبًا من مشاعر طفله، مستمعًا لاحتياجاته النفسيّة، حاضنًا لمخاوفه، ومشجّعًا لفرحه وأحلامه.
- الاتّساق والثبات: توفير بيئة مستقرّة، وقواعد واضحة، وروتينًا يوميًّا يُشعر الطفل بالأمان، ويُساعده في فهم العالم من حوله.
- التأديب الإيجابيّ: تربية تقوم على التوجيه والحوار والقدوة الحسنة، بدلًا من العقاب أو التهديد، ما يعزّز من بناء الضمير الأخلاقيّ لدى الطفل.
- الدعم والتشجيع: تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتنمية شعوره بالقيمة، ومساعدته في بناء المرونة النفسيّة التي تُعينه في مواجهة تحدّيات الحياة.
المشاركة الفعّالة: الانخراط الحقيقيّ في حياة الطفل اليوميّة، من التعلّم واللعب، إلى الحديث والاستكشاف، ما يعزّز الروابط ويُغني النموّ العاطفيّ والمعرفيّ.
في نهاية المطاف، لا يُقاس نجاح الوالد بصفته أبًا أو أمًّا، بل بمدى التزامه بمرافقة طفله في رحلة الحياة بحبّ وثبات واحترام.
***
ربّما السؤال الأجدر بالطرح ليس: هل الأمّهات أفضل من الآباء في تربية الأطفال؟ بل: كيف يمكن لكلّ من الوالدين أن يسهم بفاعليّة في تنمية أطفالهما ورفاههم؟
فالتربية ليست ساحة تنافس بين الأدوار، بل شراكة متكاملة، جوهرها التعاون والمحبّة. الأطفال لا يحتاجون إلى والد "أفضل"، بل إلى بالغين حاضرين يمنحونهم الحنان والدعم والتوجيه، بعيدًا عن القيود التي يفرضها النوع أو العرف.
الاعتراف بالقيمة الفريدة التي يُقدّمها كلّ من الأب والأمّ، واحترام تنوّع الأدوار لا تقليديّتها، يفتح الباب أمام أسر أكثر توازنًا، وأطفال أكثر استقرارًا ونضجًا.
ومع تطوّر مفاهيم التربية في عصرنا، فإنّ مسؤوليّتنا الكبرى تكمن في ترسيخ قيم المشاركة والتعاطف والتفاهم المتبادل، بدلًا من إعادة إنتاج تصنيفات نمطيّة فقدت صلاحيّتها. ففي نهاية المطاف، لا يُقاس "تفوّق" الوالد بصفته البيولوجيّة، بل بما يمنحه يوميًّا من حبّ ورعاية ووجود حقيقيّ في حياة أبنائه.
المراجع
https://www.ajnet.me/family/2024/10/8/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF#:~:text=%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8,%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85.
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-48627260#:~:text=%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B2%20%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A,%D8%B1%D8%BA%D9%85%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%22.&text=%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9.
https://ivypanda.com/essays/are-women-better-parents-than-men/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2023/01/24/gender-and-parenting/