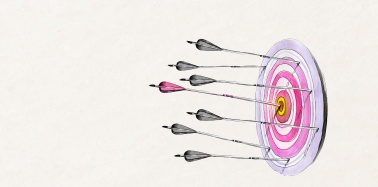يعدّ ضبط الصفّ عمليّة ديناميكيّة، تعتمد على توازن دقيق بين إدارة البيئة الصفّيّة وتنفيذ الاستراتيجيّات التعليميّة. مع تطوّر التربويّات الحديثة، تحوّل مفهوم ضبط الصفّ من مجرّد فرض للانضباط إلى فنّ تربويّ راقٍ، يعتمد على توجيه طاقات المتعلّمين نحو التعلّم الفعّال. وفي هذا السياق، يبرز دور المعلّم بصفته مخرجًا بارعًا، يحوّل الفوضى المحتملة إلى فرص. فكيف يمكن تحقيق التوازن بين الحيويّة الصفّيّة والانضباط التعليميّ، في ظلّ استراتيجيّات التعلّم الحديثة؟
أوّلًا: استراتيجيّات ضبط الإيقاع الصفّيّ
يقوم المستقبل التربويّ على معلّم لا يكبح جماح الطاقة لدى المتعلّمين، بل يحوّلها إلى وقود للتعلّم؛ ولا يقمع الضجيج، بل يوجّهه نحو حوار منتج؛ ولا يفرض النظام، بل يزرع ثقافة الانضباط الذاتيّ. إنّه تحوّل من فلسفة التحكّم في الصفّ إلى تمكين التعلّم، إذ يصير الفصل مساحة حيّة، تتنفّس الإبداع وتنبض بالتفاعل الهادف.
تبيّن دراسة الاستراتيجيّات أهمّيّة ضبط الإيقاع الصفّيّ بحسب التوجّهات التعليميّة، مثل التعلّم النشط الذي يقوم على استخدام الأنشطة التفاعليّة، مثل التعلّم التعاونيّ ولعب الأدوار وغيرها الكثير، ويؤكّد د. سليمان أبو مغلي (2019) في كتابه "استراتيجيّات التعلّم الحديثة"، على أنّ "تحوّل دور المعلّم من ناقل للمعرفة إلى ميسّر للتعلّم، يتطلّب إعادة هندسة للبيئة الصفّيّة، مع التركيز على التخطيط المرن والتقييم التكوينيّ".
كما يمكن اعتماد التعلّم القائم على المشاريع، عن طريق إشراك المتعلّمين في مشاريع طويلة المدى، ما يستدعي توفير جدول زمنيّ واضح مع نقاط تقييم مرحليّة. أمّا الصفّ المقلوب (Flipped Classroom)، فيعتمد على دراسة المادّة في المنزل ومناقشتها لاحقًا في الصفّ، ما يجعل المناقشات تفاعليّة عن طريق طرح الأسئلة التنافسيّة. وطبقًا لدراسة رانيا محمّد (2023)، فقد "أظهرت النتائج أنّ 78% من المعلّمين الذين طبّقوا استراتيجيّة الصفّ المقلوب، لاحظوا تحسّنًا ملحوظًا في انضباط الطلّاب، حيث أصبح الصفّ بيئة للمناقشة بدلًا من التلقين". وعلى الرغم من أهمّيّة هذه الاستراتيجيّات في بناء بيئة تعلّم ديناميكيّة، إلّا أنّ تطبيقها على أرض الواقع يواجه عقبات تُثقل كاهل المعلّمين، بسبب اكتظاظ الصفوف بأعداد من المتعلّمين تفوق القدرة الاستيعابيّة للفصل، ونقص الموارد، مثل محدوديّة الأدوات الرقميّة، أو صعوبة توفير بيئة تفاعليّة في مدارس ذات بنية تحتيّة قديمة، بالإضافة إلى الأعباء الإداريّة، مثل تراكم الأعمال الورقيّة والمهامّ غير التعليميّة التي تستهلك وقت المعلّم، وضغط المنهاج، إذ يُطلَب منه إنهاء محتوى مكثّف في وقت محدود، ما يُضعف فرص التطبيق الإبداعيّ.
هذا كلّه يجعل التحوّل من المعلّم الملقّن إلى الميسّر تحدّيًا أشبه بالسير على حبل مشدود. يصف أحد المعلّمين الذين التقيت بهم في إحدى الدورات التدريبيّة تجربته بقوله: "نؤمن بفلسفة التعلّم النشط، لكن كيف نطبّقها حين يكون لدينا 45 متعلّمًا في فصل ضيّق، ووزارة التعليم تصرّ على اختبارات تقيس الحفظ فقط".
وبناء على رؤيتي التربويّة ومقاربتي الموضوع من جهات عديدة، لا سيّما في عملي مشرفةً تربويّة، أرى أنّه على الرغم من ذلك، فالإصرار لدى العديد من المعلّمين على إيجاد حلول مرنة، يدفعنا إلى التكيّف مع الإمكانات باستخدام موادّ بسيطة (مثل الألعاب الورقيّة)، لتفعيل التعلّم التعاونيّ، والمبادرات الفرديّة مثل إنشاء مجموعات صغيرة أثناء الحصص الإضافيّة، والتضامن المجتمعيّ عن طريق التعاون مع أولياء الأمور أو المؤسّسات المحلّيّة أو البلديّات، لتوفير موارد داعمة.
لذا، يصير دور المؤسّسات التربويّة أساسيًّا في سدّ الفجوة، عن طريق تنفيذ تدريبات عمليّة وتنظيم دورات تدريبيّة، حتّى لا يظلّ الاعتماد قائمًا على النظريّات فقط، إضافة إلى توفير بيئة مدرسيّة داعمة تقوم على تخفيف الأعباء الإداريّة، وتخصيص ميزانيّات للأدوات التفاعليّة، ومراجعة سياسات التقييم بما يتوافق مع بيداغوجيا التعلّم النشط.
هذا كلّه يشكّل طريقة فعّالة في جعل الصفّ أكثر حيويّة، والتغلّب على التحدّيات الكامنة في صعوبة التحكّم بالوقت حينًا، أو الضجيج أحيانًا.
ثانيًا: الفرق بين الصفّ النشيط والصفّ الفوضويّ
في عالم التعليم، يبرز فارق جوهريّ بين الصفّ النشيط والصفّ الفوضويّ، إذ يتجلّى الأوّل بوصفه بيئة تعليميّة حيويّة، تزخر بالمشاركة الفاعلة والتعاون البنّاء، بينما يتحوّل الثاني إلى فضاء مشتّت، يفقد فيه التعليم جوهره. فالصفّ النشيط ينهض على هدف سامٍ يمثّل التعلّم بالمشاركة الإيجابيّة، إذ يؤدّي المعلّم دور الموجّه والمنظّم الذي يحوّل الضجيج إلى حوارات مثمرة ومناقشات هادفة، لينتهي المطاف بتحقيق الأهداف التعليميّة وإنجاز المهامّ بكفاءة. أمّا الصفّ الفوضويّ فيغيب عنه هذا النسق المنظّم، إذ يتحوّل المعلّم من قائد تربويّ إلى شخص عاجز عن التحكّم، ويصير الضجيج عشوائيًّا مليئًا بالتشويش والشتات، ما يؤدّي في النهاية إلى هدر الوقت وضياع الفرص التعليميّة، من دون تحقيق أيّ نتائج تذكر. وبين هذين النموذجَيْن، يتحدّد مصير العمليّة التعليميّة بين الإنجاز والفشل، وبين البناء والهدم.
ثالثًا: التحدّيات والحلول في إدارة الصفوف المدرسيّة
تواجه العمليّة التعليميّة تحدّيات متنوّعة، تتطلّب حلولًا إبداعيّة تضمن تحقيق الأهداف التعليميّة. وتواجه المدارس العربيّة – بخاصّة الموجودة في البيئات محدودة الموارد – تحدّيات حقيقيّة، تعيق تطبيق النظريّات التربويّة المثاليّة، مثل اكتظاظ الفصول (60-70 متعلّمًا في الصفّ، ما يضعف فرص التعلّم الفرديّ)، ونقص التدريب على استراتيجيّات إدارة الصفوف الكبيرة، والمناهج المكثّفة التي تركّز على الكمّ بدلًا من الجودة، وغياب الدعم اللوجستيّ (مثل عدم توفّر التقنيّات أو المساحات الكافية).
لكن، على الرغم من هذه التحدّيات، يبتكر المعلّمون العرب حلولًا عمليّة تُظهر مرونة مدهشة، منها:
1. تكييف استراتيجيّات عالميّة مع الواقع المحلّيّ:
- - مراكز التعلّم (Learning Stations): يمكن تطبيقها بشكل مبسّط، عن طريق تقسيم المتعلّمين إلى مجموعات ثابتة (5-6 متعلّمين)، مع تكليف كلّ مجموعة بمهمّة محدّدة، مثل مناقشة سؤال، أو حلّ تمرين جماعيّ، ثمّ تناوب المجموعات على الأنشطة خلال الحصّة.
- - التعليم المتمايز (Differentiated Instruction): باستخدام التمارين الذكيّة، مثل طرح ثلاثة مستويات من الأسئلة (سهلة/متوسّطة/صعبة)، وترك الحرّيّة للمتعلّم لاختيار ما يناسبه، مع تشجيع من ينهي مبكّرًا على مساعدة زملائه.
2. حلول إبداعيّة من الصفوف العربيّة:
- - نظام المساعدين: تفعيل متعلّمين متميّزين مساعدي معلّمين، لمراقبة المجموعات الصغيرة أو تصحيح التمارين البسيطة، ما يخفّف العبء عن المعلّم.
- - حقيبة الطوارئ التعليميّة: إعداد أنشطة سريعة (أوراق عمل، ألغاز، منافسات شفهيّة)، لاحتواء الفوضى عند فقدان السيطرة على الصفّ.
- - التعليم بالتمثيل: تحويل الدروس إلى قصص أو مواقف دراميّة بسيطة يشارك فيها المتعلّمون، لجذب الانتباه في الصفوف المزدحمة.
3. أدوات بسيطة لإدارة الضجيج والوقت:
- - إشارات غير لفظيّة: يتّخذ المعلّم بعض الإشارات في صفّه، مثل رفع اليد لإعادة التركيز، أو استخدام جرس صغير، للإعلان عن الانتقال بين الأنشطة.
- - القواعد المشتركة: يتمّ التفاوض عليها مع المتعلّمين في بداية العام. مثال: "مَنْ يريد الكلام يرفع يده، ونحترم وقت الإجابة".
- - التصفيق الإيقاعيّ: مثل اعتماد نمط تصفيق معيّن (على سبيل المثال لا الحصر: تصفيقتان سريعتان + تصفيقة بطيئة) لاستعادة التركيز.
- - المعلّم الصامت: الكتابة على السبّورة بدل الكلام عند ارتفاع الضجيج (يجذب الانتباه بالفضول).
في حوار شخصيّ مع أحد المعلّمين العرب، في تمّوز 2025، قال: "نطبّق ما نستطيع، لا ما يُكتب في الكتب. حين أسمع بـالصفّ المقلوب، أضحك، لأنّ نصف تلامذتي لا يملكون إنترنت في بيوتهم. لكنّني استخدمت التعلّم بالتناوب، بأن يشرح المتعلّمون لبعضهم بعضًا داخل الصفّ، وقد وجدت ذلك حلًّا عمليًّا، أو أن أحضر بعض الجرائد التي تلقي الضوء على معلومات مهمّة أريد عرضها، ولكنّ الصعوبة تكمن في قلّة الموارد التفاعليّة، ما يجعلني أخترع بعض الطرائق من أجل الابتعاد عن التلقين".
4. دور المؤسّسات في الدعم:
على كلّ مؤسّسة توفير تدريبات ميدانيّة، تركّز على إدارة الصفوف الكبيرة بدلًا من النظريّات العامّة،إضافة إلى تخفيف أعباء المنهج، لترك مساحة للتطبيقات التفاعليّة التي صارت ذات أهمّيّة كبيرة في العمليّة التعليميّة، ناهيك عن تعزيز التعاون بين المعلّمين عن طريق تبادل الحلول الناجحة، مثل مجموعات الواتسآب التربويّة، أو المشاهدات الصفّيّة التي تؤدّي إلى الإفادة من بعضهم بعضًا.
ولمواجهة هذه التحدّيات، يقدّم المربّون حلولًا إبداعيّة جُرّبَت ميدانيًّا، منها تطبيق نظام المكافآت الرمزيّة الذي يحفّز المتعلّم بمنح نقاط للسلوك الإيجابيّ، تُترجم لاحقًا إلى امتيازات صفّيّة، مثل اختيار الأنشطة التعليميّة. كما أثبت التقييم الذاتيّ فاعليّته، عندما يُشرك المتعلّم في تقييم أدائه اليوميّ بواسطة استمارات بسيطة، ما يعزّز لديه روح المسؤوليّة والوعي الذاتيّ. وقد ذكر المركز العربيّ للبحوث التربويّة (2022) في تقريره إدارة الصفوف في البيئات محدودة الموارد: "تعاني المدارس العربيّة من تحدّيات فريدة، في التوفيق بين متطلّبات المناهج المكثّفة واستراتيجيّات التعلّم النشط". وانطلاقًا من هذه الفكرة، صار لزامًا علينا تدريب المعلّمين، وتعزيز التعليم النشط من دون التأثير السلبيّ في دراسة المنهج، ما يتطلّب خلق بيئة تعليميّة ديناميكيّة تحترم الفروق الفرديّة، وتحقّق الانضباط الذاتيّ، ما ينعكس إيجابًا على جودة العمليّة التعليميّة برمّتها. وقد أكّد أبو مغلي (2019) ذلك في كتابه: "إنّ التمايز التعليميّ ليس رفاهيّة تربويّة، بل ضرورة ملحّة في الصفوف المختلطة المستوى، حيث تظهر الدراسات أنّ الطلاب يتعلّمون بفعّاليّة أكبر بنسبة 40% عندما تتوافق الأنشطة مع مستواهم".
وإن أردنا التأكّد ممّا نقوله، يمكننا الاستشهاد بمثال تطبيقيّ. ففي إحدى المدارس الحكوميّة في محافظة إربد في الأردنّ، يصل عدد المتعلّمين إلى خمسة وستّين متعلّمًا في الصفّ، وقد طبّق المعلّمون استراتيجيّة التعلّم التعاونيّ بالمراكز، باستخدام موارد محدودة:
1. تحويل الفناء الخلفيّ إلى مساحة تعلّميّة، باستخدام سجّاد قديم وطاولات متحرّكة.
2. تقسيم المتعلّمين إلى مجموعات صغيرة ( 5-6 متعلّمين)، مع تكليف كلّ مجموعة بمهمّة مختلفة (تحليل نصّ، حلّ تمرين، رسم خرائط ذهنيّة).
3. استخدام أدوات محلّيّة، مثل علب الكرتون الفارغة لصنع صناديق المعرفة، وورق الجرائد الملوّن للأنشطة التفاعليّة.
وبعد أربعة أشهر، وبحسب التقرير الرسميّ لوزارة التربية والتعليم الأردنيّة (2022)، تبيّن انخفاض معدّلات الفوضى بنسبة ٥٠٪، وتحسّن نتائج المتعلّمين في الاختبارات الوطنيّة بنسبة ٣٠٪، وزيادة مشاركة أولياء الأمور في دعم الأنشطة الصفّيّة.
رابعًا: ضبط الصفّ بين المراحل التعليميّة: بين التنظير والتحدّيات اليوميّة
يختلف ضبط الصفّ من مرحلة تعليميّة إلى أخرى، لكنّ التحدّيات المشتركة، مثل الاكتظاظ وقلّة الموارد، تجعل التطبيق العمليّ أبعد ما يكون عن السهولة النظريّة. ففي المرحلة الابتدائيّة، يُنصح بالروتين والأغاني التعليميّة، حيث يجد المعلّم نفسه أمام خمسين طفلًا، يحتاجون إلى أكثر من بطاقات ملوّنة لجذب الانتباه. بعض المعلّمين ينجحون في تحويل الضبط إلى لعبة جماعيّة، بأن يسمحوا للمجموعة الأكثر هدوءًا أن تختار النشاط التالي، بينما يلجأ آخرون إلى تفويض المهامّ الصغيرة، مثل حارس الأقلام، ومنظّم الدفاتر، وهذا كلّه من أجل تعزيز المسؤوليّة الفرديّة.
أمّا في المرحلة المتوسّطة، يبرز تمرّد المراهقة، وتصير استراتيجيّات تعزيز المسؤوليّة الذاتيّة مجرّد كلام نظريّ، إذا لم تُبنَ على احترام متبادل. لذا، يتحوّل التفاوض مع المتعلّمين حول قواعد الصفّ (كيف ننظّم المناقشة؟) إلى حلّ أكثر فاعليليّة من التلقين، كما إنّ تقسيم الحصّة إلى أنشطة قصيرة متنوّعة (شرح، منافسة، تطبيق) يُقلّل من فرص الفوضى.
وفي المرحلة الثانويّة، نرى أنّ المتعلّمين يعتمدون على أنفسهم، وهذا ما قد يفشل تعيين قادة الصفّ، إذا شعر المتعلّمون بأنّه شكل من أشكال التمييز، أو تحوّل إلى سلطة مزعجة. بعض المعلّمين يجدون حلًّا في القيادة الدوريّة، أو ربط المحتوى باهتمامات المتعلّمين، مثل مقارنة استراتيجيّات كرة القدم بالحروب التاريخيّة. عبر هذه المراحل كلّها، تثبت التجارب الميدانيّة أنّ الضبط الفعّال ليس تطبيقًا حرفيًّا للنظريّات، بل مزيج من المرونة والحزم، إذ يعترف المعلّم أحيانًا بأنّ بطاقات الألوان فشلت، لكنّه يكتشف أن تفويض المهامّ اليوميّة قد نجح.
***
ضبط إيقاع الصفّ ليس معادلة ثابتة، بل مرنة تتكيّف مع حاجات المتعلّمين والسياق التعليميّ. والنجاح هنا لا يقاس بالصمت المطلق، بل بقدرة المعلّم على تحويل الفوضى المحتملة إلى طاقة تعلّميّة. المفتاح هو التخطيط المسبق والمرونة والفهم العميق لطبيعة المتعلّمين، لأنّ الصفّ الجيّد ليس مكانًا يُسمع فيه صوت المعلّم فحسب، بل مكانًا تُسمع فيه أصوات المتعلّمين وهم يُكوّنون أفكارهم.
إنّ إدارة الصفّ الناجحة تشبه قيادة الأوركسترا؛ إذ ينسجم كلّ من المعلّم والمتعلّمين في تناغم إيقاعيّ مثمر. ومثل موسيقيّ محترف، على المعلّم أن يعرف متى يرفع العصا، ومتى يخفضها، ومتى يترك الفرصة للآلات (المتعلّمين) أن تعزف لحنها الخاصّ. وكما يقول البروفيسور سميث (2022): "المعلّم الناجح في العصر الحديث هو من يستطيع تحويل التحدّيات إلى فرص تعلّم، مستخدمًا طاقات الطلّاب وقودًا للعمليّة التعليميّة بدلًا من كبحها".
وتبقى إدارة الصفّ فنًّا تربويًّا متجدّدًا، يحمل في طيّاته إمكانات لا محدودة للتطوير والإبداع. ففي عصر يتسارع فيه تغيّر المنظومات التعليميّة، وتتنوّع فيه حاجات المتعلّمين، يبرز سؤال جوهريّ: كيف يمكن تحويل كلّ تحدّ إلى فرصة، وكلّ صعوبة إلى بوّابة إبداع؟
المراجع
- أبو مغلي، سليمان. (2019). استراتيجيّات التعلّم الحديثة بين النظريّة والتطبيق. دار الفكر.
- الحارثي، منى. (2023). المرونة التربويّة في إدارة الصفوف المكتظّة. مجلّة التربية، 8(1)، 30-45.
- العتيبي، أحمد. (2021). فنّ إدارة الصفّ في عصر التعلّم النشط. دار الجامعة.
- المركز العربيّ للبحوث التربويّة. (2022). تقرير إدارة الصفوف في البيئات محدودة الموارد. القاهرة.
- محمّد، رانيا. (2023). أثر التعلّم المقلوب على الانضباط الصفّي. مجلّة العلوم التربويّة، 15(2)، 45-67.
- وزارة التربية والتعليم الأردنيّة. (2022). التقرير السنويّ لمشروع "مدرستي تحدٍّ وإبداع". إربد: إدارة الإشراف التربويّ.
- Lemov, D. (2015). Teach Like a Champion 2.0. Jossey-Bass.
- Marzano, R. J. (2003). Classroom Management that Works. Virginia: ASCD.
- Leonard, D. (2023, October 13). Simplifying classroom management for new teachers. Edutopia.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025