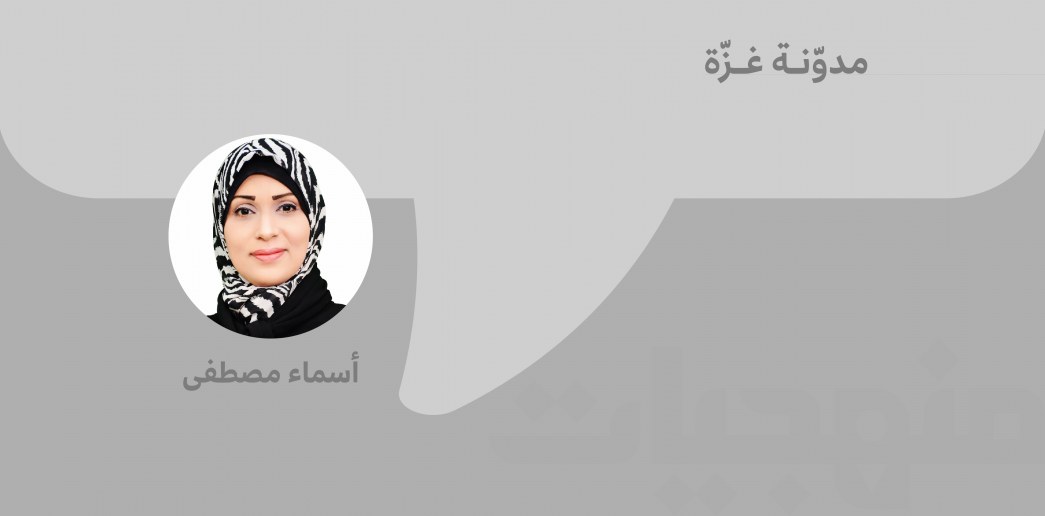منذ اللحظة التي خفّ فيها دخان الانفجارات الأولى، وبقي الأطفال يطوون الأيّام بين الخوف والجهل، وُلدت حالة تربويّة فريدة في غزّة، لم تأتِ من قاعات الوزارة ولا من مكاتب المؤسّسات، بل جاءت من قلب المعلّمين أنفسهم، أولئك الذين رفضوا أن يتركوا الطفولة تواجه العتمة وحدها. لم تنتظر المبادرات تَوقّف الحرب كي تنطلق؛ بل بادر المعلّمون تحت النار، ودرّسوا الأطفال تحت القصف، وجعلوا من كلّ زاوية آمنة نسبيًّا فصلًا صغيرًا يصدّ الجهل ويواسي القلوب. هكذا ظهر المعلّمون المبادرون مثل روح موازية للنظام التعليميّ المتهالك، ونداءٍ أخلاقيّ لا ينتظر إذنًا رسميًّا ولا غطاءً مؤسّسيًّا. نداء يؤمن بأنّ التعليم ليس وظيفة، بل غريزة من غرائز البقاء. ومع ذلك، فهذه الحركة التي نهضت بكلّ هذا الإيمان، سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة واقع شديد التعقيد، تتقاطع فيه البنية الرسميّة للتعليم مع ضرورات الطوارئ، ويختلط فيه الواجب الأخلاقيّ بالصراع على السلطة، لتنشأ علاقة ملتبسة، صداميّة أحيانًا، بين النظام الرسميّ والمعلّمين المبادرين.
البديل المبادِر
استمرّ الحال في غياب نظام تعليم رسميّ يمكن الاتّكاء عليه، فيما ظلّ العمل المبادراتيّ هو الخيط الوحيد الذي يربط الأطفال بعالم التعلّم. كانت المدارس ركامًا أو ملاجئ مكتظّة، والكتب ضائعة بين النزوح والموت، والوزارة نفسها تواجه انهيارًا إداريًّا لم تشهده منذ عقود. في هذا المشهد الذي تقدّمت فيه غريزة النجاة على أيّ أولويّة أخرى، بدا التعليم في الأيّام الأولى أشبه برفاهيّة مؤجّلة. ومع ذلك، فالأطفال بطبيعتهم التي تتشبّث بالاعتياد، كانوا يفتقدون المدرسة كما يفتقدون بيوتهم، وربّما أكثر. وهنا بالتحديد واصلت المبادرات التربويّة العفويّة تمدّدها، إذ ظلّ المعلّمون يجمعون الأطفال في زوايا المخيّمات، أو تحت الأشجار، أو في غرف صغيرة ما زالت واقفة، محاولين أن يعيدوا إلى الصغار ما يمكن إنقاذه من الروتين، ومن الإحساس بأنّ هناك عالمًا طبيعيًّا ما زال موجودًا خارج الحرب.
ولم تكن هذه المبادرات مجرّد بدائل مؤقّتة للتعليم، بل كانت في الحقيقة محاولات لإعادة ترميم الروح الغزيّة المنكوبة. المعلّمون الذين فقد بعضهم منازلهم وأفرادًا من عائلاتهم، حملوا على أكتافهم مسؤوليّة أكبر من طاقتهم، ولكنّهم مضوا على رغم ذلك؛ وكأنّ كلّ طفل يجلس أمامهم تعويض عن طفل آخر سقط، وكلّ صفحة يقرؤوها إعلان مقاومة ضدّ الفراغ. هنا تحديدًا بدأت القصّة الحقيقيّة التي يسعى هذا المقال لتوثيقها: قصّة المعلّمين الذين تصدّوا لفراغٍ تربويّ هائل، ثم وجدوا أنفسهم لاحقًا في مواجهة بُنية رسميّة لم تفهم طبيعة ما فعلوه، أو ربّما فهمته وبدأت بالتصادم معه عقب انتهاء حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة.
ما ينمو من الأرض وما يُسقط عليها
ومع استمرار الكثير من مؤسّسات التعليم الدوليّ إلى التدخّل في غزّة بعد أشهر قليلة من الحرب، بدأت تتشكّل مفردات جديدة في المشهد التربويّ: "خطط التعليم في مرحلة التعافي"، و"الإطار الوجيز"، و"الاستجابة العاجلة ما بعد الصدمة"، و"مساحات التعافي"، و" مساحات صديقة للطفل"، وغيرها من المصطلحات التي بدت برّاقة من بعيد، لكنّها لم تستطع إخفاء حقيقة أنّ من كان على الأرض قبيل هذه الخطط هم المعلّمون أنفسهم: يعملون بلا تدريب، وبلا أدوات، وبلا غطاء. كانت مؤتمرات الدول تتحدّث عن التعليم بوصفه حاجة إنسانيّة، بينما كانت المبادرات التربويّة في الميدان تتحوّل إلى شريان حياة. هذه المفارقة خلقت توتّرًا مبكّرًا بين ما هو نظريّ وما هو عمليّ، بين التخطيط المكتبيّ وبين التدريس وسط الخراب.
وبينما أخذت المؤسّسات الدوليّة تبحث عن شركاء محلّيّين للعمل معهم، اتّجهت الأنظار، بشكل طبيعيّ، نحو الوزارة بوصفها الجهة الرسميّة. غير أنّ هذا التوجّه أعاد إلى السطح سؤالًا حساسًا: أين موقع المعلّمين المبادرين في منظومة التعافي؟ هنا بدأت علاقة متوتّرة تتكشّف، علاقة لم تكن عدائيّة في بدايتها، لكنّها اتّخذت شكل الصدام تدريجيًّا، حين بدأ النظام الرسميّ ينظر إلى المبادرات باعتبارها كيانات تعمل خارجه، وربّما قد تُضعف سلطته أو تُربك سرديّته الإداريّة. في المقابل، شعر المعلّمون المبادرون بأنّ الدور الذي أدّوه في الأيام الأكثر ظلمة يجري تهميشه، وأنّ خبرتهم الميدانيّة، التي تكاد تكون معرفة لا تُقدّر بثمن، يجري تجاهلها لصالح إملاءات مركزيّة لا تعكس واقع الطوارئ.
ومع مرور الوقت، لم يعد التوتّر مجرّد شعور داخليّ، بل أصبح واقعًا ينعكس في القرارات والتصاريح وآليّات التنسيق. كثير من المعلّمين وجدوا مبادراتهم مهدّدة بالإيقاف بحجّة أنّها تعمل خارج الإطار الرسميّ، بينما كانوا يدركون أنّ الإطار نفسه كان منهارًا حين بدأوا العمل. بدا الأمر كما لو أنّ النظام التربويّ يحاول استعادة سلطته سريعًا، ولو على حساب أكثر التجارب صدقًا وأصالة في تاريخ التعليم في غزّة. هذا الشعور بالهشاشة، والخوف من أن يصبح الجهد الكبير مهدّدًا، دفع بالعديد من المعلّمين إلى التراجع أو العمل بصمت، وهو ما أثّر بشكل عميق على جودة التعليم البديل، وعلى صحّة الأطفال النفسيّة.
بين جمود ومرونة والأطفال بينهما
واللافت في هذه المرحلة أنّ جوهر الصراع لم يكن تربويًّا خالصًا، بل كان إداريًّا وسياسيًّا في المقام الأوّل. فالنظام الرسميّ، بطبيعته، يميل إلى المركزيّة والانضباط، بينما المبادرات بطبيعتها استجابة فوريّة إنسانيّة مرنة، متغيّرة حسب ظروف الواقع المجتمعيّ المنكوب، وتقوم على التحرريّة، وعلى الابتكار الفرديّ. هذا الاختلاف الفلسفيّ جعل كلّ طرف يشعر بأنّ الطرف الآخر يتصرّف على نقيضه. وقد علت مؤخّرًا أصواتٌ من النظام التعليميّ الرسميّ كانت ترى في المبادرات حالة تفلّت وعشوائيّة. والمعلّمون كانوا يشعرون بأنّ الوزارة تمنع الحياة من الوصول إلى الأطفال. ومع استمرار هذا التوتّر، بدأت تظهر خسائر ملموسة: مبادرات توقّفت، وأطفال فقدوا البيئة الآمنة التي كانوا يجدونها، ومعلّمون تراجعوا رغم قدرتهم العالية على العطاء.
غير أنّ ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا هو أنّ المعلّمين المبادرين لم يكونوا مجرّد فاعلين تربويين، بل كانوا شهودًا على الألم الجماعيّ، وأمناء على رواية المعاناة كما رآها الأطفال. كانت المبادرات مساحة يجتمع فيها التعليم مع العلاج النفسيّ، واللعب مع المقاومة الاجتماعيّة، والحكاية مع البقاء. ولذلك، لم يكن توقّف هذه المبادرات عن العطاء، لأيّ سبب كان، مجرّد إجراء إداريّ فحسب؛ بل كان يعني فقدان أحد أهمّ أنسجة التعافي الاجتماعيّ. لقد كانت المبادرات، ببساطتها، واحدة من أهمّ أدوات مواجهة الصدمة، ولعلّ هذا ما لم يدركه المنادون بوقفها عاجلاً.
ومع مرور الشهور، بدأت تتشكّل لدى كثير من المعلّمين قناعة بأنّ استمرار عملهم أصبح مشروطًا بانصياع صارم للقرارات، أو بقدرة على العمل بعيدًا عن النمط التحرريّ. هذه الظروف خلقت حالة من الازدواجيّة في أدوارهم: فهم من جهة، يلتزمون بالتعليم الرسميّ حين يُستأنف. ومن جهة أخرى يشعرون بأنّ التعليم الرسميّ نفسه لا يعترف بما قدّموه خلال فترة الانهيار. هذا التناقض لا يؤثّر فقط في نفسيّة المعلّم، بل يؤثّر في روح العمليّة التعليميّة نفسها، لأنّ التعافي الحقيقيّ يحتاج إلى معلّم يشعر بالاستقرار، وبالتقدير، وبأنّ جهده ليس مجرّد "سدّ فراغ مؤقّت".
النقاش الحقيقيّ هنا لا يتعلّق بوجود النظام الرسميّ أو غيابه، ولا يتعلّق بضرورة المبادرات من عدمها، بل يتعلّق بسؤال أعمق: كيف نعيد بناء نظام تعليميّ في مجتمع محاصر، مُنهك، تعرّض إلى أكبر موجة تدمير في تاريخه؟ وهل يمكن لنظام كهذا أن يتعافى من دون احتضان القوى الحيّة التي ظهرت وسط الركام؟ وهل يمكن للوزارة أن تبني مستقبلًا تربويًّا بغير الاعتراف بمن حافظوا على التعليم حين كانت هي نفسها عاجزة؟ هذه الأسئلة ليست مجرّد تقارير، بل هي مفاصل أساسيّة في فهم مستقبل التعليم في فلسطين.
إعادة تعريف التعليم تنطلق من غزّة
ولعلّ أكثر ما يستحق التأمّل هو أنّ الطفل الغزّيّ، الذي عاش الحرب بكلّ تفاصيلها، لم يكن يفرّق بين معلّم رسميّ ومعلّم مبادر، بل كان يرى معلّمه شخصًا يمنحه الأمان. هذا المعنى البسيط والعميق، يلخّص كلّ ما حدث. فالطفل الذي كان يجلس تحت شادر، ممسكًا بدفتر متّسخ، كان يجد في المعلّم عنوانًا للحياة. ولذلك، فإن أيّ نقاش إداريّ يتجاهل حقيقة أنّ التعليم في غزّة لا يقوم على المكاتب، بل يقوم على هذا اللقاء الإنسانيّ، سيكون نقاشًا قاصرًا، مهما بلغت دقّته.
ومن هُنا، يصبح من الضروريّ إعادة النظر في مفهوم "التعليم الرسميّ" نفسه. ففي الطوارئ، لا يمكن للتعليم أن يُدار بالطريقة نفسها التي يُدار بها في الفترات الاعتياديّة. ولا يمكن للنظام التربويّ أن يتصرّف وكأنّ الحرب لم تحدث. الطوارئ تفرض مرونة، وجرأة، وإبداعًا، وتفرض الاعتراف بأنّ المبادرات ليست منافسًا، بل شريكًا أصيلًا. تجربة غزّة ليست مجرّد حالة محليّة، بل هي نموذج عالميّ لكيف يمكن للتعليم أن ينهض من تحت الرماد حين يمتلك المعلّمون شجاعة التدخّل. هذه التجربة، لو تمّ احتضانها، ستكون مرجعًا عالميًّا في تعليم الطوارئ، ولكنّها، للأسف ما زالت مهدّدة بالتفكك بسبب التعقيدات السياسيّة والإداريّة.
المستقبل التربويّ لغزّة يتوقّف اليوم على قدرة النظام الرسميّ على تجاوز مخاوفه، وقدرة المعلّمين المبادرين على الصمود، وقدرة المؤسّسات الدوليّة على التعامل باحترام مع التجربة المحلّيّة. فالوزارة بحاجة إلى أن تعترف بأنّ التعليم في الطوارئ لا يمكن ضبطه بمعايير البيروقراطيّة، والمعلّمون بحاجة إلى مظلّة حماية تدعمهم بدلًا من أن تقيّدهم، والمؤسّسات بحاجة إلى أن تستمع أكثر مما تتحدّث. هذا الثالوث، إذا تحقّق فيه الحدّ الأدنى من الانسجام، سيُحدث نقلة نوعيّة في مسار التعافي.
وفي النهاية، لا يمكنني في هذا المقال إلا أن أُذكّر بأنّ غزّة اليوم أمام فرصة عظيمة لإعادة تعريف التعليم. الفرصة لا تأتي من الأبنية الجديدة التي ستُشيّد، ولا من المناهج التي ستُطبع، بل تأتي من الإنسان نفسه: من المعلّم الذي لم يترك الطفل وحيدًا، ومن الطفل الذي أصرّ على أن يتعلّم على رغم كلّ شيء. وبين هذين الطرفين، يجب أن تنشأ رؤية تربويّة تحترم المبادرة، وتمنحها الشرعيّة، وتبني عليها نظامًا أكثر اتّساعًا من البيروقراطيّة، وأكثر إنسانيّة من اللوائح، وأكثر إخلاصًا من كلّ الخطابات.
***
التعليم في غزّة لم يعد مجرّد مؤسّسة، بل أصبح فعل مقاومة. وأوّل درس في هذه المقاومة هو أن نعترف بالمعلّمين المبادرين بوصفهم قلب المرحلة، وأن ندرك أنّ الصدام بين النظام الرسميّ والمبادرات ليس قدرًا محتومًا، بل هو معركة يمكن تحويلها إلى شراكة، إذا توفّرت الإرادة، وإذا أدرك الجميع أنّ مصلحة الطفل يجب أن تكون أعلى من كلّ شكل من أشكال السلطة. وفي ذلك، تبدأ القصّة الجديدة: قصّة بناء تعليم يليق بغزّة، وبمعلّميها، وبأطفالها الذين علّمونا أنّ الحياة ممكنة، حتّى حين يتعارض كلّ شيء مع الحياة.