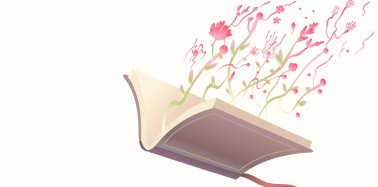أصداء الدردشة قراءات في سؤال من أسئلة قسم الدردشة في منهجيّات، تختار فيها هيئة التحرير سؤالًا من نسخة من نسخ الدردشة في المجلّة، بناءً على ارتباط السؤال بملفّ العدد، أو بأهمّيّة الموضوع أو راهنيّته المستجدّة، حيث تُدرَس إجابات مجموعة من المعلّمين، ويُجمع بينها باستنتاجات أو خلاصات منها. في كلّ عدد من منهجيّات صدى جديد من أصوات معلّمينا ومعلّماتنا.
****
يشهد التعليم اليوم تحوّلات متسارعة في مضمونه وأهدافه؛ إذ لم تعد المعرفة وحدها كافية لتأهيل الطالب لمواجهة متطلّبات الحياة. فقد بات من الضروريّ أن يكتسب المتعلّم – إلى جانب المعارف العلميّة – مهارات اجتماعيّة تساعده في التواصل الفاعل، والعمل الجماعيّ، وحلّ المشكلات، والتفاعل الإيجابيّ مع محيطه. يستند هذا التوجّه إلى رؤية شاملة تعتبر الإنسان وحدة متكاملة، لا تنفصل فيها القدرات الذهنيّة عن المهارات السلوكيّة.
لكن يطرح هذا التوجّه تحدّيات حقيقيّة داخل البيئة التعليميّة، خصوصًا عندما يتعلّق الأمر بتطبيقه ضمن البرامج الدراسيّة الحديثة، والتي غالبًا ما تركّز على المحتوى العلميّ والمعايير الأكاديميّة. وهنا يبرز سؤال جوهريّ: "إلى أيّ مدى يمكن التوفيق بين تعليم المهارات الاجتماعيّة وتعليم المعارف العلميّة؟" يمثّل هذا التساؤل نقطة الانطلاق لهذا المقال الذي يحاول استكشاف الإجابة، بتحليل تصوّرات المعلّمين والتربويّين الذين طُرح عليهم هذا السؤال ضمن إحدى نسخ الدردشة لعام 2023.
دمج المهارات الاجتماعيّة في الأنشطة الصفّيّة
يمثّل النشاط الصفّيّ مساحة حيويّة، يمكن بواسطتها إدخال المهارات الاجتماعيّة ضمن سياق التعلّم الأكاديميّ، من دون الحاجة إلى فصلها عن المحتوى العلميّ، أو التعامل معها باعتبارها مكوّنًا مستقلًّا. تقول روزين رزق: "لا يمكن تدريس المعارف بوصفها "معرفة معزولة"، إنّما يُدمج تعلّم المعارف بالمهارات عن طريق تعزيز مهارات التفكير النقديّ والإبداعيّ، واحترام وجهات النظر، والتعلّم التعاونيّ، واتّخاذ القرارات، والتواصل الفعّال، ومراعاة المشاعر الذاتيّة ومشاعر الآخرين".
تستدعي الأنشطة الصفّيّة بطبيعتها التفاعل بين الطلّاب؛ فعندما تُصمّم بما يحقّق أهدافًا معرفيّة واجتماعيّة في الوقت ذاته، يصبح من الممكن تحقيق توازن فعليّ بين الجانبين، من دون التضحية بأحدهما. يرى مجد خضر ضرورة توظيف التعليم الدامج الذي يدمج بين الأنشطة المنهجيّة في المادّة الدراسيّة، مع المهارات الاجتماعيّة والمواقف المتنوّعة التي قد تواجه الطالب في حياته. ويؤكّد على استخدام أنشطة وتمرينات معتمدة على النتاجات والمعارف العلميّة في الكتب المدرسيّة، والتي تطوّر مهارات ومعارف الطلّاب.
يتطلّب تصميم الأنشطة الصفّيّة رؤية تعليميّة، تدمج المهارات ضمن الموقف التعليميّ نفسه، وتُوظّف التفاعل وسيلة لتحقيق الفهم. يشير طارق محمّد إلى مسؤوليّة المعلّم في التخطيط للأنشطة الصفّيّة، مؤكّدًا على ضرورة وضع استراتيجيّات متنوّعة وهادفة لتحسين المهارات الاجتماعيّة، وحصول الطلّاب على المعارف العلميّة المطلوبة. وبهذا الشكل، يصبح التفاعل جزءًا من بنية الدرس.
ويقترح مصطفى أمين تضمين أنشطة تعاونيّة ومشروعات جماعيّة، ضمن مناهج العلوم والرياضيّات لتعزيز المهارات الاجتماعيّة، وتدريبات الاتّصال والتفاعل الاجتماعيّ في البرامج العلميّة للموادّ الأدبيّة، لتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعيّ؛ إذ يساعد هذا التوازن في تطوير طلّاب متوازنين، يمتلكون المعرفة العلميّة والمهارات الاجتماعيّة اللّازمتين للنجاح في الحياة الشخصيّة والمهنيّة.
كما يعزّز الاعتماد على الأنشطة الصفّيّة من انخراط المتعلّمين في الدرس، ويمنحهم شعورًا بالدور والفاعليّة؛ وهو ما ينعكس بدوره على مناخ الصفّ بأكمله. فكما تشير تيو إيمان، لا تُكتسب المهارات الاجتماعيّة بالتنظير وحده، وإنّما بالممارسة اليوميّة داخل مواقف طبيعيّة، تُحفّز الطالب على أنّ يكون مشاركًا لا متلقّيًا.
تصميم المواقف التعليميّة حول المهامّ لا المعلومات
تحوّل التعليم من كونه عمليّة تكديس معلومات، إلى كونه بناء للمعنى داخل مواقف مركّبة، يفتح المجال أمام الجمع بين المعرفة والمهارات الاجتماعيّة في آنٍ واحد. فعندما يُعاد تشكيل الموقف التعليميّ حول مهمّة تؤدّي إلى إنتاج أو حلّ، وليس حول معلومة تُستقبَل فقط؛ يصبح المتعلّم طرفًا فاعلًا في العمليّة التعليميّة. ويشير ماهر منصور إلى التعلّم القائم على المشروعات، بوصفه أحد الأساليب التي يجب اتّباعها في هذا الصدد، فيقول: "يتمكّن الطالب من فهم المحتوى، وتطوير مهارات العمل الجماعيّ، بدمج المشاريع التعاونيّة وتطبيقات العالم الحقيقيّ للمفاهيم العلميّة".
يربط هذا الأسلوب – ضمن أساليب أخرى – بين المعرفة والمهارات الاجتماعيّة في صورة تكامليّة، تسمح بتكوين معرفة حيّة قابلة للنقل والتطبيق. فالمهامّ المصمّمة بعناية تستفزّ المتعلّم للتفكير والتحليل، وفي الوقت نفسه تضعه في موضع من يحتاج إلى مشاركة الآخرين لفهم أو إنجاز. وتشير ياسمين حسن إلى أهمّيّة اتّباع أسلوب التعلّم التفاعليّ والتجريبيّ؛ لاعتماده على التجارب العلميّة والمحاكاة والأنشطة التفاعليّة بين الطلّاب؛ ما يسمح لهم بتبادل الأفكار والتعلّم في ما بينهم. ويعزّز هذا التداخل بين النشاط العقليّ والعمل الاجتماعيّ من عمق الفهم، ويمنح المهارات الاجتماعيّة معناها العمليّ داخل سياق علميّ.
ويتطلّب هذا التحوّل في تصميم الموقف التعليميّ وعيًا جديدًا من المعلّم، وطريقة مختلفة في التخطيط للدروس. فتقول ديالا كمال: "يجب على المعلّمين تصميم خبرات تعليميّة حقيقيّة وواقعيّة، تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باحتياجات الطلّاب، والقيام بالتقييم والتقويم المستمرّين للعمليّة التعليميّة، والمهارات الاجتماعيّة والعمليّة للطلّاب. فيجب استخدام تقييمات متنوّعة، مثل: تقييم المشاركة في المناقشات، والمشاركة في المشروعات الجماعيّة، إلى جانب الأداء في الاختبارات الأكاديميّة".
مرونة المناهج والمحتوى شرطًا للتوفيق
لا يمكن التفكير في التوفيق بين تعليم المهارات الاجتماعيّة والمعارف العلميّة، من خارج عمليّة إعداد المنهج نفسه. تقول لميس أبو شدق: "الأصل أنّ يكون التوفيق مرافقًا لخطوة إعداد المناهج الدراسيّة، فالمهارات الاجتماعيّة جزء لا يتجزّأ من شخصيّة الطالب الذي يمثّل بناؤه الهدف الأسمى للتربية". لهذا، فإنّ تصميم المنهج يجب أن ينطلق من رؤية شاملة لطبيعة المتعلّم، تأخذ في الحسبان توازنه النفسيّ والاجتماعيّ، وليس مستواه المعرفيّ فقط.
ويشير مروان حسن إلى إمكانيّة تحقيق التوفيق من خلال محاذاة المنهج؛ إذ يضمن ذلك الترابط والاتّساق بين المعارف، والكفايات الأكاديميّة، والمهارات الاجتماعيّة، وطرائق تدريسها، ومهامّ التقييم، وأنشطة التعلّم. وهكذا تبرز أهمّيّة أن يقوم المنهج على قدر عالٍ من المحاذاة الداخليّة؛ إذ يمنح الاتّساق البنائيّ الحاصل بين المعارف والكفايات والمهارات الاجتماعيّة، المعلّم قدرة فعليّة على التوفيق بين الجانبين، لأنّ كلّ عنصر في المنهج يدعم الآخر، ويصبّ في اتّجاه تكوين موحّد غير متنافر.
ولتحقيق ذلك، لا بدّ من إعادة التفكير في طبيعة المحتوى نفسه، وتوسيعه ليشمل موضوعات ترتبط بالواقع الاجتماعيّ والإنسانيّ، وليس أن يقتصر على المفهومات العلميّة المجرّدة. ويؤكّد عبد الرحمن حسنيوي على ضرورة تصميم مناهج شاملة، تجمع بين المفهومات العلميّة، والموضوعات الاجتماعيّة المهمّة. فحين تُبنى المناهج بهذه الطريقة، تصبح مواقف التعلّم مجالًا طبيعيًّا لتكامل المعنى العلميّ بالسلوك الاجتماعيّ، ويغدو التفاعل جزءًا من فهم الفكرة.
دور المعلّم في تحقيق التوازن بين الجانبين
يمثّل المعلّم الحلقة الأكثر تأثيرًا في إمكان التوفيق بين تعليم المهارات الاجتماعيّة، وتقديم المعارف العلميّة. إذ إنّه يعمل على بناء مناخ تعليميّ يُشجّع الطلّاب فيه على التفاعل الواعي؛ بتوسيع فرص اتّخاذ القرار والمشاركة النشطة. تقول شيماء عادل: "تشير معظم الأبحاث إلى فعّاليّة التعليم في تطوير المهارات الاجتماعيّة لدى الطالب، أثناء وجوده في الصفّ، عن طريق تشجيعه على اتّخاذ القرارات الفرديّة، والعمل الجماعيّ". فحين يشعر المتعلّم أنّ صوته مسموع، وأنّ له دورًا حقيقيًّا في سير الدرس، تنمو لديه المهارات الاجتماعيّة بالتوازي مع تَملّك المعارف العلميّة. وهكذا، تصبح لحظة التعلّم لحظةً مزدوجة: لحظة فهم، ولحظة تواصل.
كما يُشكّل حسن اختيار المعلّم لاستراتيجيّاته التعليميّة، عنصرًا هامًّا في تحقيق التوازن المطلوب. فالاعتماد على طرائق تدريس تسمح بالحوار، وتوزيع المهامّ، والتعلّم التعاونيّ، يخلق فرصًا دائمة للتفاعل من دون الإخلال بالأهداف المعرفيّة. وقد أكّدت شريهان بكرون ذلك قائلة: "أعتقد أنّه على كلّ معلّمة/ معلّم استخدام استراتيجيّات مختلفة لتعزيز ذلك"، ودعت إلى تنظيم الطلّاب في مجموعات صغيرة لأداء المهامّ التعليميّة، باعتبار أنّ هذا النمط يُسهّل دمج المعرفة بالمهارات الاجتماعيّة، إلى جانب تقبّل الاختلاف والتعاون.
هل نطلب من المعلّم ما لم نُدرّبه عليه؟
كلّ ما عُرِض من تصوّرات حول دمج المهارات الاجتماعيّة في سياق تعليم المعارف العلميّة، يظلّ حبرًا على ورق ما لم يُقابله تأهيل حقيقيّ للمعلّم. فالمعلّم الفاعل الرئيس في تحويل المنهج من وثيقة إلى واقع، والموقف التعليميّ من فكرة إلى ممارسة. ومع ذلك، لا تزال غالبيّة برامج إعداد المعلّمين تقف عند حدود تقليديّة، تُدرّبهم على إدارة المحتوى وضبط الصفّ، من دون تمكينهم من فهم أعمق لكيفيّة صناعة بيئة تعليميّة، تسمح بنموّ معرفيّ واجتماعيّ متوازن. تتّسع الفجوة بين ما يُطلب من المعلّم، وما يتلقّاه في إعداده الأوليّ عامًا بعد عام.
فلا يُتوقّع من معلّم لم يُدرّب على بناء أنشطة تكامليّة، أو إدارة تفاعل جماعيّ حقيقيّ، أن يصنع هذا التوازن بمفرده. يحتاج التوفيق بين المهارات والمعارف إلى أدوات واستراتيجيّات واضحة، يُكتسب كثير منها في تدريب حقيقيّ ومتخصّص. والمؤسف أنّ هذا النوع من التدريب غالبًا ما يكون غائبًا في برامج التأهيل الأوّليّ، أو يأتي في صورة دورات نظريّة مجزّأة، لا تقترب من الواقع الفعليّ للفصل، ولا تمنح المعلّم الثقة أو الكفاءة اللازمتين لخوض تجربة تعليميّة متكاملة.
كما يشمل دعم المعلّم الإعداد الأكاديميّ، وتمكينه داخل المؤسّسة التعليميّة، ومنحه مساحة للتجريب، وتوفير بيئة عمل تُقدّر الدور المعقّد الذي يؤدّيه. يحتاج المعلّم الذي يُطالَب بإحداث هذا التوفيق إلى نظام يُقدّر جهوده، ويرى في مهمّته مشروعًا تربويًّا وليس وظيفة يوميّة. من دون هذا الإيمان المؤسّسيّ بدوره، ومن دون إعادة بناء منظومة إعداد المعلّمين، ستظلّ الدعوة إلى دمج المهارات الاجتماعيّة بالمعارف مطلبًا نظريًّا، لا يجد سبيله إلى التطبيق.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025