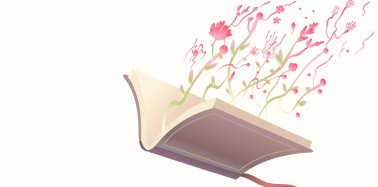كان في بيتنا مكتبة. مكتبة جيّدة، فيها مئات الكتب الكبيرة؛ مجلّدات في التاريخ والسيرة والتفسير، وعدد من المعاجم الأساسيّة. في الرفّ السفليّ تربّعت الموسوعة البريطانيّة باللغة الإنجليزيّة، وموسوعة طبّيّة صغيرة بالإنجليزيّة أيضًا، من خمس مجلّدات جميلة ذات ورق لامع ومليئة بالصور. في تلك الأيّام، كانت تجربة كاشفة وحيدة مع كتاب ما، كفيلة بجرّك إلى مربّع القراءة المتواصلة، بهدف إنهائه، والانتقال إلى كتاب آخر. كان لبرامج الأطفال مواعيد معيّنة في الصباح وبعد الظهيرة، إذا انتهت فترتُها لا يكون أمام الطفل سوى خيارَين، بحسب طبيعة أهله وظروفهم: إمّا اللعب في الشارع حتّى العشاء، أو أن يُحبس في البيت. فإذا ما انحبس فيه، وكان في بيته بعض الكتب، ووقع على كتاب يغريه ويستطيع قراءته، فإنّه سيظلّ يقرأ فيه حتّى ينهيه، بل أغلب الظنّ أنّه سيقرؤه أكثر من مرّة، حتّى يكاد يحفظه، فالكتب في بيوتنا العربيّة قليلة، وأقلّ منها الكتب التي تناسب الأطفال.
لم تكن مسألة استجماع الانتباه والمناعة من التشتّت ما يحول دون القراءة، بل توفّر الكتب، والقدرة على الوصول إلى المكتبات.
أمّا اليوم، فالكتب المتوفّرة باتت أكثر نسبيًّا، بما فيها تلك الموجّهة إلى الأطفال، لكنّ القراءة الحرّة، بوصفها نشاط تسلية ووسيلة لتمضية الوقت، تتراجع باستمرار. يسود انطباع عامّ بيننا، نحن الآباء والأمّهات، بأنّ فرصة انغماس الطفل في تجربة القراءة، على نحو تتحوّل فيها تلك التجربة إلى عادة يمكن إدمانها والتعلّق بها في سنواته اللاحقة، باتت شبه مستحيلة. أمّا السبب العامّ الذي يُطرح لتفسير هذه الظاهرة، فيكمن في شكل البيئة الرقميّة التي ينمو فيها الطفل ويتعوّد على مدخلاتها، وما يترتّب عليها من وضعيّة تتّسم بالتشتّت الدائم، وتدنّي القدرة على التركيز العميق، وبالتالي الحرمان من الانغماس بأنشطة غير مرتبطة بالشاشة الرقميّة. هذا كلّه يؤثّر سلبًا كما هو متوقّع في مهارة القراءة لو تشكّلت، أو في فرصة تشكّل عادة القراءة ابتداءً، بسبب طغيان هذه الشاشات والأجهزة الرقميّة، الصغير منها والكبير، منذ سنوات الطفل الأولى.
كلّ وسط جديد يغيّرنا
في منتصف الستّينات من القرن الماضي، سيصدر مارشال ماكلوهان كتابه الشهير "فهم وسائل الإعلام"، وسيضمّن فيه ملاحظة بدت حينها أشبه بالنبوءة، بشأن التأثير العميق للوسائط الجديدة لانتقال المعلومات وتقنيّاتها متسارعة التطوّر. فقد توقّع ماكلوهان بحدسه السليم، أنّ تقنيّات الاتّصال ستؤثّر على نحو عميق في طرق تفكيرنا وسلوكنا على المستوى الفرديّ والاجتماعيّ. وحين صاغ الفيلسوف الكنديّ عبارته الشهيرة "الوسط هو الرسالة" (Medium is the Message)، فإنّه لم يكن يصف حقيقة ناجزة بعد، بل كان يتنبّأ بواقع بدا له أنّه يتشكّل بسرعة، وقد يخرج عن السيطرة: الوسط الذي تنتقل به المعلومات كفيل بتغييرنا، وسيغيّرنا أفرادًا وجماعات. يضيف ماكلوهان: "إنّ آثار التقنيّة لا تظهر على مستوى الأفكار والمفاهيم وحسب، بل إنّها تنفذ إلى ما هو أبعد من ذلك، وتغيّر أنماط إدراكنا بالتدريج، وبلا أيّ مقاومة" (Carr, 2010, p. 3).
في سنة 2010، سيعود الباحث الأمريكيّ نيكولاس كار إلى نبوءات ماكلوهان تلك، ويثبت بالأدلّة العلميّة الحديثة من حقول دراسات الأعصاب والعلوم الإدراكيّة، أنّ هذه التقنيّات تتسلّل عميقًا إلى أنظمتنا العصبيّة، وتغيّرنا رغمًا عنّا، وقبل أن نطوّر كيفيّة مقاومتها. يخبرنا كار أنّنا نغفل عن التفكير في أثر هذه الوسائط، لأنّنا ننشغل حدّ العجز بالمحتوى الذي تولّده، وتُهيله علينا بلا انقطاع. في كتابه "السطحيّون" (The Shallows) الذي يتناول فيه قصّة هذه التغييرات التي دهمتنا بسبب الإنترنت، ووطأة الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعيّ، والاعتماد على محرّك البحث، يتوقّف كار طويلًا عند نبوءة ماكلوهان: "كلّ وسط جديد يغيّرنا"، ليفنّد الانطباع السلبيّ الذي يعلّق التبعات السلبيّة للتقنيّة على "سوء الاستخدام الفرديّ"، ويفنّد مغالطة أخلاقيّة ومعرفيّة سائدة في خطاب الحداثة الرقميّة، والذي يصرّ على إعفاء التقنيّة نفسها من المسؤوليّة، وتبرئة طرف الشركات التي تطوّرها وتصمّم نماذج عملها، واعتبارها محايدة.
فالوسط الجديد قوّة فاعلة في ذاتها، تغيّرنا وتعيد تشكيل الشبكات العصبيّة بما يتلاءم معها، وفق منطق داخليّ خاصّ بها، لا ينفصل عن المصالح المادّيّة للشركات التي ابتكرتها، والتي تهدف أساسًا إلى استهلاك أكبر جزء ممكن من حياتنا أمام الشاشة. فالتقنيّة حين تسيطر وتسود، تكيّفنا نحن ولا تتكيّف معنا. نحن مثلًا، الجيل الذي عاش حتّى بداية الدراسة الجامعيّة على الأقلّ بلا هاتف محمول، فضلًا عن هاتف مربوط بالإنترنت، ندرك تمامًا هذا التغيّر. كيف كنّا نقرأ بتركيز ونكتب برويّة، وكيف كان نمط تفاعلنا مع العالم والآخرين من حولنا. ثمّ في لحظة ما، حصلت تلك الطفرة، ودخلنا عالم الإنترنت بالتدريج، من محرّكات البحث والمنتديات والمدوّنات، وصولًا إلى فيسبوك وتويتر، ثمّ إنستغرام وتيكتوك. لقد تآكلت في أذهاننا تلك العمليّة الخطّيّة من التفكير، وانهارت مع ذلك "ذهنيّة القراءة". يصف كار في كتابه هذه الذهنيّة القارئة، حين كان طالبًا في الجامعة يقضي ساعات طويلة بين رفوف الكتب، بمناعة كاملة من أيّ وارد يشتّته عن القراءة، ثمّ يروي كيف دهمت الأجيال الرقميّة الجديدة طريقة في التعاطي مع المعرفة، لا تستوعب المعلومات إلّا على جرعات قصيرة وسريعة وقلقة وغير مترابطة وغير صافية. ثمّة نعيم في القراءة، بحسب كار، ضاع منّا أو يكاد، ويرى أنّ "الوسط" الرقميّ والشركات التي تستثمر في تطويره، هي المسؤول الأكبر عن إفراز هذا الجحيم من العطب الذهنيّ الذي يحول بيننا وبين القراءة.
فوسائط الاتّصال الحديثة - أو ما يمكن تسميته بشكل أدقّ "التقنيّات المعرفيّة"، والتي تندرج فيها وسائل التواصل الاجتماعيّ ومنصّات المحتوى المختلفة ومحرّكات البحث - تقنيّات يتفاعل معها الدماغ، ليس على مستوى المحتوى نفسه وحسب، ضارًّا كان أو نافعًا، بل على مستوى تصميمها وآليّات عملها نفسها. وهي آليّات لا تهدف في حقيقة الأمر إلّا إلى استلاب انتباه المستخدمين، واستدامة ارتباطهم بها. هذا هو المنطق الاقتصاديّ الذي جعل "الانتباه" هو المورد الذي تتنافس عليه الشركات المطوّرة لهذه التقنيّات، وفق آليّات/خوارزميّات لا سبيل للمستخدمين لمعرفتها على وجه الدقّة، فضلًا عن التحكّم بها وتوجيهها لصالحهم.
جيمس ويليامز، الباحث السابق في جوجل، يتوسّع في هذا النقد للأثر الذي خلقته التقنيّات الرقميّة، فيقول في كتابه "النور الذي فقدناه: الحرّيّة والمقاومة في اقتصادات الانتباه"، إنّ كارثة "التشتّت" التي تحول بيننا وبين القراءة، تتضاعف بسبب ما يتولّد عنها من "أزمة الإرادة" على المدى البعيد؛ بمعنى أنّ هذه التقنيّات الرقميّة لا تسرق الوقت والانتباه وحسب، بل تعمل متقصّدة على تحطيم قدرتنا على الرغبة في الانخراط بأنشطة أكثر عمقًا وأسمى معنى، لصالح ما تريده الشركات المصنّعة لها ومالكوها. وإذا ما اعتبرنا أنّ القراءة الذاتيّة الحرّة، بمعناها العميق غير المرتبط بدرس أكاديميّ أو مهمّة عمل، تتطلّب نوعًا من الحرّيّة من هذه المشتّتات والفطام عنها، فإنّ هذه التقنيّات والمنصّات كفيلة بتقويض كلّ ذلك ومقاومته.
هكذا بات من البداهة العامّة تقريبًا اليوم، الحكم بأنّ ثمّة تراجعًا كبيرًا وبنيويًّا في ممارسة القراءة في مختلف المجتمعات حول العالم، وعلى نحو يعكس هيمنة هذه البنية التقنيّة، القائمة على منطق مختلف جوهريًّا عن منطق القراءة.
"إنسان القراءة" أم "إنسان المنصّات"؟
تساعدنا بعض البيانات المتوفّرة في تعرّف ملامح أكثر دقّة لهذا التراجع العالميّ في القدرة على القراءة، والذي لا يمكن فهمه بمعزل عن التحوّلات الرقميّة العميقة في حياتنا. فبحسب نتائج اختبار التقييم الدوليّ للطلبة "PISA" لسنة 2022 - وهو اختبار معروف يقيس قدرات الطلبة في القراءة والرياضيّات والعلوم يصدر عن منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية - فإنّ معدّلات القراءة بين الطلبة في دول المنظّمة قد هبطت بمعدّل 10 نقاط، مقارنة بالدورات السابقة. وبحسب التقرير، فإنّ هذا التراجع غير مسبوق في تاريخ هذا الاختبار الذي يُجرى كلّ ثلاث سنوات منذ سنة 2000.
يعزو التقرير هذا التراجع إلى أسباب متنوّعة، سلوكيّة ونفسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة لدى الطلبة في الفصول الدراسيّة، إلّا أنّ أحد العوامل الأكثر وضوحًا تمثّل في حالة التشتّت المفرطة، المتولّدة عن الاستخدام المستمرّ للأجهزة الرقميّة، والتي باتت عنصرًا دائم الحضور في حياة الطلبة داخل الغرف الصفّيّة وخارجها، وهو ما يؤدّي بشكل متواصل إلى تشويه علاقتهم مع الكتاب، ويحول بينهم وبين تشكيل ذهنيّة قارئة، تتّسم بالتركيز والتأنّي والتفاعل النقديّ مع النصوص، والقدرة على تذكّرها واستحضارها والتعلّم منها، بدل الانغماس الدائم بالترفيه والتلصّص الفضوليّ السريع عبر المنصّات الرقميّة.
يعرّف اختبار "PISA" مهارة التمكّن من القراءة (Reading Literacy)، بأنّها "امتلاك القدرة على فهم النصوص واستخدامها وتقييمها، والتفكّر فيها، والتفاعل معها، من أجل تحقيق الأهداف الشخصيّة، وتطوير المعرفة والإمكانات، والمشاركة الفاعلة في المجتمع". ولهذه المهارة مستلزمات أساسيّة، من بينها القدرة على التركيز العميق لفترة معتبرة متواصلة، من أجل قراءة نصّ طويل، وهو شرط يمنع من تحقّقه كلّ تلك المشتّتات الرقميّة التي تحيط بالقارئ، طالبًا كان أو بالغًا. كما يُبرز التقرير ملاحظة لافتة، إذ أشار إلى تزايد قدرة الطلبة على التركيز وتحقيق نتائج أفضل في القراءة واستيعاب النصوص، في الحالات التي يُفرَض عليهم فيها إغلاق هواتفهم، أو إيقاف الإشعارات التي تصلهم من حساباتهم على منصّات التواصل الاجتماعيّ. لذا، فإنّ التقرير يؤكّد على ضرورة فتح النقاش سريعًا، حول مسؤوليّة المؤسّسات التربويّة وأولياء الأمور وعموم المجتمع، بشأن تطوير "السياسات التي تُعنى بمتابعة الطلبة وسلوكيّاتهم عند استخدام الأجهزة الرقميّة، من أجل الحدّ من التشتّت الذي يعانونه" (PISA, 2022, p. 230)، ومقاومة تلك النزعة إلى الاستسلام أمام هيمنة التقنيّة، أو الرضا بالتعايش مع آثارها السلبيّة التي تنال من الحقّ في القراءة، والتي هي أساس العلاقة بين الإنسان الحديث والمعرفة.
تحصل هذه المشاكل في القراءة لدى الطلبة في الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية، أي الدول التي يتمتّع مواطنوها، ولا سيّما الطلبة، بمعدّلات أعلى من الوصول إلى "رأس المال الثقافيّ"، خصوصًا ذلك المتمثّل بالبنى التحتيّة التعليميّة المتقدّمة، وأعداد الكتب المطبوعة ونسبة كلّ فرد منها، ومعدّلات الوصول إلى الإنترنت، وتوفّر الطلبة على مكان هادئ للدراسة والقراءة، وعلى الوقت اللازم للقراءة، فضلًا عن التوفّر على الشخص الذي يساعد في مهمّة القراءة، وهي معطيات من المفترض أن تساعد في التحفيز على القراءة وممارستها. وعلى رغم التباين في هذه المعطيات بين الدول نفسها، في المجموعة التي تضمّ 38 دولة متطوّرة، وبين فئات من الطلبة في كلّ دولة بحسب ظروفهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلّا أنّه، وحتّى بين الطلبة الأقلّ حظًّا على السلّم الاقتصاديّ والاجتماعيّ، فإنّ معدّل عدد الكتب الموجودة لديهم في المنزل تتجاوز 133 كتابًا، في حين يصل هذا المعدّل إلى الضعف بين الطلبة الأكثر حظًّا، وهو ما يؤكّد على أنّ الإشكال لا يتعلّق بتوفّر الكتب وفقر الموارد الثقافيّة، بل بالطبيعة المتغيّرة للعلاقة مع المعرفة، ونجاح التطوّرات التقنيّة في استلاب المقدرة على القراءة، وإقصاء الحاجة للكتاب في حياة الطلبة.
أمّا في العالم العربيّ، وعلى ندرة الإحصاءات المنهجيّة بشأن القراءة، فإنّ الصورة تبدو أكثر قتامة بكثير؛ إذ تمتدّ جذور هذه البنية الرقميّة السامّة والسالبة للانتباه، في أرض تغيب فيها القراءة على نحو مزمن ومديد عن أولويّات السياسات التعليميّة والثقافيّة، وحيث تضعف صنعة الكتاب وتتواصل هشاشة قطاع النشر، ويتراجع عدد المكتبات العامّة، وتتواصل مشكلة الأمّيّة وتتفاقم. وفي مثل هذا السياق، فإنّ المشهد يتكشّف عن كارثة حقيقيّة مزدوجة: على صعيد الموارد المعرفيّة نفسها، وإمعان السلطات السياسيّة في إفقارها، وعلى صعيد اضمحلال القدرة على اكتساب ملكة القراءة، والإيمان بأهمّيّتها وجدواها بين الطلبة في مختلف الفئات العمريّة لهذا الجيل الرقميّ، وهو ما ستترتّب عليه انعكاسات مضاعفة على الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ المتهتّك، والمهشّم أصلًا في العديد من بلدان المنطقة.
لذلك، فإنّ مطلب "استعادة" القدرة على القراءة في سياقنا قد يبدو مجانبًا للدقّة، وذلك لأنّ العالم العربيّ لم يُكتب له الانطلاق أصلًا حتّى قبل هذه الحقبة الرقميّة، سواء على صعيد تعميم ثقافة القراءة، وبناء مجتمعات المعرفة، وتطوير المنهجيّات الخاصّة بالقراءة الحرّة بين الطلبة، أو التراجع في دور المدرسة والمكتبات العامّة والصحافة الحرّة، في دعم ثقافة القراءة وإحياء الوهج العامّ لها في المجتمع.
المراجع
- بشارة، عزمي. (2015). أبحاث شبكات التواصل الاجتماعيّ: قضايا وتحدّيات (محاضرة).
- المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). (2023). الأمّيّة في الدول العربيّة: الوضع الحاليّ والتقديرات المستقبليّة في حدود سنة 2030، (النشرة الإحصائيّة التاسعة).
- Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. McGraw-Hill.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. PISA 2022 Results (Volume I).
- Williams, J. (2018). Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy. Cambridge University Press.







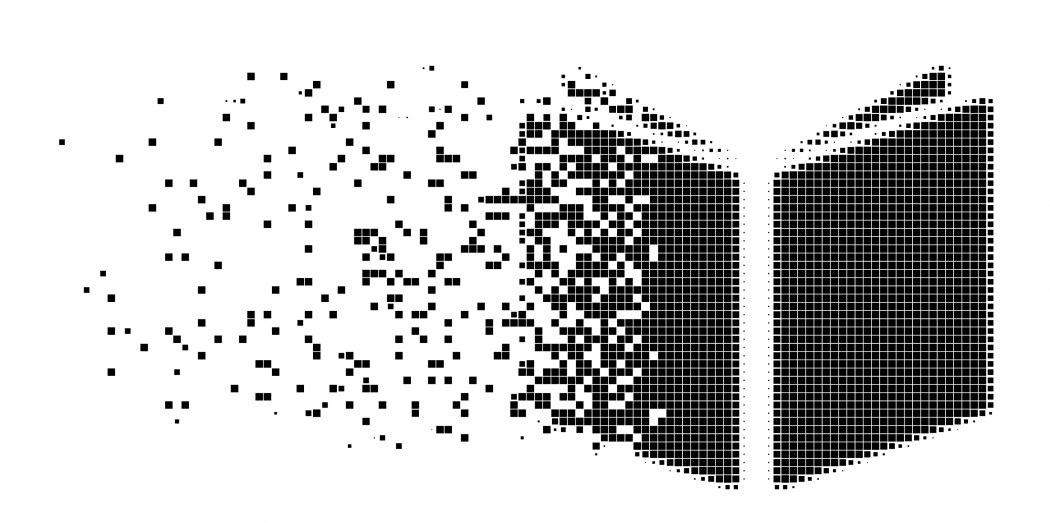





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025