والديّة
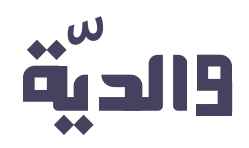
تستكمل منهجيّات مقاربتها العمليّة التربويّة والاهتمام بالأطفال والشباب المتعلّمين عبر إطلاق قسم الوالديّة. فالمجلّة والمنصّة تنطلقان/ تستهدفان الممارسين التربويّين في المدارس، من معلّمين وواضعي سياسات. ودائرة الموضوعات تشمل كلّ قضايا الاهتمام بالمدرسة، ممارسة وتخطيطًا. لكنّنا شعرنا دائمًا انّ حلقةً ناقصةٌ في هذه المقاربة، تتعلّق بـ"الممارسين التربويّين" في البيت، قبل أن يذهب الأولاد إلى المدارس، وبعد أن يعودوا منها. ولاستكمال اهتمامنا بصحّة الأولاد الجسديّة والنفسيّة، ومحاولتنا لفت النظر إلى من هم بحاجة إلى عناية خاصّة منهم، نطلق قسم الوالديّة ليصير واحدًا من أبواب المنصّة الدائمة.
تتوجّه مقالات الوالديّة الى أهالي المتعلّمين، المهتمّين بالتعليم بشكل عامٍّ، وبتعليم أبنائهم وتأمين نموّ سليم لهم على كلّ الصعد. وتنطلق المقالات ممّا يكثر البحث عنه في محرّكات البحث، لتقدّم للقرّاء/ الأهل مواضيع تربوية تهمّهم، وتزيد من وعيهم بخصائص مراحل نموّ أبنائهم، وتساعدهم في التعرّف إلى أساليب التعامل مع بعض المشاكل السلوكيّة التي من الممكن أن تظهر عند أبنائهم، وإلى برامج تعليميّة تساعدهم على اتّخاذ قرارات تخصّ تعليمهم.
وقد اهتممنا بأن تكون المقالات سهلة سلسة، واضحة ومباشرة، تساعد على فهم الموضوع وإثارة النقاشات بين الأهالي المهتمّين. كما اعتمدنا على أكثر من مصدر لكتابة كلّ مقال، وأثبتنا هذه المصادر في ختام المقالات لتزويد الأهل الراغبين بمعرفة أشمل بالموضوع المقروء.
وأخيرًا، نلفت الانتباه إلى قضيّة شديدة الأهمّيّة: الكثير من المقالات تقارب قضايا ومؤشّرات لها علاقة بأنماط نفسيّة خاصّة بالأطفال والمراهقين، أو قضايا المتعلّمين ذوي الصعوبات التعلّميّة. إنّنا نشدّد على أنّ المقالات تقدّم إلى الأهل نصائح وإرشادات تساعدهم أو تحثّهم على طلب مساعدة الاختصاصيين، ولا تقدّم معالجات أو مبادرات للأهل كي يقوموا بها بأنفسهم حين رصد ظواهر تستدعي الانتباه.















