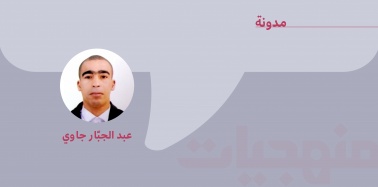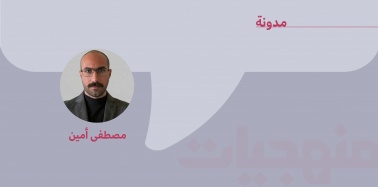بدأت ألاحظ شيئًا يتكرّر داخل الفصل الدراسيّ. بعض المتعلّمين، على رغم حضورهم الجسديّ الكامل، لا يبدو عليهم أيّ نوع من التفاعل المعرفيّ أو الانتباه. عيونهم تائهة، أذهانهم شاردة، وكأنّ عقولهم ليست حاضرة في المكان.
في البداية، ظننت أنّ الأمر عارض أو مرتبط بموضوع الدرس. لكن، مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أنّ هذا النمط من فقدان التركيز أصبح ظاهرة متكرّرة. هذا المشهد دفعني إلى التساؤل: لماذا لم يعد المتعلّم قادرًا على البقاء حاضرًا ذهنيًّا في الحصّة الدراسيّة؟ وهل للهواتف الذكيّة دور في هذا التغيّر السلوكيّ؟
بالعودة إلى الدراسات الحديثة في علم النفس وعلم الأعصاب، يتّضح أنّ ما نلاحظه في الصفوف الدراسيّة اليوم لا يمكن فصله عن البيئة الرقميّة التي أصبح المتعلّم جزءًا منها. فالدماغ البشريّ يتجاوب بشدّة مع المحفّزات السريعة والمكافآت الفوريّة مثل تلك التي توفّرها الهواتف الذكيّة من إشعارات، ومقاطع فيديو قصيرة، والتي تؤدّي بدورها إلى إفراز الدوبامين، المادّة المسؤولة عن الإحساس بالمتعة والتحفيز.
ومع الوقت، يعتاد الدماغ على هذا النمط السريع من التحفيز، فيُصاب بحالة من "الاعتياد العصبيّ " (Neuroadaptation)، أي إنّه يصبح أقلّ قدرة على التفاعل مع الأنشطة التي تتطلب تركيزًا طويل الأمد وجهدًا معرفيًّا منتظمًا، مثل الحصص الدراسيّة التقليديّة. وهنا يكمن التحدّي الحقيقيّ: المتعلّم لا يرفض التعلّم، لكنّه ببساطة لم يعد مهيّأً عصبيًّا ونفسيًّا لتحمّل إيقاع التعليم التقليديّ البطيء نسبيًّا، مقارنة بما اعتاد عليه على شاشته الصغيرة.
هذا النوع من التحفيز الرقميّ المستمرّ يؤثّر في وظيفة الانتباه لدى الدماغ، ويُضعف القدرة على البقاء مُركّزًا في بيئات لا توفّر مستوى الإثارة نفسه، ما يُفسّر شيوع الشعور بالملل داخل الفصول، حتى لدى المتعلّمين المتفوّقين.
لكنّ الأهمّ من تشخيص المشكلة هو البحث عن حلول واقعيّة، تأخذ في الاعتبار التغيّرات التي طرأت على بنية الانتباه لدى المتعلّم العصريّ. أحد المفاتيح المهمّة يكمن في إعادة تصميم البيئة الصفّيّة لتكون أكثر تفاعلًا وتحفيزًا، سواء باستخدام التكنولوجيا التعليميّة بشكل مدروس، أو ببناء محتوى يدمج النشاط والمشاركة والتفكير النقديّ. كما يجب أن يترافق ذلك مع جهود لتثقيف المتعلّمين حول أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكيّة في الدماغ والسلوك.
في المحصّلة، لا ينبغي النظر إلى ظاهرة الملل داخل الصفّ على أنّها نتيجة مباشرة لضعف الطالب أو فشله في مواكبة العمليّة التعليميّة، بل تنبغي قراءتها بوصفها نتاجًا لتحوّلات عميقة في نمط الانتباه والمعالجة العصبيّة لدى الجيل الرقميّ. وهذا يتطلّب منّا، معلّمين وباحثين وأولياء أمور، أن نتعامل مع هذه الظاهرة برؤية علميّة وإنسانيّة في آنٍ واحد، تسهم في بناء منظومة تعليميّة أكثر وعيًا وفعّاليّة.