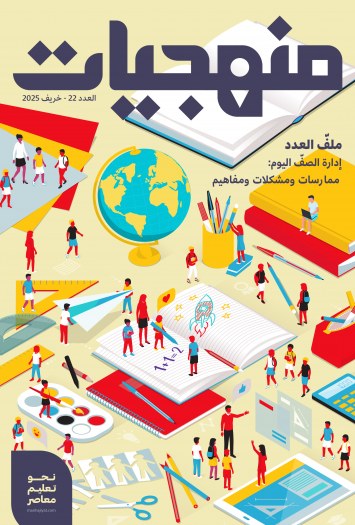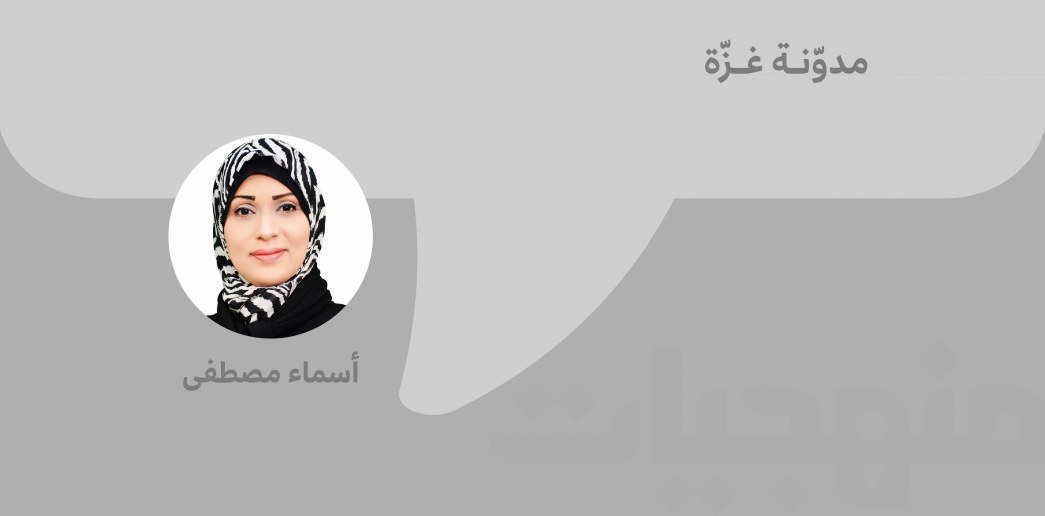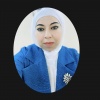تعرّض القطاع التعليميّ في غزّة منذ أكتوبر 2023 إلى دمار شامل طال البنية التحتيّة والمؤسّسات التعليميّة والعاملين فيها والطلبة. وتشير بيانات اليونسكو (2025) ووزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة إلى أنّ حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع التعليميّ في غزّة يُعدّ الأعلى تاريخيًّا من حيث النطاق والعمق؛ فقد قُتل أكثر من 17,000 طفل، وأصيب نحو 12,000 آخرين بإعاقات دائمة أو بتور في الأطراف، وفقًا لمنظمة الصحّة العالميّة. كما استُشهد أكثر من 3,800 معلّم ومعلّمة، ما أدى إلى فقدان مكوّنات أساسيّة من الكادر التربويّ المؤهّل. وعلى مستوى البنية التحتيّة، دُمّرت 85 مدرسة بالكامل، وتضرّرت أكثر من 400 مدرسة بدرجات متفاوتة بحسب تقارير اليونسكو ومكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA). كذلك توقّفت 12 مؤسّسة للتعليم العالي عن العمل بسبب الدمار أو النزوح، وفق مجلس التعليم العالي الفلسطينيّ. توضح هذه الأرقام أنّ التعليم في غزّة فقد جزءًا كبيرًا من رأس ماله البشريّ والمادّيّ، ما يجعل عمليّة التعافي التربويّ أكثر تعقيدًا من مجرّد إعادة إعمار المباني، إذ تتطلّب إعادة بناء منظومة متكاملة من الموارد البشريّة والمؤسّساتيّة، بما في ذلك إعادة البناء التربويّ التي باتت مهمّة معقّدة تتجاوز حدود الترميم الهندسيّ.
ماذا يقصد بالتعافي التربويّ؟
يشير مفهوم التعافي التربويّ إلى العمليّة الشاملة التي تهدف إلى استعادة الأداء الوظيفيّ والمهنيّ للنظام التعليميّ بعد الكوارث، عبر استراتيجيّات متعدّدة المستويات تتكامل فيها الجوانب النفسيّة والمؤسّسيّة والمجتمعيّة. فهو لا يقتصر على إصلاح الأبنية أو استئناف الدراسة، بل يمثّل مقاربة تكامليّة تسعى لإعادة بناء الثقة بالمدرسة كمؤسّسة تربويّة آمنة، وتأهيل المعلّمين ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض المجتمعيّ، وتمكين الأطفال من التعلّم في بيئات مؤقّتة ومرنة تستجيب لاحتياجاتهم المتغيّرة. كما يشمل التعافي التربويّ إعادة صياغة المناهج بما يعزز المرونة والمهارات الحياتيّة والقدرة على التكيّف، ليصبح التعليم أداة لإعادة بناء الإنسان والمجتمع في آن واحد.
أولويّات التعافي التربويّ:
تشكّل أولويّات التعافي التربويّ الإطار العمليّ لإعادة بناء النظام التعليميّ في مرحلة ما بعد الكارثة، بما يضمن استدامة العمليّة التعليميّة واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسّسات التربويّة. ويمكن تحديد هذه الأولويّات ضمن خمسة محاور رئيسة مترابطة:
يبدأ المحور الأوّل بـ دعم الكادر التعليميّ بوصفه الركيزة الأساسيّة لاستمرار التعليم، إذ يُعدّ المعلّمون واجهة الصمود الأولى في مواجهة الانهيار التربويّ. يتطلّب ذلك تنفيذ برامج تدريبيّة متخصّصة في التعليم في حالات الطوارئ (EiE) والدعم النفسيّ والاجتماعيّ، بما يمكّنهم من التعامل مع الصدمات والاحتياجات المتنوّعة للمتعلّمين. كما يشكّل الاستقرار الوظيفيّ والمعيشيّ للمعلّمين أولويّة ملحّة، لتجنّب تسرّب الكفاءات التربويّة نحو أعمال أخرى نتيجة تدهور الظروف الاقتصاديّة. ومن المهمّ كذلك تطوير وحدات إشراف تربويّ متخصّصة في إدارة التعافي والتعليم المرن، تتولّى متابعة الأداء الميدانيّ وتقديم الدعم الفنّيّ والنفسيّ المستمرّ للمعلّمين.
أمّا المحور الثاني فيتعلّق بـ إعادة تأهيل البنية التحتيّة التعليميّة، بتبنّي نهج "إعادة البناء المرحليّ" الذي يستند إلى تقييم دقيق للأضرار، ويوازن بين الإغاثة السريعة والاستدامة طويلة المدى. ويتضمّن ذلك إنشاء مساحات تعليميّة بديلة في المناطق الآمنة مثل الخيام التعليميّة والمراكز المجتمعيّة والمدارس المتنقّلة، لضمان استمراريّة التعلّم في ظلّ الدمار الواسع. كما يُعدّ الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الهندسيّة التي توصي بها كلّ من اليونسكو ووكالة الأونروا أمرًا جوهريًّا لحماية الطلبة والعاملين في البيئات التعليميّة المؤقّتة.
ويبرز المحور الثالث في تطوير المناهج والوسائل التربويّة لتتلاءم مع الواقع الطارئ. فالمناهج التقليديّة تحتاج إلى إعادة صياغة ضمن وحدات تعلّم قصيرة المدى، تركّز على المهارات الحياتيّة، والتعاون، وإدارة الصدمة، والوعي الصحّيّ، مع دمج الأنشطة الفنّيّة والتعبيريّة كوسائل للتأقلم النفسيّ من دون فصلها عن المحتوى الأكاديميّ. كما يوصى بإدخال التعليم الرقميّ والهجين خيارًا استراتيجيًّا لضمان استدامة التعلّم في حالات الانقطاع أو النزوح.
ويأتي المحور الرابع ليؤكّد أهمّيّة الدعم النفسيّ والاجتماعيّ المدمج في البيئة المدرسيّة، بحيث يُدرج هذا المكوّن ضمن اليوم الدراسيّ وليس خدمةً منفصلة أو هامشيّة. وينبغي تدريب المعلّمين على رصد مؤشّرات الصدمة والسلوك ما بعد الكرب لدى الطلبة، مع تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلّيّ والاختصاصيّين الاجتماعيّين لضمان بيئة تعلّم آمنة وداعمة.
أمّا المحور الخامس والأخير، فيرتبط بـ الحوكمة والتمويل، إذ يتطلّب التعافي التربويّ بنية إداريّة واضحة من خلال إنشاء وحدة وطنيّة لإدارة التعافي التربويّ تنسّق بين الحكومة والجهات المانحة والمنظّمات الدوليّة. كما يجب تأمين تمويل متعدّد المصادر (محلّيّ، دوليّ، وأهليّ) لضمان الاستمراريّة، مع اعتماد مؤشّرات أداء رئيسة (KPIs) لقياس التقدّم، مثل نسبة المدارس المعاد تشغيلها، وعدد المعلّمين المدرّبين، ومعدل انتظام الطلبة، ومستوى جودة بيئة التعلّم في المرافق المؤقّتة.
التحدّيات التي تواجه مرحلة التعافي:
تواجه عملية التعافي التربويّ في غزّة تحدّيات بنيويّة عميقة تعيق قدرتها على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة إعادة البناء المستدام. فمحدوديّة الموارد الماليّة تشكّل العائق الأكبر أمام إعادة الإعمار، إذ تعمل المؤسّسات التربويّة في ظلّ نقص حادّ في التمويل اللازم لتأهيل المدارس، ودفع رواتب المعلّمين وتأمين الوسائل التعليميّة الأساسيّة. كما إنّ ضعف البنية التحتيّة الأساسيّة، من كهرباء ومياه واتّصالات، يجعل البيئة المدرسيّة بيئة هشّة لا تصلح أحيانًا لأبسط أشكال التعلّم الآمن.
ويُعد استمرار التهجير وانعدام الأمن من العوامل التي تقوّض أيّ تخطيط تربويّ طويل الأمد، إذ يُجبر آلاف الطلبة والمعلّمين على التنقّل بين مناطق مختلفة، ما يجعل انتظام العمليّة التعليميّة مرهونًا بظروف ميدانيّة متقلّبة. كما أدّى فقدان عدد كبير من المعلّمين والمشرفين التربويّين إلى تراجع الكفاءات المهنيّة والخبرات التربويّة، الأمر الذي خلق فجوة في الإشراف الأكاديميّ والتطوير المهنيّ.
ومن التحدّيات المتفاقمة أيضًا الانقطاعات المستمرّة في العمليّة التعليميّة، التي نتجت عنها فجوات معرفيّة واسعة بين الطلبة، وتفاوت كبير في مستويات التحصيل. هذا الانقطاع المتكرّر أضعف الروابط التربويّة بين المعلّمين وطلّابهم، وأثّر في دافعيّة التعلّم. إلى جانب ذلك، تعاني المنظومة من تآكل رأس المال الاجتماعيّ، والثقة بالمؤسّسات التربويّة الرسميّة نتيجة تراكم الإخفاقات الإداريّة، وضعف القدرة على توفير بيئة تعليميّة آمنة ومنصفة، ما يستدعي إعادة بناء الثقة بين المدرسة والمجتمع بوصفها خطوة مركزيّة في أيّ مشروع تعافٍ تربويّ حقيقيّ.
ومن بين أبرز التحدّيات التي تعيق مسار التعافي التربويّ في غزّة، طبيعة العلاقة التنافسيّة بين نظام التعليم الرسميّ من جهة، والمؤسّسات المجتمعيّة والتعليميّة الدوليّة من جهة أخرى. فبدل أن تشكّل هذه العلاقة إطارًا تكامليًّا يسهم في تسريع الاستجابة التربويّة، أصبحت في كثير من الأحيان ساحة لتضارب الأولويّات وتعدّد المرجعيّات. ويؤدّي هذا التنافس إلى تباطؤ في تنفيذ البرامج التدريبيّة والتعليميّة الهادفة إلى التعافي، كما ينعكس سلبًا على توحيد الجهود الميدانيّة وتنسيق الموارد.
ويكمن جوهر الإشكاليّة في اختلاف الرؤى والمنطلقات بين الأطراف الفاعلة: إذ ينظر النظام الرسميّ إلى التعافي من منظور إداريّ مؤسّسيّ يسعى لاستعادة الهياكل القائمة وضمان الانضباط النظاميّ، في حين ترى المؤسّسات المجتمعيّة والدوليّة أنّ التعافي يتطلّب نهجًا أكثر مرونة، يقوم على دعم المبادرات المحلّيّة وتمكين المعلّمين والمجتمعات المتضرّرة من قيادة التغيير التربويّ. هذا التباين الجوهريّ في الفهم والتطبيق يفضي إلى إطالة زمن التعافي وتأخير الوصول إلى نتائج تربويّة مرضية، ما يستدعي تأسيس آليّة تنسيق وطنيّة واضحة تُحدّد الأدوار والمسؤوليّات وتوحّد الرؤية بين مختلف الشركاء، لضمان تعافٍ تعليميّ فعّال وشامل.
رؤية مستقبليّة مهنيّة لتحقيق التعافي:
تفرض مرحلة ما بعد الحرب في غزّة ضرورة إحداث تحوّل جذريّ في فلسفة التعليم، يقوم على الانتقال من التركيز على الكمّ إلى التركيز على الكيف، ومن إعادة البناء الهندسيّ للمباني إلى إعادة البناء الإنسانيّ والمؤسّسيّ للنظام التربويّ. فالتعافي الحقيقي لا يتحقّق بترميم الجدران فحسب، بل بإحياء المعنى التربويّ للمدرسة بوصفها فضاءً للحياة والأمان والكرامة. ويمكن توصيف مسار التعافي التربويّ في غزّة على نحوٍ تدريجيّ بثلاث مراحل مترابطة: تبدأ بـ مرحلة الاستجابة الطارئة (من صفر إلى ستّة أشهر)، التي تركّز على توفير بيئة تعليميّة آمنة، وضمان الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسيّة للأطفال والمعلّمين. تليها مرحلة الاستقرار المتوسّط (من ستّة إلى أربعة وعشرين شهرًا)، والتي تشمل بناء القدرات المهنيّة، وتدريب الكوادر التربويّة، وإصلاح المدارس بشكل جزئيّ لاستعادة سير العمليّة التعليميّة. ثمّ تأتي مرحلة الاستدامة طويلة الأمد (بعد العام الثاني)، التي تهدف إلى تطوير نظام تعليميّ مرن وقادر على الصمود في وجه الأزمات المستقبليّة.
إنّ وضع التعليم في قلب استراتيجيّة التعافي الوطنيّ في غزّة ليس خيارًا قطاعيًّا، بل استثمار استراتيجيّ في البقاء المجتمعيّ، فالمجتمعات لا تتعافى فعليًّا إلّا عندما يعود أطفالها إلى التعلّم، ويستعيد معلّموها دورهم التربويّ في بيئة تحترم الحقّ في المعرفة، وتعيد إلى الإنسان كرامته بوصفه محور العمليّة التعليميّة وغايتها.
ختاماً، يمكنني القول إنّ التعافي التربويّ في غزّة ليس مجرّد استعادة ما فقدناه من مدارس ومناهج ومعلّمين، بل هو مشروع إعادة بناء الإنسان والمجتمع بأكمله، بعد أن حاصرته الحرب وأثقلت كاهله الخسائر والفقد. المستقبل الذي نطمح إليه يتطلّب أن يكون كلّ جهد منظّمًا ومدروسًا علميًّا، يوازن بين الاحتياجات العاجلة للطلبة والمعلّمين وبين الرؤية الاستراتيجيّة طويلة المدى للنظام التعليميّ. أملنا قائم على إيماننا بالقدرة البشريّة على التعلّم والابتكار، وعلى يقيننا بأنّ كلّ مدرسة تُعاد تشغيلها، وكلّ معلّم يتلقّى الدعم والتأهيل، وكلّ طفل يفتح كتابه بشغف، يشكّل خطوة جديدة نحو إعادة صياغة غزّة مجتمعًا قادرًا على التعلّم والنموّ والصمود.
غزّة التي شهدت التهجير والفقد، قادرة أن تصبح نموذجًا للمرونة التعليميّة، حيث تُبنى البرامج على المعرفة والبحث والبيانات، ولا تترك شيئًا للصدفة، وتتحوّل كلّ تجربة صعبة إلى درس عمليّ يثري مسار التعافي. الأمل الذي نحمله اليوم ليس شعورًا عاطفيًّا فحسب، بل استراتيجيّة فعليّة، وخطّة مهنيّة متكاملة، تضع الأطفال والمعلّمين في مركزها، وتؤكّد أنّ التعليم ليس رفاهية يمكن تأجيلها، بل هو الضمان الحقيقيّ لاستمرار الحياة وبناء المستقبل.