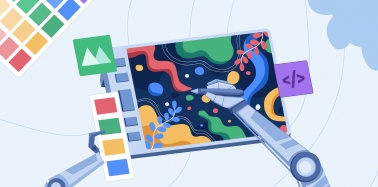أصداء الدردشة قراءات في سؤال من أسئلة قسم الدردشة في منهجيّات، تختار فيها هيئة التحرير سؤالًا من نسخة من نسخ الدردشة في المجلّة، بناءً على ارتباط السؤال بملفّ العدد، أو بأهمّيّة الموضوع أو راهنيّته المستجدّة، حيث تُدرَس إجابات مجموعة من المعلّمين، ويُجمع بينها باستنتاجات أو خلاصات منها. في كلّ عدد من منهجيّات صدى جديد من أصوات معلّمينا ومعلّماتنا.
تشهد البيئات التعليميّة المعاصرة تنوّعًا متزايدًا وغير مسبوق في خلفيّات المتعلّمين وقدراتهم واهتماماتهم، وسياقاتهم الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة. إذ يجتمع طلّاب من مشارب متعدّدة ضمن فضاء تعلّميّ واحد، يحمل في طيّاته فرصًا غنيّة للتفاعل، لكنّه في الوقت ذاته يفرض على المعلّمين تحدّيًا تربويًّا مستمرًّا: كيف يمكن بناء تجربة تعليميّة شاملة، تضمن لكلّ متعلّم حقّه في المشاركة والتعلّم وفق احتياجاته وإمكاناته الفرديّة، من دون أنّ يتخلّف أحد عن الركب؟ لهذا، سألنا مجموعة من المعلّمين والمربّين في نسخة الدردشة لسنة 2024 عن تجربتهم داخل الصفّ، بسؤال بدا بسيطًا في ظاهره، لكنّه يحمل في عمقه جوهر الممارسة التربويّة:
"ما الاستراتيجيّة الأكثر فاعليّة التي استخدمتها داخل الغرفة الصفّيّة؟"
تسعى هذه المقالة لتحليل إجابات المعلّمين، استخلاصًا للسمات المشتركة لممارسات التدريس التي تُجسّد مبادئ التعليم الشامل، وتحوّل مفهوم الشمول من إطار نظريّ إلى تجربة تعليميّة حيّة، تُمكّن كلّ متعلّم من التعلّم بطريقته الخاصّة.
التعلّم التعاونيّ وشمول الجميع في الفعل التعليميّ
يبرز التعلّم التعاونيّ بوصفه القاسم المشترك الأوسع في استجابات المعلّمين، باعتباره أسلوب تدريس ومنظورًا تربويًّا شاملًا، يُعيد تشكيل الغرفة الصفّيّة إلى مجتمع تعلّميّ مصغّر، يقوم على المشاركة والمسؤوليّة المشتركة والدعم المتبادل. فعندما يتعاون الطلّاب حول فكرة أو مهمّة واحدة، تتقاطع قدراتهم وتتداخل خبراتهم، بطريقة تُتيح لكلّ فرد أن يجد موقعه ضمن العمليّة التعليميّة، بغضّ النظر عن خلفيّته أو مستوى أدائه.
أشارت نسرين آدم إلى أنّ تقسيم الطلّاب إلى مجموعات صغيرة، كان عاملًا أساسيًّا في تحسين فهمهم المادّة، وتعزيز الروابط في ما بينهم. فتقول: "لاحظت زيادة في مستوى التفاعل والحماس لديهم، وتطوير مهارات التواصل وحلّ المشكلات بشكل جماعيّ". بينما لاحظت وصال مرعي أنّ هذا النمط من التعلّم جعل الطلّاب جزءًا فاعلًا من العمليّة التعليميّة، وأسهم في تطوير الأفكار بصورة تدريجيّة وتعاونيّة. فتقول: "شعروا أنّهم جزء من عمليّة التعلّم". وهذا يؤكّد أنّ التعلّم التعاوني يشكّل وسيلة فاعلة لدمج المتعلّمين ذوي الخلفيّات المتنوّعة، في إطار موحّد من النشاط التعليميّ المشترك.
وتُظهر تجربة فرح الهبش أنّ العمل الجماعيّ شجّع الطلّاب على تنمية الاستقلاليّة وتحمّل المسؤوليّة الجماعيّة، في حين أوضحت مرسال حطيط أنّ توزيع الفصل إلى مجموعات متوازنة يتيح مشاركة الجميع، ويثري مخرجات التعلّم الإبداعيّة والمهاريّة. فتقول: "أكثر الاستراتيجيّات فعّاليّة من حيث تجاوب الطلبة، وبعد استخدام العديد منها في الصفّ، استراتيجيّة التعلّم التعاونيّ أو المجموعات".
بناءً على ذلك، يمكن النظر إلى التعلّم التعاونيّ على أنّه أحد الركائز الجوهريّة للتعليم الشامل، إذ يمنح كلّ متعلّم فرصة للتعبير والمشاركة والتعلّم من الآخرين، محوّلًا الفصل الدراسيّ من فضاء قائم على التنافس الفرديّ، إلى بيئة تشاركيّة تعيد تعريف العدالة التعليميّة، عن طريق الممارسة اليوميّة داخل الصفّ.
الأمان النفسيّ شرط الشمول الحقيقيّ
عند تناول مفهوم التعليم الشامل، يبرز البعد النفسيّ والعاطفيّ بوصفه ركيزة أساسيّة في تحقيق الدمج الحقيقيّ داخل الفصول الدراسيّة. فلا يمكن بلوغ الشمول الفعليّ، ما لم يشعر المتعلّم أنّ بيئة الصفّ تمثّل مساحة آمنة، تتيح له التعبير عن ذاته من دون خوف من الحكم أو الرفض.
أشارت هنادي طلال الدنف إلى أنّ العامل الأكثر تأثيرًا في تجربتها الصفّيّة، كان بناء بيئة آمنة يشعر فيها الطلّاب بالانتماء، والقدرة على التعبير عن أنفسهم بحرّيّة، مُضيفة: "أبدأ الحصص دائمًا بنشاط بسيط، مثل التحدّث عن مشاعرهم، ما يسهم في جعلهم يشعرون بالارتياح والانفتاح. وأستخدم التعزيز الإيجابيّ بشكل متكرّر، ليساعد في تحسين مشاركة الطلّاب الخجولين وتشجيعهم على التعبير".
تُظهر هذه الممارسات أنّ الدمج يبدأ من المناخ العاطفيّ للصفّ، إذ إنّ البيئة التي تحتضن مشاعر المتعلّمين وتقدّر اختلافاتهم، تمهّد الطريق أمام مشاركة حقيقيّة وتعلّم ذي معنى. فعندما يشعر الطلّاب بالأمان، تصبح المشاركة ممكنة، ويزداد استعدادهم للتفاعل والتعاون.
من جهتها، وصفت نادرة قاسمي صفّها بأنّه فضاء يقلّ فيه الخوف من الخطأ، ويشعر فيه الطلّاب بأنّ أصواتهم مسموعة ومقدّرة، بينما يقول أحمد البليخ "الحوار المباشر مع الطلبة يُتيح لهم أن يعبّروا بحرّيّة، فيشعرون بالثقة، ويصبحون أكثر جرأة على طرح الأسئلة والنقاش مع زملائهم".
من هذا المنطلق، يُعدّ الوعي العاطفيّ لدى المعلّمين أساسًا في تطبيق التعليم الشامل، إذ لا يمكن تحقيق العدالة التعليميّة من دون عدالة عاطفيّة، تضمن لكلّ متعلّم الحقّ في الأمان النفسيّ، والشعور بالانتماء ضمن الجماعة التعليميّة.
التعلّم التفريديّ والمتمركز حول الطالب
تُعدّ القدرة على توظيف التنوّع بوصفه منطلقًا للتعلّم لا عائقًا أمامه، من أبرز السمات المميّزة للتعليم الشامل. فالتعلّم المتمايز الذي يقوم على فهم خصائص المتعلّمين واحتياجاتهم الفرديّة، وتكييف أساليب التدريس بما يتناسب معها، يوفّر فرصًا عادلة لجميع الطلّاب للوصول إلى الأهداف التعليميّة ذاتها، وإن كان بواسطة مسارات مختلفة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
أوضح زيد الخطيب أنّ التفاعل الشخصيّ مع المادّة التعليميّة جعل الطلّاب أكثر انخراطًا، لأنّهم شعروا بأنّ المعرفة مرتبطة بحياتهم الواقعيّة. بينما أشارت نهيل شديد إلى اعتمادها على نهج مونتيسوري في الأنشطة الحسّيّة، فتقول: "عملي يقوم على تحديدي لمستوى الطفل، وكأنّه منهج لكلّ طفل على حسب قدراته".
كما إنّ التعليم القائم على المتعلّم يستلزم إعادة توزيع الأدوار داخل البيئة الصفّيّة، إذ يتحوّل المعلّم إلى ميسّر وموجّه، بينما يصبح الطالب شريكًا فاعلًا في بناء المعرفة. ذكر عبد اللّه المكحّل أنّه اعتمد بُنىً تعاونيّة تُعزّز اكتشاف المعرفة، وتمكّن الأطفال من التعبير عن أنفسهم. تجسّد هذه النماذج التطبيقيّة جوهر التعليم الشامل القائم على التمكين، إذ يجد كلّ متعلّم طريقه الخاصّ نحو المعرفة ضمن نظام يثمّن الاختلاف، ويُصغي إلى أصوات الطلّاب، ويتيح لهم التقدّم وفق وتيرتهم الفرديّة.
التعلّم النشط والدراما والمشروعات
في التعليم الشامل، يتحوّل التنوّع من مفهوم نظريّ إلى ممارسة حيّة، تُترجم إلى أنماط متعدّدة من التعلّم، بحيث يجد كلّ متعلّم وسيلته الخاصّة للتعبير والفهم. فعندما يُتاح للطلّاب التعلّم بالتجربة والحركة والأداء، يصبح الصفّ فضاءً تفاعليًّا يُثمّن الاختلاف ويُعزّز المشاركة.
أشارت مي الديني إلى أنّ توظيف الدراما التكوينيّة ومنهج STEAM، فعّل جميع الطلّاب على اختلاف مستوياتهم، فتقول: "رفع ثقة الطلّاب بأنفسهم وإدراكهم لذواتهم". بينما وصفت روزان علو استراتيجيّتها المسمّاة "البوصلة" في مرحلة رياض الأطفال، بأنّها تدمج بين اللعب والحركة والحماس، وتُنمّي روح التعاون والمشاركة بين الأطفال.
وحين يتحوّل الدرس إلى مساحة للتجريب والاكتشاف، تتراجع الفروق بين المتعلّمين، لأنّ المشاركة لم تعد مشروطة بنمط واحد من الأداء أو الفهم. تؤكّد عبير أبو حمد على أهمّيّة التعلّم القائم على المشروعات، فتقول: "لاحظت تفاعل الطلّاب الإيجابيّ، وزيادة دافعيّتهم عند تطبيق المفاهيم على مواقف حياتيّة واقعيّة". في حين أشارت فيكتوريا مارييفا إلى أنّ استخدام الاستكشاف والتجريب في الأنشطة الفنّيّة، عزّز ثقة المتعلّمين بأنفسهم.
الشمول يبدأ من الحصّة لا من السياسات
تكشف ردود المعلّمين أنّ التعليم الشامل، قبل كلّ شيء، منظور أخلاقيّ وتربويّ يتخلّل كلّ ممارسة صفّيّة. وعلى الرغم من اختلاف الموادّ الدراسيّة والمستويات الدراسيّة، فالقاسم المشترك بين تجاربهم، يتمثّل في التزام المعلّمين بضمان حقّ كلّ متعلّم في الوجود والمشاركة، والتقدّم وفق وتيرته الفرديّة وقدراته الخاصّة وأسلوب تعلّمه المفضّل.
يتبيّن هذا الوعيّ بأشكال متعدّدة: التعاون الذي يؤكّد على المساواة في القيم، والبيئات الآمنة التي تسمح بالتعبير من دون خوف، والتمايز الذي يعترف بالقدرات المتنوّعة، والتعلّم النشط الذي يمنح الجسد والعاطفة والعقل دورًا مشتركًا في الفهم. وعلى الرغم من بساطة هذه الممارسات في ظاهرها، فإنّها تعبّر عن تحوّل جوهريّ في أدوار الفاعلين التربويّين، إذ يغدو المعلّم ميسّرًا وداعمًا لرحلة التعلّم الفرديّة، فيما يصبح الفصل الدراسيّ مجتمعًا مصغّرًا للعدالة والتنوّع.
هكذا يتجسّد التعليم الشامل قناعة يوميّة يؤمن بها المعلّمون، بأنّ العدالة التعليميّة تبدأ من لحظة الإصغاء إلى صوت طالب مختلف، أو من تعديل نشاط صغير يضمن عدم استبعاد أحد. تمنح هذه التفاصيل البسيطة الشمول معناه الحقيقيّ، وتحوّله من إطار نظريّ إلى ممارسة تربويّة حيّة، تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المتعلّمين كلّ يوم.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026