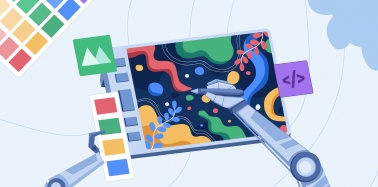يعدّ الكتاب المدرسيّ تعاقدًا تربويًّا بين المدرّس والمتعلّم، تنطلق منه الممارسة التعليميّة، وتنبثق التفاعلات الصفّيّة أثناء الإنجاز. لذلك اجتهد المشرّع التربويّ في تنويع مادّته ووحداته، لتكون قادرة على تحقيق الكفايات المتوخّاة.
ولمّا كان التجديد سنّة محمودة ومطلوبة بحكم المتغيّرات التي تمسّ مناحي الحياة، وتمتدّ إلى طرائق التفكير وأنماط السلوك، حرص المشرّع التربويّ على تجديد كتاب اللغة العربيّة في بعض المستويات، فشمل هذا التجديد النصوص الوظيفيّة ودرس التعبير والإنشاء فقط، وجُمعت هذه المكوّنات في كتاب مدرسيّ واحد يضمّ النصوص النثريّة والشعريّة، ودروس اللغة نحوًا وصرفًا وتطبيقًا، إضافة إلى التعبير والإنشاء، بعدما كان لدرس اللغة والتطبيق كتاب مستقلّ عن كتاب المطالعة والنصوص. ومنح المشرّع التربويّ المدرّس حرّيّة كاملة في اختيار المهارات الإبداعيّة التي يراها أكثر نجاعة في تحقيق الأهداف التعليميّة، وتنمية القدرة على الكتابة، بما ينسجم مع السياقات التعليميّة واحتياجات المعلّم. وصادقت وزارة التربية الوطنيّة في المغرب سنة 2003 على الكتاب المدرسيّ الجديد، ليُعتمد رسميًّا تحت مسمّيات مختلفة، مراعاة للجهويّة واحترامًا لخصوصيّات الجهات واختلافاتها البنيويّة العميقة. وقد جدّد المشرّع التربويّ في أصناف النصوص الأدبيّة نثرًا وشعرًا، وقيّد مهارات التعبير والإنشاء، مع الإبقاء على الدروس اللغويّة نفسها التي اعتمدها الكتاب القديم، باستثناء إضافة درس جديد بعنوان "التذكير والتأنيث" في كتاب المرجع في اللغة العربيّة للسنة الثانية الإعداديّة.
النصّ الشعريّ ومشكلات الكمّ والكيف
مشكلات الكمّ
لم يستطع التجديد الذي مسّ الكتاب المدرسيّ اختراق أسوار درس اللغة، لصعوبة بنائه ودقّته المعرفيّة، ولشدّة ارتباطه بالنصّ الوظيفيّ الذي يُعدّ منطلقًا لاستخراج الظاهرة اللغويّة الكامنة في بنيته النحويّة بالقراءة. لذلك اتّجه المشرّع نحو النصّ الوظيفيّ، لسهولة انتقائه من مصادر متنوّعة، مثل المجلّات العربيّة والمنتجات الإبداعيّة، فتكثّف حضور النصّ النثريّ في الكتاب المدرسيّ، وخفت ضوء النصّ الشعريّ الذي لم يحظَ، في بعض الكتب المقرّرة، بالمكانة التي تليق بأهمّيّته في المدونة التراثيّة العربيّة، باعتباره ديوان العرب. وقد ضمّ كتاب الرائد في اللغة العربيّة للسنة الأولى من السلك الإعداديّ، ثلاث قصائد فقط على امتداد السنة الدراسيّة كلّها: الأولى قصيدة "البردة" لمحمّد الحلويّ من ديوانه "شموع" في مدح الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وجاءت في أولى الوحدات؛ والثانية "أطلال" للناقد أمجد طرابلسي من ديوانه "كان شاعرًا" في الوحدة الثالثة؛ أمّا الأخيرة فهي "أيّوب" لبدر شاكر السيّاب في الوحدة السادسة. وحاول المشرّع تدارك هذا النقص الكمّيّ في مقرّر السنة الثانية، فأدرج عددًا مهمًّا من النصوص الشعريّة، حتّى إنّه أورد في بعض الوحدات قصيدتين، لإتاحة مساحة من الحرّيّة للمدرّس ليختار أجودهما، أو يعتمدهما معًا إن كانتا متقاربتين في المستوى الفنّيّ. وفي السنة الثالثة حضر النصّ الشعريّ في الوحدات الستّ، باستثناء وحدة المجال الاجتماعيّ الاقتصاديّ، مع أنّ هذا المجال يحتمل عددًا من القصائد الاجتماعيّة الزاخرة في مدوّنتنا القديمة والحديثة. وأمام هذا النقص الكمّيّ الذي لا يشبع الفضول الجماليّ، ولا يغذّي الذائقة الفنّيّة للمتعلّم، وفي ظلّ هيمنة النصّ النثريّ الذي تحوّل إلى المصدر القرائيّ الأكبر، تفاقم مشكلة "الكيف" الناجمة عن سوء الانتقاء، بفعل رغبة المشرّع المحمومة والمدفوعة بسرعة التجديد.
مشكلات الكيف في الكتاب المدرسيّ
الاجترار الدلاليّ
وقع النصّ الشعريّ في محظور الاجترار الدلاليّ، وأقصد به معاودة التيمة الشعريّة نفسها، بالتشبيهات والرموز ذاتها، ما يحوّلها في ذهن المتعلّم إلى صور نمطيّة متكرّرة، لا تُحدث الدهشة الجماليّة التي ينشدها المتلقّي من قراءة النصّ الشعريّ. فكانت شعريّة المديح، التي تمثّلها قصيدتا "البردة" لمحمّد الحلويّ و"المحمّديّة" لعلّال الفاسي، مع معانقتهما لأشعار المديح القديمة في مدوّنتنا الشعريّة العربيّة، وشعريّة المدينة مع حجازي في قصائد مثل "مقتل صبيّ"، و"سلّة ليمون"، و"الرحلة إلى الريف"، من أبرز النماذج الواردة في الكتاب المدرسيّ، والتي ظلّت واقفة عند الحدود الموضوعيّة ذاتها، وبالرؤية الشعريّة نفسها التي حكمت إنتاج هذه النصوص.
الجودة الشعريّة
لم يحكم الانتقاء في عدد من القصائد المختارة معيار الجودة الشعريّة، نظرًا إلى اجتزائها من أصولها خدمةً لتيمة الوحدة، ما أفقد تراتبيّة الأبيات تلك اللُّحمة العضويّة التي ترفع بالقصيدة إلى مصافّ الشعريّة، كما حصل مع قصيدة "اللّه في البؤساء" لشاعر الحمراء محمّد بن إبراهيم، وقصيدة "أطلال" لأمجد طرابلسيّ. إذ يقتضي الأمر مراعاة العناصر الفنّيّة التي تحقّق الجماليّات الشعريّة، من بلاغة وجماليّة إيقاع وغيرها، وهي عناصر لم تحضر بالقوّة الكافية التي تجعل المتعلّم يستشعر وجود نفس شعريّ قويّ يمتدّ في مثل هذه النصوص، ما يصيبه بنوع من الفتور أثناء القراءة. ولعلّ غياب فكرة استدعاء ملابسات الخطاب عن المشرّع التربويّ كان العامل الحاسم في مسألة الجودة، إذ إنّ تجريد النصّ من سياقه الحقيقيّ كي يلبّي رغبة الانتماء إلى الوحدة، كفيل بإخراج النصّ من دائرته الأصيلة إلى سياق جديد، يفقده قوّته الشعريّة بسبب عزله عن بيئته الأصليّة. ومثال ذلك قصيدة "الغابة المفقودة" لإيليا أبي ماضي، في كتاب المرجع في اللغة العربيّة للسنة الثانية، وهي نصّ غزليّ أدرجه المشرّع في باب المجال السكّانيّ، تحايلًا منه على القصيدة لتناسب الطبيعة الموضوعيّة للوحدة.
تجريد القصيدة من بنيتها الشكليّة
تحقيقًا لرغبة المشرّع في ربط النصّ بسياق الوحدة، عمد أحيانًا إلى تغيير بنية النصّ متصرّفًا في نظامه الشكليّ، وهو ما يُعدّ خرقًا سافرًا للنظام الإيقاعيّ والدلاليّ للقصيدة. ولعلّ قصيدة "المواكب" لجبران خليل جبران في كتاب المرجع في اللغة العربيّة، مثال واضح على هذا الاختراق الذي أفسد دلالة النصّ ومزّق عراه. لذا، فإنّ إعادة النصّ إلى أصله بمعيّة المتعلّمين - وهي مهمّة جليلة يضطلع بها المعلّم - تُعدّ استعادة للصوت الثاني الذي اختاره جبران، لنقل صورة العالم المثاليّ الذي يجسّده الغاب في نقائه وصفائه، وهو يعبّر عن فلسفته في الحياة في قصيدة "المواكب".
الشعر الحرّ ومعضلة التأويل
يعدّ إدراج النصّ الشعريّ الحرّ في الكتاب المدرسيّ خطوة محمودة، لما يتيحه من مواجهة مختلفة بين النصّ والقارئ، تحتاج إلى تبصّر وحسن اختيار، بحكم ما تطرحه القصيدة الحرّة من إشكالات تأويليّة واختلافات في الأفهام، قد تجرّها أحيانًا إلى فوضى التفكيك في سبيل القبض على المعنى. لذلك طرحت بعض النماذج الحرّة معضلات كبرى على مستوى التأويل، لتأسّسها على رؤية شعريّة وفلسفة بدت متناهية ومتقادمة، بل وغير مقبولة لدى القارئ، لا سيّما ما يتعلّق بشعر المدينة عند حجازي في مختلف الكتب المدرسيّة المقرّرة. وصحيح أنّ هذه القصائد على درجة عالية من الجماليّة الشعريّة، إلّا إنّها من حيث الرؤية لم تُستسغ من قبل متعلّم ترعرع في أحضان المدينة، ولا يستطيع أن يتذوّق القيم ذاتها التي تطرحها قصائد مثل "مقتل صبيّ" و"سلّة ليمون" و"الرحلة إلى الريف"، في ظلّ ما يكتنفها من ألغاز ورمزيّة مشحونة في أبنية القول الشعريّ.
مشكلة المحفوظ الشعريّ
واحدة من أكبر المشكلات التي تعترض مدرّس اللغة العربيّة في المنهاج الجديد، إلغاء المحفوظ الشعريّ من التقويم التربويّ. فلم يعد المتعلّم مطالبًا بحفظ القصائد التي يقرؤها، واستظهارها لاختبار قدرته على تخزين محفوظه الشعريّ، واستثماره في التعبيرات الإنشائيّة، سواء باعتباره أسلوبًا منزاحًا أو شواهد يستدعيها السياق الكلاميّ. لذلك يُكتفى بقراءة النصّ وتحليله صفّيًّا، الأمر الذي يُعدّ إخلالًا بمبدأ حفظ المدوّنة الشعريّة، وكبحًا للقدرات الإبداعيّة التي ينبغي أن تتنامى لدى المتعلّم لصناعة شعراء المستقبل. وقد أوضحت مدوّنتنا الشعريّة أنّ كثرة المحفوظ الشعريّ تمثّل الطريق الأوحد نحو إبداع القصيدة، فقد ذُكر أنّ أبا نواس قال: "من أراد أن يكون شاعرًا، فليحفظ ألف بيت ثمّ ينسَه".
هذه المعضلات التي تضافرت جميعها في النصوص الشعريّة المختارة، من شأنها أن تعيق عمليّات التلقين، بحكم الطبيعة المختلفة للنصّ الشعريّ عن غيره من النصوص، خصوصًا وأنّ المدّة الزمنيّة المخصّصة لتدريس النصّ الشعريّ ساعة واحدة، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا تحقيقه. يجعل هذا الوضع المدرّسَ مضطرًّا إلى زيادة الحصيص الزمنيّ، قصد تحقيق القدر الأكبر من الكفايات المرجوّة، لا سيّما الكفاية الذوقيّة والجماليّة، ناهيك عن اللغة المنزاحة التي تحتاج إلى فكّ الشفرات وتطويعها وتقريبها من الأفهام.
تناول الخطاب الشعريّ في الكتاب المدرسيّ
تعامل الكتاب المدرسيّ مع النصّ الشعريّ على أنّه استثناء جماليّ، يختلف بطبيعته عن المنثور، وأدرج نصوصًا تفاوتت مقاديرها الشعريّة من حيث الجودة والصنعة، فتعالى بعضها في سماء الشعريّة العربيّة، وانحدر بعضها الآخر إسفافًا، نظرًا إلى اجتزائها من أصولها التي يسهم فيها السياق بشعريّته الخاصّة. وقد قدّم المشرّع كمًّا من القصائد، محاولًا التنويع في موضوعاتها استجابةً لخصوصيّات الوحدات التي أُدرجت فيها، وعمد إلى التنويع في أبنيتها الشكليّة، مستدعيًا تحوّلات الشكل؛ فحضرت القصيدة الكلاسيكيّة ذات الشطرين المتناظرين، وحضر النظام المقطعيّ بمثابة مرحلة وسطى، مهّدت للانتقال نحو شعر الحداثة الذي استدعاه المشرّع بأسمائه الرائدة في العالم العربيّ (السيّاب وحجازي وسعدي يوسف). وكانت هذه التنويعات الشكليّة ذات أهمّيّة كبرى في تغذية وعي المتعلّم بتحوّلات النصّ الشعريّ على المستوى الهيكليّ، ومن ثمّ إقداره على تنمية قدراته القرائيّة التي تستوجبها اختلافات الشكل بين النصّ وصاحبه، مثلما تُغذَّى كفاياته الذوقيّة والجماليّة بهذا الفسيفساء من النصوص المتنوّعة.
إنّه تنويع محمود النتائج، غير أنّه وقف عند حدود الشكل والموضوع اللذين فرضتهما إيقاعات الوحدات، والتي تراوحت بين دينيّة ووطنيّة وإنسانيّة وحضاريّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسكّانيّة وفنّيّة وثقافيّة. لكنّه افتقد إلى التنويع الأدبيّ الذي يتعلّق بمسألة التحقيب، والتي غفل عنها المشرّع وهو يتنكّر للقصيدة الجاهليّة والإسلاميّة والأمويّة والعبّاسيّة، ولشعراء الأندلس، فقَصُر انتقاؤه على شعراء العصر الحديث، وكأنّ المدوّنة الشعريّة العربيّة القديمة لا تستطيع، بحمولاتها الثقافيّة والإبداعيّة وتشكيلاتها الفنّيّة، أن تلبّي حاجة المتعلّم الذوقيّة، أو أنّها تنأى عن فهمه أو عن عصره. لذلك لم تحضر أيّ قصيدة تنتمي إلى هذه التحقيبات الزمنيّة، مع أنّ مدوّنتنا الشعريّة حافلة بقصائد جميلة، يستطيع المتعلّم في المرحلة الإعداديّة تذوّقها وفهمها، إن وُجد لها مدرّس متمكّن قادر على إيصال معاني النصّ، وحمل المتعلّم على التفاعل الجماليّ والفنّيّ مع القصيدة.
المتعلّم والشعر
من المؤكّد أنّ الشعر خطاب يلامس العاطفة الإنسانيّة، وقادر على اقتحام الباطن والتغلغل إلى الوجدان. إنّه خطاب نابع من الشعور، لذلك يستشعر المتعلّم أثناء قراءته النصّ الشعريّ أنّه أمام نصّ مختلف، يفرض نسقًا قرائيًّا مغايرًا تمامًا لما اعتاده في قراءته للخطابات النثريّة، بفعل ما يعتمل داخله من إيقاع ووزن خاصَّين. كما يدرك في الآن نفسه، أنّ طرائق مخاطبته تختلف جذريًّا عن النصوص النثريّة، لبعده عن المباشرة واعتماده على الانزياح، فهو نصّ غنيّ بالصور والأخيلة، مضبوط بالإيقاع والوزن، ويشيّد معمارًا متناسقًا ومنسجمًا، يحتاج إليه المتعلّم لا باعتباره ديوان العرب وسجلّها الثقافيّ والتاريخيّ فحسب، وإنّما لما يمنحه هذا النوع من النصوص من تفاعل عاطفيّ عميق بين الشاعر والقارئ، يصل إلى أرفع درجات تذوّق الجمال. ناهيك عمّا يبعثه النصّ الشعريّ من إدراك لجماليّات اللغة، عن طريق تفكيك أبنيته التعبيريّة المنزاحة، وفكّ شفراته للوصول إلى المقصديّة الدلاليّة، بما يسهم في تنمية الحسّ النقديّ والإبداعيّ لدى المتعلّم، وتكوين شخصيّته من الناحية القيميّة، لما تبثّه القصيدة من قيم إنسانيّة وأخلاقيّة. كما يسهم النصّ الشعريّ في تغذية ملكة الحفظ بفضل نظامه الإيقاعيّ.
***
القصيدة ليست مجرّد نصّ يُقرأ صفّيًّا وتُتداول معانيه أثناء الإنجاز، بل خطاب عاطفيّ قادر على أن يكشف للمتعلّم مشاعر جديدة كانت مخبوءة في باطنه، وطريق لاكتشاف الذات الإنسانيّة بالإسقاطات والمقارنات التي تتيحها التجربة الإنسانيّة، ما يمنحه فرصة التأمّل في العالم من حوله على نحو لا يستطيع النصّ النثريّ، مهما بلغت أدبيّته، أن يحقّقه. لذا، يظلّ النصّ الشعريّ ذا أهمّيّة أكبر في تعليميّة اللغة العربيّة، وحسبنا أن نذكر أنّ المدونة التراثيّة العربيّة جعلت من الشعر طريقًا لتعليم العلوم، فكُتبت قصائد في الطبّ والفلك والفلسفة، كما أُلّفت المنظومات الفقهيّة والنحويّة وغيرها، لتبسيط المعرفة العالمة للطلّاب.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026