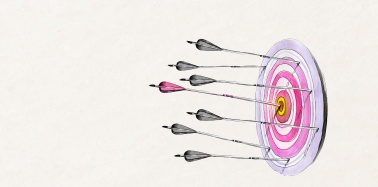باتت العلاقة مع الكتب أمرًا يميّز جيل التسعينيّات وما قبله بقليل، لذلك لا أستطيع تخيّل الحياة من دون كتب. وبعد أن أصبحت معلّمة لمادّة اللغة العربيّة، بدأ صراعي مع سؤالَين جوهريّين: لماذا ندرّس هذه المواضيع؟ ولماذا تُقدّم كتب المنهاج بهذا الشكل المملّ والكئيب؟
ولكنّني خرجت من سؤالي الذي لا جواب مقنعًا له باستنتاج: "كيف نعلّم" مسألة أهمّ بكثير من "ماذا نعلّم".
لا يملك المعلّم في معظم الأحيان الخيار في وضع المناهج، وعلى مرّ التاريخ كانت الدول المسيطرة هي التي تتحكّم بشكل المنهاج، فقد طبّقت الدولة العثمانيّة في بلاد الشام قانون التعليم العثمانيّ، ومن بعدها جاءت بريطانيا، والآن بات الاحتلال الإسرائيليّ يشكّل عبئًا ووحشًا لا مهرب منه في جميع مناحي الحياة.
الكتاب، المنهاج... المهمّ كيف تعلّم!
يعاني المعلّم الفلسطينيّ شكل المنهاج، وبوجه خاصّ في الكتب الأدبيّة. وأنا، معلّمة اللغة العربيّة، أعاني كآبةَ تصميم الكتاب من جميع النواحي: لون الورق، والرسومات داخله، وجودة الطباعة، وحجم الخطّ وشكله، وترتيب المواضيع، ونوعيّة النصوص التي يركّز عليها دون غيرها؛ إذ تفرض هذه العناصر على الطالب التفكير في منحى واحد واتّجاه محدّد، من دون أن تتيح له فرصة التأمّل أو الإنتاج الأدبيّ والفكريّ.
وبما أنّ التعليم جزء من السلطة الحاكمة في الدولة، ولأنّ الكثير من المعلّمين لا يدركون حتّى الآن الدور الحقيقيّ للمعلّم الذي يتجاوز حدود المنهاج والمدرسة، وحدود المسموح والممنوع، فإنّهم يتابعون التعليم ضمن حدود المنهاج من دون زيادة أو نقصان، بهدف إرضاء الإدارة والمشرف، واللذَين يمثّلان السلطة الحاكمة في هذه المؤسّسات. ومن هنا يتأكّد الاستنتاج السابق: "كيف نعلّم" أهمّ من "ماذا نعلّم".
في كتب اللغة العربيّة، على سبيل المثال، لماذا لا يُقسّم المنهاج إلى أربع أو خمس مهارات تُدرّس في وحدات منفصلة ومتكاملة على مدار العام، بدلًا من تشتيت الطالب بدرس قراءة، يتبعه درس قواعد، ثمّ درس إملاء...؟ لماذا لا تخصّص مثلًا وحدة كاملة في الصفّ السابع لتعلّم فنّ القصّة القصيرة، بعرض عدد وافر من القصص والتجارب الأدبيّة؟ ثمّ تليها وحدة للقواعد تُقدّم فيها المفاهيم النحويّة بشكل تراكميّ، بهدف تمكين الطالب من كتابة نصّ سليم، لا إجراء اختبارات تركّز على الحفظ من دون التأكّد من قدرته على التطبيق. بعد ذلك، تُدرّس وحدة خاصّة بكتابة الهمزات وعلامات الترقيم، ثمّ تُخصّص الوحدة الأخيرة لتعليم أساسيّات كتابة القصّة، استكمالًا لما تناولته الوحدات السابقة، فتُدرّس الوحدات بالتتابع من دون انقطاع أو مزج مشتّت. وبهذا النمط، يتعلّم الطالب في كلّ عام مهارة جديدة، وفنًّا تعبيريًّا متقدّمًا في الكتابة والسرد والتلخيص والمناقشة والوصف.
كيف تُعلّم فداء طلّابها؟
في البداية، أنا لا أدّعي المثاليّة في التعليم؛ أنا معلّمة أتعلّم من طلّابي أكثر ممّا أعلّمهم، وهذا يجعل التعليم أسهل وغير قائم على ثنائيّة المعلّم والطالب، والمرسل والمتلقّي. أستخدم كتب المنهاج، ولكنّني أحوّل النصوص التقليديّة إلى نصوص حيويّة، عن طريق فتح نقاشات حول موضوع أو فكرة معيّنة من الدرس، من دون الخوض في جميع تفاصيله. وقد يكون الهدف الأساسيّ الذي يسعى له واضع النصّ غير مهمّ بالنسبة إليّ، ولا إلى الواقع المعاش، فأختار ما يناسب فكرتي. وقد يقتصر دور الدرس على النقاش، من دون ممارسة الرتابة المعتادة في تحليل النصوص التي يعتمدها معلّمو اللغة العربيّة.
في الدروس التي تتحدّث عن فلسطين والحواجز في منهاج الصفّ السابع، أستعمل مع الطلّاب العصف الذهنيّ للتعبير عن معاني الدرس بالصورة التي تناسب كلّ طالب. طلبت إليهم كتابة أوّل كلمة تخطر في بالهم عند مشاهدة كلمة الحاجز، والتعبير عنها شفويًّا في ما بعد، وبعدها تحوّلت الحصّة إلى حصّة رسم، فقمنا برسم الحواجز، وهناك من رسم رسمًا مجازيًّا يعكس فكرة أو موقفًا في خاطره. وفي النهاية تحدّثنا عن ناجي العلي، وحاولنا كتابة عبارات على الرسومات، لنخرج بشيء قريب من فنّ الكاريكاتير. كانت التجربة غنيّة ومليئة بالمعرفة والمعلومات والنقاشات والحرّيّة.
في قصّة "رجال في الشمس" للكاتب غسّان كنفاني، شاهدنا القصّة في فيلم، وطلبت من الطلّاب قراءتها كاملة، لأنّ المنهاج في معظم نصوصه المأخوذة من كاتب، سواء كانت قصّة أو رواية، يختصر ويقتطع الجزء الذي يراه مناسبًا، متجاهلًا السياق الكامل للنصّ. لذلك، أحرص في أغلب الحالات على أن يقرأ الطلّاب القصّة كاملة. وطبّقت الدرس وفق منهجيّات الدراما، حتّى بلغ الطلّاب نقطة الذروة في القصّة، وتوقّفوا عند السؤال الجوهريّ: "هل ستدقّ جدران الخزان؟"
وهنا وقفت أمام إجابات رائعة، ومهرب جميل وذكيّ خفّف من ثقل السؤال الذي رافق كثيرين منّا: لماذا لم يدقّوا جدران الخزّان؟
قال بعضهم: "سأدقّ جدران الخزّان"، وقال آخرون: "لن أدقّ جدران الخزّان"، وانقسم الصفّ إلى مجموعات عدّة، كان على كلّ منها أن تشرح وجهة نظرها. فتحوّل الدرس إلى مساحة غنيّة بالرؤى والأفكار والمعاني التي لا يمكن الوصول إليها بالطرح التقليديّ للمنهاج، والأساليب المعتادة في التدريس.
منذ بداية الحرب على غزّة، لم أعد أفصل بين نشرات الأخبار وحصصي الدراسيّة. ما الجدوى من تعليم الطلّاب قصيدة عن الوطن، من دون التطرّق إلى ما يحدث فعليًّا في الوطن، ومن دون أن نفتح المجال أمامهم لانتقاد السلطة أو المقاومة، أو مناقشة المفاهيم الكبرى التي تحيط بنا؟ ما الفائدة من تجاهل مشاعرهم أمام مقطع فيديو لطفل يعاني الجوع أو الفقد؟ وما الهدف من تدريبهم على كتابة إعلان في حصّة التعبير للصفّ السابع، بينما هناك فنّ يُدعى فنّ كتابة القصّة القصيرة، والذي كلّما تعمّقت فيه أكثر وجدت أنّه فنّ لا تنضب أشكاله، ولا تنتهي طرق تدريسه؟ لماذا لا نخصّص العام الدراسيّ لتعليم الطلّاب كيف يكتبون قصّة، ويصلون في نهايته إلى إنتاج نصّ أدبيّ من كتابتهم، بدلًا من التشتّت بين مواضيع متفرّقة تُدرَج تحت عنوان التعبير في مادّة اللغة العربيّة؟
كيف أعلّم طلابي درسًا عن الصحّة العالميّة وحقوق الإنسان، ولماذا، ونحن نرى أنّ الإنسان لا قيمة له في كثير من بقاع العالم؟ كيف أعلّمهم عن العدل والمساواة في ظلّ اندثار هذا المفهوم وسخفه وغيابه عن أرض الواقع.
يصعب عليّ تفهّم موقف معلّم لا يتناول موضوع المقاطعة في حصصه، ولا يشير إلى افتتاح مطاعم في احتفالات مهينة لدماء شعبنا، مفضّلًا السير وفق تسلسل المنهاج على حساب واقعيّة الحياة.
***
طرق التعليم كثيرة، ومن المحزن ربط المنهاج فقط بالكتاب المدرسيّ، حتّى لو كان شيئًا مفروضًا. علينا أن نعلّم حتّى باستخدام الترندات المتداولة التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبالأغاني، وقصص الجدّات، ونشرات الأخبار، ونتائج المباريات. كلّ هذه الوسائل التي تحيط بطلّابنا تعدّ مصادر للتعلّم والتعليم، إذا امتلك المعلّم الخبرة والمعرفة لتوظيفها بشكل جيّد ومختلف.
ومن هنا نعود إلى نقطة البداية: وجود الكتاب أمر مهمّ للطالب، لكنّ الأهمّ هو العمل على جودة هذا الكتاب، وطريقة عرضه، وعلى إمكانيّات المعلّم نفسه، وتحرّر فكره ومعتقداته، واستمراره في تعلّم مفاهيم ومهارات جديدة تمكّنه من تجاوز الشكل التقليديّ في التعليم، والسعي لإنتاج فكر ومعرفة مختلفين للطلّاب، حتّى في ظلّ كتاب ومناهج مملّة. ومن هنا أؤكّد مجدّدًا: "كيف نعلّم" أهمّ من "ماذا نعلّم".













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025