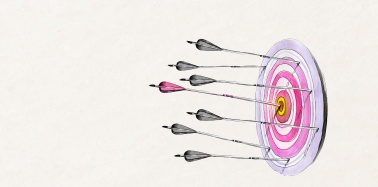لم تعد غرفة الصفّ فضاءً متجانسًا: فحركات الهجرة العالميّة، وبرامج التعليم الدوليّة، وسياسات الدمج الشامل جعلت الصفّ مصغّرًا للعالم بتنوّعه اللغويّ والثقافيّ. ومع هذا التنوّع تتعقّد مهمّة المعلّم في بناء بيئة تعلّميّة عادلة وآمنة، ومحفّزة لجميع المتعلّمين، وتزداد معه التحدّيات أمام الطلّاب للاندماج والانفتاح أكثر على هذه الاختلافات. ستتمحور إشكاليّات هذه المقالة حول استكشاف المفاهيم الرئيسة، والمشكلات الشائعة، والممارسات لإدارة الصفّ في سياقات متعدّدة الثقافات واللغات، مستندة إلى نظريّة ومقاربات من جهة، ونماذج تطبيقيّة من جهة ثانية، من تجربتي معلمةً في مدرسة دوليّة.
الأساس المفاهيميّ – من الإدارة التقليديّة إلى "التدريس المستجيب ثقافيًّا"
في المنظورات التربويّة التقليديّة، يُنظر إلى إدارة الصفّ بوصفها "أداة ضبط" لضمان النظام والانضباط، فيفرض المعلّم القواعد ويُتوقّع من المتعلّمين الامتثال لها. إذ يُفترض أنّ الصفّ في هذه المنظومة التقليديّة فضاء متجانس ثقافيًّا واجتماعيًّا وسلوكيًّا. بيد أنّ هذا النموذج يفقد جدواه في صفوف تضمّ طلّابًا من خلفيّات ثقافيّة متعدّدة، لا سيّما في البيئة التعليميّة المعاصرة؛ إذ ترى المقاربات التربويّة الحديثة، ومنها التربية "المستجيبة ثقافيًّا"، أنّ الإدارة الصفّيّة فعل تربويّ نابع من الوعي بالسياق، ومرتبط ببناء علاقات متكافئة مع المتعلّمين، تراعي خلفيّاتهم وتجاربهم، وتُوظّفها في عمليّة التعلّم. فما المقصود بالتربية المستجيبة ثقافيًّا؟
"التدريس المتجاوب ثقافيًّا يمثّل التدريس الذي يركّز على تلبية احتياجات الطلبة الاجتماعيّة والعاطفيّة، ويهتمّ بفهم خلفيّاتهم الثقافيّة، واحترام معتقداتهم وممارساتهم الثقافيّة، ويسعى لإنشاء بيئة تعليميّة إيجابيّة" (المندلاوي، 2024). كما يُعرّف بانكس (1997) التربية متعدّدة الثقافات، بأنّها عمليّة إصلاحيّة "تهدف إلى توفير فرص تعليم متكافئة لجميع الطلبة، مع الاعتراف بخلفيّاتهم العرقيّة والاجتماعيّة واللغويّة". وبذلك، فإنّ إدارة الصفّ في البيئات المتعدّدة ممارسة تربويّة مركّبة توفّق بين:
- - الانضباط البنّاء.
- - التعلّم الاجتماعيّ–العاطفيّ.
- - التجاوُب الثقافيّ واللغويّ.
أوّلًا: تحدّيات إدارة الصفّ في بيئات متعدّدة الثقافات واللغات
1. حواجز اللغة والتواصل
تُعدّ اللغة حاجزًا أساسيًّا أمام المشاركة والفهم وبناء العلاقات الصفّيّة. فاللغة أداة التواصل الرئيسة بين الطالب ومجتمعه التعليميّ، وعندما لا يفهم الطالب التوجيهات، أو لا يستطيع التعبير بحرّيّة بلغته، يتراجع تفاعله وتقلّ ثقته بنفسه. وبالتجربة الشخصيّة، لاحظت أنّ بعض الطلّاب الذين لا يتقنون العربيّة أو الإنجليزيّة جيّدًا، يتجنّبون المشاركة، أو يبدون مشتّتين أثناء النقاشات الصفّيّة. حتّى إنّ الاختلاف على مستوى اللهجات والثقافات، له تأثير في فهم بعض المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مناهجنا، وهو ما يمكن أن يخلق أحيانًا غموضًا معرفيًّا. فمثلًا في مادّة التاريخ، يواجه الطالب أحيانًا صعوبة في فهم مفهوم "الحضارة" أو "الثقافة" أو "الأيديولوجيا"، لأنّه تعلّمه أو لديه معرفة مسبقة عنه في سياق مختلف. لذلك، فإنّ تكييف المفاهيم ضمن مقارنة ثقافيّة بسيطة وأمثلة واقعيّة، مهمّ في هذا السياق.
2. سوء الفهم الثقافيّ
قد تظهر مشاكل سلوكيّة نتيجة لسوء الفهم الثقافيّ، وليس لسوء نيّة من الطالب. فعلى سبيل المثال، قد يُنظر إلى عدم الاتّصال البصريّ على أنّه علامة على قلّة الاحترام في ثقافة ما، بينما يُعدّ سلوكًا متواضعًا في ثقافة أخرى.
كما إنّ بعض المواضيع، ولا سيّما المرتبطة بالدين أو الطقوس والمعتقدات، تحمل حساسيّة ثقافيّة عالية. فعلى سبيل المثال، عند تدريس موضوع التنوّع الدينيّ في الثقافات للصفّ الثامن، أثارت مناقشة أحد الطقوس القديمة بعض الحساسيّات بين الطلبة. لذلك، فإنّ الحرص على اختيار المصطلحات، وطريقة التقديم والنقاش، له دور في تحويل هذه المواضيع من مثيرات للحساسيّة، إلى مجالات للثراء وتبادل المعارف.
3. تفاوت الخلفيّات الأكاديميّة
يأتي بعض الطلبة من بيئات تعليميّة لا تُشجّع المشاركة الصفّيّة، أو تعمل وفق نظم تقييم مغايرة. بعض الطلّاب كانوا معتادين على الحفظ والاستظهار فقط، وكان من الصعب عليهم التفاعل مع أنشطة التفكير النقديّ والمناقشات المفتوحة. لذا، تبنّيت استراتيجيّات تدريجيّة: مثل تعويدهم على طرح الأسئلة، وتقسيم المهامّ إلى مراحل، وتقديم أمثلة ملموسة لطرق التفكير التاريخيّ. هذا ساعدهم في التأقلم والتدرّج في بناء الثقة الأكاديميّة.
ثانيًا: مبادئ الإدارة الصفّيّة المستجيبة للتنوّع
1. الإدماج اللغويّ
ينبغي استخدام اللغة باعتبارها أداة للتمكين، لا وسيلة للإقصاء. ففي الأكاديميّة العربيّة الدوليّة هناك مرونة واضحة في هذا الجانب، بالتشجيع على التبسيط بلغة سهلة ومفهومة، خصوصًا عند عرض المفاهيم الرئيسة، مع توفير موارد داعمة، مثل الصور التوضيحيّة والترجمات الثنائيّة عند الحاجة. وقد شجّع ذلك الطلّاب على التفاعل وتبادل المعرفة بأسلوبهم الخاصّ، ودمج هويّاتهم اللغويّة في عمليّة التعلّم.
2. تخصيص أنشطة تعكس تنوّع الخلفيّات
لا يعني تكليف جميع الطلبة بالنشاط نفسه أنّنا نحقّق العدالة، فالمقصود بالعدالة الحقيقيّة تفهّم احتياجات كلّ طالب، وتزويده بما يمكّنه من النجاح. لذلك يصبح من الضروريّ توفير بيئة صفّيّة تراعي الفروقات الفرديّة. ويمكن تحقيق ذلك مثلًا، بتكليف الطلبة بالعمل في مجموعات متنوّعة ثقافيًّا، مع تدوير الأدوار بينهم، مثل منسّق وكاتب ومتحدّث، بما يعزّز روح التفاهم والتعاون، ويكسر الصور النمطيّة. وقد لوحظ أنّ الطلبة بدأوا يطرحون أسئلة على زملائهم حول ثقافاتهم بدافع الفضول الإيجابيّ، الأمر الذي أسهم في بناء علاقات أكثر احترامًا وانفتاحًا.
وفي هذا الإطار؛ من بين المشاريع التي أنجزها طلّاب الصفّ السادس في العام الماضي، اختيار معلَم تاريخيّ من بلدهم الأمّ والتعريف به، ما أثار فضول زملائهم، ووسّع مداركهم، وأسهم في تبادل ثقافيّ غنيّ. كما يمكن أن تمتدّ الأنشطة إلى خارج الصفّ، مثل الاحتفاء بيوم الثقافة العربيّة، والذي يفتح المجال أمام الطلّاب لتقديم جوانب من ثقافتهم، باستخدام الأطعمة والحكايات والأغاني والأمثال الشعبيّة والفولكلور. وقد شكّلت هذه الفعّاليّات فرصة للتبادل الثقافيّ، وتطبيق المهارات الحياتيّة، بربطها بواقعهم وتجاربهم اليوميّة.
3. تكييف التقييمات
لتفادي إقصاء بعض الطلبة بسبب ضعفهم في لغة التعليم، أو لاختلاف مرجعيّاتهم، ينبغي على المربّي توفير مهامّ بديلة ومشاريع متنوّعة، مثل كتابة مقال، أو تصميم خريطة ذهنيّة، أو تقديم عرض شفهيّ، أو إعداد فيديو وثائقيّ بأسلوب الطالب الخاصّ. ولاحظت أنّ هذا التنويع أتاح للطلبة التعبير عن فهمهم بطرق مختلفة، تراعي اختلاف أنماط التعلّم وخلفيّاتهم الأكاديميّة، خصوصًا في مادّة الأفراد والمجتمعات. كما ساعد تقديم تغذية راجعة بلغة مشجّعة وواضحة، في تحفيزهم على التطوّر من دون الشعور بالإحباط. وتظلّ النقطة الأهمّ في هذه التقييمات ربط الطالب بواقعه، باستخدام أمثلة مستمدّة من ثقافته وتاريخه ومجتمعه.
ثالثًا: دور المعلّم ميسّرًا للاندماج الثقافيّ
1. المعلّم بوصفه مُتعلّمًا دائمًا
في البيئات الصفّيّة متعدّدة الثقافات واللغات، يتجاوز دور المعلّم كونه ناقلًا للمعرفة أو حارسًا للنظام، ليصبح فاعلًا تربويًّا يتعلّم باستمرار من تفاعله مع التنوّع داخل الفصل الدراسيّ. يفترض هذا الدور الجديد اعترافًا صريحًا من المعلّم بحدود معرفته، لا سيّما في ما يتعلّق بالاختلافات الثقافيّة والدينيّة واللغويّة، والتي قد لا يكون ملمًّا بها مُسبقًا. هذا الاعتراف لا يُعدّ مؤشّر ضعف، بل مدخلًا للتحوّل المهنيّ الواعي الذي يتطلّب استعدادًا مستمرًّا للتعلّم، والانخراط في برامج تدريبيّة وتكوينيّة تُعنى بموضوعات العدالة التعليميّة، والتربية المستجيبة ثقافيًّا، والحساسيّة تجاه التعدّد. فالتعامل مع المتعلّمين المختلفين ثقافيًّا، لا يمكن أن يقتصر على النيّات الحسنة أو الانطباعات الشخصيّة، بل يحتاج إلى تأطير معرفيّ ومهنيّ، يمكّن المعلّم من تفكيك أنماط التفكير النمطيّ، وفهم الديناميكيّات الرمزيّة للعلاقة التربويّة في سياقات غير متجانسة. ولهذا، تؤكّد الأدبيّات التربويّة المعاصرة أنّ التطوير المهنيّ الفعّال يجب أن يكون مستمرًّا، ومتجذّرًا في السياق، ويشمل فرصًا للتأمّل التعاونيّ والتعلّم من الميدان، لا مجرّد وحدات تدريب نظريّة معزولة.
2. التعلّم من الطالب والمجتمع
في نموذج الإدارة الصفّيّة المستجيبة ثقافيًّا، لا يُنظر إلى الطالب باعتباره مستقبلًا سلبيًّا للمعرفة، بل مصدرًا غنيًّا للتجارب والرؤى والمعاني. ينطوي هذا التصوّر على تحوّل في العلاقة التربويّة، فيصبح المعلّم متعلّمًا من طلّابه، ويتعامل مع مجتمعاتهم المحلّيّة بوصفها حوامل ثقافيّة ومعرفيّة، قادرة على إثراء الممارسة التعليميّة. يمكن ترجمة هذا التوجّه عمليًّا بجملة من المبادرات، منها تنظيم مقابلات قصيرة مع أولياء الأمور أو أفراد من الجالية المحلّيّة، بهدف فهم السياقات الاجتماعيّة واللغويّة التي ينتمي إليها الطلبة. كما يمكن دعوة ضيوف من خلفيّات ثقافيّة متنوّعة – مثل فنّانين أو ناشطين اجتماعيّين أو حرفيّين – لتقديم ورشات أو مداخلات قصيرة داخل الصفّ، ما يُعزّز حضور الثقافة الحيّة، ويمنح الطلبة شعورًا بالانتماء والاعتراف. كذلك، يمكن تفعيل دور الأسرة ليس فقط في الدعم المنزليّ، بل باعتبارها مكوّنًا أساسيًّا في العمليّة التربويّة، بإشراكها في تصميم بعض الأنشطة، أو في تنظيم أيّام ثقافيّة تُعرّف بثقافات الطلبة وتجاربهم. إنّ هذا النوع من الانفتاح لا يُرسّخ فقط ثقافة الاعتراف والاحترام المتبادل، بل يُعيد للمدرسة دورها المجتمعيّ، بوصفها فضاءً تفاعليًّا يعكس التنوّع الحقيقي للمجتمع الذي توجد فيه.
3. التأمّل المهنيّ في الممارسة
لا يمكن فصل تحسين إدارة الصفّ في البيئات متعدّدة الثقافات، عن ممارسة تربويّة نقديّة تتأسّس على التأمّل المستمرّ. فالمعلّم الذي يعي أنّ ممارساته ليست محايدة بالضرورة، بل قد تكون مشروطة بثقافته أو قيمه، أو حتّى تحيّزاته اللا واعية، هو المعلّم القادر على التعلّم من ذاته وتطوير أدواته. لذلك، يُعدّ التأمّل المهنيّ – سواء الفرديّ أو الجماعيّ – آليّة مركزيّة في تمكين المعلّم من فحص ممارساته، وتحليل أثرها في الطلبة، ولا سيّما أولئك الذين قد يشعرون بالإقصاء أو عدم الانتماء. من الوسائل الفعّالة في هذا الإطار، تخصيص دفتر يوميّات تأمّليّة، يسجل فيه المعلّم بشكل دوريّ مشاهداته وتساؤلاته وردود أفعاله تجاه مواقف صفّيّة معيّنة. كما يمكن استخدام الملاحظات الجماعيّة – وهو ما نعمل عليه في المدرسة – مثل الزيارات الصفّيّة المتبادلة، أو مجموعات التعلّم المهنيّة، لتبادل التغذية الراجعة بطريقة داعمة وناقدة في الآن ذاته. وتساعد هذه الممارسات في كسر العزلة المهنيّة، وتحفيز التعاون بين الزملاء في بناء استجابات تربويّة أكثر حساسيّة للسياق الثقافيّ. فالتأمّل في الممارسة ليس رفاهًا مهنيًّا، بل ضرورة تربويّة تمكّن المعلّم من الارتقاء بأدائه، وتجنّب إعادة إنتاج أنماط الإقصاء أو التحيّز غير المرئيّ داخل الصفّ.
***
في عالم يشهد تحوّلات سريعة على مستوى الحركات السكّانيّة والهويّة، تصبح المدرسة مرآة للتنوّع، وغرفة الصفّ مساحة لاختبار إمكانات العيش المشترك. إدارة الصفّ في بيئة متعدّدة الثقافات واللغات ليست مجرّد مسألة تقنيّة، بل ممارسة تربويّة مقاومة، تُعيد الاعتبار للطالب باعتباره ذاتًا ناطقة بهويّته، ومعلّمة لغيره. وكلّ معلّم يُقرّ بهذا، يُصبح فاعلًا في مشروع تربويّ أكثر عدالة وإنسانيّة.
المراجع
- بانكس، ج. (1997). تربية المواطنين في مجتمع متعدّد الثقافات. دار نشر كلّيّة المعلّمين.
- المندلاوي، علاء. (2024). التدريس المستجاب ثقافيًّا: تعزيز بيئة صفّيّة فاعلة. مؤسّسة العراقة للثقافة والتنمية. 3، 1.
- Banks, J. A. (1997). Educating Citizens in a Multicultural Society. Teachers College Press.







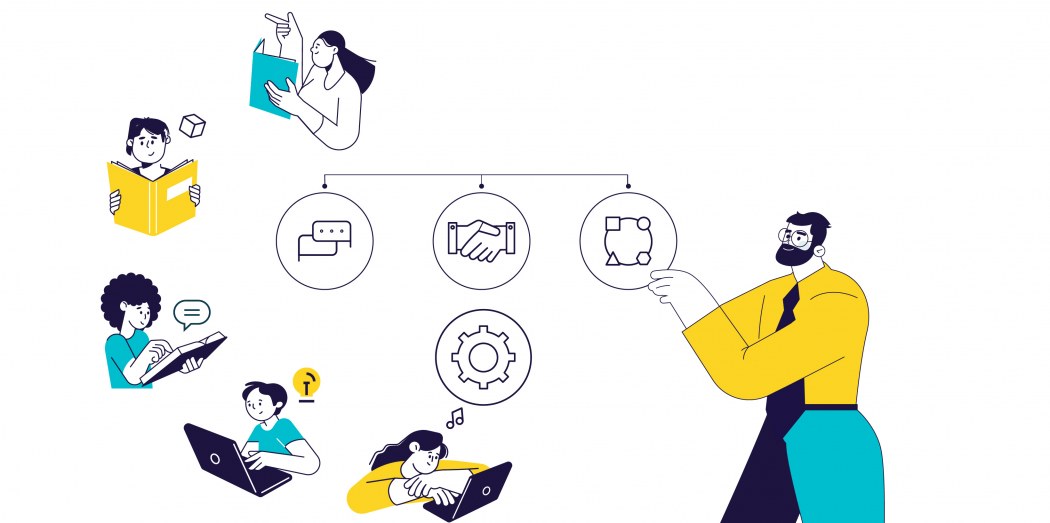





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025