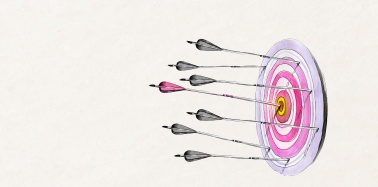تُمثّل إدارة الصفّ المدرسيّ تحدّيًا تربويًّا جوهريًّا: كيف نوفّق بين تنمية الفرد المستقلّ، وتنظيم جماعة متنوّعة في مكان وزمان محدودين؟ هذا التحدّي ليس تقنيًّا فحسب، بل فلسفيّ يلامس طبيعة العلاقات وسلطة المعرفة في الفصل. كما تتجلّى إدارة الصفّ المدرسيّ بوصفها ممارسة بيداغوجيّة في رحى المأزق التربويّ الحاضر، فهي تقع على مفترق طرق حاسم، بين تجلّيات المثاليّة التربويّة في تمثّلها التنمويّ للفرد المفكّر المستقلّ، وبين الضرورة العمليّاتيّة في تنظيم جماعة متباينة ضمن حيّز مكانيّ وزمانيّ محدودين، ما يعني أنّ هذه الثنائيّة تطرح اشتباكات إشكاليّة مفاهيميّة عميقة الجذور، وتتطلّب تأمّلًا فلسفيًّا حكيمًا، يلامس جوهر العمليّة التربويّة التعلّميّة وعلاقات القوّة الكامنة فيها. فإدارة الصفّ ليست وهم تقنيّات ضبط سلوكيّ سطحيّة، بل تتعدّى ذلك إلى الممارسات الأنطولوجيّة التي تشكّل وعي المتعلّم، وترسم حدود إمكاناته الكامنة داخل الفضاء التربويّ.
عندما تُستحضر إشكاليّة المعرفة والسلطة، كما تناولها فوكو (1995)، باعتبارها إحدى أعمق الإشكاليّات التربويّة، فإنّ إدارة الصفّ لا تكون محايدة بالتأكيد، بل تُعدّ آليّة لإنتاج، وإعادة إنتاج، أنماط معرفيّة وسلوكيّة وقيميّة معيّنة؛ تتجلّى في اختيارات المعلّم في تنظيم الحيّز الصفّيّ (ترتيب المقاعد)، وتوزيع زمن الحصّة، ومنح السؤال والملاحظة، وتقييم الإجابات... والتي تمارس جميعها سلطة رمزيّة، كما يصفها بورديو (2007)، تشكّل ما يعتبر معرفة مشروعة وسلوكًا مقبولًا.
هذه الممارسات الخطيرة في وعيها، قد تُعزّز هيمنة ثقافيّة معيّنة أو تقمع أساليب تعلّم مغايرة، متجاهلة التعدّديّة المعرفيّة والثقافيّة في بيئة الصفّ. فكيف يمكن لإدارة الصفّ أن تكون فضاء رحبًا للتحرّر المعرفيّ وطرائق التفكير، بدلًا من أن تكون أداة قمعيّة تنتج الانضباط والتطبيع الاجتماعيّ؟
الإشكاليّات الأساسيّة: رؤى متضاربة
1. الصفّ: نظام مغلق أم نسيج حيويّ؟
النموذج التقليديّ كما في فلسفة هوبز (1996) ودوركهايم (1956): يُركّز على ضبط الفوضى عبر قواعد صارمة ومراقبة مستمرّة، كما في نموذج "السجن البانوبتيكي" عند فوكو (1995). مثال: ترتيب المقاعد في صفوف مستقيمة، وأنظمة العقاب والثواب الصارمة.
النموذج التفاعليّ المستند إلى ديوي (1966) وميد (حمداوي، 2019): يرى الصفّ "مجتمعًا مصغّرًا" تُبنى قوانينه عبر التفاعل والتشارك. مثال: وضع قواعد الفصل جماعيًّا.
الإشكاليّة: كيف نوفّق بين قيادة المعلّم الضروريّة، ومساحة التحرّر التي يحتاج إليها الطلّاب؟
2. السلطة والمعرفة: من يحدّد الـ"مشروعيّ"؟
كلّ خيار تربويّ (طريقة توزيع الوقت، منح الكلمة، تقييم الإجابات) يُعبّر عن هيمنة ثقافيّة أو معرفيّة، كما يرى بورديو (2007) وفوكو (1995). مثال: تفضيل الطالب الذي يستخدم لغة أكاديميّة رسميّة على من يُعبّر بلهجته المحكيّة، أو تجاهل أساليب التعلّم الحركيّة.
التحدّي: كيف نجعل الصفّ فضاءً للتنوّع بدلًا من آلة للانضباط؟
نحو بيداغوجيا توازنيّة: حلول عمليّة
1. الحكمة العمليّة والمرونة:
تجنُّب الثنائيّات الجامدة (صرامة مطلقة، فوضى). بدلًا من ذلك، تطبيق "الوسط الذهبيّ" لأرسطو: توازن ديناميكيّ حسب الموقف.
تطبيق عمليّ:
- - فرض هيكليّة واضحة للأنشطة الجماعيّة (مثل مناقشة علميّة موجّهة).
- - إتاحة مساحات حرّة للاكتشاف (مثل "ركن الاستقصاء" للتجارب الحرّة).
- - اعتبار الخطأ خطوة تعلّم (مثل تحليل أخطاء الرياضيّات جماعيًّا).
2. التشارك لا الإملاء:
تحويل القواعد من أوامر إلى "عقد اجتماعيّ" يُتفاوض عليه.
تطبيق عمليّ:
- - "مائدة مستديرة" أوّل السنة الدراسيّة: مناقشة أسباب القواعد مع الطلّاب (لماذا الهدوء أثناء الشرح؟).
- - إشراكهم في صياغتها (ميثاق الفصل المصوَّر).
- - تعزيز "الرقابة الذاتيّة" ضمن مسؤوليّات جماعيّة (مثل "لجنة الحوار" لحلّ النزاعات).
3. الوعي النقديّ بالسلطة:
كما يشير فريري (1980)، لا بدّ من تساؤل مستمرّ: "هل ممارساتي تُعزّز التمكين أم التبعيّة؟"
تطبيق عمليّ:
- - توزيع الأدوار القياديّة (مثل "مُيسّر المناقشة").
- - تصميم أنشطة تعكس تنوّع الثقافات (مثل مشاريع عن التراث المحلّيّ).
- - تشجيع التساؤل الجريء (ما المصدر الذي يعتمد عليه هذا الرأي؟)
4. عدالة الاعتراف لا المساواة الشكليّة:
العدل هو الإنصاف حسب الاحتياج، كما يرى رولز (2001).
تطبيق عمليّ:
- - تخصيص وقت إضافيّ لذوي الصعوبات.
- - مراعاة أنماط التعلّم (عروض مرئيّة، أنشطة حركيّة).
- - "سجلّ الاعتراف": تسجيل إسهامات كلّ طالب مهما صغرت.
5. الفضاء الآمن والمحفِّز:
البيئة النفسيّة أساسيّة للتعلّم العميق.
تطبيق عمليّ:
-
- "طقس بداية الحصّة": دقيقتان للتعبير عن المشاعر.
-
- تزيين الفصل بأعمال فنّيّة للطلّاب.
-
- كسر الجمود بتمارين حركيّة قصيرة.
نحو التمكين في مواجهة النظام
التحوّل من بيداغوجيا القمع إلى التمكين يتطلّب أكثر من إرادة المعلّم؛ فهو محكوم بسياقات نظاميّة (أنظمة التعليم، ضغط المنهج، ثقافة المدرسة). السؤال الجوهريّ: كيف يمكن تمكين المعلّم نفسه ليمارس هذه الرؤية في ظلّ منظومة قد تقيّد خياراته؟
الحلّ يكمن في:
-
- تضامن المعلّمين: بناء شبكات داعمة لتجارب التمكين (مثل "مجتمعات الممارسة").
-
- إصلاح السياسات: الضغط لتعديل الأنظمة التي تعيق الابتكار (مثل المرونة في التقييم).
-
- التمكين المتدرّج: البدء بتطبيقات صغيرة (مثل "دقيقتان للتفاوض") برغم القيود.
إنّ وعي المعلّم النقديّ بآليّات السلطة والممارسة التحرّريّة، يجعله يطوّر ذاته بوعي نقديّ رفيع (فريري، 1980) بطبيعة السلطة التي يمارسها، وكيفيّة تشكيلها للمعرفة والعلاقات داخل الصفّ. هذا يتطلّب منه مراجعة مستمرّة لممارساته: هل تعزّز قيمًا ديمقراطيّة وتعدّديّة؟ هل تتيح مساحات متكافئة للتعبير عند جميع المتعلّمين، بغضّ النظر عن خلفيّاتهم أو أساليب تعلّمهم؟ هل تشجّع التساؤل النقديّ أم الامتثال السلبيّ؟ الإدارة التحرّريّة تسعى لتقويض العلاقات الهرميّة التقليديّة، لا لإلغاء سلطة المعلّم. تحوّلها إلى سلطة تمكين، تمكّن المتعلّم من امتلاك زمام تعلّمه والتعبير عن ذاته بثقة، ضمن إطار من الاحترام المتبادل والمسؤوليّة، ما ينتج العدالة التوزيعيّة والتقديريّة داخل الفضاء الصفّيّ. حين ترتكز الإدارة على مفهوم عميق للعدالة، ليس باعتبارها مساواة شكليّة، بل إنصاف، كما طوّره جون رولز (2001)، وشرحت تطبيقاته التربويّة كوستا (2010)، فإنّ ذلك يتطلّب من المعلّم مراعاة الفروق الفرديّة والظروف الخاصّة، وتوزيع اهتمامه وموارده البيداغوجيّة (مثل منح الكلمة، وتقديم الدعم، وتوزيع النظرة) بشكل عادل، يراعي الاحتياجات المختلفة، لضمان أن يشعر كلّ متعلّم بأنّه مرئيّ ومسموع وقادر على المشاركة، والاستفادة من الفرص المتاحة من دون تمييز أو إهمال. العدالة هنا مرتبطة بالاعتراف (هونيث، 1995) بكرامة كلّ فرد في الجماعة الصفّيّة وكينونته، وهو ما يضفي على الفضاء الصفّيّ بُعدًا جماليًّا ووجدانيًّا، يجعل من إدارته الفعّالة أكثر من مجرّد تنظيم وإجراءات، بل وسيلة لخلق بيئة تعلّم ذات معنى: خلق فضاء جسديّ ونفسيّ يشعّ بالأمان والاحترام والدفء، وحتّى الجمال (بتنظيم الحيّز، واستخدام الفنّ والطبيعة). كلّ ذلك يشكّل بيئة مواتية للتعلّم العميق؛ فالعلاقات الإنسانيّة الإيجابيّة القائمة على التعاطف والتقدير المتبادل بين المعلّم والمتعلّمين، وبين المتعلّمين أنفسهم، هي حجر الزاوية في بيداغوجيا إدارة الصفّ، فهي تشكّل "المناخ النفسيّ الاجتماعيّ" الذي يحدّد قدرة العقل على الانفتاح والاستكشاف والإبداع.
***
إدارة الصفّ التمكينيّة ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء عقل نقديّ ومواطن فاعل. تحقيقها ممكن، ولو جزئيًّا، بالتوازن المرن بين المثاليّة والواقع، وبين الفرديّة والجماعة، وبين حرّيّة الطالب ومسؤوليّة المعلّم. ومن هنا تأتي بيداغوجيا إدارة الصفّ المدرسيّ، في تجلّيها الفلسفيّ الأعمق، بوصفها فنًّا للتوازن الوجوديّ والمعرفيّ والأخلاقيّ؛ فهي ممارسة تتطلّب من المعلّم أن يكون فيلسوفًا عمليًّا، وقائدًا تشاركيًّا، وواعيًا نقديًّا لآليّات السلطة التي يمارسها، وميسّرًا لفضاء تعلّميّ تحرّريّ. إنّ تجاوز الإشكاليّات المفاهيميّة – من ثنائيّة النظام والحرّيّة، إلى إشكاليّة السلطة والمعرفة، إلى صعوبة الشرعيّة – لا يتمّ بواسطة حلول تقنيّة جاهزة، بل بتبنّي رؤية تربويّة شاملة، تقوم على الحكمة العمليّة في الموازنة بين المتطلّبات التشاركيّة والتفاوضيّة في بناء قواعد العيش المشترك، والوعي النقديّ بالممارسات وتأثيراتها، والعدالة التوزيعيّة والتقديريّة في التعامل، وإيلاء البُعد الجماليّ والوجدانيّ الأهمّيّة التي يستحقّها. فقط باعتماد هذا النهج المتكامل والواعي، يمكن تحويل إدارة الصفّ من إشكاليّة قمعيّة إلى بيداغوجيا تمكينيّة، تسهم في تشكيل أفراد أحرار، مفكّرين ونقديّين، ومواطنين مسؤولين في مجتمع ديمقراطيّ قادر على مواجهة تعقيدات الوجود الإنسانيّ.
المراجع
- بورديو، ب.، وباسرون، ج. (2007). إعادة الإنتاج: في سبيل نظريّة عامّة لنسق التعليم. (ترجمة: تريمش، ماهر). المنظّمة العربيّة للترجمة.
- دوركهايم، إ. (1956). التربية وعلم الاجتماع. (ترجمة: قاسم، محمود). دار المعارف.
- ديوي، ج. (1966). الديمقراطيّة والتربية. (ترجمة: القوصي، عبد العزيز). دار المعارف.
- فوكو، م. (1995). المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن. (ترجمة: أبي صالح، جورج). دار المدى.
- فريري، ب. (1980). تعليم المقهورين. (ترجمة: بدور، محمّد). دار ابن خلدون.
- حمداوي، جميل. (2019). سوسيولوجيا التربية. مؤسّسة الورّاق للنشر والتوزيع.
- هوبز، ت. (1996). اللفياثان. (ترجمة: عمر، حسين). المنظّمة العربيّة للترجمة.
- هونيث، أ. (1995). الصراع من أجل الاعتراف. دار جداول.
- هونيث، أ.، وفريزر، ن. (2003). إعادة التوزيع أم الاعتراف؟ جدل سياسيّ–فلسفيّ. دار الطليعة.
- رولز، ج. (2001). العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. (ترجمة: مجموعة مترجمين). المنظّمة العربيّة للترجمة.
- Costa, V. (2010). Rawls, citizenship, and education. Routledge.







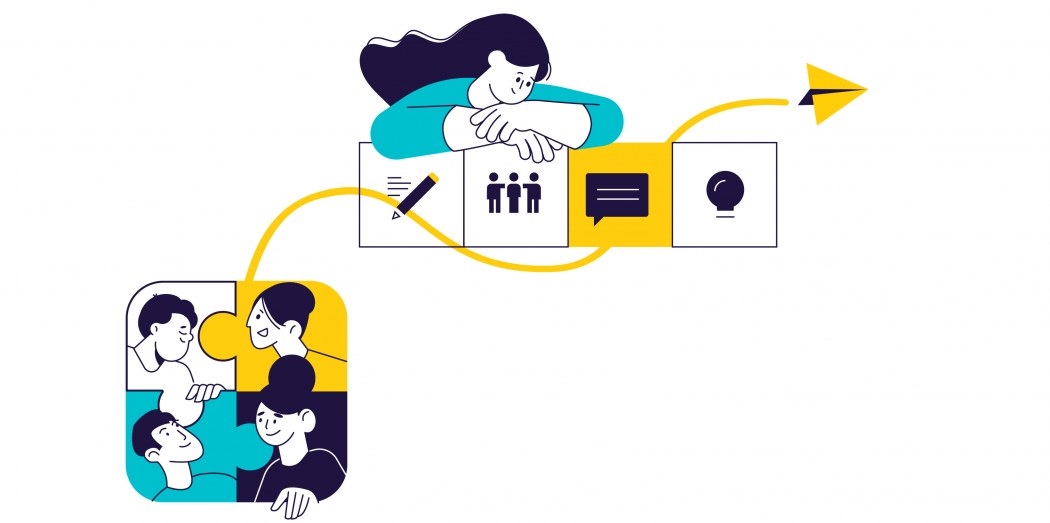





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025