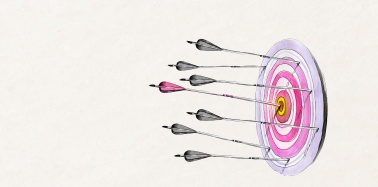يُعدّ الكتاب المدرسيّ أحد الركائز الأساسيّة في المنظومة التعليميّة، لما يقدّمه من معرفة منظّمة ترافق المتعلّم داخل الفصل وخارجه. غير أنّ علاقة المتعلّمين بهذا الوسيط التعليميّ تتّسم بالتعقيد، إذ تتأرجح بين تقديره باعتباره أداة للنجاح الدراسيّ، ونفورهم منه باعتباره عبئًا تقليديًّا لم يعد يواكب التحوّلات الرقميّة. في مدينة القنيطرة، إحدى كبريات المدن المغربيّة، يتفاعل المتعلّمون مع الكتاب المدرسيّ في سياق تربويّ يشهد تنافسًا متزايدًا بين الوسائط التقليديّة والرقميّة، ما يؤثّر في تمثّلاتهم تجاهه.
يستند هذا المقال إلى بحث سوسيولوجيّ نوعيّ أُجري حديثًا في إحدى مؤسّسات التعليم الثانويّ في القنيطرة، وشمل عيّنة قصديّة مكوّنة من 120 متعلّمًا ومتعلّمة، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، من مختلف المستويات الدراسيّة (الجذع المشترك، والسنة الأولى والثانية من البكالوريا)، ومن خلفيّات اجتماعيّة واقتصاديّة متباينة. يهدف البحث إلى استكشاف تمثّلات المتعلّمين للكتاب المدرسيّ بصفته وسيطًا تعليميًّا، وتحليل العوامل المؤثّرة في علاقتهم به، سواء كانت إيجابيّة (التقدير والاعتماد عليه)، أو سلبيّة (النفور والإهمال)، في ظلّ التحوّلات الرقميّة الراهنة.
تبرز أهمّيّة هذا البحث في تسليط الضوء على الكتاب المدرسيّ باعتباره عنصرًا محوريًّا في الفعل التعليميّ، في سياق التحدّيات التي تفرضها الوسائط الرقميّة والمنصّات التفاعليّة. ويسعى لسدّ فراغ معرفيّ يتعلّق بندرة الأبحاث النوعيّة التي تتناول البُعد الرمزيّ والاجتماعيّ للكتاب من منظور المتعلّمين أنفسهم. ولم يُنشر هذا البحث بعد ضمن مجلّة علميّة، إلّا أنّه يُعدّ جزءًا من مشروع أكاديميّ أشمل، يهدف إلى إعادة النظر في مكانة الكتاب المدرسيّ ضمن المنظومات التربويّة العربيّة.
موضوع الدراسة
ركّز البحث على فهم التمثّلات الاجتماعيّة لمتعلّمي التعليم الثانويّ تجاه الكتاب المدرسيّ، عن طريق رصد المعاني والدلالات المتولّدة عن تجاربهم اليوميّة، وتفاعلاتهم مع هذا الوسيط التعليميّ. وقد استُنِد إلى مفهوم "التمثّلات الاجتماعيّة" مثل ما بلوره سيرج موسكوفيتشي (Moscovici, 1961)، والذي يحيل إلى الكيفيّة التي يُكوّن بها الأفراد معاني مشتركة للظواهر الاجتماعيّة. وكما أوضح دوفين (Duveen, 2000)، تتشكّل هذه التمثّلات بواسطة تفاعلات اجتماعيّة، تجعل من الكتاب المدرسيّ ظاهرة ثقافيّة محمّلة بدلالات رمزيّة (مثل المكانة المعرفيّة أو الارتقاء الاجتماعيّ)، وتثير مواقف متباينة (بين التقدير والتجاهل). ساعد هذا الإطار النظريّ في تحليل كيفيّة تشكّل تمثّلات المتعلّمين في سياق تربويّ متحوّل.
وقد تمحورت الإشكاليّة حول الأسئلة الآتية:
- - كيف يعبّر المتعلّمون عن تمثّلاتهم تجاه الكتاب المدرسيّ؟ وما مظاهر التردّد بين التقدير والنفور؟
- - ما العوامل الاجتماعيّة (مثل الوضع الاقتصاديّ ودور الأسرة) والتربويّة (مثل طرق التدريس أو تصميم الكتاب) المؤثّرة في هذه التمثّلات؟
- - كيف يمكن توظيف نتائج البحث لتحسين تفاعل المتعلّمين مع الكتاب المدرسيّ؟
منهجيّة الدراسة: الأدوات والاستراتيجيّات المعتمدة
اعتمد البحث المنهج النوعيّ، لما يوفّره من إمكانات لاستكشاف التمثّلات وتحليل التجارب الذاتيّة بعمق. وقد وُظّفت ثلاث أدوات رئيسة لجمع البيانات:
المقابلات شبه الموجّهة: أُجريت مقابلات فرديّة مع 120 متعلّمًا ومتعلّمة، تراوحت مدّتها بين 20 و25 دقيقة. ركّزت الأسئلة على تجاربهم مع الكتاب المدرسيّ، وتقييمهم لمحتواه وشكله، وتأثير العناصر المحيطة (مثل الأسرة والمعلّم). من الأسئلة المطروحة: "ما الذي يعجبك أو لا يعجبك في الكتاب المدرسيّ؟"، و"كيف تقارن بينه وبين المصادر الرقميّة؟". وقد واجه الباحث تحدّيات مثل تردّد بعض المتعلّمين، ما استلزم بناء الثقة.
الملاحظات الميدانيّة: أُجريت ملاحظات منهجيّة خلال 20 حصّة دراسيّة في موادّ مختلفة (الرياضيّات والاجتماعيّات والعلوم والفلسفة والتربية الإسلاميّة)، وثّقت أنماط التفاعل مع الكتاب، مثل الإهمال أو استخدامه مصدرًا رئيسًا.
تحليل المضمون: استُخدم لتصنيف البيانات إلى محاور دلاليّة (مثل: "الكتاب أداة للنجاح" أو "النفور بسبب الأسلوب")، ضمن إطار نظريّ يستلهم من علم الاجتماع التربويّ وعلم النفس الاجتماعيّ.
وقد روعي في اختيار العيّنة التنوّع في الجنس والمستوى الدراسيّ والخلفيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مع تمثيل المتعلّمين من أوساط حضريّة وقرويّة (روافد). ولضمان موثوقيّة البيانات، اختيرت أدوات البحث أوّليًّا لضبط صياغة الأسئلة وضمان فعّاليّتها.
نتائج الدراسة: تمثّلات متباينة للكتاب المدرسيّ
كشفت الدراسة عن تعدّد التمثّلات التي يحملها المتعلّمون تجاه الكتاب المدرسيّ، وتفاوتها بين التقدير باعتباره وسيلة لا غنى عنها للتحصيل، والنفور نتيجة لمحدوديّة جاذبيّته. ويمكن تلخيص النتائج في المحاور الآتية:
1- الكتاب المدرسيّ رمزًا للنجاح الدراسيّ والاجتماعيّ
عبّر 78 من المتعلّمين (65%) عن تقديرهم للكتاب المدرسيّ، خصوصًا في الموادّ العلميّة، واعتبروه مرجعًا ضروريًّا للنجاح الدراسيّ. في هذا السياق، صرّح أحد المتعلّمين في السنة الثانويّة الثانية: "كتاب الفيزياء مفتاحي للنجاح، أعتمد عليه في الامتحانات ومراجعة الدروس. لا أستطيع تصوّر الدراسة من دونه". ويعكس هذا التصوّر ارتباط الكتاب بمنظومة التقييم، إذ يُنظر إليه بوصفه أداة حاسمة لاجتياز الاختبارات وتحقيق التفوّق.
كما أشار 55 متعلّمًا إلى أنّ الكتاب يمثّل رمزًا للترقّي الاجتماعيّ، لا سيّما لدى المتعلّمين من أوساط اقتصاديّة متواضعة. ذكرت إحدى المتعلّمات: "أهلي يعتبرون الكتاب المدرسيّ استثمارًا في مستقبلي، ولا يستسيغون النجاح الدراسيّ من دون ملازمته". تعزّز هذه الرؤية الدلالة الرمزيّة للكتاب بصفته وسيلة لتحقيق الطموحات وتغيير الوضع الاجتماعيّ.
2- الكتاب المدرسيّ باعتباره عبئًا تقليديًّا ومصدرًا للنفور
في المقابل، عبّر 36 متعلّمًا (30%) عن نفورهم من الكتاب المدرسيّ، مرجعين ذلك إلى كثافة محتواه وأسلوبه التقريريّ، وانفصاله عن الواقع اليوميّ. في هذا السياق، قالت إحدى المتعلّمات في السنة الثانويّة الأولى - آداب: "كتاب التاريخ مملّ، نصوصه طويلة ومليئة بالتواريخ التي لا أفهم علاقتها بحياتنا. أفضّل مشاهدة فيديوهات تعليميّة على الإنترنت". يعكس هذا الرأي شعورًا بالإحباط من الأسلوب الخطّيّ والتلقينيّ للكتاب الذي يعتمد على الحفظ بدلًا من التفكير النقديّ.
أشار 28 متعلّمًا إلى شعورهم بالضغط النفسيّ بسبب حجم الكتب وتعدّد الموادّ. قال أحد المتعلّمين في سلك البكالوريا: "في غالب الأحيان، أستغني عن الكتاب وألجأ إلى الملخّصات الإلكترونيّة لأنّها أكثر اختصارًا". كما رصدت الدراسة بواسطة الملاحظات الميدانيّة، أنّ المتعلّمين يتفاعلون بشكل أقلّ مع الكتب ذات النصوص الكثيفة، مقارنة بتلك التي تحتوي على رسوم توضيحيّة أو أنشطة تفاعليّة.
3- تمثّلات متباينة حسب الموادّ والسياق
أظهرت النتائج أنّ تمثّلات المتعلّمين ليست ثابتة، بل تتغيّر بحسب المادّة الدراسيّة والظروف التعليميّة. في هذا السياق، أبدى 70% من المتعلّمين تفضيلًا لكتب الموادّ العلميّة (مثل الرياضيّات والفيزياء) على الأدبيّة (مثل التاريخ والجغرافيا)، لارتباطها بأهداف مستقبليّة، مثل الالتحاق بالكلّيّات العلميّة والمعاهد العليا. صرّح أحد المتعلّمين: "كتاب الرياضيّات مفيد جدًّا لأنّه منظّم ويحتوي على تمارين عمليّة، لكنّ كتاب الجغرافيا مجرّد نصوص طويلة لا أجد لها فائدة".
4- العوامل المؤثّرة في التمثّلات
رصد البحث مجموعة من العوامل المؤثّرة في تمثّلات المتعلّمين:
- - أسلوب التدريس: المعلّمون الذين وظّفوا الكتاب بطرق إبداعيّة (مثل ربط المحتوى بأمثلة حياتيّة، أو استخدام أنشطة جماعيّة) قلّلوا من النفور. في حصّة علوم الحياة والأرض، وظّف الأستاذ رسومات الكتاب لشرح المفاهيم، ما حفّز المتعلّمين وزاد انخراطهم.
- - تصميم الكتاب: الكتب التي تحتوي على ألوان جذّابة ورسوم توضيحيّة وأنشطة تفاعليّة حظيت بتفاعل أكبر. قالت متعلّمة في شعبة الآداب: "كتاب العلوم جذّاب بصريًّا، يجعلني أرغب في قراءته، عكس كتاب مادّة الفلسفة المليء بالنصوص".
- - الخلفيّة الاجتماعيّة: المتعلّمون من أسر داعمة، خصوصًا تلك التي تقدّر التعليم، أظهروا تقديرًا أكبر للكتاب باعتباره أداة للارتقاء. على العكس، أبدى بعض المتعلّمين من أوساط هشّة نفورًا بسبب غياب التوجيه.
- - المنافسة الرقميّة: أشار 65 متعلّمًا إلى تفضيلهم للمصادر الرقميّة (مثل يوتيوب أو تطبيقات تعليميّة)، لأنّها تقدّم محتوى بصريًّا وتفاعليًّا، على عكس الكتاب المدرسيّ التقليديّ.
استنتاجات: نحو إعادة التفكير في مكانة الكتاب المدرسيّ
تشير نتائج الدراسة إلى أنّ تمثّلات المتعلّمين تجاه الكتاب المدرسيّ تتّسم بالتعقيد والتنوّع، فهي لا تعكس موقفًا موحّدًا، بل تتقاطع فيها عوامل معرفيّة ونفسيّة واجتماعيّة. ففي حين يُنظر إلى الكتاب المدرسيّ باعتباره رمزًا للنجاح والدعم الدراسيّ، يُنظر إليه أيضًا وسيطًا تقليديًّا لا يواكب التحوّلات التربويّة والرقميّة الراهنة. يكشف هذا التناقض عن أزمة ثقة كامنة بين المتعلّم والمحتوى المدرسيّ، ما يستدعي التفكير في سبل إعادة تأهيل الكتاب المدرسيّ ليتناسب مع حاجات المتعلّمين ورهانات العصر.
وقد أبرزت الدراسة أنّ التفاعل الإيجابيّ مع الكتاب لا يرتبط فقط بجودة المحتوى، بل أيضًا بطريقة تقديمه وتوظيفه في الفصل الدراسيّ. فالمتعلّمون الذين خاضوا تجارب تعليميّة تفاعليّة، وارتبطوا عاطفيًّا ومفاهيميًّا بالمادّة، عبّروا عن تمثّلات إيجابيّة تجاه الكتاب. بينما ارتبط النفور غالبًا بمظاهر العزلة البيداغوجيّة، والنفور من النمط التقليديّ للعرض، وغياب الصلة بين محتوى الكتاب وحياة المتعلّمين اليوميّة.
كما تبيّن أنّ الوسائط الرقميّة باتت تمثّل منافسًا قويًّا للكتاب المدرسيّ، نظرًا إلى قدرتها على تقديم المعرفة بأساليب مرئيّة وتفاعليّة. غير أنّ هذا لا يعني نهاية دور الكتاب، بل يستوجب التفكير في دمجه ضمن بيئة تعليميّة متعدّدة الوسائط، يكون فيها الكتاب عنصرًا داعمًا وليس وحيدًا.
توصيات: من أجل تطوير العلاقة مع الكتاب المدرسيّ
بناءً على ما سبق، توصي الدراسة بما يأتي:
- تحديث محتوى الكتاب المدرسيّ وتصميمه: باعتماد تخطيطات مرئيّة جذّابة، وإدماج وسائط متعدّدة (صور ورموز وأنشطة وأمثلة حياتيّة)، وتبنّي لغة تواصليّة تراعي اهتمامات المتعلّمين ومستوى فهمهم، من دون الإخلال بالعمق الأكاديميّ.
- إعادة تأهيل دور المعلّم: عبر تكوين مستمرّ لاستراتيجيّات توظيف الكتاب بشكل تفاعليّ، وإدماجه ضمن أنشطة تعليميّة تحفّز التفكير النقديّ والتعاون بين المتعلّمين.
- الاستفادة من الوسائط الرقميّة: بإنشاء نسخ رقميّة تفاعليّة للكتب المدرسيّة، مدعومة بروابط (QR) لمصادر إضافيّة، وتمارين ذاتيّة التصحيح، بما يجعل من الكتاب منصّة ديناميّة، وليس وسيلة جامدة.
- مراعاة الفوارق الاجتماعيّة: عبر سياسات داعمة لاقتناء الكتب، وإشراك الأسر في مسارات التعلّم، ما يعيد للكتاب مكانته باعتباره أداة للتنمية الفرديّة والاجتماعيّة.
- تعزيز البحوث النوعيّة في مجال التمثّلات التربويّة، لاستكشاف أصوات المتعلّمين ومواقفهم بشكل معمّق، والتأسيس لنماذج بيداغوجيّة منبثقة من الواقع المدرسيّ المغربيّ.
- تعزيز دور الأسرة: ينبغي أن تشعر الأسر بأهمّيّة دعم أبنائها عاطفيًّا ومادّيًّا، مثل توفير بيئة مناسبة للدراسة، أو تشجيعهم على استخدام الكتاب بذكاء.
***
في الختام، يؤكّد هذا البحث ضرورة تجاوز النظرة التقنيّة للكتاب المدرسيّ باعتباره مجرّد أداة لنقل المعرفة، نحو مقاربته بصفته منتجًا ثقافيًّا واجتماعيًّا يحمل دلالات متغيّرة. إنّ فهم تمثّلات المتعلّمين تجاهه يفتح آفاقًا لتطوير السياسات التعليميّة، ومراجعة مناهج التأليف، بما يجعل من المدرسة فضاءً أكثر انسجامًا مع التحوّلات المجتمعيّة وانتظارات الأجيال الصاعدة.
المراجع
- - أشهبون، ع. المالك. (2021). الكتاب المدرسيّ: مسارات وتجارب وانتظارات. مركز الأبحاث السيميائيّة والدراسات الثقافيّة.
- - الحسين، أ. (2017). صناعة الكتاب المدرسيّ. مركز الحسين للاستشارات والبحوث.
- - Apple, M. W. (2019). Ideology and curriculum (4th ed.). Routledge.
- - Duveen, G. (Ed.). (2000). Social Representations: Explorations in Social Psychology. Polity Press.
- - Moscovici, S. (1961). La psychanalyse, son image et son public. Presses Universitaires de France.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025