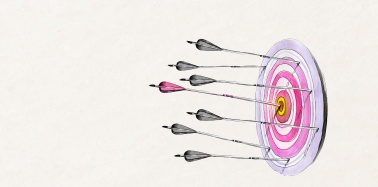الحرب الأهليّة اللبنانيّة، مثلها مثل العديد من الطامّات الكبرى في التاريخ، لم تنتهِ بصمت، بل استمرّ صداها في الهمسات والإسقاطات والذكريّات المُنقّحة بعناية. تصف مي غصّوب في تأمّلاتها المؤثّرة ما تلا تلك الحرب ليس بكونه شفاء، بل "لمسة من فقدان الذاكرة": نسيان جماعيّ مُطرّز بدقّة في نسيج الحياة اليوميّة. إنّه نسيان يفضّل السلام على الحقيقة، والوحدة على العدالة، والسرد على التذكّر. وفي الفصول الدراسيّة، تدخل هذه الذاكرة المُنسّقة بهدوء عن طريق صفحات الكتب المدرسيّة المطبوعة والمنظّمة والمعتمدة. غالبًا ما تقدّم هذه الكتب روايات منتقاة تُضخّم فيها بعض الأصوات، بينما تُمحى أخرى، ما يمنح الطلّاب نسخة من التاريخ مُعقّمة ومجزّأة ومنقوصة.
هذه الذاكرة الانتقائيّة ليست مجرّد ظاهرة مجتمعيّة، ولكنّها ظاهرة مؤسّسيّة رُسّخت في المحتوى التعليميّ، وخصوصًا الكتب المدرسيّة التي تعمل مصادر موثوقة للمعرفة عند الطلبة. فغالبًا ما تصوّر هذه الكتب حقائق معقّمة، أو تفكّك الهويّات والتواريخ المعقّدة إلى أجزاء قابلة للهضم. حالات الحذف والإزالة هذه ليست مجرّد إغفال - إنّما ممارسة للقوّة تؤثّر في ماهيّة المعرفة المشروعة، والآلام التي نعترف بها، والصوت المسموع (Concilio, 2016). بعيدًا عن الحياديّة، تؤدّي الكتب المدرسيّة دورًا مركزيًّا في تشكيل كيفيّة فهم المتعلّمين للهويّة والتاريخ والعدالة.
يتّضح هذا أيضًا في الجدل الدائر حول إزالة قصّة "ماوس" لآرت شبيجلمان من المناهج الدراسيّة، على الرغم من أهمّيّتها الأدبيّة والتربويّة في التصوير الثابت للصدمة، وتحدّيها للسرد التاريخيّ المعقّم، ما يؤكّد الطبيعة المثيرة للجدل للمحتوى التعليميّ. هذا يكشف كيف يمكن قمع الأدب الذي يتحدّى الظلم عندما يواجه مناطق الراحة والروايات المهيمنة.
كما أشير إليه في مشروع قصّة "ماوس"، تسهم إزالة مثل هذه النصوص من الفصول الدراسيّة في الحدّ من تطوّر الوعي النقديّ، وتقلّل من فرص الحوار الصادق حول الصدمة والهويّة والمسؤوليّة التاريخيّة.
وبشكل مماثل، تنتقد إيفانوفا (2017) كيف أنّ الروايات التاريخيّة غالبًا ما تعطي الأولويّة لأحداث وأصوات معيّنة، وأبرزها تلك التي أُطّرت بواسطة العدسات الأخلاقيّة الغربيّة، بينما تتجاهل الروايات الأخرى أو تستبعدها. وبالمثل، تذكّرنا كينغ (2009) أنّ الذاكرة والتمثيل غالبًا ما يُشكَّلان لخدمة المصالح السياسيّة، بدلًا من خدمة الحقيقة أو العدالة، فتكشف هذه الأفكار عن الكتاب المدرسيّ باعتباره أكثر من مجرّد أداة للتعليم، ليصبح قطعة أثريّة ثقافيّة محمّلة بالخيارات حول الإدماج والإغفال والمنظور.
المعرفة المتنازع عليها: الرقابة والصمت والأصوات المسموعة
تسلّط هذه الأمثلة الضوء على الصراع المستمرّ حول من تعتبر قصصهم مناسبة أو ذات قيمة في السياقات التعليميّة. وبالتالي، كيف يمكننا، بصفتنا أكاديميّين عاملين في مجال التعليم، أن ندرّس مفاهيم مثل العدالة الاجتماعيّة والإنصاف والقمع والسلطة، من دون أن يكون ذلك على حساب أولئك الذين نعلّم عنهم ونعرّضهم إلى الخطر؟ كيف يمكننا التأكّد من أنّنا لا نختزلها في لقطات أو محتوى اختزاليّ أو موارد، تعمل ببساطة على تعزيز أهداف التعلّم في مساحات أكثر امتيازًا، والتي من شأنها التقليل من شأن عدم المساواة والقضايا الحقيقيّة؟
علينا هنا أن نطرح على أنفسنا مجموعة من الأسئلة: قصص مَن تلك التي نرويها؟ من استُبعد منها؟ وما عواقب هذا الغياب؟ لا يقتصر دورنا بصفتنا معلّمين على تقديم المحتوى فحسب، بل يتمثّل في الفحص النقديّ للأنظمة والهياكل التي تحدّد المحتوى الذي يُدرّس وتشكّله، وذلك بنقد الكتاب المدرسيّ الذي يعتبر أيقونة ثقافيّة، فنبدأ في الكشف عن جذور عدم المساواة التعليميّة، وفتح مسارات لتجارب تعليميّة أكثر عدلًا وشموليّة وصدقًا. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الكتاب المدرسيّ باعتباره منتجًا ثقافيًّا وأيديولوجيًّا، فنحن نعمل على التدبّر في كيفيّة قيام المناهج الدراسيّة بتعزيز التسلسلات الهرميّة الاجتماعيّة وتحدّيها، خصوصًا في السياقات التعليميّة شحيحة الموارد، أو المتنوّعة، أو التي تعاني آثارَ ما بعد الاستعمار. من هذه العدسة يمكننا إعادة تصوّر التعليم، ليس بصفته أداة لتقديم محتوى وحسب، ولكن بصفته فعلًا واعيًا للتمثيل والتحوّل.
الكتب المدرسيّة باعتبارها أيقونات ثقافيّة: سياسة التمثيل عن طريق تصميم المناهج
غالبًا ما يُنظر إلى الكتب المدرسيّة على أنّها أدوات تعليميّة محايدة، بينما في الحقيقة تخضغ منتجاتها وعمليّة اختيارها واعتمادها في الأساس لدوافع وأسس سياسيّة. بعيدًا عن كونها ناقلات موضوعيّة للمعرفة، فإنّ الكتب المدرسيّة تمثّل أيقونات ثقافيّة تعكس الأطر الأيديولوجيّة والتاريخيّة والسياسيّة للمجتمعات التي تنتجها (Camara, 2025)، فهي لا تنقل الحقائق فحسب، بل تعمل على بناء الرواية وإضفاء الشرعيّة على هياكل السلطة، كما تحدّد الأحداث التاريخيّة والهويّات والنظريّات المعرفيّة التي تستحقّ أن تدرج في المنهج.
هكذا تعمل الكتب المدرسيّة أدوات للسلطة المعرفيّة، ما يعزّز ما يسمّيه كونيل (2007) "منهج النواة" (أنظمة المعرفة التي تتوافق مع نظريّات المعرفة الغربيّة والتقاليد الفكريّة وتفضّلها)، ويؤدّي إلى قمع بعض الفظائع وتضخيم الفظائع الأخرى. وبهذه الطريقة، لا تشكّل الكتب المدرسيّة ما يتعلّمه الطلّاب فحسب، بل أيضًا كيف يتعلّمون تقدير تواريخ وهويّات معيّنة على أخرى.
علاوة على ذلك، تجادل شعيب وآخرون (2024) بأنّ الموادّ التعليميّة، بما في ذلك الكتب المدرسيّة، تتشكّل بواسطة هياكل السلطة الحاليّة وديناميكيّات السياسات، وغالبًا ما تُعيد إنتاج الأيديولوجيّات المهيمنة بدلًا من تحدّيها. عندما تحاول منظّمات المجتمع المدنيّ التدخّل في إنتاج هذه الموادّ، فإنّها غالبًا ما تواجه مقاومة من الجهات الفاعلة المؤسّسيّة المستثمرة في الحفاظ على الوضع الراهن. لذلك، من الأهمّيّة بمكان تبنّي نهج تشاركيّ في وضع المناهج الدراسيّة، بحيث يكون للمجتمعات رأي في القصص التي تُسرد في المدارس. وضمن هذه الرؤية، تتعدّى الكتب المدرسيّة كونها أدوات لسرديّات الدولة، لتصبح مساحات حواريّة يمكن أن تتعايش فيها أصوات متعدّدة.
حتّى في السياقات متعدّدة الثقافات أو ما بعد الاستعمار، تؤكّد شعيب وآخرون (2024) أنّ الكتب المدرسيّة تُنتج في كثير من الأحيان عن طريق عمليّات من أعلى إلى أسفل، تستبعد وجهات نظر المجتمعات المهمّشة. وتجادل بأنّ أنظمة التعليم في لبنان وفلسطين والأردنّ تتّسم بالتشرذم أو التشتّت الأيديولوجيّ، حيث غالبًا ما يُستبعد المجتمع المدنيّ من وضع المناهج الدراسيّة الهادفة، وينتج عن هذا الإقصاء كتب مدرسيّة تعزّز الهويّات الضيّقة التي تقرّها الدولة، بينما تتجاهل التعدّديّة الثقافيّة والتاريخيّة، وتقوّض شعور الطلّاب بالهويّة والانتماء.
وبالتالي، فإنّ البُعد السياسيّ للكتب المدرسيّة لا يكمن في محتواها فحسب، بل في وظيفتها نفسها حارسة للبوّابة التي تُحدّد ما يُعتبر معرفة، وبالتالي تحديد الأفكار التي يُسمح لها بأن تُرى وتُسمَع وتُحفَظ في الذاكرة الجماعيّة. للتحرّك نحو نظام تعليميّ أكثر عدلًا وانعكاسًا، يجب أن ننتقل من سؤال "ماذا يوجد في الكتاب المدرسيّ؟" إلى "من الذي يسهم الكتاب المدرسيّ في إضفاء الشرعيّة عليه، ولأيّ غاية." يمكن أن تكشف الإجابات على هذه الأسئلة الكثير عن المنهج المخفيّ المضمّن في المنهج المرئيّ.
تعطيل هيمنة الكتب المدرسيّة: تحدّي الرواية السرديّة السائدة
ظهر مفهوم إنهاء استعمار المناهج الدراسيّة بعد الطفرة في تحدّي الروايات المهيمنة والمطالبة بعدالة المناهج المدرسيّة، إذ كان له دور مهمّ في الدفع نحو إصلاح منهجيّ شامل وتشاركيّ يستجيب للمجتمع، لا سيّما في السياقات التي تُسكَت فيها الأصوات المهمّشة بشكل روتينيّ. وفقًا لأبو مغلي وكديوال (2021)، لا ينبغي اختزال الدفع نحو إنهاء الاستعمار في الإدماج الرمزيّ للأصوات المهمّشة في قوائم قراءة متنوّعة. بدلًا من ذلك، يتطلّب الأمر إعادة تصوّر جذريّة لمن يضفي التعريفات على المعرفة المنهجيّة وكيفيّة إنتاجها، والتحرّك نحو العدالة المعرفيّة والتحوّل الهيكليّ داخل المؤسّسات التعليميّة. في هذا السياق، تصبح منظّمات المجتمع المدنيّ مركزيّة في خلخلة أنظمة المعرفة المهيمنة، بتضخيم المعارف المقهورة، والمشاركة في إنشاء محتوى مناهج دراسيّة تعكس الحقائق التعدّديّة من الواقع.
على هذا النحو، يتطلّب إنهاء استعمار المناهج الدراسيّة، بما في ذلك الكتاب المدرسيّ (المصدر الرئيس لإعادة الإنتاج الأيديولوجيّ)، التعاون عبر القطاعات مع مناصرة المجتمع المدنيّ، وذلك لاعتماد المنح الدراسيّة النقديّة وتعبئة الطلّاب، ما يخلق الضغط والرؤية اللازمين لإصلاح المناهج الدراسيّة الشاملة والموجّهة نحو العدالة، بحيث يُنظر إليها على أنّها مساحة للمقاومة والتنافس والتحوّل الاجتماعيّ.
***
الكتب المدرسيّة ليست أدوات غير سياسيّة للتعلّم، بل متشابكة بعمق في السياسة الثقافيّة وعلاقات القوّة، فهي تمثّل أيقونات منسّقة تؤثّر في كيفيّة إدراك الطلّاب لأنفسهم والآخرين، وتشكيل الروايات المجتمعيّة من الفصل الدراسيّ إلى الخارج. ومع ذلك، فإنّ هذه القوّة المهيمنة ليست بلا منازع؛ فبالمناصرة والبحث وتطوير المناهج الدراسيّة التشاركيّة، تُتاح القدرة على تعطيل احتكارات الكتب المدرسيّة، وتُعزَّز أشكال المعرفة الشاملة والتعدّديّة والمشاركة بشكل نقديّ، بحيث تتحوّل وظيفة الكتاب المدرسيّ من كونه قطعة أثريّة ثابتة إلى وثيقة حيّة، تتطوّر بالحوار والنقد والذاكرة الجماعيّة.
للمضيّ قُدُمًا، يجب ألّا تركّز جهود إصلاح المناهج الدراسيّة على ما يُدرّس فحسب، بل على من يقرّر ما يستحقّ أن يُدرّس، ليتماشى هذا التحوّل مع ما يسمّى "دمقرطة المعرفة الرسميّة"، وهي عمليّة تفتح المجال للأصوات الصامتة تاريخيًّا والروايات المضادّة.
يذكّرنا فريري دائمًا، أنّ التعليم ليس محايدًا أبدًا، فهو إمّا يعمل على إعادة إنتاج الوضع الراهن، أو يصبح أداة للتحرّر.
المراجع
- - Abu Moghli, M., & Kadiwal, L. (2021). Decolonising the curriculum beyond the surge: Conceptualisation, positionality and conduct. London Review of Education, 19(1), 1–16.
- - Apple, M. W. (2014). Official knowledge: Democratic education in a conservative age (3rd ed.). Routledge.
- - Apple, M. W. (2004). Ideology and Curriculum. Routledge.
- - Camara, J. (2025). Towards critical, anticolonial and antiracist education in national and global contexts. International Review of Education.
- - Concilio, C. (2016). Representations of the Lebanese Civil War and Peace in two Short Stories by Mai Ghoussoub. Le Simplegadi.
- - Connell, R. (2007). Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Polity Press.
- - Ivanova, L. (2017). Teaching about genocide: Applying lessons from the Holocaust to promote equality in genocide education. Fox International Fellowship: Policy Brief Series.
- - King, E. (2009). Genocide: Truth, memory and representation. Human Rights & Welfare, 9(1), 352 pp.
- - Shuayb, M., Brun, C., Abu Moghli, M., Abdel Aziz, R., AlKhamash, M., AlSamhoury, O., Nehme, N., & Saab, C. (2024). Towards a new political imagination for education change: The role of civil society in Lebanon, Palestine and Jordan. Centre of Lebanese Studies.
- - Shuayb, M., Samhoury, O., Nehme, N., & Brun, C. (2024). The role of civil society in shaping education change in Lebanon. Centre of Lebanese Studies.







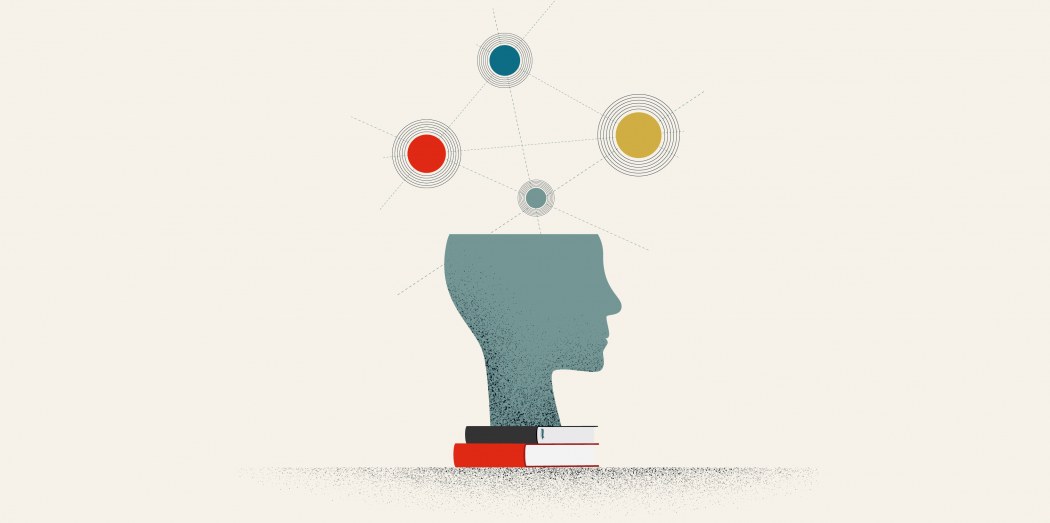





 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025