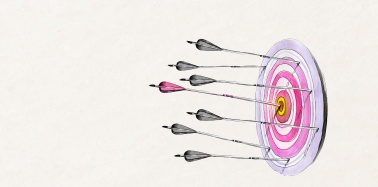بدأت فكرة المعلّم يزن من البيت.
يوم رائق عاد فيه المعلّم يزن إلى المنزل في المساء، بعد أن أنجز مهمّات خاصّة، وحول مائدة الطعام كان ابنه الذي يدرس في الصفّ الخامس صامتًا على غير العادة. فحاول إثارة اهتمامه بمزاح وتعليقات طريفة، لكنّها لم تحدث الأثر المتوقّع، فوجّه السؤال مباشرة لابنه: ما بك؟ ما الذي حصل معك؟
لم يجب الابن، فتطوّعت شقيقته للإجابة قائلة: لقد حطّم محمّد المزهريّة الكبيرة في غرفة الضيوف بضربة واحدة من كرته، فغضبت أمّي.
تمالك المعلّم يزن أعصابه وقال: اتّفقنا أنّ اللعب يكون في الحديقة، فلماذا لم تلتزم باتّفاقنا؟ لم يرفع محمّد رأسه عن الأرض، وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة، فنبّهه الأب إلى ضرورة رفع رأسه، والنظر في وجه المتحدّث. فقال محمّد: المعلّم قال إنّه يجب أن ننظر إلى الأرض عندما نتكلّم مع الكبار.
استوقفت العبارة الأب المعلّم بعمق، ولولا إلحاح الموقف العائليّ لترك القصّة الأساسيّة جانبًا، وانغمس في حوار مع ابنه حول التفاصيل التي دفعت المعلّم إلى فرض هذا الأمر على طلبة الصفّ الخامس.
تطرح منهجيّات في ملفّ هذا العدد التعقيدات التي أصابت علاقة المعلّم بالطلبة والأهل، من ناحية مراقبة سلوكيّاتهم - لا أفضّل استخدام كلمة ضبط- والتحكّم بسير عمليّة التعلّم في الغرف الصفّيّة، والحدود التي يجب أن يقف عندها المعلّم كي لا يتدهور أداؤه، ويوصف بأنّه لا يستطيع السيطرة على طلبته، ولا ينجح في قيادتهم لتحقيق أهداف التعلّم.
هذا المقال محاولة للإشارة إلى أنّ سلوكيّات الطلبة ليست مؤذية كلّها، وأنّه يمكن توجيهها ضمن إطار مرجعيّ مُتّفق عليه. ومن جهة أخرى، فإنّ الأفكار التي يطرحها هذا المقال، ستأخذ بيد المعلّمين الأقلّ مهارة في التعامل مع الطلبة وإدارة سلوكيّاتهم، وستشكّل الأفكار الواردة فيه ما يشبه القانون المتّفق عليه بين المدرسة والأهل. هذا المقال يدعو إلى تطبيق ما يشبه الإشارة الضوئيّة في شوارعنا، لا تُجامل أحدًا، ويستطيع شرطيّ المرور إيقاف عملها أو تعطيل دورها في حالات محدّدة معروفة، وليس بناء على رغبة من هو أعلى منه.
ما الذي يجعل هذه الوثيقة مختلفة؟
تبدأ الأعوام الدراسيّة عادة بنشاط يطلب من الطلبة إعداد قوائم بالحقوق والواجبات، ثم تُعلّق هذه القوائم في الغرف الصفّيّة. ويُلفت نظر الطلبة دائمًا إلى أنّ حقوقهم تفوق واجباتهم بأضعاف، على أمل أن يكون دافعًا لهم إلى تجنّب السلوكيّات غير المرغوبة، وليظهروا بمظهر الطلبة الملتزمين والمنضبطين بما يريده المعلّم، في صورة أقرب إلى "الحَمَل الوديع".
لكنّ هذا لا يحدث.
مدّة قصيرة قد لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين، ثمّ تفقد هذه الوثيقة الغرض الذي وُضعت من أجله. قليل من المعلّمين من يتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى هذا الإخفاق، فنعود إلى المربّع الأوّل في العلاقة بين المعلّم والطالب؛ علاقة تقوم في أغلب الأحيان على الخوف. فالطالب يخاف من بعض المعلّمين، ولا يخاف من آخرين، وقد تصدر عنه سلوكيّات في حصّة لا يجرؤ على إظهارها في حصّة أخرى. ومع أنّنا نتّفق جميعًا على أنّ الخوف عامل مهمّ في هذا الأمر، إلّا أنّنا نُجمع في الوقت ذاته على أنّنا لا نريد تنشئة طالب يخاف، إنما نريد طالبًا عاقلًا يميّز بين الخطأ والصواب، وما يجوز وما لا يجوز، مهما كان الشخص الواقف أمامه.
سنتأمّل ونتفكّر: ماذا لو كانت هذه الوثيقة موحّدة بين أركان المجتمع التعليميّ كلّها؟ ماذا لو وضعنا دستورًا للمدرسة يعرفه الأهل والإدارة والطلبة والمعلّمون معًا، يوضّح الحقوق والواجبات لكلّ طرف بإنصاف، بعيدًا عن التسلّط أو الانحياز أو المحاباة أو المزاجيّة؟
ما يجعل هذه الوثيقة مختلفة أنّها تنبع من ثقافة مدرسيّة لا يملكها المعلّم وحده؛ إذ إنّ تعلّم الطلبة اليوم بات مرتبطًا بمجتمع أوسع من المدرسة، له قيمه وثقافته ومفاهيمه، ويمتلك أدوات للتعبير عنها لا يستطيع المعلّم السيطرة عليها بمفرده. ومن جهة أخرى، فإنّ وجود دستور مدرسيّ مشترك يمنع خضوع القوانين للمزاجيّة الفرديّة، ويوفّر للمعلّمين لغة واحدة يتواصلون بها مع الطلبة؛ لغة تمتدّ لتشمل تفاصيل اليوم المدرسيّ بأكمله.
الأسباب والدوافع
باتت الحاجة ماسّة إلى هذه الوثيقة للأسباب الآتية:
1. تغيّرت أدوار المعلّم في العمليّة التعليميّة، وصار له شركاء في تعليم الطلبة، بفعل التحوّلات الاجتماعيّة والتطوّرات التكنولوجيّة التي فتحت فضاءً واسعًا لتدفّق المعلومات أمام الجميع، لا أمام الطلبة فقط. فقبل هذه التحوّلات، كانت المدرسة تُعدّ مصدر المعرفة الأوحد للطلبة، وأقصى ما يمكنهم الوصول إليه مكتبة المسجد أو مكتبة المدرسة، وغالبًا ما تكون فقيرة بالمصادر، أو مقتصرة على نوع واحد من الكتب.
2. هذه المحدوديّة في المصادر، جعلت الطلبة يعتمدون اعتمادًا كاملًا على المعلّم في تحصيل المعلومات والمعارف. أمّا اليوم، فقد انقلب المشهد، إذ يواجه المعلّمون طلبة على صلة يوميّة بالإنترنت وتطبيقاته، بما يتيحه من آلاف الطرق لتزويدهم بالمعلومات بشكل آنيّ وسريع.
فكيف سيتصرّف المعلّمون والمعلّمات؟
هذه الوثيقة ستكون حلًّا مناسبًا، ورحلة إقناع أولياء الأمور بها ستستند إلى الأسباب السابقة، فضلًا عن كونها تمهّد لمسؤوليّة مشتركة بين أركان المجتمع المدرسيّ، وتشكّل نقطة مرجعيّة لتغيير ثقافة المدرسة. وستلتقي أطراف هذا المجتمع على صياغتها، وكتابة بنودها ومضامينها التي تُفضي إلى بيئة مدرسيّة عادلة وموضوعيّة، تعمل وفق أعلى معايير الشفافيّة، وتضع حدًّا للقرارات المزاجيّة غير المدروسة، أو المبنيّة على العلاقات الشخصيّة. وهكذا يقف الجميع للعمل وفق قواعد واضحة تعزّز المسؤوليّة والالتزام، وتمنح الأهالي والمعلّمين والطلبة شعورًا بأدوارهم الحقيقيّة في قيادة العمل المدرسيّ، بدل الاكتفاء بتنفيذ تعليمات طرف آخر من دون نقاش. ومع هذه الوثيقة، ستعرف الأطراف جميعها أدوارها بوضوح، بما يقلّل من احتماليّة وقوع الخلافات أو النزاعات أو سوء الفهم.
ما يجعل هذه الوثيقة ضروريّة ومهمّة، أنّ قيادة المدرسة لن تكون وحدها في مواجهة أعباء اليوم المدرسيّ ومتطلّباته، بل سيكون لها شركاء يسهّلون عليها تنفيذ بعض القرارات، ويقدّمون لها المشورة والنصح في المنعطفات المفصليّة، داخل بيئة يفترض أن تحقّق العدل الذي يتيح للطلبة أن يتعلّموا ويشاركوا، وللمعلّمين أن يعملوا ويتطوّروا.
إنّ الأثر الذي ستحدثه هذه الوثيقة لن يكون آنيًّا فحسب، بل ستشكّل أداة فاعلة للاستدامة والاستمراريّة، حتّى مع تغيّر قيادة المدرسة. كما أنّ انضمام أطراف جديدة في بداية كلّ عام، يمنح فرصة ثمينة لتطويرها وتحسين بنودها، وجعلها أداة مرنة قابلة للنموّ والتجدّد، وهو ما يجعلها حلًّا مناسبًا لإرساء العلاقة بين أطراف المجتمع المدرسيّ في نصابها المتوازن.
ما المضامين؟
سيكون تركيز هذه الوثيقة على الجانبين السلوكيّ والأكاديميّ، لماذا؟
1. لأنّ تدخّلات أولياء الأمور اليوم في تعليم أبنائهم باتت أكثر من ذي قبل، واشتراطاتهم تزداد في ضرورة توفير التعليم النوعيّ الذي ينسجم مع سوق العمل ومتطلّباته، ويُكسب أبناءهم المهارات اللازمة، مثل الحوار وتقبّل الاختلاف والتفكير النقديّ.
2. لأنّ الملاحظات التي يقدّمها المعلّمون على قرارات النظم التعليميّة، بوصفهم الأقرب إلى واقع الطلبة ونتائج هذه القرارات، تكشف الحاجة إلى تنظيم هذه الأدوار والتدخّلات من الجوانب جميعها.
3. لأنّ هذه الوثيقة عندما تتطرّق إلى الجوانب السلوكيّة في أداء الطلبة، فإنّها لا تعني المراقبة بقدر ما تركّز على توفير الوعي التربويّ، والذي يرسل رسالة للطلبة بأنّهم العنصر الأوّل والجوهريّ في بناء هذا الوعي. وهكذا، ستُعنى هذه الوثيقة برصد سلوكيّات الطلبة، والتصرّف الملائم عند ظهور كلّ سلوك.
4. لأنّ الوثيقة ستحدّد السلوكيّات التي تربك العمل اليوميّ، أو تعيق تحقيق أهداف التعلّم، مع التأكيد على أنّ سلوكيّات الطلبة ليست كلّها كذلك. فالمعلّم لن يقف عند كلّ سلوك، ولن يبالغ في ردّة فعله، وستكون ردود أفعال المعلّمين منسجمة ومرجعيّتهم موحّدة. أمّا الطالب، فسيدرك حدوده، ويعرف أنّ له مساحة يتحرّك ضمنها، من غير أن يؤثّر هذا التحرّك سلبًا في العمليّة التعليميّة.
قد تُقسّم الوثيقة إلى قسمين: سلوكيّات مرغوبة، وسلوكيّات غير منتجة، وفي كلا القسمين طريق واضح نحو بيئة تعليميّة آمنة. إذ يمكن التركيز على سلوكيّات تُعزّز الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المجتمع التعليميّ، وأهمّيّة الحفاظ على مستوى مهذّب من اللغة في التخاطب، وتعظيم قيم الانضباط والالتزام بالقوانين والتعليمات، مثل الزيّ المدرسيّ، أو تحمّل المسؤوليّة والاعتراف بالأخطاء، أو التعامل السليم مع ممتلكات المدرسة. ويمكن أن يتضمّن هذا القسم أيضًا قيم المشاركة الفاعلة بإيجابيّة، والاشتباك البنّاء مع قضايا المدرسة اليوميّة، والتعاون مع أركان المجتمع التعليميّ في معالجتها والحدّ من آثارها.
في هذا القسم من الوثيقة ستُبيّن آليّات التعامل مع المشكلات الناتجة عن العنف، وطرق حلّ أيّ خلاف بالحوار وتجنّب الصراخ، إضافة إلى أساليب معالجة حالات الغشّ والخداع، أو محاولات الإخلال بالنظام المدرسيّ باستخدام العنف مهما كان شكله. كما ستوضّح الوثيقة ما هو مسموح به عند إحضار الأجهزة الذكيّة إلى المدرسة واستخدامها في التصوير، وكيفيّة تعامل المدرسة مع قضايا التمييز العنصريّ والإساءات المترتّبة عليه. وإلى جانب ذلك، ستؤكّد الوثيقة أنّ الاهتمام بنظافة مرافق المدرسة لا يقلّ أهمّيّة عن أيّ جانب آخر من جوانب العمليّة التعليميّة.
سيندرج في الجزء الآخر من الوثيقة ما يُعزّز بيئة التعلّم في المدرسة، بوصفه دورها الجوهريّ الذي بات اليوم يأخذ منحًى جديدًا يفرض التعلّم الذاتيّ، وهو التعلّم الذي يثق به الأهل والمعلّمون، ويستندون إلى أدلّة تؤكّد أنّ الطلبة قد اكتسبوه، وذلك ضمن التزام بالدوام المدرسيّ، واستخدام مرافق المدرسة بما يدعم هذا التعلّم. كما سيتضمّن هذا القسم القيم المرتبطة بالتعلّم، مثل الأمانة العلميّة ونَسب الأفكار إلى أصحابها، إضافة إلى الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وأدواتها.
إضافة مهمّة
مثلما توجد فروقات فرديّة بين الطلبة، فإنّ هناك فروقات أيضًا في مهارات المعلّمين والمعلّمات في قيادة الغرف الصفّيّة، وهو أمر يشير إليه قادة المدارس باستمرار، ويؤثّر في المعلّمين أنفسهم، إذ يكونون أوّل من يُكلّف بالمهمّات التي تتطلّب إدارة وتواصلًا مباشرًا مع الطلبة، مثل الرحلات أو الأنشطة المدرسيّة الطويلة. ولهذا، فإنّ الوثيقة المرجعيّة أو "دستور المدرسة"، سيكون عونًا للمعلّمين الأقلّ خبرة أو مهارة؛ إذ يعرف الطلبة من خلالها ما هو الممنوع والمسموح، ويقتصر دور المعلّم على التذكير بهما. كما أنّ البنود الصريحة المتعلّقة بالتعامل مع الطلبة ستشكّل سندًا لهذه الفئة، وتحول دون وقوعها في اجتهادات لا تضمن إدارة فاعلة للتعلّم.
لتطبيق فعّال
إنّ وجود الوثيقة ووضعها في أعلى درجات الحرص والاهتمام، لا يعني بالضرورة أنّ البيئة المدرسيّة ستصبح أكثر تميّزًا على الفور؛ فهي بحاجة إلى أسس وقواعد واضحة:
1. اتّفاق أركان مجتمع المدرسة على صياغتها بطريقة تشاركيّة.
2. إتاحة الوصول السهل إليها، وتوفير نسخة منها لدى كلّ طرف.
3. تطبيقها على امتداد العام الدراسيّ كلّه، من دون تعطيل أو استثناء.
4. تشكيل لجنة لمتابعة ضبط جودة تطبيقها، تضمّ جميع الأطراف، وتفصل في أيّ خلاف ينشأ عن سوء تقدير أو التباس في الفهم.
هذه القواعد الأساسيّة، حال الالتزام بها، ستؤدّي إلى تقليل المزاجيّة في القرارات المدرسيّة بشكل كبير، وترسل رسالة واضحة إلى الأهل والطلبة بالتزام المعلّمين والمعلّمات، وحرصهم على أداء أدوارهم بمهنيّة عالية تفرض الاحترام المتبادل، وتوجّه سلوكيّات الطلبة نحو التعلّم، كما توحّد النظرة الإجرائيّة عند مواجهة المواقف اليوميّة في المدرسة.
وهذه القواعد لن تكون حبرًا على ورق، بل ستختلف عن المواثيق والعهود التقليديّة التي اعتدنا وجودها من دون تنفيذ. فهي ستولّد في نفوس أولياء الأمور ثقة بنزاهة المدرسة، عندما يدركون أنّ هناك وثيقة مرجعيّة تراقب أداء الأطراف جميعًا بإشرافهم المشترك، فلا طرف واحد يمتلك القرار وحده، سواء في صياغة الوثيقة أو في الإشراف على تنفيذها وضبط سير عملها. وربّما بهذه المنهجيّة يختفي الانحياز المطلق للأبناء في مواجهة المدرسة، ونخرج من دائرة الاتّهام الدائم للمعلّمين بأنّهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع الطلبة. وفي المقابل، ستنال قيادة المدرسة دعمًا إضافيًّا في الحدّ من السلوكيّات غير المنتجة للطلبة، وفي معالجة القضايا التي قد تطرأ جرّاء الانحيازات أو التفسيرات الخاطئة للسلوكيّات.
***
وجود الوثيقة ووضعها ليس غاية للضبط والتقييد والمراقبة، بل هو أشبه بالعقود التي يبرمها الناس لحفظ الحقوق وتوثيق المعاملات. وفي البيئة المدرسيّة، ومع ما تشهده من تحوّلات متسارعة، صار من الضروريّ الاحتكام إلى نقطة مرجعيّة تنطلق منها الأطراف، وتعود إليها عند كلّ طارئ أو مستجدّ. فالجميع يبتغي تحقيق بيئة تعلّم داعمة وآمنة، ولتحقيق هذا الهدف لا بدّ من وجود أداة يتّفق عليها الأطراف جميعًا، ويشرفون على تنفيذها بعيدًا عن الانفراد بالقرار؛ ضمانًا لأعلى درجات الجودة في أداء الطلبة والمعلّمين وأولياء الأمور.
إنّ التطبيق الجادّ والمسؤول لبنود هذه الوثيقة المقترحة سيكفل حفظ حقوق الأطراف كافّة، ويعين المعلّم في ظلّ التحوّلات الهائلة في تعليم الطلبة، ويضبط تدفّق المعارف الذي يتعرّض إليه الطالب، كما يضيء الطريق أمام أولياء الأمور لتتكامل جهودهم مع جهود المدرسة.







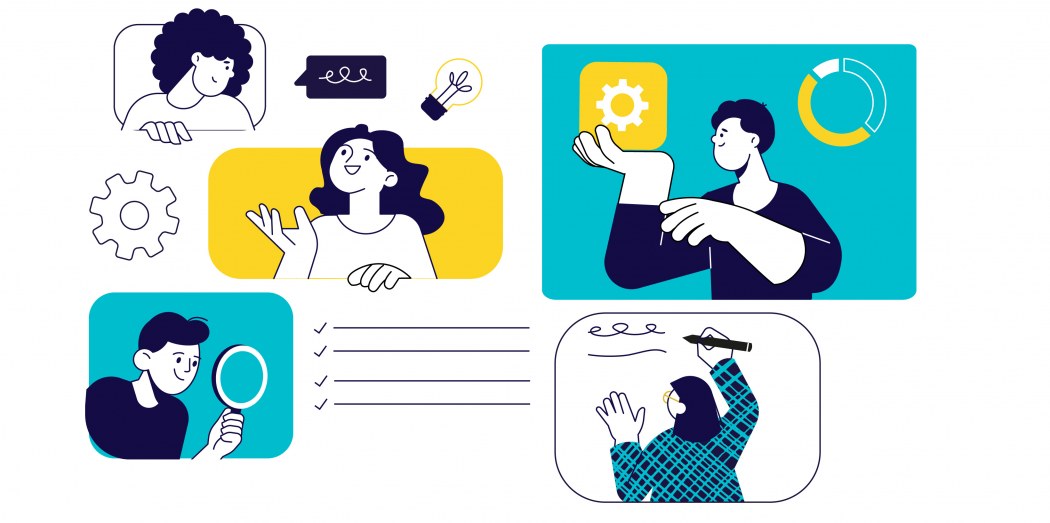





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025