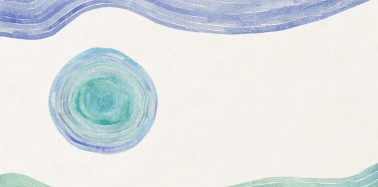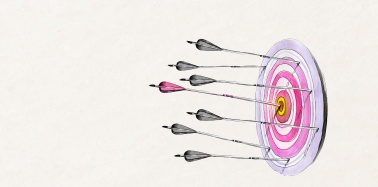في مدينة متعدّدة الثقافات مثل بيروت، لا يزال ربط المناهج الدوليّة بالحياة الواقعيّة للطلّاب تحدّيًا مستمرًّا، لا سيّما في المدارس الخاصّة التي تعتمد كتبًا من أنظمة تعليميّة غربيّة. هذه الكتب، على رغم جودتها، تفشل أحيانًا في نقل المضامين بما يراعي السياق اللبنانيّ. من أمثلة ذلك: الإشارات إلى تقاليد أجنبيّة أو مشكلات حياتيّة لا يمرّ فيها الطفل اللبنانيّ، أو حتّى أمثلة رياضيّة تتعلّق بقياسات بوصة وياردة.
التعليم الفعّال يبدأ من الطالب
منذ أن كنت طالبة، أذكر كيف كان المعلّمون يضطرّون إلى تحضير أوراق عمل إضافيّة ليجعلوا المحتوى أكثر قربًا من بيئتنا. ومع انتقالي إلى مهنة التعليم، بدأت أدرك هذه الحاجة بعمق أكبر، لا بوصفها مجهودًا إضافيًّا، بل ضرورة تربويّة.
تؤكّد غاي (2010) في كتابها Culturally Responsive Teaching أنّ دمج الثقافة وتجارب الحياة اليوميّة في التعليم لا يُعدّ مجرّد ترف تربويّ، بل هو عنصر جوهريّ يُعزّز من تفاعل الطلّاب مع المحتوى، ويُسهم في تحسين تحصيلهم الأكاديميّ. فحين يرى الطالب نفسه ولغته ومجتمعه، وحتّى تفاصيل حياته اليوميّة تنعكس في ما يتعلّمه، يشعر أنّ المعرفة تخصّه، ولا تُفرض عليه من خارج سياقه. وفي مدينة مثل بيروت، حيث يجتمع تنوّع ثقافيّ واجتماعيّ واسع داخل الصفّ الواحد، تصبح هذه المقاربة ضرورة لا خيارًا. لا يمكننا أن نتعامل مع المنهج باعتباره حياديًّا، بينما الطلّاب يأتون بخلفيّات وتجارب غنيّة ومتفاوتة، تتطلّب حسًّا تربويًّا عاليًا في التكييف والتعديل.
من جهتها، تضيف توملينسون (2001) أنّ التفريق الفعّال في التعليم لا يتحقّق فقط بتنويع الأنشطة أو تقسيم الطلّاب حسب مستواهم، بل بعمليّة أكثر عمقًا، تتطلّب تعديل المحتوى نفسه، وآليّات التعلّم، وأهدافه النهائيّة، لا لتتلاءم مع قدرات الطلّاب وحسب، بل أيضًا مع أساليب تعلّمهم ودوافعهم وخلفيّاتهم الثقافيّة والاجتماعيّة. التفريق في هذا الإطار لا يعني مجرّد تقديم "نسخ مبسّطة"، بل يعني إعادة التفكير في كيفيّة إيصال المفاهيم نفسها بطرق متعدّدة، تصل إلى عقل كلّ متعلّم وقلبه.
وهنا تلتقي النظريّتان في تأكيد أنّ التعليم الفعّال لا يبدأ من الكتاب، بل من الطالب: من هويّته، ومن لغته، ومن تجاربه. وهذا ما اختبرته بنفسي بصفتي معلّمة في بيروت. فعندما أدرّس مفاهيم رياضيّة باستخدام أسماء شوارع يعرفها طلّابي، أو أشرح مفهوم "القياس" بوصف إعداد وصفة لبنانيّة، أجد أنّ التفاعل مضاعف، وأنّ المفهوم يرسخ في أذهانهم بسهولة.
وبالتالي، لا يعود دورنا، نحن المعلّمين، مقتصرًا على نقل المعرفة، بل يصل إلى ترجمتها إلى لغة الطالب، وإعادة تخيّل المحتوى ليتحوّل من مادّة جامدة إلى تجربة حيّة. لكنّ تنفيذ هذا التفريق يضع المعلّمين أمام تحدّيات حقيقيّة: الوقت، وشحّ الموارد، والضغط الأكاديميّ. قبل أن أبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي، كنت أعتمد على أوراق قديمة، أو أعدّل نصوصًا يدويًّا، أو أترجم محتوى وأعيد كتابته بأسلوبي. كانت هذه المهام تستهلك ساعات، ما جعلها بالنسبة إلى الكثير من الزملاء رفاهيّة تصعب ممارستها يوميًّا.
الذكاء الاصطناعيّ شريكي في المحتوى الدراسيّ
عندما بدأت استخدام أدوات مثل ChatGPT، تغيّرت علاقتي بالتحضير. لم يكن الهدف اللحاق بالموضة، بل البحث عن طريقة فعّالة لتوفير وقتي من دون التنازل عن الجودة. الذكاء الاصطناعيّ لم يكن بديلًا عن تفكيري التربويّ، بل شريكًا يساعدني في ترجمة رؤيتي إلى موارد ملموسة:
- في أحد دروسي للصفّ الثاني عن "المرفأ"، رغبت في ربط المحتوى بحادثة انفجار مرفأ بيروت بطريقة إنسانيّة مناسبة لأعمار صغيرة، فصغت توجيهًا لأداة الذكاء الاصطناعيّ قلت فيه:
"اكتب نصًّا باللغة العربيّة يبدأ بانفجار مرفأ بيروت، يوضّح ما المرفأ، وكيف تُستخدم وسائل النقل المائيّ للتصدير والاستيراد، وكيف تحوّل المرفأ من كونه الوسيلة الوحيدة للنقل إلى استخدامات محدّدة مثل الترفيه والتجارة. ثمّ عد إلى موقع لبنان وأهمّيّته الجغرافيّة من ناحية الإطلالة المائيّة".
خلال ثوانٍ، حصلت على نصّ مبسّط ومتماسك يُعرّف مفهوم المرفأ، ويوضّح دوره في التجارة البحريّة، ويربطه بموقع لبنان الجغرافيّ المطلّ على البحر المتوسّط. استخدمت هذا النصّ نقطة انطلاق لنقاش مع الطلّاب حول كيف تتأثّر المدن الساحليّة بالاقتصاد والنقل، فكان التفاعل مذهلًا.
- في تجربة أخرى أثناء تحضيري لفصل دراسيّ كامل لرياض الأطفال، كنت بحاجة إلى قصّة واحدة تكون نقطة انطلاق لكلّ أنشطة الفصل وأهدافه. أردت أن تتضمّن عنصرًا غنائيًّا، ولحظة للطبخ، وموقفًا يساعد على تعلّم العدّ، بالإضافة إلى إدراج مفردات معيّنة ومفاهيم تربويّة محدّدة. جمعت كلّ هذه الأهداف وطلبتها من الأداة بشكل واضح، فكتبت لها: "أنشئ قصّة لرياض الأطفال يمكن استخدامها أساسًا لفصل دراسيّ، تتضمّن أغنية، وموقف طبخ، ولحظة تعليميّة رياضيّة، وتُدمج فيها مفردات ومفاهيم نريد تدريسها".
خلال دقائق، حصلت على قصّة تربط بين هذه العناصر بسلاسة، وتُشجّع الأطفال على التفاعل والتكرار، ما ساعدني ليس فقط في تنفيذ أهداف الفصل، بل في توليد أنشطة من القصّة ذاتها: ركن فنّ، وركن تمثيل، ونشاط عدّ بالأدوات، وزاوية كلمات جديدة. هذه القصّة لم تكن مجرّد بداية لدرس، بل صارت وحدة تعليميّة بحدّ ذاتها.
- في أحد الدروس حول السرعة والمسافة والزمن، أردت أن أبتعد عن المثال التقليديّ في الكتاب، وأن أقدّم نشاطًا نابعًا من واقع الطلّاب في بيروت. كان التحدّي أنّني أردت للنشاط أن يكون قريبًا من تجربة كلّ طالب بشكل شخصيّ، لا مجرّد نشاط موحّد. استخدمت أداة الذكاء الاصطناعيّ، وصغت لها التوجيه التالي: "اصنع لي نشاطًا رياضيًّا يشرح مفهوم السرعة، باستخدام بيانات تتعلّق بوسائل النقل المختلفة التي يستخدمها الطلّاب للوصول إلى المدرسة: سيّارة، درّاجة، مشي، حافلة مدرسيّة. أريد أن يحصل كلّ طالب على سيناريو يناسب وسيلته الشخصيّة". خلال دقائق، حصلت على أربعة سيناريوهات مختلفة، كلّ واحد منها يبدأ بسرد قصير: "تأخّر كريم عن المدرسة. هو يركب الحافلة يوميًّا، والمسافة من منزله إلى المدرسة 6 كم. إذا كانت سرعة الحافلة 30 كم/ساعة، كم دقيقة يحتاج للوصول؟". وهكذا لبقيّة الوسائل.
لم يكن الناتج مجرّد تمارين حسابيّة، بل نشاطًا شخصيًّا يشعر فيه الطالب أنّ المسألة تخصّه. هذا النوع من التفريق ما كان ليتمّ بهذه السهولة من دون الذكاء الاصطناعيّ. ففي السابق، كنت سأحتاج إلى وقت أطول لتحضير سيناريو واحد فقط، أمّا الآن فأصبحت أستطيع تكييف التعلّم بشكل فوريّ وفعّال، ما يزيد من شعور الطالب بالانتماء إلى ما يتعلّمه.
الذكاء معدوم بلا توجيه!
ما تعلّمته أنّ الذكاء الاصطناعيّ لا يعمل وحده، بل يحتاج إلى مهارة تربويّة دقيقة تُعرف بـ "فنّ التوجيه" (Prompt Engineering). نحن لا نكتب جملة عشوائيّة وننتظر النتيجة، بل نحدّد بدقّة ما نريده: الفئة العمريّة والسياق والنبرة ونوع المفردات، وحتّى طبيعة النشاط المأمول من النصّ الناتج.
أصبحت هذه المهارة بالنسبة إليّ أداة تخطيط يوميّ، بل أكثر من ذلك. تمامًا وكما أراجع الأهداف التعليميّة قبل كلّ حصّة، أصبحت أراجع "أهداف الـ prompt" قبل كلّ تفاعل مع الأداة. أتساءل: ما الرسالة التي أريد أن تصل الطالب؟ كيف أريد أن يشعر أثناء قراءته هذا النصّ؟ ما المفهوم الذي أريد أن يكون واضحًا لديه؟ وعندها فقط أبدأ بصياغة التوجيه.
في مرّات كثيرة، أحتاج إلى تعديل الـ prompt أكثر من مرّة، بل أحيانًا أعود لتجزئته إلى خطوات صغيرة، حتّى أحصل على نتيجة دقيقة وقابلة للاستخدام. هذه الممارسة جعلتني أدرك أنّ الذكاء الاصطناعيّ لا يختصر الجهد تمامًا، بل ينقل الجهد من مرحلة الإنتاج اليدويّ إلى مرحلة التصميم الذكيّ. وفي كثير من الأحيان، أجد نفسي أتعامل مع ناتج الذكاء الاصطناعيّ كما أتعامل مع مسوّدة أو مسرحيّة أوّليّة: أضيف وأحذف وأعدّل، حتّى أصل إلى نسخة توافق النتيجة التي أريدها.
التوجيه الجيّد للأداة يشبه طرح السؤال المناسب في الصفّ: قد يغيّر مسار التفكير بالكامل. ومن هنا، أرى أنّ تدريب المعلّمين على التوجيه الفعّال ينبغي أن يُصبح جزءًا من تدريبهم التربويّ العامّ، تمامًا كما نتعلّم كتابة الأهداف وصياغة الأسئلة الصفّيّة.
شيئًا فشيئًا، أصبحت أفضل في مهارة التوجيه، ليس فقط بالتجربة، بل بدراسة متخصّصة لهذه المهارة في السياق التربويّ. تابعت عدّة دورات تدريبيّة، وحصلت على شهادات في استخدام الذكاء الاصطناعيّ في التعليم، وتحديدًا في فنّ التوجيه للمعلّمين. كلّ شهادة كانت تؤكّد لي شيئًا واحدًا: أنّنا لم نعد بحاجة إلى تدريب المعلّمين على استخدام التكنولوجيا من الناحية التقنيّة وحسب، بل على كيفيّة التفكير من خلالها، والتفاعل معها بصفتها شريكًا تربويًّا في التخطيط، لا مجرّد أداة تنفيذ.
بات واضحًا لي أنّ التوجيه في الذكاء الاصطناعيّ امتداد للتخطيط التربويّ نفسه. أصبح من الضروريّ أن نُعيد تصميم تدريباتنا المهنيّة لتشمل مهارات الصياغة الذكيّة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعيّ في إعداد الدروس، وتصميم الأنشطة، وتوليد موارد تعليميّة تراعي السياق والمستوى والهدف. نحن لسنا بصدد استبدال الكتاب، بل بصدد إعادة تعريف "المحتوى المدرسيّ". ولسنا في صراع مع التكنولوجيا، بل في حاجة إلى امتلاكها وتوجيهها بما يخدم طلّابنا، لا أن نُستخدم نحن وسطاء لها من دون وعي.
***
في بيئة تعليميّة مليئة بالتحدّيات – من قلّة الموارد، إلى الضغوط الإداريّة، إلى تفاوت مستويات الطلّاب – يمكن للذكاء الاصطناعيّ أن يمنح المعلّم تلك المساحة التي افتقدها طويلًا: مساحة للتفكير والتأمّل وإعادة النظر في ما ندرّسه، ولماذا.
وفي وقت باتت فيه الميزانيّات ضئيلة والخيارات محدودة، يصبح ذكاؤنا في استخدام هذه الأدوات المورد الحقيقيّ.
إذا كانت لدينا أداة قادرة على توفير الوقت وتحرير الطاقة الإبداعيّة، فلمَ لا نستخدمها؟ شرط أن نستخدمها بحذر، وبنيّة تربويّة واضحة، ووعي حقيقيّ بأنّ التكنولوجيا مهما بلغت من تطوّر، لن تعوّض قلب المعلّم، ولن تفهم واقع الطالب إلّا من عينيّ معلّمه.
المراجع
- - Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice (2nd ed.). Teachers College Press.
- - Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. (2nd ed.). ASCD.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025