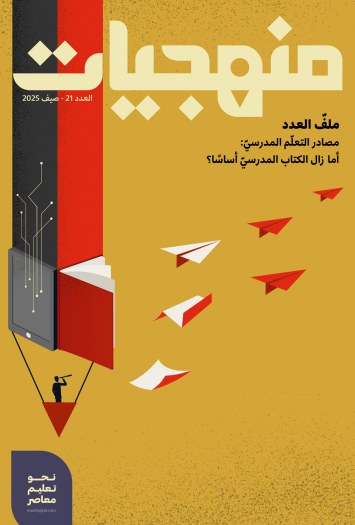لا شكّ أنّ عمليّة التعليم تقتضي تخطيطًا وتدبيرًا لما سيُقدَّم إلى المتعلّم/ة من أنشطة تعليميّة تعلّميّة، مع مراعاة خصوصيّاته النمائيّة والعقليّة والمعرفيّة، وتمثّلاته ومكتسباته. بما يستدعي اختيار أنشطة ملائمة تتناسب وما يُراد تحقيقه من تعلّمات.
كلّ معلّمة أو معلّم يضع تصوّرًا نظريًّا استشرافيًّا لما سيخطّطه من تعلّمات. يختار فيه مراحل إنجازها، والوسائل المقترحة، والأنشطة (المضامين والمحتويات). إضافة إلى صيغ العمل، وكذلك تقويمها لاكتشاف مصادر الخلل، لينتهي بالدعم والمعالجة. بعد عمليّة التخطيط، تأتي عمليّة التدبير التي تعتبر مرحلة التنفيذ والإنجاز لما خُطّط له. كلّ هذه العمليّات ممنهجة وفق برامج مُسطّرة سلفًا، فيبقى للمعلّم/ة الدور الأساسيّ في تطبيقها وتقديمها، وفق كتب مدرسيّة تُعتبر مُعينات أو وسائل تعليميّة. فعادة ما يُلتزَم بمحتوى الكتب المدرسيّة من وثائق وصور ونصوص وتمارين.
تحدّثنا في الأسطر الأولى عن خصوصيّات المتعلّمين والمتعلّمات وتمثّلاتهم وخصائصهم، فهل تتناسب الأنشطة المقترحة في الكتب المدرسيّة مع هذه الخصوصيّات؟ وهل المعلّم/ة ملزمٌ/ة بالتقيّد بها؟
يمكن تعريف الكتاب المدرسيّ بأنّه مورد تعليميّ يُستخدم من طرف المعلّم/ة أو المتعلّم/ة، يحتوي على المحتوى المقرّر بطريقة منظّمة وموجّهة. مُؤلّف من طرف خُبراء أو متخصّصين حسب المادّة/ التخصّص. ويأخذ بعين الاعتبار الأهداف التعلّميّة والمستوى المعرفيّ للمتعلّم/ة. ويُعرف أيضًا الكتاب المدرسيّ بأنّه وسيلة بيداغوجيّة موجّهة للأستاذ والتلميذ معًا، لبلوغ أهداف محدّدة وفق البرامج المُسطّرة وغاياتها، وما يتوافق مع فلسفة المجتمع.
يُراعى في تأليف الكتب المدرسيّة كلّ من الحقائق والمعلومات المنظّمة والمختارة بأساس ودقّة علميّين، وكذلك الدعامات المُصاحبة للكتاب من صور وخرائط ورسوم وإحصائيّات ووثائق، من ناحية وضوحها وحداثتها ودقّتها وأنماطها وإثارتها للمتعلّم/ة. كما تُؤخذ بعين الاعتبار النظريّات والمقاربات.
للمعلّم/ة الحريّة في اختيار الوسائل التعليميّة شريطة توافقها مع خصوصيّات الطالب النمائيّة والعقليّة، سلوكه وردود فعله وذكاءاته المتعدّدة. وكذلك وضوحها وإثارتها للمتعلّم/ة. فيمكن القول إنّ الكتاب المدرسيّ ليس إلّا مرجعًا من المراجع التي تحتوي على معلومات منتقاة تواكب المقرّر. فنستطيع بذلك التصرّف في محتويات الكتاب المدرسيّ من صور ووثائق ونصوص؛ فهو لا يضمن فرص فهم واستيعاب الكثير من الظواهر والمواضيع، لا سيّما الغريبة عن محيط المتعلّم/ة.
من الضروريّ الاستعانّة بوسائل تعليميّة مُختارة وفق تخطيط مُسبق. تنصبّ غايتها في تنمية مهارات المتعلّم وبناء معارفه وقيمه. اختيار هذه الوسائل يعتمد على فاعليّتها في نقل المعارف. وذلك يتمّ بشكل تعاقديّ بين المتعلّم/ة والمعلّم/ة حتّى لا يتشكّل عائق أو عدم فهم أثناء بناء المعرفة. تفيد أيضًا الوسائل في الكشف عن تمثّلاث المتعلّم/ة، واستحضار محيطه وتمثيله، فتُبسّط المفهوم وتخرجه من الإطار التجريديّ، وتساعد أيضًا على التخيّل والإبداع والإنتاج، والتطبيق عبر الأعمال اليدويّة.
ولا ننسى جانبًا أساسيًّا في حياتنا، ألا وهو التكنولوجيا الحديثة. فهذه الأخيرة تؤدّي دورًا مهمًّا في تقريب الواقع لدى المتعلّم/ة وتنمية الجانب الحسّيّ الخاصّ به، ومهارات أخرى كالمحاكاة والتفاعل. فهو يرى ويفهم ويحاكي أو يقلّد. الأمر الذي لا يسمح به الكتاب المدرسيّ، خصوصًا بصوره الجامدة ونحن في ظلّ العمل اليوميّ بالوسائل الحديثة. كما إنّ الاستعمال السليم لهذه الوسائل سيمكّن من إرساء ثقافة رقميّة سليمة داخل الفصول، وتواصل فعّال. بالإضافة إلى ذلك، فالوسائل الحديثة تساعد على العمل بصيغ متنوّعة وبمجهود أقلّ. كما إنّها مصدر من مصادر المعلومة، ولا ننسى جانب التعلّم الذاتيّ الذي أصبح متاحًا من خلال التكنولوجيا الحديثة باعتبارها وسيلة ناجحة تمكّن المتعلّم/ة من بناء المعرفة، من دون معلّم/ة في أيّ وقت، وفي أيّ مكان يرغب فيه.
جوابًا عن السؤال المطروح مسبقًا، فالمعلّم/ة غير ملزم/ة باعتماد الكتاب المدرسيّ وسيلةً داخل الفصل، بل يمكنه اختيار وسائل أخرى، شريطة أنّ تكون هذه الوسائل مخطّطًا لها مسبقًا، تحقّق الهدف التعلّميّ، وتحفّز المتعلّم/ة وتجعله مقبلًا على التعلّم.