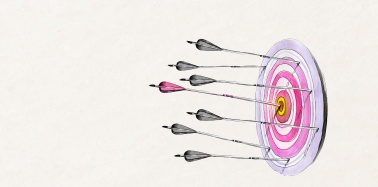كان ذلك في حصّة للتعبير الشفهيّ، حين طرحت سؤالًا بسيطًا على طلّاب الصفّ السادس: "ما رأيكم في قصّة اليوم؟". ساد صمت ثقيل. ثلاثون زوجًا من العيون تحدّق في الفراغ، أو في الأرض، أو في أيّ مكان عدا عينيّ. انتظرت. مرّت دقيقة كاملة - وأنا أعدّ الثواني - من دون أن ترتفع يد واحدة. لم يكن هذا صمت التفكير العميق، بل صمت الخوف من الخطأ؛ صمت الاعتقاد بأنّ الإجابة الصحيحة واحدة فقط، وهي التي في ذهن المعلّم، صمت من اعتاد على أن يُقيَّم لا أن يُسمع، أن يُحكم عليه لا أن يُحاور.
في تلك اللحظة، أدركت أنّ المشكلة ليست في السؤال ولا في القصّة، بل في شيء أعمق: في طبيعة العلاقة بيني وبين طلّابي، وفي ثقافة صفّيّة بُنيت على الخوف من العقاب، بدلًا من الرغبة في المشاركة. منذ أن كنت طالبًا، أذكر كيف كان المعلّمون يشتكون من "سلبيّة" الطلّاب و"عدم تفاعلهم". واليوم، بعد أن أصبحت معلّمًا، أجد نفسي أحيانًا أردّد الشكوى نفسها. لكنّ السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل الطلّاب سلبيّون بطبيعتهم، أم أنّ هناك شيئًا في ممارساتنا التربويّة يدفعهم إلى هذه السلبيّة؟
بناء العلاقات الإيجابيّة: من سلطة المعرفة إلى معرفة الإنسان
في السنة الأولى من عملي، كنت أعرف عن طلّابي أسماءهم ودرجاتهم فقط. كنت أصنّفهم: متفوّق، متوسّط، ضعيف، مشاغب، هادئ. تصنيفات جاهزة تختزل إنسانًا كاملًا في كلمة واحدة. ثمّ حدث موقف غيّر نظرتي. كان هناك طالب - لنسمّه ياسين - دائم الشرود، نادرًا ما يؤدّي واجباته. صنّفته في خانة "الكسالى". في أحد الأيّام، جاءني زميل وقال: "هل تعلم أنّ ياسين يعمل كلّ مساء في ورشة والده حتّى منتصف الليل؟". صُدمت. كيف أحكم على طالب من دون أن أعرف ظروفه؟ كيف أطالبه بالتركيز وهو منهك؟ كيف ألومه على عدم أداء الواجبات، وهو بالكاد يجد وقتًا للنوم؟
دفعني هذا الموقف إلى التساؤل: هل يمكن أن نعلّم من لا نعرف؟ في كتابه "Pedagogy of the Oppressed"، يتحدّث باولو فريري (1970) عن "التعليم البنكيّ" الذي ينظر إلى الطلّاب باعتبارهم أوعية فارغة، يملؤها المعلّم بالمعرفة. هذا النموذج، رغم قدمه النظريّ، ما يزال حيًّا في ممارساتنا اليوميّة. فنحن نتحدّث على التعلّم النشط والتفكير النقديّ، لكنّنا في الواقع نكافئ الطاعة والحفظ، ونعاقب السؤال والاختلاف.
قرّرت تغيير مقاربتي. بدلًا من البدء بــ "افتحوا الكتاب على الصفحة،" بدأت أخصّص الدقائق الأولى من كلّ حصّة للحديث إلى الطلّاب. ليس حديثًا عشوائيًّا، بل محادثات هادفة أسعى من خلالها لمعرفتهم على المستوى الشخصيّ. بدأت بأسئلة بسيطة: "كيف كان يومكم؟"، ثمّ تطوّرت إلى: "ما الذي يسعدكم؟ ما الذي يقلقكم؟ ما أحلامكم؟" في البداية، كانت الإجابات مقتضبة: "الحمد للّه"، "عادي"، "لا شيء". لكن مع الوقت والإصرار، بدأت الجدران تتصدّع.
على مدار ثلاثة أشهر من هذه الممارسة، اكتشفت عوالم مذهلة: سلمى التي تبدو "بطيئة الفهم"، تعاني ضعف سمع لم يُشخّص، وعمر "المشاغب" يتحمّل مسؤوليّة إخوته الصغار بعد وفاة والدته، أمّا مريم "الصامتة"، فتكتب شعرًا جميلًا لكنّها تخاف السخرية. كلّ اكتشاف كان يعيد تشكيل فهمي لمعنى التعليم. لم أعد أُدرِّس "مادّة دراسيّة" لــ "طلّاب"، بل أشارك رحلة تعلّم مع بشر لديهم قصصهم وأحلامهم ومخاوفهم وإمكاناتهم.
طوّرت ما أسمّيه "بطاقة الهويّة الإنسانيّة" لكلّ طالب. ليست بطاقة رسميّة، بل مساحة في دفتري أدوّن فيها اهتمامات كلّ واحد منهم، وهواياته ونقاط قوّته (ليس فقط الأكاديميّة)، والتحدّيات التي يواجهها، وأحلامه وطموحاته، وملاحظات عن أسلوب تعلّمه المفضّل. هذه المعلومات غيّرت طريقة تعاملي مع كلّ طالب. مثلًا، عندما علمت أنّ أحمد يحلم بأن يصبح ميكانيكيًّا، بدأت أستخدم أمثلة من عالم السيارات في دروس الرياضيّات. النتيجة؟ أحمد الذي كان يكره الرياضيّات، أصبح من أكثر الطلّاب حماسًا.
التعزيز الإيجابيّ: من ثقافة العقاب إلى ثقافة التقدير
في تراثنا التربويّ مقولة شهيرة: "العصا لمن عصى". نشأنا في بيئة تربويّة ترى في العقاب وسيلة التربية الأساسيّة. حتّى عندما نحاول تطبيق التعزيز الإيجابيّ، نفعل ذلك بشكل سطحيّ: نقطة هنا، "أحسنت" هناك، من دون فهم عميق لفلسفة التعزيز. السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل نريد طلّابًا يفعلون الصواب خوفًا من العقاب، أم طلّابًا يفعلون الصواب لأنّهم يؤمنون به؟
عندما نعود إلى نظريّة التعزيز عند سكينر (كما ورد في الحربي، 2018)، نجد أنّ معظمنا يطبّقها بشكل خاطئ. نحن نعزّز النتائج (الدرجة الكاملة) ونتجاهل العمليّة (المحاولة والتحسّن والجهد). توضّح كارول دويك (2006) في أبحاثها عن "عقليّة النموّ"، أنّ التعزيز يجب أن يركّز على الجهد والاستراتيجيّة والتحسّن والمثابرة، وليس فقط على النتيجة النهائيّة.
قرّرت تغيير طريقة تعزيزي للطلّاب. بدلًا من التعزيز العامّ ("أحسنت"، "ممتاز")، بدأت أستخدم التعزيز الوصفيّ المحدّد. فبدلًا من "أحسنت يا سعيد"، أقول: "لاحظت يا سعيد أنّك استخدمت ثلاث طرق مختلفة لحلّ المسألة، حتّى وصلت إلى الإجابة. هذا يدلّ على تفكير مرن". وبدلًا من "إجابة خطأ"، أقول: "محاولة جيّدة. أعجبني أنّك فكّرت في المسألة بطريقة مختلفة. دعنا نرى أين يمكن تعديل الطريقة".
استعرت من ستيفن كوفي (1989) مفهوم "البنك العاطفيّ"، وطبّقته في الصفّ. الفكرة: كلّ تفاعل إيجابيّ بمثابة "إيداع" في رصيد العلاقة، وكلّ تفاعل سلبيّ "سحب". وضعت قاعدة لنفسي: 5 إيداعات مقابل كلّ سحب. أيّ إنّ كلّ ملاحظة تصحيحيّة، يجب أن تسبقها أو تتبعها 5 ملاحظات إيجابيّة.
الموقف الذي غيّر قناعاتي تمامًا، حدث عندما أسقط طالب زميله في الصفّ أثناء اللعب. الطريقة التقليديّة ستكون: عقابًا، واستدعاء وليّ الأمر. لكنّني جمعت الصفّ وسألت: "ما الذي حدث؟" اعترف الطالب فورًا (نتيجة الثقة المبنيّة مسبقًا). سألت الصفّ: "كيف نحلّ هذه المشكلة؟" اقترح الطلّاب: وضع قوانين للعب. النتيجة؟ لم تتكرّر الحادثة، والطالب أصبح الأكثر حرصًا على سلامة زملائه في الصفّ.
بعد سنة من تطبيق هذه المقاربة، عدت إلى السؤال نفسه: "ما رأيكم في قصّة اليوم؟" هذه المرّة ارتفعت عشرون يدًا. سمعت آراء متنوّعة، بعضها أدهشني بعمقه. حتّى من اختار الصمت، كان صمت تفكير لا صمت خوف. ربّما لم أغيّر نظام التعليم، لكنّني غيّرت صفّي؛ حوّلته من مكان يُلقَّن فيه الطلّاب، إلى مساحة يتعلّمون فيها، من فضاء يُحكم فيه عليهم، إلى مجتمع يُحتفى فيه بهم.
إدارة الصفّ الفعّالة ليست مجموعة تقنيّات نطبّقها، بل فلسفة تربويّة نعيشها. عندما نبني علاقات حقيقيّة مع طلّابنا، عندما نراهم بشرًا كاملين، وليس مجرّد متلقّين للمعرفة، وعندما نعزّز الخير فيهم بدلًا من البحث عن الخطأ - عندها فقط نخلق بيئة يزدهر فيها التعلّم الحقيقيّ. السؤال الذي أتركه لكلّ معلّم: في نهاية العام الدراسيّ، ماذا تريد أن يتذكّر طلّابك؟ المعلومات التي حفظوها؟ أم الإنسان الذي آمن بهم؟ الإجابة على هذا السؤال قد تغيّر ممارستك التربويّة إلى الأبد.
المراجع
- الحربيّ، علي. (2018). دور قادة مدارس محافظة الليث في تنمية مهارات الإدارة الصفّيّة لدى المعلمين. دراسات عربيّة في التربية وعلم النفس، 100(297-325).
- Covey, S. R. (1989). The 7 habits of highly effective people. Free Press.
- Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025