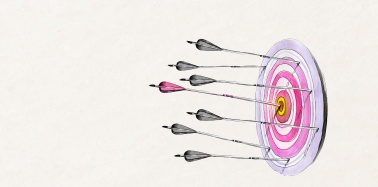حينما وصلتني رسالة بريديّة من منهجيّات حول دعوة إلى الكتابة عن "إدارة الصفّ اليوم: ممارسات ومشكلات ومفاهيم"، لفت انتباهي الحديث عن هذه القضيّة؛ إذ أحيت في ذهني فكرة لطالما شغلتني لسنوات: كيف يمكن للمعلّم أن يوازن بين فرض النظام وتحفيز الطلبة على التعلّم في الوقت نفسه؟ هذه التساؤلات رافقتني، لا سيّما أثناء عملي معلّمةً للموادّ العلميّة في المرحلة الأساسيّة، حيث كان تحقيق الانضباط داخل الصفّ يتطلّب جهدًا ووقتًا كبيرين، خصوصًا وأنّ غالبيّة طلّابي كانوا من الذكور.
على مدى سنوات، استمرّت محاولاتي للعثور على الطريقة الأنسب لتقليل المشتّتات، وجذب انتباه الطلّاب، وتحقيق الانضباط داخل الغرفة الصفّيّة، وقد استخدمت في ذلك العديد من الأساليب التربويّة التي أسهمت في تحسين سلوك الطلّاب، وزيادة تفاعلهم مع الأنشطة الصفّيّة، ورفع مستوى دافعيّتهم نحو التعلّم.
في هذه المقالة، سأتطرّق إلى بعض هذه الأساليب، بهدف تسليط الضوء عليها، ومشاركة تجربتي العمليّة مع المعلّمين والتربويّين المهتمّين بالموضوع.
دوافع التغيير وتحدّيات الواقع الصفّيّ
من الأمور التي دفعتني نحو التغيير في أساليب إدارة الصفّ، ضعف الدافعيّة لدى الطلّاب نحو التعلّم، وتدنّي مستوى تقييم الأداء، إلى جانب التشويش المتكرّر من بعض الطلبة أثناء الحصّة، وصعوبة اندماجهم في مجريات الدروس التقليديّة، ما شكّل عائقًا أمام تحقيق بيئة صفّيّة منتجة ومحفّزة.
وقد واجهت طوال رحلتي التعليميّة لتطوير أساليب تدريس داعمة للإدارة الصفّيّة الفعّالة جملة من العقبات، منها:
- - ضيق الغرف الصفّيّة مقارنة بعدد الطلّاب الذين تراوحت أعدادهم بين 25 و30 طالبًا، وهو ما كان يحدّ أحيانًا من إمكانيّة تطبيق أنشطة حركيّة.
- - ارتفاع نصاب الحصص الأسبوعيّ لمعلّمي المرحلة الأساسيّة، حيث بلغ نصاب حصصي 25 حصّة، الأمر الذي تسبّب في إرهاقي جسديًّا وضغطي نفسيًّا، خصوصًا في الأيّام التي لم تتخلّلها حصص فراغ، ما دفعني إلى إعداد الوسائل التعليميّة في المنزل خارج أوقات الدوام، والاستعانة بأولياء الأمور عن طريق الخطّة الأسبوعيّة أو وسائل التواصل الاجتماعيّ.
- - كثافة محتوى المنهاج، وضيق الوقت المخصّص لتنفيذه.
- - الحاجة إلى مجهود كبير في بداية تطبيق الاستراتيجيّات التعليميّة، حتّى يتقن الطلّاب قوانينها وآليّات تنفيذها.
- - ضعف البنية التحتيّة التقنيّة، وعدم توفّر الأجهزة الإلكترونيّة الكافية لدى الطلّاب أو أولياء الأمور لتفعيل التعليم المدمج أو الإلكترونيّ.
- - غياب الغرف التخصّصيّة في المدرسة، مثل المختبرات.
وفي المقابل، أسهمت عوامل عدّة في دعمي نحو تبنّي أساليب تدريس تدعم الإدارة الصفّيّة، من أبرزها:
- - القدرة على توظيف الأنشطة التعليميّة بمرونة، وفقًا للإمكانات والموارد المتوفّرة في البيئة المدرسيّة.
- - تعاون الإدارات المدرسيّة في توفير الوسائل التعليميّة اللازمة، ودعم تطبيق استراتيجيّات تدريس متنوّعة.
- - تنوّع مستويات الطلبة، ما شكّل دافعًا إلى اختيار استراتيجيّات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.
مع مرور الوقت، وتعاملي بشكل يوميّ مع طلبة المرحلة الأساسيّة الذين ينتمون إلى خلفيّات اجتماعيّة واقتصاديّة متوسّطة، بدأت تتّضح أمامي ملامح الحاجة المُلحّة إلى التغيير، ما دفعني إلى إعادة النظر في أساليب إدارتي للصفّ، والبحث عن بدائل أكثر فاعليّة. من هنا، بدأت رحلتي نحو تطوير أدواتي التربويّة، سواء بالانخراط في برامج التنمية المهنيّة، أو بناء شراكات مع أولياء الأمور، أو صياغة قوانين صفّيّة واضحة تدعم الانضباط الإيجابيّ.
برامج التنمية المهنيّة
من أهمّ العوامل التي أسهمت في تحسين الانضباط لدى طلّابي في الغرفة الصفّيّة، اعتمادي أساليب تدريس تفاعليّة متنوّعة، وضعت الطالب في مركز العمليّة التعليميّة. أتذكّر جيّدًا تلك المرحلة التي كنت أبذل فيها مجهودًا كبيرًا في الشرح، من دون أن أحقّق المخرجات المرجوّة. لكن، مع التحاقي ببرنامج "دبلوم التأهيل التربويّ"، بدأت الأفكار التربويّة تتدفّق، وتشكّل تحوّلًا حقيقيًّا في مسيرتي التعليميّة. تعلّمت كيف أُفعّل أساليب تدريس تجعل الطالب عنصرًا فاعلًا: يعمل ضمن مجموعات، ويطرح الأسئلة، ويلاحظ ويدوّن ويعبّر عن ملاحظاته، فيصبح منخرطًا في التعلّم من دون ملل.
لاحقًا، أسهم برنامج ماجستير التربية في تطوير قدرتي على تشخيص المشكلات الصفّيّة، وتنفيذ مبادرات تربويّة تسهم في معالجتها، ما مكّنني من رؤية مساحات جديدة للتطوير لم تكن واضحة لي سابقًا.
كما أتاح لي الانخراط في برامج تدريبيّة متعدّدة، فرصة التعرّف إلى تجارب تربويّة ثريّة أغنت مسيرتي المهنيّة، وأكّدت لديّ قناعة راسخة بأهمّيّة التدريب المستمرّ، سواء كان رسميًّا تنظّمه وزارة التربية والتعليم، أو غير رسميّ ضمن ورشات عمل تقدّمها منصّات تعليميّة متنوّعة. وقد أسهمت هذه البرامج في تعزيز قدراتي على إدارة الصفّ وضبطه بطرق أكثر فاعليّة، إذ تعرّفت من خلالها إلى استراتيجيّات تعليميّة حديثة، وأساليب التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة المختلفة، وطرائق لتعزيز السلوك الإيجابيّ، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين البيئة الصفّيّة، وزيادة انخراط الطلبة في الأنشطة التعليميّة.
التواصل الفعّال مع أولياء الأمور
أثناء سنوات عملي في التعليم، أدركت أنّ التواصل مع أولياء الأمور يمنح المعلّم مزايا عديدة، منها استمرار الدعم الأكاديميّ، وتحسين الأداء السلوكيّ، والتعاون في حلّ المشكلات التي تواجه الطلبة. وتبرز أهمّيّة هذا التواصل بشكل خاصّ مع الطلبة الذين يعانون صعوبات أكاديميّة أو سلوكيّة، إذ يصبح التعاون مع وليّ الأمر ضرورة لإيجاد حلول فعّالة ومتابعة مستمرّة.
كما لا يمكن إغفال الدور الحيويّ لوليّ الأمر في دعم الطلبة المتقدّمين دراسيًّا، إذ يمكن تشجيعهم والمشاركة معهم في الأنشطة المتقدّمة على مستوى المدرسة أو المديريّة، أو حتّى وزارة التربية والتعليم، ما يعزّز من نموّهم الأكاديميّ، ويحفّزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.
وفي هذا الإطار، ومع تطوّر التكنولوجيا وازدياد انتشار منصّات التواصل الاجتماعيّ، أصبح من السهل على المعلّم بناء جسور تواصل مستمرّة ومرنة مع أولياء الأمور. فهذه الوسائل الحديثة تتيح فرصًا متعدّدة للتفاعل الفوريّ والفعّال، ما يسهّل فهم التحدّيات التي يواجهها الطالب، ويساعد في توفير الدعم المناسب له في الوقت المناسب، وبالتالي تعزيز فرص نجاحه وتقدّمه داخل البيئة المدرسيّة.
الانطلاق من اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم
من الضروريّ أن يعمل المعلّم على توطيد علاقته بطلبته، ويتفهّم احتياجاتهم، ويوظّف استراتيجيّات تعلّم نشط تتناسب مع مرحلتهم العمريّة والمادّة الدراسيّة. كما ينبغي أن يراعي المعلّم التنوّع في أنماط التعلّم والذكاءات المتعدّدة، باستخدام وسائل بصريّة وسمعيّة، وفيديوهات تعليميّة، وألعاب حركيّة، وأنشطة ذهنيّة، لتشجيع التركيز والاندماج في التعلّم.
ومن المهمّ الانطلاق من المعرفة السابقة للطلبة، لأنّها تسهم في تحقيق انخراطهم في تعلّم بنائيّ ذي معنى، كما إنّ إشغالهم الدائم بمهمّات مناسبة لقدراتهم يرفع من إنتاجيّتهم، ويقلّل من تشتّتهم.
فعلى سبيل المثال، يمكن إعداد صندوق يحتوي على أسئلة إثرائيّة أو ألغاز أو أوراق عمل مخصّصة للطلبة المتقدّمين، لتنفيذها بعد الانتهاء من المهامّ الأساسيّة. كما يمكن في الوقت الحاليّ الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعيّ، مثل ChatGPT أو MagicSchool لتوليد أسئلة تفكيريّة. وبالنسبة إلى الطلبة ذوي التحصيل المتدنّي، يمكن تزويدهم بمصادر تعلّم إضافيّة ملائمة لحاجاتهم، مع متابعة فرديّة، نظرًا إلى أنّ أسباب عدم الانضباط قد تعود إلى ضعف التركيز، أو غياب الدافعيّة، أو وجود مشكلة اجتماعيّة غير محلولة.
وجود قوانين صفّيّة
من خبرتي في تعليم الصفوف الأساسيّة، وجدت أنّه من الضروريّ وضع اتّفاق صفّيّ في بداية العام، يُشارك فيه الطلبة بوضع القوانين التي تنظّم حياتهم الصفّيّة، إلى جانب تحديد العقوبات المناسبة لكلّ خرق.
تُعرَض هذه القوانين بشكل واضح داخل الغرفة الصفّيّة، ويُعاد تذكير الطلبة بها باستمرار. وعند خرق أحد القوانين، يُشار إلى اللوحة، ويُطلب من الطالب اختيار العقوبة المناسبة، مثل إزالة نجمة، أو الحرمان من نشاط معيّن. هذه المشاركة في صناعة القواعد تعزّز الشعور بالمسؤوليّة لدى الطلبة، وتقلّل من السلوكيّات غير المرغوبة.
أساليب التعزيز والعقاب
في ظلّ الانفتاح التربويّ والتواصل المهنيّ بين المعلّمين، أصبحت مشاركة الخبرات أداة مهمّة في تطوير الممارسات الصفّيّة. وقد استفدت كثيرًا من تجارب الزملاء، ومن أبرز ما طبّقته:
- - بطاقات الإنجاز لتكريم التميّز الأكاديميّ أو السلوكيّ.
- - لوحات النجوم التي تُعلّق في الصفّ، لتحفيز الطلبة على الاستمرار في الأداء الجيّد.
- - جوائز أو هدايا رمزيّة تحفّز الطالب على الاستمرار، وتحفّز غيره على تحسين الأداء.
- - امتيازات بسيطة، مثل اختيار مكان الجلوس أو قيادة نشاط صفّيّ.
- - بطاقات التميّز على مستوى المدرسة، لتكون بمثابة تشجيع للطلبة، ووسيلة للاعتراف بتحسّن أدائهم.
أمّا العقاب، فقد كنت حريصة على أن يكون بنّاءً وتربويًّا، ومفهومًا للطلبة في سياق واضح، وقد التزمت بجملة من المبادئ:
- - الوضوح والاتّساق في تحديد القوانين الصفّيّة منذ بداية العام، بالشراكة مع الطلبة.
- - التركيز على السلوك وليس الشخص، بما يحفظ كرامة الطالب.
- - التدرّج في الردّ على المخالفة، بدءًا من التنبيه، ثمّ الحرمان من الامتياز، وصولًا إلى إشراك وليّ الأمر عند الحاجة.
- - خيارات العقوبة، بحيث يشارك الطالب في اختيار ما يراه مناسبًا ضمن خيارات تربويّة مسبقة.
- - العقاب الإصلاحيّ، كأن يعتذر الطالب كتابةً، أو يشارك في نشاط لإصلاح أثر سلوكه.
- - تجنّب العقوبات المهينة أو الجماعيّة، لأنّها تضرّ بالعلاقة التربويّة وتولّد مقاومة.
لقد وجدت أنّ العقاب حين يكون بنّاءً، ومسبوقًا بعلاقة احترام وثقة، يمكن أن يكون أداة فعّالة لضبط السلوك وتوجيهه نحو الأفضل، من دون أن يترك أثرًا نفسيًّا سلبيًّا.
***
إنّ ضبط الصفّ ليس إجراءً آنيًّا أو مهمّة سلوكيّة فحسب، بل منظومة متكاملة تستند إلى فهم عميق لاحتياجات الطلبة، وبناء علاقة إيجابيّة معهم، وتوظيف استراتيجيّات تعليميّة فعّالة، وتعزيز بيئة صفّيّة آمنة ومحفّزة. لقد علّمتني تجربتي أنّ الانضباط لا يتحقّق بالصرامة وحدها، بل يتجسّد حين يشعر الطالب أنّ له دورًا وصوتًا وقيمة داخل الغرفة الصفّيّة.
كلّما طوّر المعلّم أدواته التربويّة، وانخرط في برامج تنمية مهنيّة مستمرّة، وتواصل مع أولياء أمور الطلبة، وراعى الفروق الفرديّة بينهم، أصبح أكثر قدرة على خلق بيئة تعليميّة جاذبة، يكون فيها التعلّم ممتعًا، والانضباط سلوكًا نابعًا من الداخل، لا مفروضًا من الخارج.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025