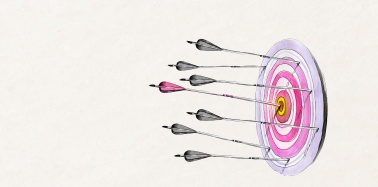لو أنّنا نفترض جدلًا غياب التربية والتعليم عن مجتمعاتنا الحديثة، فسيُعدّ ذلك انتكاسة لإنسانيّتها، ويستحيل على الفرد أن يصير إنسانًا ضمنها إلّا بالتربية، فهو "الوحيد الذي تجب تربيته. ونقصد فعلًا بالتربية: الرعاية والانضباط والتعليم المقترن بالتكوين" (كانط، 2002). وهو كذلك صنيعتها وأثرها، إذ تتسلّمه مؤسّساتها مادّة خامًا، لتُشكّل منه بالتعلّم والانضباط والثقافة كائنًا واعيًا وعاملًا بما تشرّبه. فمن لم تخترقه التربية يظلّ فظًّا، ومن لم يُليّنه الانضباط والالتزام يبقَى أقرب للتوحّش.
1. في تلازم التربية والضبط
من رحم المؤسّسة ومن أتون فصولها، تنشأ المعرفة وتتشكّل الثقافة وتترسّخ القيم ويسود الانضباط وتولد الحرّيّة في مهج روّادها. لكنّ مسالك العناية بها (الحرّيّة لدى الأطفال) تنشئةً وتنميةً، صعبة ومتشعّبة، إذ كيف لنا أن نشرع في زرع بذرة المعرفة والتحرّر في عقول أطفالنا، بمنسوب كبير من الفرض والتسلّط والإخضاع؟
وقد أشار إيمانويل كانط إلى هذا الأمر، مبيّنًا هذه المفارقة التي تسكن عقل "التربية الحديثة" بين التحرّر بوصفه غاية، والضبط والسيطرة بوصفهما أسلوب عمل ميدانيّ. وهو لا يرى في هذه المفارقة تناقضًا داخليًّا، يهدّد أنواريّة التعليم وقدرته على إحداث التغيير، إذ تعتبر المدرسة بالنسبة إليه فضاء للتحرّر، وأداة للتقدّم وبناء المستقبل. بل هي ضاغطة تفرضها طبيعة التعلّم لدى الأطفال، وحاجتهم إلى من يساعدهم في هضم تجربة الحرّيّة بجرعات محدّدة، تتناسب وقدراتهم الذهنيّة والعاطفيّة.
ووفق هذه الموازنة الكانطيّة، فإنّ العمليّة التربويّة، بما هي فنّ صقل مهارات الأطفال الذهنيّة والعاطفيّة والاجتماعيّة والجسديّة وتنميتها، ليكونوا مواطنين أحرارًا، تستدعي انطلاقة يحكمها التوجيه والضبط والرقابة، خشية حرّيّة منفلتة، بلوغًا إلى نهاية تطفو فيها حرّيّة متعقّلة، تتجلّى بمقتضاها الذوات المتشبّعة بفضيلتي الحقّ والواجب.
ولعلّ ذلك قدر التربية وقدر المدرّس في النهاية، لأنّه هو الذي سيعيش هذه المفارقة توتّرًا معرفيًّا في ذهنه، وعسرًا عمليّاتيًّا في ممارساته البيداغوجيّة داخل الفصل. فحاله – إن جازت الاستعارة – مثل حال مدرّب الأفاعي (العيساوي) الذي يُدير وضعًا من الـ"لا متوقّع" والـ"لا يقين"؛ فقد يُلدغ لدغة موت، وهو يتفنّن في ملاعبة كائناته لاقتلاع إعجاب جمهوره، معتقدًا بخضوعها له! لكن، لسائل أن يسأل: ما وجه الشبه هنا بين كائناته وبين الأطفال؟ إنّه في الخروج عن سكّة التربية بوصفها فعل ترويض وإخضاع قصديّ، والنكوص إلى حالة طبيعة أولى، بما فيها من منسوب توحّش ورفض طاعة.
ويكون لحظتها المعلّم في مفترق طرق: بين أن يكون مرافقًا وصديقًا لأطفاله (مُنشّطًا) من جهة، أو آمرًا ومراقبًا لهم (مُلقّنًا) من جهة أخرى. وبين الوضع الأوّل والثاني سيكون – مثل حامل جمر بين كفّيه – حريصًا على ألّا تنفلت طفولة عفويّة من بين يديه، وهو يُشكّلها بفائض من ليونة ومرح، وألّا تتصلّب وتجفّ عيونها بجرعات قويّة من فرض وتشديد.
ذلك هو وجه الشبه بين "العيساوي" و"المعلّم"، في ما يعرضانه من فنون تدريب وتحكّم بميزان، حتّى لا تهيج زواحف أو تتمرّد طفولة، فيُقضى على الأوّل بسمّ زعاف، وعلى الثاني بعدم أهليّة في تربية أجيال. .
2. على أيّ وجه يمكننا أن نفهم "ضبط الصفّ" التربويّ؟
حين نتأوّل مفهوم "ضبط الصفّ"، فإنّنا نراه ترجمانًا لإرادة التربية وسلطان الاجتماع البشريّ، في رغبتهما الملحّة في إنتاج نموذج من البشر، يضمن استمراريّة القيم والقواعد الاجتماعيّة السائدة حفاظًا على الوحدة والتلاحم. وبالرغم من بداهة هذا التصوّر الذي يظهر جليًّا في موقف الاتّجاه الوظيفيّ، فإنّ أوضاع هذا المفهوم لم تبقَ على صيغها الأولى، مثل التي عند كانط وكوندورسيه وجول فيري ودوركايم، بل أصبح أمرها أكثر تعقيدًا مع تغيّر أنماط الحياة وأساليبها، وبروز عناصر موضوعيّة من خارج محيط المدرسة، تؤثّر في مسار الضبط والتوجيه والتربية المعتمدة.
فالتغييرات الاجتماعيّة والثقافيّة الحاصلة، واكتساح "الفردانيّة" للأسرة بوصفها أقدم تنظيم اجتماعيّ وسياسيّ في تاريخ الإنسان، أدّت إلى نتائج عميقة. فقد سيطرت "الفردانيّة" على الطفولة، وأغرقتها في ثقافة استهلاكيّة، وحوّلتها إلى كائن رغبويّ مدلّل، يصعب عليه العيش والتكيّف خارج ما برمجته له الآلة الاقتصاديّة المنتجة. وبات من الصعب العثور على "وحدة مفهوميّة وتنظيميّة" لعبارة "ضبط الصفّ المدرسيّ"، من جرّاء تهافت الحداثة وانتقالها من وضع الصلابة إلى وضع السيولة (زيغمونت باومان)، بما تعنيه هذه "السيولة من هشاشة وفردانيّة وتردّد، أساسه اللا يقين واللا وضوح في الوظائف والعلاقات والهويّات والقيم" إضافة إلى سلعنة كل شيء: تربيةً كانت، أو قيمًا أو فنونًا أو إبداعًا.
فما المعنى الذي يمكن أن نسكبه على مفهوم "ضبط الصفّ" اليوم؟ هل نحن الآن في حاجة إلى إبقائه ممارسة عموديّة قهريّة ومخيفة، كما أراد لها التلقين منذ أمد بعيد؟ أم أنّنا في حاجة إلى تحريك أثافيها وتجديد استراتيجيّات اشتغالها بولادة التربية النشيطة؟ هل من الممكن الانتقال من "ضبط الصفّ" إلى "إدارته"؟
في الحقيقة، تعكس هذه الأسئلة الإشكاليّة الراهنة – والتي لا نزعم تقديم إجابات شافية لها في هذا المقال، أكثر من إثارتها وجعلها موضوع تفكير – تعقّد المسألة التربويّة، ولا معقوليّة الادّعاء بالحكم القاطع في قضاياها وحيازة حقائقها الثابتة. "فالتربية أهمّ وأصعب مشكلة تطرح على الإنسان" (كانط، 2002)؛ فهي تؤرّقه في كلّ آن، لأنّ معضلاتها تتناسل، وفكرها يأبى الثبات والجمود، ويحرص على محايثة حركة التاريخ والاجتماع، ليتحوّل ويتجدّد في كلّ طور. وما مفهوم "ضبط الصفّ" إلّا مثالًا قادحًا على ذلك، إذ استمرّت العبارة منذ أمد، لكن تغيّرت مفاعيلها تبعًا لتغيّر أنماط التفكير وظروف العيش الإنسانيّ، حيث يصير الشديد ناعمًا، والصارم ليّنًا، والرقيب مرافقًا.
وحين تحرّر الفكر التربويّ المعاصر من قيود التلقين، واكتشف التعلّم النشيط والمقاربة بالكفاءة، ثمّ المقاربة بالمشروع، وتحوّل فيه التعليم من "حرفة" إلى "مهنة"، ارتجّت صفائح هذا المفهوم – التي ظلّت طويلًا تعبيرة سلطويّة عموديّة وعقابيّة، اختزلتها صورة المعلّم التقليديّ ذي السحنة الجادّة والملامح الزاجرة – وتشقّقت بنيتها الصلبة، وتسرّب داخلها هواء جديد يراهن على ذات المتعلّم، ويحرص على كسبها باللين أكثر من رهانه على سجنها بالشدّة.
وممّا سرّع في تجاوز التلقين والضبط والانخراط في خيار التربية النشيطة ذات الملمح الإنسانيّ الحديث، تشكّل التوجّه نحو "تمهين التعليم" الذي يُصرّ على مغادرة "حرفة" التدريس، بما فيها من ماضويّة، إلى "مهنة" التعليم بكلّ ما تتطلّبه من تأصيل نظريّ، وتنوّع ممارساتيّ، وانخراط في موجات تحديث الأفكار والطرائق البيداغوجيّة. إذ يُجمع الخبراء على أنّ تمهين التعليم يعتبر ضرورة أكيدة لإنجاح أيّ إصلاح تربويّ مقترح، وخصوصًا معايير اختيار المعلّمين، وهندسات تكوينهم، وأشكال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم، وإلّا يُعدّ إصلاحًا زائفًا لا يحقّق المنتظر منه.
وضمن هذا التوجّه التمهينيّ، سيتشكّل نموذج جديد لمدرّس يؤمن شديدًا بأهمّيّة تغيير نظرتنا إلى الطفولة، من جهة فكّ الحصار عليها من الرقابة الصارمة، والتعامل معها في محيط تنشيطيّ تفاعليّ سعيد، تنبسط فيه أسارير الأنفس، وتتفتّح فيه الأذهان وتبدع. فالتعلّم النشيط الذي يتبنّاه المعلّم "المهنيّ"، مسار حيويّ يرمي بالمتعلّمين في أتون الفعل والاكتشاف والنقاش وأخذ القرار وتصوّر الحلول. هو استغلال لطاقات الأطفال الحيويّة وإسماء لها (Sublimation)، واستخراج لأفكارهم ولتصوّراتهم وخططهم الذهنيّة إلى حيّز التطبيق، وتمكين لقدراتهم الذاتيّة الكامنة من الخروج تحت الضوء، وتجربة نفسها في أشكال تعبيريّة متنوّعة، حسّ حركيّة وذهنيّة ونفسيّة ووجدانيّة وفنّيّة، أو في شكل رؤى موضوعيّة أو إيديولوجيّة.
وشتّان هنا بين ضبط صفّ صلب – غايته حفظ النظام وإرساء هدوء قسريّ في القاعة، حتّى يتمكّن المعلّم من إلقاء درسه وتمرير معارفه بأسلوب تلقينيّ – وبين إدارة صفّيّة مرنة، وواعية بالاحتياجات الإنسانيّة التي يستحقّها المتعلّمون، في مراوحة بين الحاجة إلى تحقيق الذات، مرورًا بالحاجة للأمان والحاجة الاجتماعيّة والحاجة للتقدير (هرم ماسلو). فالروابط بين المعرفيّ والنفسيّ لا يمكن لعاقل أن يحيّدها، بسبب ترابط المحدّدات المعرفيّة والنفسيّة أثناء إنجاز الأنشطة الذهنيّة للمتعلّم.
وحين يدرك المدرّس علميًّا خصائص هذه المرحلة العمريّة، وما تتطلّبه من إحاطة وعناية، يتحوّل معه "ضبط الصفّ" من إجراء تقنيّ صلب، إلى إدارة مركّبة تعمل على خلق مناخ علائقيّ إيجابيّ داخل حجرة الصفّ (تكوين علاقات إيجابيّة بين المعلّم والمتعلّم من جهة، وبين المتعلّمين من جهة أخرى)، إذ يستدعي لذلك نمطًا آخر من المهارات الأفقيّة (Transversales)، أو المهارات الناعمة المتكئة على الذكاء العاطفيّ والاجتماعيّ، بحيث ينشط التواصل ويغتني بأخلاقيّات المودّة والقبول، لضمان التعامل الناجع في محيط العمل. فيستحيل بذلك الضبط من مجرّد هوس رقابيّ ينزعج من ضجيج الأطفال وحركاتهم، إلى وعي علميّ بما تتطلّبه الطفولة من مرونة في الفهم ومرافقة في الممارسة. وما يُلاحظ في التلقين خوفه من الحركة، وخشيته من النقاش والتفاعل داخل الفصل، معتقدًا في إعاقتها لحركة المعرفة من منبعها إلى متلقّيها.
***
لا شكّ في أنّ تصفية تركة "التلقين" من العقل التربويّ الجمعيّ تصفيةً واعية وعقلانيّة، ستساعدنا، نحن التربويّين، في وعي قيمة التربية النشيطة التي تنبعث فيها كيانات المتعلّمين، وتنتعش بمنسوب تفاعلها ومشاركاتها واختياراتها ومشاريعها التي تنجزها في الفصول والمدارس، في إطار إدارة مركّبة للصفّ تتجاوز فيها الضبط الرقابيّ الصلب إلى المهارة الناعمة.
المراجع
كانط، إ. (2002). ثلاثة نصوص: تأمّلات في التربية، ما هي الأنوار؟ ما التوجّه في التفكير؟ (ترجمة: بن جماعة، محمود). دار محمّد علي للنشر.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025