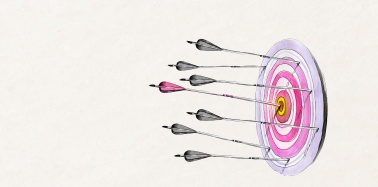المدرسة مؤسّسة تعمل على إكساب المتعلّمين الخبرات والمهارات الحياتيّة المختلفة، ووضعها موضع التطبيق. كما تولي المدرسة عناية خاصّة بالجانب التربويّ، وغرس مجموعة من القيم الراقية لدى المتعلّمين، فتعدّ فضاءً تربويًّا متكاملًا، يشكّل الصفّ الدراسيّ قلبها النابض الذي تتمّ فيه مختلف العمليّات التربويّة والتعليميّة، والتي تدور بين المتعلّم والمدرّس في نقل المعارف وبنائها. ويُعتبر الصفّ الدراسيّ أيضًا بيئة للتفاعل وفق ميثاق تعاقديّ صريح أو ضمنيّ، قصد تحقيق أهداف تربويّة تعليميّة معيّنة.
إدارة الصفّ بين ممارسة نمطيّة وممارسة تبصّريّة
تدبير الصفّ هو "كلّ شيء يشرف على تخطيط أوضاع التعليم والتعلّم وتنظيمها. علاوة على ذلك هو مجموعة الأفعال الإجرائيّة: التوضيح والتحكّم والتحفيز والاحترام التي يقوم المدرّس من خلالها بترتيب البيئة التعليميّة" (Nault & Fijalkow, 2002).
كما عرّف كلّ من Archambault وChouinard (1996) إدارة الصفّ على أنّها مجموع الممارسات التربويّة التي يلجأ إليها المدرّس، قصد إرساء جوّ إيجابيّ والحفاظ عليه، أو إعادة النظام بغاية نماء كفايات المتعلّمين.
الحديث عن إدارة الصفّ بوصفها كفاية يتملّكها كلّ مدرّس، يأتي بعد خطوة أوّليّة، ألا وهي كفاية التخطيط: من تخطيط لزمن التعلّمات والأهداف والمضامين والوسائل وصيغ العمل المراد العمل بها. فكلّ هذه العناصر تدخل أيضًا في إدارة الصفّ. ويتّضح جليًّا أنّ التخطيط المحكم لعمليّة التدريس، يليه تدبير وإدارة جيّدان للصفّ الدراسيّ.
هنا يمكن القول إنّ إدارة الصفّ ذات بعد تنزيليّ تطبيقيّ لما خطّط له المدرّس نظريًّا. والسؤال هو: هل كلّ مدرّس ملزم أن يبقى حبيس ما خطّط له؟
من المعروف أنّ الباحثين في المجال طوّروا مقاربات ذات خلفيّات علميّة، تساعد كلّ ممارس لفعل التعلّم في فهم سلوكيّات المتعلّمين وضبطها، وتحسين التعلّمات وكيفيّة بنائها وتقويمها. وللمتعلّم أيضًا خصوصيّات وحاجات ينبغي الاعتماد عليها في إدارة الصفّ الدراسيّ. هذا يستدعي ممارسة استباقيّة تبصّريّة للممارسة المهنيّة، وذلك بأن يُسائل المدرّس ممارسته، ويُعدّلها في ضوء أداءات المتعلّمين.
وفي هذا، ميّز شون (1983) بين نوعين من التفكير التبصّريّ: تفكير تبصّريّ أثناء الفعل (أثناء تدبير الفعل)، وتفكير تبصّريّ قبل الفعل أو بعده (يسمح إمّا بالرؤية الاستباقيّة لسيرورة بناء الدرس، أو بنقد لما أُنجز). وأضاف (St Arnaud, 1996) أنّه يجب على كلّ مدرّس أن يكون قادرًا على ملاحظة الأثر الذي قد يحدثه خطابه في المتعلّمين، وهو ما يُعرف بدرجة الفاعليّة الذاتيّة (efficacité personnelle).
إدارة السلوكيّات الصفّيّة المشاغبة: دوافع وحلول
دراسة حالة ميدانيّة من داخل صفّ دراسيّ
في فترة تدريبي، حضرت إحدى الحصص الدراسيّة مع أحد المدرّسين، وأثناء تدبيره للصفّ، لاحظت أنّ نسبة كبيرة من المتعلّمين لم تكن تتابع شرحه، بينما كانت مجموعة أخرى تكتب في دفاترها ما يسجّله المدرّس على السبّورة، وكان أحد المتعلّمين لا يتوقّف عن الكلام، ويحرص على شدّ انتباه المتعلّمين الآخرين، وذلك بتسليتهم طيلة الحصّة. وكان المدرّس لا يكترث بهذه السلوكيّات، مركّزًا على المتعلّمين الذين يبدون اهتمامًا أكبر، بل إنّ أحد المتعلّمين تجرّأ وخرج من الصفّ من دون استئذان، ليعود بعد دقائق، وهو مشهد جعل مجموعة من المتعلّمين يتبادلون الضحك والتعليقات.
تحدّثت مع أحد المشرفين، ووصفت له ما لاحظته أثناء الحصّة، فوضّح لي بعض دواعي تبنّي هذه السلوكيّات والحلول المقترحة، ومنها:
الدوافع
- - تعلّمات لا تعني المتعلّم ولا تدخل في اهتماماته.
- - أهداف التعلّم غير واضحة.
- - تنظيم زمن التعلّم يفوق قدرة المتعلّم على التركيز والتتبّع.
- - غياب التدرّج وتنظيم التعلّمات.
- - سياق وضعيّات لا يُحفّز المتعلّمين.
- - استعمال لغة لا يفهمها المتعلّمون.
- - تواصل لا يُشبع حاجيّات المتعلّمين الوجدانيّة.
الحلول
- - إنجاز ميثاق العمل مع المتعلّمين في بداية السنة الدراسيّة.
- - إشراك جميع المتعلّمين.
- - تخطيط مسبق للتعلّمات، وكذا حاجيّات المتعلّمين.
- - تشجيع المتعلّمين وعدم إحباطهم.
- - الاستعمال السليم للوسائل التعليميّة، خصوصًا الوسائل السمعيّة البصريّة.
- - تفادي الوقت الميّت أثناء التدبير.
- - إنصاف المتعلّمين في التعبير، والإجابة، والتقويم والتعلّم.
- - تذكير بالتعليمات وبنود ميثاق العمل.
- - تنويع أساليب التنشيط، وتكليف المشاغبين بمهامّ المسؤوليّة داخل الفصل.
- - تنظيم فضاء الدراسة: التوزيع إلى مجموعات وأشكال عمل حديثة.
- - الحرص على تميّز شخصيّة المدرّس، سواء من حيث الهندام، أو الصوت أو التوقّع أو استعمال أنواع التواصل.
حدّثني المشرف أيضًا عن بعض التقنيّات المتنوّعة للحدّ من هذه السلوكيّات، مثل الاعتماد على الوسائل التعبيريّة غير اللفظيّة (الحركات، اتّجاه النظرات...)، أو التدخّلات الكلاميّة (توقّف، كفى...). ويمكن أن يتدخّل المدرّس ليذكّر المتعلّم بالنتائج المترتّبة عن الإخلال بنظام الفصل، ولا يلجأ إلى العقاب إلّا بعد استنفاد الوسائل. ويجب أن يكون العقاب تربويًّا، خاضعًا للاعتبارات المؤسّساتيّة. كما يمكن إشراك الآباء وأولياء الأمور في إيجاد حلول، ومعرفة دوافع هذه السلوكيّات.
تجربتي لإدارة الصفّ للفصول ثنائيّة المستوى (الأقسام المشتركة)
يُقصد بالأقسام المشتركة أقسام متعدّدة المستوى، تتميّز بتباعد في أعمار المتعلّمين الزمنيّة والعقليّة، وتباعد نسبيّ في مستويات التحصيل الدراسيّ، وإيقاعات تعلّم مختلفة، وأنشطة وتمارين مختلفة، مع خطاب موحّد لكلّ مجموعة/قسم.
الأقسام المشتركة اختيار تربويّ معمول به في عدد من الدول، مثل سويسرا وهولندا وأستراليا وكندا وفرنسا، وذلك نظرًا إلى ما يفرضه توفير مقعد دراسيّ لكلّ طفل بلغ سنّ التمدرس، وتقريب المؤسّسات التعليميّة من المتعلّم، خصوصًا في المرحلة الابتدائيّة (وزارة التربية الوطنيّة، 2009).
قد نستاء بعض الأحيان بصفتنا مدرّسين من التعامل مع الأقسام المشتركة، نظرًا إلى الإكراهات التي تتمثّل في إدارة البرامج والمعلومات المكثّفة والمتنوّعة في زمن محدود، ما يستدعي في بعض الأحيان العمل بمجهود مضاعف، ومع فئات عمريّة متفاوتة، مثل التعامل مع مراهقين يجدون فرصة للقيام بالشغب، أو أطفال لم يكتسبوا بعد الذاتيّة في التعامل.
على الرغم من ذلك، يرى العديد من التربويّين مزايا مختلفة في استخدام هذا النهج، منها اختلاف تجارب متعلّمي الأقسام المشتركة وأعمارهم، والتي تصبح مصدر غنى في تكوين شخصيّة المتعلّمين. كما إنّ تعدّد البرامج يسمح للمتعلّمين بتطوير الجانب المعرفيّ، خصوصًا في مجال القراءة واللغات. أمّا بالنسبة إلى الجانب الوجدانيّ الاجتماعيّ، فالتعلّم داخل الأقسام المشتركة يُكسب المتعلّم الاستقلاليّة، والنضج العاطفيّ، والتعاون، والعمل الجماعيّ، والتعلّم الذاتيّ. كما إنّها فرصة للمدرّس لاستثمار مهاراته في تعرّف الفروقات بين المتعلّمين.
إليكم بعض الحلول المقترحة من تجربتي لإدارة الأقسام المشتركة
- - التخطيط المسبق، والمتمثّل في الإلمام ببرامج المستويات المراد تدريسها.
- - إعداد أنشطة تتناسب مع المتعلّمين ومع المدّة الزمنيّة للحصّة (ليس بالضرورة الالتزام بمحتويات الكتاب المدرسيّ).
- - استعمال صيغ عمل مختلفة، مثل العمل بالمجموعات والورشات.
- - العمل بالوصيّ، أيّ اختيار متعلّم يحلّ محلّ المدرّس في تصحيح الأخطاء القرائيّة مثلًا.
- - استخدام التكنولوجيّات والوسائل السمعيّة البصريّة، لجذب اهتمام المتعلّم.
- - استعمال أركان تربويّة خاصّة، مثل ركن للقراءة والإبداع والرسم.
***
خلاصة القول، إدارة الصفّ من بين المحطّات التي تجعل المدرّس يُسائل ممارسته اليوميّة داخل الصفّ: أيّ سيناريو وأيّ مقاربة متبنّاة لإدارة الصفّ؟ حاولت في هذا المقال اقتراح حلول لترشيد إدارة السلوكيّات المشاغبة داخل الصفّ، مع فهم الدوافع النفسيّة للمتعلّمين التي قد تجعلهم يتبنّون هذه السلوكيّات غير المسؤولة.
ويبقى للجانب التواصليّ أهمّيّة بالغة في قيام علاقات التبادل وبناء المعرفة بين المدرّس والمتعلّم، مع التركيز على أشكال الحوارات الأفقيّة، وتجاوز كلّ صيغ التدريس التقليديّة.
المراجع
- Nault, T., & Fijalkow, J. (2002). La gestion de la classe. De Boeck Supérieur.
- Archambault, J., & Chouinard, R. (1996). Vers une gestion éducative de la classe. Éditions Logiques.
- Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
- St Arnaud, Y. (1996). L'autorégulation dans les apprentissages scolaires: Fondements théoriques et implications pratiques. Les Éditions Logiques.
- وزارة التربية الوطنيّة. (2009). الدليل البيداغوجيّ للتعليم الابتدائيّ: تدبير الأقسام المشتركة (ص. 43). المغرب.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025