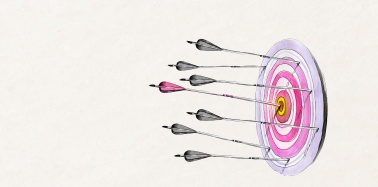تُعدّ المدرسة، منذ نشأتها الحديثة، أحد أبرز الحقول التي تتقاطع فيها السلطة والمعرفة، إذ لم تقتصر وظيفتها على نقل المعارف، بل شملت إعادة إنتاج المعايير الرمزيّة وضبط الإيقاع الاجتماعيّ، في علاقة مركّبة بين الأجيال. غير أنّ هذه الوظيفة فقدت الكثير من بداهتها مع التحوّلات الاجتماعيّة والثقافيّة الأخيرة، إذ اهتزّت شرعيّة المؤسّسة التعليميّة، وتبدّلت تمثّلات الفاعلين لأدوارها، ما جعل الصفّ الدراسيّ مجالًا متوتّرًا يعكس هذه التصدّعات.
وتكشف التحوّلات التي طالت الأسرة والسياسات التربويّة والثقافة الرقميّة، عن إعادة توزيع للسلطة التربويّة. لم تعد المدرسة مرجعيّة قيميّة مسلّم بها، بل أصبحت طرفًا ضمن شبكة واسعة من المؤثّرين. في هذا السياق، يكتسب الصفّ الدراسيّ دلالته، باعتباره فضاءً يُختبر فيه انهيار التعاقد الرمزيّ بين المتعلّم والمعلّم، ويتحوّل الضبط فيه من علاقة قائمة على الاعتراف، إلى أداءات تقنيّة تستهدف الاستقرار الشكليّ. وتبرز هذه المفارقة بوضوح في التحوّل الرمزيّ لمكانة المعلّم، وفي الممارسات الصفّيّة اليوميّة التي تعكس مقاومات ناعمة وضغوطًا رقابيّة متزايدة. هكذا يغدو "الضبط المدرسيّ" سؤالًا سوسيولوجيًّا مركزيًّا، لا باعتباره تقنيّة بيداغوجيّة، بل بوصفه تجلّيًا لأزمة أعمق تمسّ علاقة المدرسة بالمجتمع.
1. المدرسة ساحةً للتحوّلات الاجتماعيّة: من الإجماع القيميّ إلى تمزّق الشرعيّة
بُنيت المدرسة الحديثة على رهان اجتماعيّ واضح: أن تُعيد الدولة، عن طريق مؤسّستها التعليميّة، إنتاج النسق القيميّ والمعرفيّ داخل إطار وطنيّ متماسك، يقوم على التوافق حول معنى النجاح والتعلّم والانضباط (Bourdieu, 1984). بهذا المعنى، لم تكن المدرسة مجرّد مؤسّسة تعليميّة، بل شكّلت جهازًا رمزيًّا يُسهم في ضمان تماسك المجتمع، بترسيخ نموذج موحَّد للمواطنة والسلوك. غير أنّ هذا التصوّر الذي استند إلى نوع من الإجماع القيميّ، بدأ يتآكل تدريجيًّا تحت تأثير تحوّلات اجتماعيّة عميقة، مسّت شرعيّة الدولة وبنية الأسرة وأفق الأدوار الاجتماعيّة (Green, 2013).
أسهم تفكّك البنية الأبويّة، وصعود أنماط والديّة متناقضة، وتوسّع وسائط التنشئة خارج الأسرة والمدرسة، في إعادة توزيع السلطة التربويّة على نحو غير متكافئ (Moreeng et al., 2024). فلم تعُد المدرسة تحتكر التأثير في المتعلّم، بل أضحت طرفًا ضمن شبكة مفتوحة من الفاعلين الرمزيّين، يتقدّمهم الشارع والشاشة ومنصّات التفاعل الرقميّ. وبالتالي، تفقد موقعها بوصفها مرجعيّة قيميّة، وتجد نفسها في وضعيّة دفاع عن معناها ذاته (Selwyn, 2021).
ينعكس هذا التحوّل داخل الصفّ الدراسيّ؛ إذ تتعرّض العلاقة التي كانت تُبنى على تصوّر هرميّ للسلطة، إلى انهيارات متكرّرة. يشكّك المتعلّم في موقع المعلّم، ويتعامل مع المؤسّسة التعليميّة بوصفها حيّزًا مؤقّتًا، لا ممرًّا قيميًّا. في هذا الإطار، تظهر مقاومات ناعمة، وأشكال من السخرية والتشويش والتحدّي، لا تعبّر عن تمرّد فرديّ فحسب، بل تُحيل إلى انهيار التعاقد الرمزيّ الذي كان يربط أطراف العمليّة التربويّة ضمن أفق مشترك (Evans, 2023). وعليه، لا يعود "الصفّ المنفلت" نتيجة لضعف التأطير أو الاكتظاظ، بل يُفهم باعتباره ترجمة لتمزّق عميق في البنية الاجتماعيّة، والتي كانت تمنح الانضباط معناه الرمزيّ.
2. أزمة سلطة المعلّم: من الهيبة الرمزيّة إلى الهشاشة التنفيذيّة
تمرّ سلطة المعلّم، في السياق الراهن، بتحوّل عميق: تنزاح من حضور رمزيّ فاعل إلى موقع هشّ، تُمارَس فيه تحت وطأة الشكّ والتدقيق الإداريّ، بدلًا من أن تنبع من اعتراف تربويّ متبادل (Yıldız et al., 2021). لذلك، لم يعُد موقعه داخل الفصل يتأسّس على الهيبة المعرفيّة أو الشرعيّة الأخلاقيّة، بل صار مشروطًا بمعايير تقييم رقميّة، ومحاصرًا بإكراهات الأداء المدرسيّ التي تُفرغ العلاقة التعليميّة من بُعدها التأويليّ. وفي ظلّ هذا التحوّل، لم تعُد السلطة التربويّة تُمارَس عبر رموز خفيّة وإشارات ناعمة، بل أضحت سلطة مرئيّة وتقنيّة، تُدبَّر خارجيًّا، ويُراقَب أثرها أكثر ممّا يُفهم معناها.
تُرغم هذه الوضعيّة المعلّم على التصرّف داخل مفارقة حرجة: يُطلَب منه ضبط صفوف تعيش تفكّكًا قيميًّا عميقًا، في حين لا يُحاط بأيّ اعتراف مؤسّسي فعليّ، ولا يُدعَم بمنظومة رمزيّة تُؤطّر فعله. يعيش تحت ضغط التوجيهات الإداريّة من جهة، ومقاومات المتعلّمين من جهة ثانية، وضبابيّة أدوار الأسرة من جهة ثالثة (المستاري، 2025). وبذلك، تتآكل سلطته على مستويين: أوّلًا من حيث تمثّله الذاتيّ لدوره، وثانيًا من حيث موقعه في أعين تلامذته الذين باتوا يختبرون السلطة، بدل أن يخضعوا لها.
تكمن الإشكاليّة المطروحة اليوم في أزمة الشروط البنيويّة لإنتاج الشرعيّة التربويّة، لا في ضعف المهارات أو قصور التكوين. فحين يشتغل المعلّم خارج أيّ ترابط قيميّ، ويفتقر إلى خطاب اجتماعيّ يمنحه موقعًا مرجعيًّا، يتحوّل فعله إلى تنفيذ آليّ لتعليمات، أو استجابة فوريّة لسلوكيّات غير منضبطة، من دون أن يُحوّل الصفّ إلى مجال لبناء المعنى. يغيب البعد التواصليّ، وتذوب العلاقة التربويّة في تفاصيل تنظيميّة تُدبَّر أفقيًّا، بلا عمق ولا استمراريّة رمزيّة.
في المقابل، لا ينبغي أن يُفهم "ضعف الضبط" على أنّه فشل مهنيّ، بل ترجمة لفقدان الاعتراف، وعرض لأزمة أعمق في العلاقة بين السلطة والتعلّم (Willis, 1977). لقد انتقل المعلّم من موقع المرجعيّة التي تمثّل معنى النجاح، إلى دور المنفّذ الذي يشتغل على هامش إدارة مثقلة بالمهامّ البيروقراطيّة، وعاجزة عن إسناد الفعل التربويّ برؤية متماسكة. وبهذا، تغيب السلطة التربويّة بوصفها طاقة دلاليّة، وتُستبدل بسلطة شكليّة لا تُنتج سوى ردود فعل ظرفيّة، عاجزة عن استعادة المبادرة داخل الصفّ.
3. آليّات الضبط المعاصر: من السيطرة السطحيّة إلى "الانفلات المراقَب"
تُظهر الممارسات الصفّيّة المعاصرة تحوّلًا بنيويًّا في فلسفة الضبط، إذ انتقلت من نموذج تربويّ يستند إلى إنتاج المعنى وترسيخ الشرعيّة الرمزيّة، إلى نموذج إداريّ – تقنيّ، يهدف أساسًا إلى التحكّم في الفوضى والحفاظ على استقرار شكليّ ( 1971, Berstein). فالاضطراب الذي كان يُقرأ في السابق على أنّه خلل دلاليّ، يمسّ جوهر العمليّة التعليميّة، ويفرض مساءلة أسسها القيميّة، أضحى يُتعامل معه على أنّه "معطى تقنيّ" قابل للاحتواء بتدخّلات إجرائيّة سريعة، مثل تقارير الأداء وشبكات التقييم وخطط التدخّل.
تُعيد هذه المقاربات إنتاج نمط من "الانضباط الزائف"، إذ يتحوّل الصفّ إلى فضاء خاضع لتمثيليّة الضبط، لا لبنائه الفعليّ. يسود نوع من الهدوء المُعلَّب، تروّج له بعض الخطابات التربويّة بوصفه مؤشّرًا على نجاعة التقنيّات البيداغوجيّة، بينما يُخفي صمته طبقات من الانفصال الشعوريّ والاحتجاج المكبوت. يتجاوب المتعلّم مع إيقاع الحصّة من دون اندماج، ويُساير السلطة المدرسيّة من دون اعتراف فعليّ، ما يُنتج علاقة تربويّة جوفاء، خالية من الفعل التأويليّ والتفاعل القيميّ (McCarthy, 2024).
تكشف ممارسات مثل "الأنشطة الترفيهيّة"، و"خطط التدخّل الفرديّة"، و"المواكبة النفسيّة السريعة" عن محاولة لإبقاء الانفلات تحت السيطرة، لا بتفكيك أسبابه، بل بإعادة ترتيبه بصيغ قابلة للتدبير. وعليه، لا تُعالَج المفارقات الرمزيّة التي تعتري العلاقة التربويّة، بل تُعاد قولبتها إداريًّا، في منطق يُحاكي الضبط من دون أن يُنتجه فعليًّا. ولذلك، يتحوّل الصفّ إلى مسرح لمفارقة خطيرة: استقرار ظاهريّ يقوم على هشاشة رمزيّة عميقة، وضبط يُخفي عجزًا بنيويًّا عن بناء الاعتراف المتبادل.
يفرض هذا الوضع إعادة مساءلة جذريّة لمفهوم "الانضباط" ذاته. فالضبط لا يُقاس بغياب الضجيج، ولا تُحدَّد فعّاليّة الفصل بصمت الأجساد، بل بتوتّر المعاني، وبقدرة المعلّم على تحويل العلاقة التربويّة إلى لحظة تفاعليّة، تُنتِج الشرعيّة من داخل التفاعل. ومن دون هذا التحوّل، يتحوّل الصفّ إلى مجرّد وحدة مراقبة، لا فضاءً لإنتاج الذات والمعرفة.
من مساءلة الضبط إلى إعادة بناء العلاقة التربويّة
يكشف تحليل أنماط إدارة الصفّ أنّ الضبط المدرسيّ لم يعد مسألة تقنيّة، بل أصبح مجالًا رمزيًّا تتقاطع فيه أزمات المعنى، وصراعات السلطة، وإشكاليّات الاعتراف، وأزمات التنشئة. فالاختلالات السلوكيّة التي تُصوَّر أحيانًا على أنّها مجرّد مظاهر انفلات، تخفي في العمق أزمة بنيويّة أوسع تمسّ تصوّر المدرسة، ووظيفة المعلّم، وموقع التربية في المجتمع.
وبذلك، فإنّ الصراع الصفّيّ، في مستوياته الصامتة والعلنيّة، يُحيل إلى غياب مرجعيّة تربويّة موحّدة، تتقاطع عندها الأسرة والمدرسة والدولة والمجتمع المدنيّ، حول معنى مشترك للتعلّم والانضباط. وفي غياب هذا الإطار المرجعيّ، يتفكّك البعد التأهيليّ للفصل، ويتحوّل إلى حيّز ملتبس تُدار فيه المفارقات اليوميّة من دون تفكيكها، وتُمارَس فيه السلطة بوصفها إكراهًا إجرائيًّا أكثر منها قوّة رمزيّة مشروعة. عند هذا الحدّ، تتجلّى إحدى مفارقات المدرسة الحديثة: محاولة ترسيخ النظام داخل مجتمع يتفكّك رمزيًّا.
إنّ جوهر المعضلة الراهنة لا يكمن في أدوات الضبط، بل في الشرعيّة التي تمنح هذه الأدوات معناها التربويّ، وتحوّلها من تقنيّة مراقبة إلى علاقة تواصليّة، قادرة على إنتاج المعنى والاعتراف المتبادل. ففي غياب هذا الأساس، تصبح كلّ أشكال السيطرة عرضة للانهيار بمجرّد تراجع المراقبة، ويتحوّل الضبط إلى تمثيل إداريّ يخدم مقاييس الأداء، أكثر ممّا يخدم مشروع التربية ذاته، وهو ما يتناقض مع ما يطرحه هابرماس من ضرورة تأسيس الشرعيّة على الحوار التواصليّ، لا على الإكراه.
وعليه، فإنّ أيّ إصلاح جادّ للضبط المدرسيّ، يفترض إعادة التفكير في العلاقة التربويّة برمّتها، ليس بوصفها عمليّة تبليغ معرفيّ فحسب، بل أفقًا تأويليًّا لتبادل المعاني وبناء الذات. ويتطلّب ذلك استعادة مكانة المعلّم بوصفه فاعلًا تربويًّا منتجًا للمعنى، لا مجرّد منفّذ لبرامج إداريّة، وإعادة اعتبار الفصل بوصفه فضاء للتفاعل الرمزيّ الذي يربط المعرفة بالاعتراف، لا بوصفه وحدة تقنيّة لإنتاج السلوك. ولن يتحقّق ذلك إلّا عبر إعادة التفاوض حول المعاني المؤسّسة للفعل التربويّ — معنى النجاح، ومعنى التقدير، ومعنى السلطة نفسها — بحيث يصبح الضبط نابعًا من داخل العلاقة التربويّة، لا مفروضًا من خارجها، ويتحوّل الصفّ إلى مجال حقيقيّ لبناء المواطنة، بدل أن يُختزل في ساحة لترويض الأجساد.
المراجع
- المستاري، محمّد. (2025). المدرسة المغربيّة وسؤال المواطنة الرقميّة: من الرهان التربويّ إلى مفارقات المجتمع الشبكيّ. مجلّة جيل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، 117(9-33).
- Bernstein, B. (1971). Class, Codes and Control: Volume 1 – Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. Routledge & Kegan Paul.
- Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
- Evans, A. M. (2023). It’s a Shit Show, and It’s Fine: Symbolic Nonviolence Practices in Higher Education in 2020. Critical Education, 14(3), 1-27.
- Green, A. (2013). Education and State Formation: Europe, East Asia and the USA. Palgrave Macmillan.
- Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers, Changing Times: Teachers’ Work and Culture in the Postmodern Age. Cassell.
- McCarthy, F. (2024). (Mis)recognising the Symbolic Violence of Academically Selective Education in England: A Critical Application of Bourdieusian Analysis to Pupils’ Lived Experiences. Critical Studies in Education, 66(4), 499–515.
- Moreeng, B., Phora, T., & Lekganyane, R. (2024). Parental Involvement as a Convergence of Understanding by Teachers and Parents. Interdisciplinary Journal of Sociality Studies, 4(4), 2-10.
- Selwyn, N. (2021). Education and Technology: Key Issues and Debates (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
- Willis, P. (1977). Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Saxon House.
- Yıldız, S., Korumaz, M., & Balyer, A. (2021). Symbolic Violence Teachers Experience at Schools. Journal of Economy Culture and Society, 63(165–180).







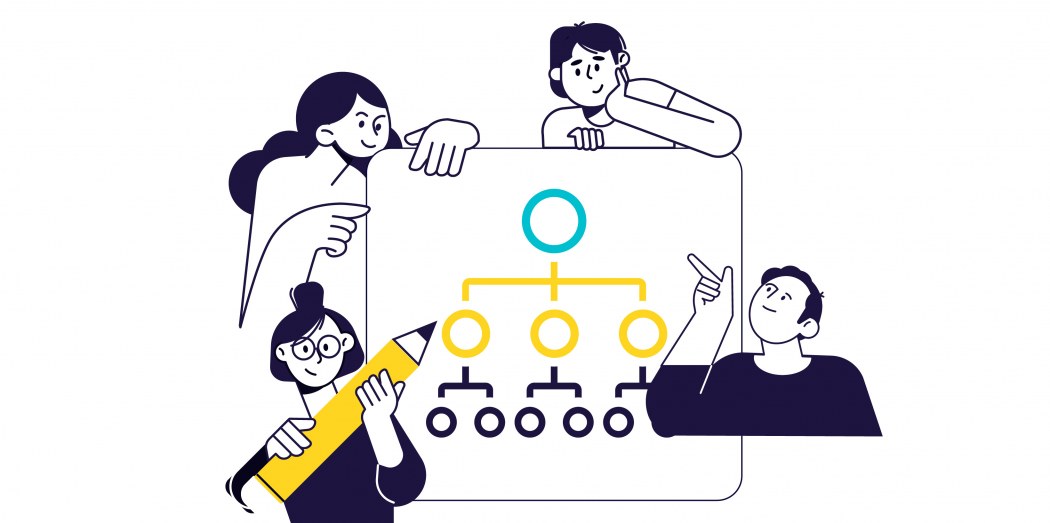





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025