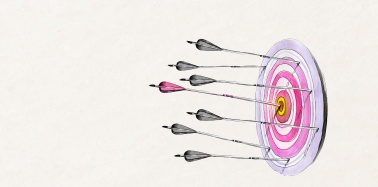لعلّ مكمَن الأزمة العالميّة التي تعيشها الإنسانيّة اليوم، والتي تمرّ فيها غالبيّة البلدان، لا سيّما العربيّة منها، لا تكمن أساسًا في الأزمات السياسيّة الأمنيّة المتمثّلة في الصراعات الجيو - سياسيّة، ولا في الأزمة الاقتصاديّة التي تنبع جذورها من أسباب ماليّة وإنتاجيّة، بقدر ما تتجسّد في البعد العلائقيّ القيميّ، حيث انهيار القيم يمثّل إحدى الأزمات التي تفاقمت في الحياة الاجتماعيّة، في ضوء الفوضى السلوكيّة التي اجتاحت المجتمعات إبّان التغيّرات السريعة في العقود الأخيرة، ما انعكس على البعد القيميّ لدى الإنسان، وأدّى إلى ظهور مجموعة من الأزمات والاضطرابات والمشكلات التي تهدّد النظام الاجتماعيّ برمّته.
لكن، حين تتعلّق الأزمة بالمتعلّم تصبح أشدّ خطورة؛ على اعتبار أنّ المتعلّم نور المجتمع ومشعله، والذي ما إن يخبو نوره حتّى يعود الظلام ويحلّ الركود. بل أبعد من ذلك، فتأزّم المتعلّم من مظاهر تأزّم المجتمع ذاته، فالصفّ المدرسيّ ليس إلّا مسرحًا تتجسّد فيه كلّ أبعاد الحياة الاجتماعيّة بكلّ تعقيداتها وتنوّعاتها؛ إنّه مرآة مصغّرة للمجتمع الكبير.
وبما أنّ التلميذ يمثّل النواة الأساسيّة ضمن المقاربة بالكفايات المعمول بها بيداغوجيًّا في المغرب، باعتباره محور العمليّة التعليميّة التعلّميّة، فإنّ القيم عمادها الأوّل وأساسها المتين؛ على اعتبار أنّ بناء متعلّم من دون قيم، ليس إلّا توهّمًا لأساس هشّ لا يصلح لأن يكون مركزًا حتّى لذاته، فكيف له أن يكون أساسًا لمنظومة تربويّة بأكملها. وعليه، فالأزمة التي تعيشها فصولنا الدراسيّة لا تكمن في عجز المناهج الدراسيّة، أو ضعف أساليب التدريس، وغياب البيئة المدرسيّة الملائمة فقط، بل يتجاوز ذلك؛ إذ إنّ جذور هذه الأزمة تكمن أساسًا في الوهن الذي أصاب قيم المتعلّمين، فآفة التعليم لا تكمن فقط في جودة المناهج، بل في جودة النفوس التي تتلقّاها، وليست في قلّة التقنيّات، بل في انعدام الرغبة في استخدامها، وغياب فضول الاستكشاف لدى المتمدرسين.
وفي سياق متّصل، وبما أنّ التاريخ الإنسانيّ يعلّمنا أنّ لكلّ أزمة تبعات عديدة لا محالة، فإنّ أزمة القيم التي ينخرط فيها المتعلّمون هي الأخرى لا تخرج عن هذا النطاق، إذ تتبعها مخلّفات خارجيّة وداخليّة في الآن ذاته. أمّا على المستوى الداخليّ، فتتمثّل أساسًا في ضعف الانتماء الذاتيّ للمتعلّم وفقدان البوصلة الأخلاقيّة. وعلى المستوى الخارجيّ، تتمثّل في تدهور البيئة التعلّميّة وصعوبة تدبير الفصل الدراسيّ، بفعل انتشار السلوكيّات الهدّامة التي تشكّل منبع الفوضى وعدم الانضباط، الأمر الذي يعيق سير العمليّة التعلّميّة ويكبّل فعّاليّتها.
أزمة القيم: قراءة فلسفيّة في مآزق الذات المعاصرة
عمل عالم الاجتماع والفيلسوف البولنديّ، الأستاذ في جامعة "ليدز" البريطانيّة، زيجمونت باومان (1925)، على تفكيك سرديّات الحداثة وتقويضها، والتي حاولت – في نظره – أسطرة قيم جديدة لا تجعل من الإله مصدرًا، بل من الإنسان نفسه، ومن الذات منبعًا لها. لكن سرعان ما أبانت هذه الحداثة، في نهاية الأمر، عن مآزق غائرة، ومزالق عدّة كانت وراء هذا الإيمان المفرط بالعقل، ما جعل منها حداثة ناقصة أو دوغمائيّة، حسب ما ذهب إليه لوك فيري (2014). وبالتالي، حاول جلّ فلاسفة ما بعد الحداثة تقويض هذا الزعم الدوغمائيّ، ابتداء من مطرقة نيتشه الهادمة لجلّ الأصنام التي قام عليها المشروع الحداثيّ، وصولًا إلى كتابات باومان ضمن سلسلة سمّاها "السيولة"، والتي كان يعبّر فيها عن تدنّي القيم الأخلاقيّة التي خلّفتها الحداثة، والتي انحرفت عن أصلها الأوّل لتدخل في طورها المتمثّل في السيولة، والمرتبط بالتطوّر السريع لوسائل التكنولوجيا، وسيطرة العقلانيّة الرقميّة التي فرضت على الإنسان منطق الاستهلاك، فعزّزت الجانب الفرديّ للقيم الأخلاقيّة ذات البعد الضيّق، والتي تلهث وراء الإشباع الفوريّ، وتحاول التأقلم مع كلّ المستجدّات الراهنة.
من هذا المنطلق، يحاول باومان وصف الأثر الذي أحدثته ما بعد الحداثة في كُنه الإنسان المعاصر، والتي أدّت - حسبه - إلى تشيّؤ الإنسان، أي تحويله إلى كائن وظيفيّ محروم من أفق أخلاقيّ، إذ أنتجت سيولة الخوف تحت وطأة الاستهلاك، والقلق ممّا يخبئه الغد، اضطرابًا أخلاقيًّا أصبح معه الشرّ، وكلّ ما ليس أخلاقيًّا، مبرّرًا. إنّه بذلك يصف التحوّل الذي تعرّضت إليه المراكز الصلبة والسرديّات الراسخة التي نادت بها الحداثة وتبجّحت بها، إذ يرى أنّ الحداثة التي أذابت ما هو صلب في العصر الوسيط، باتت الآن تتعرّض بدورها للإذابة والتمييع، نظرًا لعدم صلابتها بما يكفي.
ترجع السيولة في فكر باومان إلى وصف الوضع الراهن بأنّ لا شيء فيه يتّسم بالثبات والصلابة، إذ لم تعد القيم والمبادئ ثابتة وصلبة، بل أصبحت "سائلة" مثل المياه، تتغيّر وتتشكّل باستمرار، وتفتقر إلى أيّ أساس راسخ، وذلك بعد انهيار الأساس الكانطيّ الكونيّ القائم على فكرة الواجب، والذي على أساسه أُعامل الآخر في شخص الإنسانيّة، في إطار من الحبّ الصوفيّ الذي تتماهى فيه الذات مع الذات.
هذا التحوّل من الثبات إلى السيولة يُعزى – حسبه – إلى تآكل المرجعيّات التقليديّة، ما يحوّل الإنسان إلى "مستهلك" للقيم، يتبنّاها ويتخلّى عنها بسهولة بما يخدم مصالحه اللحظيّة. ويرجع هذا الانزلاق القيميّ أيضًا، في نظره، إلى المجازر البشريّة والهيمنة والتجبّر الذي انتهت إليه العقلانيّة الغربيّة، بحيث جرى الانتقال من قيم التنوير والدعوة إلى المواطنة وحقوق الإنسان، إلى إنتاج جماعيّ للعمى الأخلاقيّ تجاه الشعوب الضعيفة والمغلوب على أمرها.
ضبط الصفّ: هل هو هدف في ذاته أم وسيلة؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ مرحلة الطفولة أساسًا، مرحلة حركة وانفعال، فالطفل في هذه السنّ يمتلك طاقة هائلة وحاجة فطريّة للاستكشاف واللعب، ما يدفعه إلى التحرّك الدائم والتفاعل المستمرّ مع محيطه. هذه الحركة الطبيعيّة، وإن كانت ضروريّة لنموّه البدنيّ والعقليّ، غالبًا ما تتجلّى في الفصول الدراسيّة على شكل همس وضحك وفرط في الحركة، ما يصعّب على المعلّم إرساء الهدوء والتركيز اللازمين للعمليّة التعليميّة.
لكنّ ضبط الفصل الدراسيّ يتجاوز مجرّد الحفاظ على هذا الهدوء، أو فرض قواعد من شأنها أن تكبّل حركة المتعلّم؛ إنّه محاولة لبناء بيئة منظّمة يتحرّر ضمنها المعلّم والمتعلّم في الآن ذاته. فالمدرّس ينسلخ من مهمّة إدارة الفوضى، ويركّز طاقته على تيسير التعلّم، وإثراء النقاشات، وتوفير الدعم الفرديّ، في حين يشعر الطلّاب بالأمان الكافي لطرح الأسئلة، والمخاطرة الفكريّة، والتعبير عن آرائهم من دون خوف من المقاطعة أو التشتّت.
على هذه الشاكلة، يعمل المعلّم على تنظيم حرّيّات المتعلّمين، بحيث يكون انضباط المتمدرسين وفق مبادئ تُسطّر جماعيًّا بغية تقنين البيئة التعليميّة. ليس من شأن ذلك أن يكون وسيلة لتقييد الحرّيّات، بل أن يكون عملًا منظّمًا لها. إنّه يتيح لكلّ طالب مساحته الخاصّة للتعلّم، ويضمن أن تكون أصوات الجميع مسموعة، وأن تكون الفرص التعليميّة متاحة للكلّ على قدم المساواة.
وبالتالي، فإعداد بيئة يتعلّم فيها الطلّاب لا يقتصر على المحتوى المعرفيّ الأكاديميّ، بل يتيح لهم أيضًا اكتساب مهارات حياتيّة قيّمة، مثل الصبر والاحترام المتبادل وحلّ المشكلات والعمل الجماعيّ. وهذه المهارات التي تؤهّلهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين ومنتجين في المجتمع، قادرين على التكيّف مع التحدّيات المستقبليّة، وهو ما يُعرف بالكفاية في الأوساط التربويّة؛ أي اكتساب المتعلّم قدرات ومهارات تمكّنه من توظيفها في حلّ مشكلات معيّنة في سياق محدّد.
إعادة بناء القيم مدخل إلى صفّ منضبط
لعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ الإنسان ليس مجرّد كائن بيولوجيّ أو لغويّ، ولا هو مجرّد حيوان ناطق كما تهلّل مجموعة من الفلسفات، لكنّه، بالإضافة إلى ذلك، نلفيه كائنًا مقوَّمًا أخلاقيًّا. إنّه ليس مجرّد مخلوق يوجد ويحيا فقط، بل، على غرار باقي شركائه في الجنس، يفكّر في وجوده، وينظر في معيشه، ويسعى دومًا لتجاوز ذاته وتجويد حياته، محاولًا تجاوز ما هو كائن صوب ما يجب أن يكون. لكن، ما إن ينسلخ الإنسان عن ماهيّته تلك، يصبح مجرّد كائن بلا هويّة، ليس إلّا قوّة بيولوجيّة تتحرّك في الفضاء، تستهلك الموارد وتتفاعل مع المحيط، لكنّها تفتقد الجوهر الذي يميّزها عن سائر المخلوقات.
هذا التجرّد ممّا يمنح الإنسان قيمته وكرامته، نجد له تبعات على المستوى التربويّ. فإذا كان المنهاج التربويّ قد نصّ على تربية المتعلّمين على القيم، فإنّه يتحتّم على كلّ المتدخّلين في الفعل التربويّ إعادة النظر في كلّ أسسه، بما فيها الأسس الفلسفيّة والسيكولوجيّة؛ لأنّه يبدو أنّ ثمّة إشكالات على مستوى تمثّل القيم وتطبيقها على أرض الواقع، إذ يُلاحَظ أنّ المتعلّمين لا يتمثّلون ما يتلقّونه في المؤسّسات التعليميّة، فهم يعيشون فتقًا أخلاقيًّا وقيميًّا بين ما يدرسونه وما يعيشونه.
وهو الأمر الذي يعود على المؤسّسات التربويّة بالخطر، فتصبح مهمّة تسيير العمليّة التعلّميّة أمرًا أشبه بالمستحيل، وذلك في ظلّ تدنّي دافعيّة التعلّم لدى المتمدرسين، وإحلال اللامبالاة بدل الاهتمام، وغيرها من القيم المتدنّية، مثل التنمّر والعنف والاستهزاء. وهي قيم تنبع أساسًا من تجاهل أدوار الآخرين وتقديرها، سواء تقدير دور المعلّم في التوجيه، أو دور الزملاء في التعلّم، ما يجعل التعاون مستحيلًا، وبالتالي يجعل التعلّم مستحيلًا هو الآخر، لأنّ التعلّم ما هو إلّا عمليّة تعاونيّة يشارك فيها جلّ أفراد الفصل.
ولمّا كان صلاح المجتمع رهينًا بمدى تمثّل أفراده للقيم الكونيّة، وإيمانًا بأنّ التربية على القيم مدخل أساسيّ ليس لإصلاح المنظومات التربويّة فقط، بل المجتمع بشكل عامّ (1999)، نشدّد على أهمّيّة الاهتمام بالجانب القيميّ لدى المتعلّمين، إذ إنّه السبيل الأوحد إلى ضبط فصولنا الدراسيّة، ومن ثمّ تعزيز المجال التربويّ معرفيًّا وأخلاقيًّا. فبرغم ما تنخرط فيه مجتمعاتنا من أزمة قيميّة، إلّا أنّنا نتماشى مع بول ريكور الذي أكّد على أنّ أزمة القيم لا تعني بالضرورة نهاية الأخلاق، بل بداية تأويل جديد لها لا غير.
* * *
دعونا نقرّ إذًا، بأنّ ضبط الفصول الدراسيّة لن يتمّ إلّا بإيلائنا الأهمّيّة للجانب الأخلاقيّ والقيميّ لدى المتعلّمين. بل إنّ نهوض المنظومة التربويّة برمّتها رهين بمدى قدرتها على ترسيخ القيم، والترقية بالمتعلّمين من مستوى الحيوانيّة إلى المستوى الإنسانيّ، حيث التفرّد بالأخلاق الكونيّة، وبالتالي تيسير عمليّة التعلّم.
المراجع
- فيري، ل.، و كبلياي، ك. (2015). أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة (ترجمة: بن جماعة، حمّود). دار التنوير للطباعة والنشر.
- باومان، ز. (2019). الحداثة السائلة. (الطبعة الثالثة). (ترجمة: أبو جبر، حجّاج). الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر.
- ريكور، ب. (1999). الذات عينها كآخر (ترجمة وتقديم: زيناتي، جورج). المنظّمة العربيّة للترجمة.
- لجنة التربية والتكوين. (1999). الميثاق الوطنيّ للتربية والتكوين. المغرب.







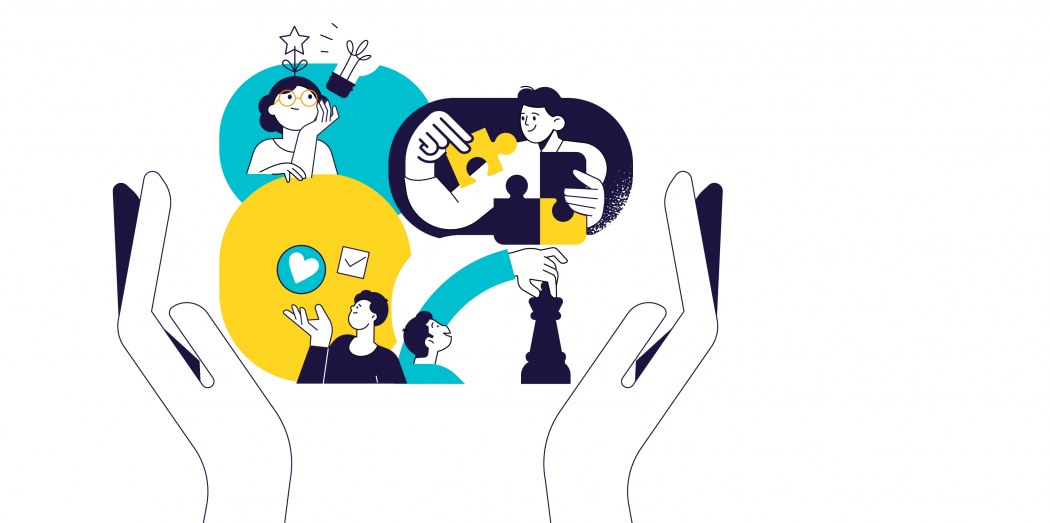





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025