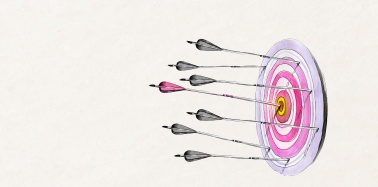عندما بدأت رحلتي في التعليم في مدارس غزّة، لم أكن أتوقّع أن أواجه تحدّيًا بهذا الحجم. تخيّل أن تدخل صفًّا يضمّ أكثر من أربعين طالبًا، وكلّ واحد منهم عالم مختلف من المشاعر والسلوكيّات والاحتياجات. للوهلة الأولى، كان المشهد مربكًا: كيف أستطيع أن أشرح الدرس بوضوح وسط هذا العدد الكبير؟ كيف يمكن أن أحافظ على النظام، وأجعل كلّ طالب يشعر بأنّه حاضر ومهمّ؟
كانت البدايات صعبة مثل العادة، والأصعب حين كنت أُدرِّس فصول الذكور، بطبيعتهم المليئة بالحركة والشقاوة. حاولت استخدام الطرق التقليديّة التي ورثناها عن المعلّمين القُدامى: رفع الصوت، والحزم الزائد، والاعتماد على "الهيبة". إلّا أنّني سرعان ما اكتشفت أنّ هذه الأدوات لم تعد مُجدية. الطلّاب اليوم يختلفون عن طلّاب الماضي؛ لم يعد الصمت يحضر بمجرّد دخول المعلّم، ولم تعد العصا أو العقوبة تعالج الفوضى، بل أحيانًا تزيد منها.
الطريق إلى القلوب
هنا بدأت أبحث عن أسلوب مختلف. كنت أقول لنفسي: إذا لم أصل إلى قلوبهم، فلن أصل إلى عقولهم. لذلك غيّرت استراتيجيّتي، وحاولت أن أجعل العلاقة بيني وبين طلّابي أكثر إنسانيّة. أدركت أنّ الطالب المشاغب ليس عدوًّا تجب السيطرة عليه، بل طفلًا يبحث عن الاهتمام، وربّما يريد فقط أن يسمع أحد صوته.
جرّبت أسلوبًا بسيطًا، لكنّه فعّال: تكليف الطالب المتمرّد بمهامّ تجعله يشعر أنّه مسؤول ومهمّ. أحيانًا أطلب من أكثر الطلّاب شقاوة أن يساعدني في تنظيم السبّورة، أو توزيع الأوراق، أو قيادة المجموعة. المفاجأة أنّ هؤلاء الطلّاب الذين كانوا مصدر الفوضى، أصبحوا أكثر هدوءًا، لأنّهم وجدوا دورًا يعبّر عنهم.
كما لجأت إلى المجموعات التعاونيّة. كنت أقسّم الصفّ إلى أزواج أو مجموعات صغيرة، بحيث يتعاون الطلّاب مع بعضهم البعض على القراءة والإجابة. لم يكن الهدف فقط السيطرة على العدد الكبير، بل أيضًا تعزيز روح التعاون بينهم. مع الوقت، بدأت أرى نتائج مذهلة: الطلّاب صاروا يساعدون بعضهم بدل التنافس غير الصحّيّ، وصار الضعيف يشعر أنّ هناك من يسنده، والقويّ يجد معنى أكبر لتميّزه.
ومع مرور الوقت، تعلّمت أنّ إدارة الصف لا تتعلّق فقط بالقوانين والأنظمة، بل بالجانب العاطفيّ والاجتماعيّ لدى الطالب. بدأت حصصي أحيانًا بدقيقة صمت أو تمرين تنفّس عميق، حتّى يهدأ الجوّ. كنت أسألهم: "من سعيد اليوم؟ من متعب؟ من زعلان؟" مجرّد هذا السؤال البسيط كان يفتح بابًا عجيبًا للتواصل. فجأة، لم يعد الطالب يشعر أنّه مجرّد "رقم" بين الأربعين، بل إنسان له مشاعر وقيمة.
لكنّها الحرب...
ثمّ جاءت الحرب، وازداد كلّ شيء صعوبة. وجدت نفسي أدرّس في صفوف بلا مقاعد ولا طاولات، وبلا كتب أو أدوات. كلّ شيء كان ناقصًا، لكنّ شيئًا واحدًا لم يغِب: الإرادة. كنت أجلس مع طلّابي على الأرض، نكتب بما هو متوفّر، ونركّز على ما هو أبعد من المادّة الدراسيّة. في هذه الظروف، أصبح تعليم مهارات مثل ضبط النفس والتعاون والتعاطف، أهمّ من أيّ كتاب أو منهج.
ولأنّ الحرب أثقلت قلوب الأطفال بالصور القاسية والأصوات المزعجة، حاولت أن أجد لهم نافذة صغيرة للسلام الداخليّ. وجدت في التلوين وسيلة بسيطة وفعّالة للتفريغ النفسيّ؛ يلوّن الطلّاب ما يشاؤون، خصوصًا ما يزوّدهم بوسائل الحماية من العنف، ويُكسبهم معرفة بطرق التعامل الآمن مع المتفجّرات. أثناء التلوين أرى في وجوههم ارتياحًا غريبًا، وكأنّ الألوان تمنحهم مساحة أمان وسط الركام. بعض الطلّاب يلوّنون بصمت طويل، وآخرون يشاركونني رسوماتهم، يروون لي قصصًا عن بيوت دُمّرت أو أحلام مؤجّلة. فالتلوين بالنسبة إليهم ليس مجرّد نشاط فنّيّ، بل علاج صامت، يخفّف من خوفهم، ويعيد إليهم شيئًا من طفولتهم المسلوبة.
لكنّ الحقيقة أنّني لم أكن أساعدهم فقط، بل كانوا يساعدونني أيضًا. فقد مررت مؤخّرًا بتجربة شخصيّة قاسية جدًّا، كسرت شيئًا بداخلي. ومع ذلك، وجدت نفسي أفرّغ هذا الغضب في الصفّ، ليس بالصراخ أو العقاب، بل بتحويله إلى طاقة إيجابيّة. كنت أقول لنفسي: إذا استطعت أن أضبط نفسي أمام هذا الألم، سأستطيع أن أضبط الصفّ أيضًا. وهكذا، علّمني عملي كيف أتعامل مع نفسي قبل أن أتعامل مع طلّابي.
أرى طلّابًا يثيرون الفوضى، لكنّني تعلّمت أن أنظر إليهم بعمق أكبر. كثير منهم لم يكن بحاجة إلى عقوبة، بل إلى حضن معنويّ، أو كلمة طيّبة. عندما جلست مع أحدهم لأستمع إليه فقط، تغيّر سلوكه بالكامل. أحيانًا مجرّد الإصغاء يعيد التوازن للطفل، ويمنحه إحساسًا بالأمان وسط عالم يمتلئ بالخوف والفوضى.
تجربة علّمتني أنا قبل أن تعلّمهم
اليوم، وبعد سنوات من هذه التجربة، أستطيع أن أقول إنّ إدارة الصفّ ليست فنًّا في السيطرة على الطلّاب، بل فنّ في بناء قلوب وعقول. إدارة الصفّ تعني أن ترى الطالب إنسانًا كاملًا، وأن تفهم أنّ وراء كلّ حركة أو كلمة أو فوضى رسالة غير منطوقة.
وعلى الرغم من صعوبة الظروف في غزّة، ورغم الاكتظاظ والحرب والحرمان من أبسط المقوّمات، تعلّمت أنّ الصفّ يمكن أن يتحوّل إلى مساحة للتعلّم والنموّ. لا أعلّمهم فقط القراءة والكتابة، بل أعلّمهم كيف يكونون بشرًا قادرين على التعايش والاحترام ومواجهة التحدّيات.
إنّها تجربة علّمتني قبل أن تعلّمهم، وغيّرت نظرتي إلى التعليم من كونه مجرّد "مهنة"، إلى كونه رسالة إنسانيّة عميقة. وما زلت أؤمن أنّ الأثر الذي نتركه في نفوس طلّابنا، قد يكون أعظم بكثير من أيّ درس أو كتاب.
جعلتني تجربتي مع الصفوف المكتظّة في غزّة، خصوصًا في ظلّ الحرب، أدرك أنّ التعليم ليس مجرّد مهنة، بل رسالة تحمل بين طيّاتها الكثير من التحدّيات والآمال. نعم، الطريق ليس سهلًا، والظروف قاسية، لكنّ ما نزرعه في نفوس طلّابنا اليوم هو ما سيبقى غدًا.
أدركت أنّ كلّ كلمة طيّبة نقولها، وكلّ لحظة نصغي فيها، وكلّ فرصة نمنحها للطالب ليشعر بقيمته، قد تغيّر مسار حياته. قد لا نملك الكتب دائمًا، ولا المقاعد، ولا حتّى الأمان، لكنّنا نملك ما هو أعظم: القدرة على أن نكون لهم سندًا، وأن نمنحهم مهارات تجعلهم أكثر قوّة أمام الحياة.
***
رسالتي إلى كلّ معلّم يواجه صفًّا مكتظًّا أو ظروفًا صعبة: لا تيأس. تذكّر أنّ إدارة الصفّ لا تعني السيطرة على أربعين جسدًا، بل احتضان أربعين قلبًا. وكلّما بنيت جسور الثقة مع طلّابك، ستجد أنّ الصفّ مهما كان مكتظًّا وضيّقًا، يمكن أن يتحوّل إلى مساحة رحبة للتعلّم والنموّ والأمل.
في النهاية، علّمني التعليم في غزّة أنّ الأصعب ليس أن تدرّس بلا مقوّمات، بل أن تستسلم. وما دمنا نقف أمام طلّابنا ونمنحهم الأمل، فإنّنا ننتصر، حتّى وسط الهزائم.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025