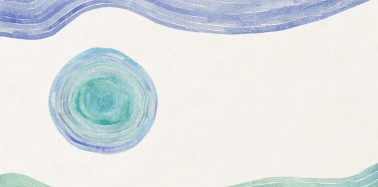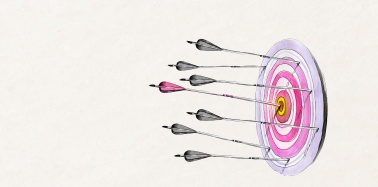شغل الكتاب المدرسيّ موقعًا مركزيًّا في العمليّة التعليميّة منذ بداية وجوده، باعتباره المصدر الأساسيّ – وغالبًا الأوحد – الذي تُبنى عليه الخطط الدراسيّة، وتُقاس به نتائج التعلّم. وعلى الرغم من التحوّلات الكبرى التي شهدها مجال التعليم في العقود الأخيرة، سواء من حيث تعدّد مصادر المعرفة أو تطوّر طرائق التدريس، ما يزال الكتاب يحتفظ بمكانة "المعيار الرسميّ" للمعرفة المدرسيّة. لكنّ هذه المكانة، التي قد تبدو بديهيّة في ظاهرها، تخفي وراءها شبكة من الأسئلة المعرفيّة والأيديولوجيّة التي لا يمكن تجاوزها.
في هذا المقال – الذي يمثّل وجهة نظر شخصيّة – نتناول الكتاب المدرسيّ بوصفه سلطة معرفيّة لا مجرّد وسيلة، ونحلّل الأبعاد الأيديولوجيّة الكامنة في إنتاجه ومضامينه، متسائلين: من يُحدّد ما يجب أنّ نتعلّمه؟ ومن يُقصى من هذا التحديد؟ كما نرصد الآثار التربويّة والثقافيّة لاختزال التعلّم في نصّ مركزيّ، ونناقش بدائل محتملة تتيح إعادة التوازن بين المعرفة الرسميّة وتعدّد الأصوات داخل الصفّ الدراسيّ.
الكتاب المدرسيّ باعتباره سلطة معرفيّة
لم يعد من الممكن النظر إلى الكتاب المدرسيّ بوصفه أداةً حياديّة لنقل المعرفة؛ إذ إنّه ينهض، في بنيته ومضمونه، بوظيفة تتجاوز التعليم إلى إنتاج المعرفة المسموح بها، وتثبيت رؤية معيّنة للعالم والمجتمع والتاريخ. فالكتاب، حين يُعتمد مصدرًا وحيدًا أو مركزيًّا، يُرسّخ تصوّرات محدّدة ويُقصي أخرى، ولا يحدّد ما يجب معرفته وحسب، بل أيضًا كيف نفكّر، وضمن أيّ أفق معرفيّ وثقافيّ.
يتّضح هذا البعد السلطويّ بوجه خاصّ في الموادّ المرتبطة بالهويّة والانتماء، مثل مناهج التاريخ والتربية الوطنيّة؛ فتُنتقى الأحداث والنصوص بعناية لخدمة سرديّة معيّنة، بينما تُهمّش سرديّات أخرى أو تُحذَف كلّيًّا. أمّا في الموادّ العلميّة، فغالبًا ما تظهر السلطة المعرفيّة في طريقة اختيار الأمثلة أو الأسماء أو التمارين، بما يعكس تحيّزات ضمنيّة ثقافيّة أو طبقيّة، حتّى في ما يبدو حياديًّا أو موضوعيًّا.
قد تحمل بعض المقرّرات الدراسيّة رسائل غير مُصرّح بها، أو تميل إلى انتقاء وقائع بعينها على حساب أخرى. أذكر حين كنت أراجع كتاب التاريخ للمرحلة الثانويّة، ولاحظت غيابًا واضحًا لبعض القضايا التي واجهتها مصر خلال العقد الماضي، وشكّلت واقع حياة المواطنين وأثّرت في مستقبلهم، مثل مشكلة التضخّم، أو ملفّ سدّ النهضة، أو أثر الأزمة الأوكرانيّة الروسيّة في الاقتصاد المصريّ. تساءلت حينها: هل تمّ تجاوز هذه الأحداث بهدف التركيز على الجوانب الأكثر استقرارًا في التاريخ المعاصر؟ أم أنّ هناك تخوّفًا من طرح قضايا قد تثير نقاشات يصعب ضبطها داخل الصفّ؟ هل ندرّس التاريخ لنساعد الطلّاب على قراءة واقعهم بعيون أكثر وعيًا، أم نكتفي باستعراض محطّات الماضي، من دون التوقّف عند ما يتقاطع منها مع الحاضر؟
في تقديرنا، تكمن الإشكاليّة الحقيقيّة في أنّ هذا البناء لا يُنتج معرفة محدودة فحسب، ولكن يُسهم أيضًا في تقييد آفاق التفكير داخل الصفّ الدراسيّ؛ إذ حين تُحصر التجربة التعليميّة في نصّ واحد مغلق، تُفقد المتعلّمين فرصة الانفتاح على تعدّديّة الأصوات، وتعلّم مهارات النقد، ومساءلة السائد. من هنا، يصبح الكتاب المدرسيّ أداةً لتثبيت النظام القائم، أكثر من كونه وسيلة لتحرير الفكر أو توسيع المدارك.
سياسات التأليف، من يقرّر ما نتعلّمه؟
غالبًا ما يُنظر إلى الكتاب المدرسيّ بوصفه منتجًا رسميًّا، يعبّر عن الدولة ومؤسّساتها التربويّة. لكنّ هذا الإنتاج ليس مجرّد فعل إداريّ؛ هو فعل سياسيّ وثقافيّ في آنٍ واحد، تحدّده اعتبارات متعدّدة تتجاوز الاحتياجات التعليميّة المباشرة. فالجهات المسؤولة عن تأليف الكتب المدرسيّة – سواء كانت وزارات التربية، أو لجان تأليف مركزيّة، أو دور نشر متعاقدة – لا تعمل في فراغ، ولكن ضمن سياق يخضع لتوازنات أيديولوجيّة، وقيود مؤسّسيّة، واعتبارات تتعلّق بالهويّة الوطنيّة، والسياسات الثقافيّة، والرقابة.
تؤدّي هذه الاعتبارات إلى تحكّم شديد في محتوى الكتاب واختيار مضامينه بعناية، من حيث ما يجب أن يُقال، وما يجب أن يُسكَت عنه. ويظهر ذلك بوضوح في تغييب قضايا تُعدّ مثيرة للجدل، مثل المساواة الجندريّة، أو الحقوق المدنيّة، أو التنوّع الدينيّ والثقافيّ، تحت ذريعة المصلحة العامّة أو حماية النسيج الاجتماعيّ. لكنّ هذا التغييب لا يخلو من أثر، إذ يُعيد تشكيل وعي المتعلّمين ضمن أطر ضيّقة، ويغلق أمامهم إمكانات التفكير الحرّ والانفتاح النقديّ.
ولا يقلّ أهمّيّة عن ذلك، غياب صوت المعلّمين والمتعلّمين أنفسهم عن عمليّة إنتاج الكتاب. ففي كثير من الأحيان، تُعدّ الكتب من دون إشراك الممارسين اليوميّين للعمليّة التعليميّة، ما يُنتج فجوة بين النصّ وواقع الصفوف. وهنا، تتحوّل المناهج إلى أدوات إسقاط من الأعلى، لا أدوات حوار مع الواقع، ما يكرّس الطابع التلقينيّ للتعليم، ويُضعف فرص التفاعل الحيّ مع المعرفة.
الثمن الخفيّ لاحتكار المعرفة
يفرض اختزال التعلّم في الكتاب المدرسيّ رؤية ضيّقة إلى المعرفة، ويخلّف أثمانًا تربويّة وثقافيّة عميقة تتسرّب إلى بنية الصفّ، وعلاقات التعلّم، وأدوار المعلّمين والمتعلّمين. فالاحتكار المعرفيّ يعني غياب التنوّع، ويُنتج بالضرورة نوعًا من الخضوع للسلطة الرمزيّة للنصّ، بما يُقيّد فضاء التفكير النقديّ، ويُضعف قدرة المتعلّمين على مساءلة المعلومات، أو التشكيك في المسلّمات.
يعزّز هذا الشكل من التعليم ثقافة التلقين، ويُعيد إنتاج أنماط الطاعة المعرفيّة؛ إذ يُدرّب الطلّاب على حفظ المحتوى وتكراره، لا على التفاعل معه أو بناء فهمهم الخاصّ. كما يُضعف دور المعلّم بوصفه مُيسّرًا ومرشدًا، ويختزله في دور الناقل والشارح؛ وهو ما يقلّص فرص الإبداع التربويّ، ويعطّل إمكانات استثمار السياقات المحلّيّة، والخبرات الحياتيّة، والتجارب الواقعيّة.
من ناحية أخرى، يؤثّر احتكار المعرفة في العدالة التعليميّة، إذ تُبنى كثير من السياسات التعليميّة والتقويم والمخرجات المدرسيّة على الكتاب المدرسيّ باعتباره مقياسًا مرجعيًّا وحيدًا؛ ما يعني أنّ كلّ من لا يمتلك هذا المرجع – لسبب اقتصاديّ أو جغرافيّ أو لوجستيّ – يجد نفسه خارج منظومة التعلّم. وهكذا يصبح الكتاب المدرسيّ أداة لإعادة إنتاج الفجوات بدل ردمها، وتثبيت الفوارق بدل تقليصها. ولا نعني أنّ البديل بالضرورة إنكار دور الكتاب المدرسيّ، ولكنّنا نطالب بإعادة النظر إلى موقعه داخل منظومة التعلّم: من مركز أوحد إلى جزء من منظومة مفتوحة ومتعدّدة الأصوات والمصادر.
وقد لمست ذلك شخصيًّا حين حاولت في إحدى الحصص توسيع النقاش التاريخيّ بما يتجاوز ما هو مكتوب في الكتاب المدرسيّ، عبر ربط المفهومات بأحداث معاصرة وأسئلة مفتوحة تستفزّ تفكير الطلّاب. كان التفاعل لافتًا، وظهرت بوادر حقيقيّة على التعلّم العميق. لكنّ المفارقة أنّني تلقّيت لاحقًا تنبيهًا بأنّني تأخّرت عن الجدول الزمنيّ، وعليّ تسريع وتيرة الشرح للّحاق بالمحتوى المقرّر. عندئذ، أدركت أنّ جودة التعلّم لم تكن المعيار الحقيقيّ، بل الالتزام الكامل بالكتاب ومحتواه الثابت. فلا يُقصى الطالب وحده حين يُحرم من الموارد، وإنّما المعلّم أيضًا حين يُمنع من الاجتهاد والتوسّع.
التمثيل والتهميش في محتوى الكتاب
يمثّل محتوى الكتاب المدرسيّ مرآة لما تعتبره المؤسّسات التربويّة جديرًا بالمعرفة. غير أنّ هذه المرآة كثيرًا ما تعكس فئات وسرديّات محدّدة، وتتجاهل فئات أخرى أو تُقصيها. فالتمثيل في المناهج – بما في ذلك الأسماء والصور والشخصيّات والقضايا وأنماط الحياة – فعل انتقائيّ يُعبّر عن رؤية ثقافيّة واجتماعيّة معيّنة، غالبًا ما تنحاز إلى المهيمن والمكرّس.
في العديد من الكتب المدرسيّة، لا نجد تمثيلًا كافيًا للنساء، ولا للأشخاص ذوي الإعاقة، أو لسكّان الأقاليم ومشكلاتهم، أو للأقليّات الدينيّة واللغويّة، أو للاجئين. وإن وُجد هذا التمثيل، فكثيرًا ما يأتي بصورة نمطيّة، إمّا لإثبات حضور رمزيّ، أو لتأكيد أدوار تقليديّة مسبقة. فمثلًا، تُقدَّم النساء غالبًا في أدوار أُسريّة، وتُغيّب أدوارهنّ العلميّة أو القياديّة، ويُختصَر الريف في الزراعة والتخلّف، بينما تُربط المدن بالحداثة والتقدّم.
ففي مقرّر التاريخ الحديث للمرحلة الثانويّة مثلًا، لم يظهر نموذج المرأة المصريّة المناضلة، أو دور النساء في الثورات أو الحركات الوطنيّة، حتّى في فترات مهمّة مثل ثورة 1919. بينما يتمّ التركيز على أدوار الرجال بصفتهم قادة سياسيّين، وزعماء وطنيّين ومفكّرين، أو قادة عسكريّين. وهكذا، فإنّ هذا التمثيل يُقصي صورة هامّة من الواقع التاريخيّ.
وفي السياقات الأخرى، كثيرًا ما تُختزل صورة المرأة في أدوار تقليديّة محدّدة، مثل تحضير الطعام أو شرح الدروس، بلا أيّ إشارة إلى نساء في مواقع علميّة أو إبداعيّة أو ميدانيّة، في حين تتنوّع أدوار الشخصيّات الذكوريّة بين الطبيب والمهندس والكاتب والمخترع. هذا النوع من التمثيل لا يعكس تحيّزًا في المحتوى فحسب، بل يكرّس أيضًا صورة ذهنيّة ضيّقة عن المجتمع، ويحدّ من آفاق التعلّم والنمذجة الإيجابيّة لدى المتعلّمين والمتعلّمات.
تعكس الاختلالات في التمثيل غيابًا معرفيًّا، وتكرّس إحساسًا بالإقصاء لدى فئات واسعة من المتعلّمين الذين لا يجدون أنفسهم في ما يتعلّمونه. كما تؤثّر سلبًا في بناء تصوّرات صحّيّة ومتوازنة لدى الجميع، وتعوق إمكانات التربية على التنوّع والاحترام والمواطَنة الشاملة.
دعوة إلى إعادة التفكير في مركزيّة الكتاب
ليس الهدف من نقد الكتاب المدرسيّ الدعوة إلى إلغائه تمامًا؛ ولكن إلى مساءلة موقعه داخل العمليّة التعليميّة، وموقع المعرفة نفسها داخل الصفّ. فيمكن للكتاب، بوصفه أداة تعليميّة، أن يُسهم في تنظيم محتوى التعليم، وتوفير إطار مرجعيّ للطلّاب، لكنّ الإشكال يتولّد حين يتحوّل إلى نصّ جامد يُفرض على الجميع، ويُبنى عليه التقييم، وتُحدَّد بواسطته ملامح النجاح أو الفشل. هنا، يصبح الكتاب المدرسيّ أداة لتثبيت المفهومات الضيّقة التي لا تعكس التعدّديّة المعرفيّة، وتُقلّل من فرصة اكتساب مهارات التفكير النقديّ والابتكار لدى الطلّاب.
إعادة التفكير في مركزيّة الكتاب تعني أوّلًا الاعتراف بأنّ المعرفة ليست ثابتة ولا محايدة؛ إنّما هي نتاج سياقات اجتماعيّة وثقافيّة متغيّرة. وثانيًا الإيمان بأنّ التعلّم لا يتحقّق بالاستهلاك السلبيّ للمحتوى، ولكن عبر التفاعل والسؤال والمقارنة والانفتاح على مصادر متعدّدة. وثالثًا تعزيز دور المعلّم باعتباره فاعلًا تربويًّا، يمتلك حرّيّة اختيار الأدوات، وتكييفها بحسب حاجات المتعلّمين، وخصوصيّات السياق.
مثال على ذلك، في ظلّ الظروف القاسية التي يمرّ فيها الشعب الفلسطينيّ، حيث تُدمّر المدارس ويهجّر الطلّاب بسبب النزوح أو الحروب، نجد المعلّمين يوظّفون الكتاب المدرسيّ مع الوسائط المتعدّدة بطرائق مبتكرة. على الرغم من غياب البيئة التعليميّة التقليديّة، استخدموا الإنترنت أو الهواتف المحمولة – في حال توفّرها – لنقل الدروس، مستفيدين من مقاطع الفيديو والموادّ التفاعليّة لتعويض نقص الموادّ الدراسيّة. كما استفادوا من الحكايات الشفويّة، والتعلّم من التجارب اليوميّة لتعزيز التفاعل والنقد لدى الطلّاب؛ وهو ما جعل التعلّم أكثر مرونة وتفاعلًا، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الكتاب المدرسيّ باعتباره المصدر الوحيد.
في هذا السياق، يصبح الكتاب المدرسيّ واحدًا من بين عدّة مداخل للتعلّم، إلى جانب التجربة، والنصوص الحرّة، والوسائط الرقميّة، والمشروعات، والحوار، والانخراط في الواقع المحلّيّ. كما تفتح هذه المقاربة المجال أمام تربية تعدّديّة، تُدرّب المتعلّمين على النقد والتأويل، وليس الحفظ والتكرار، وعلى مساءلة السلطة بدلًا من الخضوع لها، سواء كانت تلك السلطة نصًّا، أو معلّمًا، أو مؤسّسة. إنّ ما نحتاج إليه اليوم هو إعادة التفكير في فلسفة التعلّم، بما يتيح لنا توجيه العمليّة التربويّة نحو قيم التعدّديّة والنقد، ومحاولة تهيئة بيئة تعليميّة تتقبّل التحليل النقديّ وتطوير مهارات التفكير المستقلّ، حتّى وإنّ كان ذلك يتطلّب وقتًا طويلًا لتغيير الوعي الاجتماعيّ على المدى البعيد.













 نشر في عدد (21) صيف 2025
نشر في عدد (21) صيف 2025