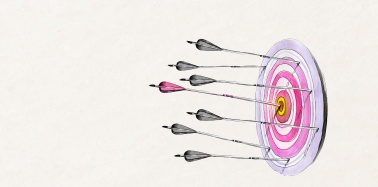في بداية مسيرتي المهنيّة أستاذًا للتعليم الابتدائيّ، لم أكن مُدركًا تمامًا حجم التحدّيات الكامنة خلف مفهوم "الصعوبات التعلّميّة". كنت أظنّ، مثل كثيرين، أنّ كلّ طفل قادر على التعلّم بالطريقة نفسها، إذا ما وُفّرت له الشروحات الكافية والانتباه اللازم. لكنّ تجربتي مع صفّ ضمّ عددًا من المتعلّمين الذين يعانون صعوبات تعلّميّة، غيّرت رؤيتي جذريًّا، لا إلى التعليم وحسب، بل إلى فهمي للانضباط والدافعيّة ودور المعلّم.
البدايات: صفّ خارج التوقّعات
كان الصفّ الذي أُسنِد إليّ مكوّنًا من 39 تلميذًا، وذلك في المجال القرويّ، من بينهم 15 على الأقل وُصِفوا بأنّهم "يواجهون صعوبات في التعلّم". لم تكن هناك ملفّات دقيقة توضّح طبيعة هذه الصعوبات، ولا تشخيصات رسميّة أو خطط دعم فرديّة. وحدها الملاحظات العامّة من بعض المعلّمين السابقين كانت تقودني: "فلان لا يركّز... فلانة لا تكتب... هذا لا يحفظ...".
في البداية، اعتمدت ما كنت أظنّه أنجع الوسائل: تبسيط الدروس، وإعادة الشرح، والتقويم المستمرّ، والتحفيز بالمكافآت، وحتّى التقرّب العاطفيّ. وعلى الرغم من ذلك، بقي عدد من المتعلّمين غير منخرطين، يبدون لامبالاة، وبعضهم تحوّل إلى مصدر "فوضى" داخل الصفّ. بدا وكأنّ شيئًا خفيًّا يحول دون اندماجهم. كانت اللحظة التي بدأت أتساءل فيها: هل نتحدّث عن صعوبة تعلّم، أم عن صعوبة انضباط؟ أم هما وجهان لعملة واحدة؟
الفوضى بوصفها عَرَضًا وليس جوهرًا
أحد أصعب التحدّيات كان التعامل مع ما يُوصَف عادة بـ"الفوضى الصفّيّة". المتعلّمون الذين يعانون صعوبات تعلّميّة، غالبًا ما يظهرون سلوكيّات مزعجة: التشتّت والكلام الجانبيّ والتحرّك الزائد، أو حتّى العنف أحيانًا. في البداية، كان ردّ فعلي تقليديًّا: التحذير والعقاب والخصم من النقاط والجلوس في الزاوية. لكن، شيئًا فشيئًا، بدأت أفهم أنّ هذه السلوكيّات ليست المشكلة، بل هي العَرَض.
كان أحد المتعلّمين يُقاطعني باستمرار، بأسئلة بدت في ظاهرها بسيطة أو غير ذات صلة. لكن، حين خصّصت له بعض الوقت خارج الحصّة، اكتشفت أنّه يعاني اضطرابًا في فهم التعليمات المكتوبة، وأنّه يُخفي قلقه خلف مزاح مستمرّ. آخر كان يرفض حلّ التمارين، ليس لأنّه لا يريد، بل لأنّه لا يستطيع القراءة بطلاقة، ويشعر بالخجل من ذلك أمام زملائه.
ومن هنا بدأت رحلة البحث عن استراتيجيّات بديلة، تُمكّن هؤلاء المتعلّمين من الانخراط.
التقنيّات التي ساعدت
-
- التعليم التفريقيّ (Differentiated Instruction):
في إطار تفعيل مبادئ التعليم التفريقيّ، اعتمدت الحصّة لتتضمّن أنشطة متنوّعة، تراعي الفروق الفرديّة وأنماط التعلّم لدى المتعلّمين. ففي درس مخصّص لمكوّن التعبير الكتابيّ حول "وصف المكان"، وُزِّع المتعلّمون إلى ثلاث مجموعات بحسب تفضيلاتهم وقدراتهم: أنجزت المجموعة الأولى إنتاجًا كتابيًّا لوصف مكان مألوف، بينما تولّت المجموعة الثانية وصف صورة لحديقة بشكل شفهيّ، أمّا المجموعة الثالثة فاستمعت إلى تسجيل صوتيّ يصف شاطئًا، وأجابت عن أسئلة للفهم. أتاح هذا التنويع في المهامّ فرصة لكلّ متعلّم للتعبير عن مكتسباته بأسلوب يلائم قدراته، كما مكّن إحدى المتعلّمات التي تعاني صعوبات كتابيّة، من عرض معارفها شفهيًّا بثقة، وأبرز مهارات متعلّم آخر يمتلك قدرة متميّزة على الفهم السمعيّ.
-
- استراتيجيّات التعلّم التعاونيّ:
طُبّقت استراتيجيّات التعلّم التعاونيّ بتقسيم الصفّ إلى مجموعات صغيرة، يتقاسم أفرادها المهامّ (القراءة، الاقتراح، الكتابة، المراجعة). في حصّة التعبير الكتابيّ، اشتغلت مجموعة على إكمال نصّ قصصيّ انطلاقًا من جملة افتتاحيّة، ما أتاح للمتعلّمين ذوي الصعوبات القرائيّة المشاركة في صياغة الأحداث شفويًّا، من دون الضغط عليهم للقراءة الجهريّة. وقد أسهم هذا في خفض القلق وتحفيز الانخراط.
-
- التقييم البديل:
بدلًا من الاختبارات الكلاسيكيّة، بدأت أقيّم بعض المهارات باستخدام مشاريع صغيرة، وعروض شفهيّة، أو حوارات. سمح ذلك للمتعلّمين الذين يعانون صعوبات كتابيّة، أن يُظهروا قدراتهم بطريقة أخرى. فمثلًا، لتجاوز محدوديّة التقويم الكتابيّ في قياس الكفايات الفعليّة للمتعلّمين، اعتمدت أشكالًا بديلة للتقويم، مثل التصنيف الشفهيّ للبطاقات. ففي درس التراكيب حول الجملة الاسميّة والفعليّة، صنّف المتعلّمون بطاقات جُمل وفق نوعها، ما مكّن متعلّمة تعاني رهبة الامتحانات الكتابيّة، من إظهار فهمها للمفهوم من دون عائق كتابيّ.
-
- استخدام الوسائط البصريّة والسمعيّة:
في إطار توظيف الوسائط المتعدّدة لدعم التعلّم، اعتمدت موارد بصريّة وسمعيّة متنوّعة، مثل مقاطع الفيديو التعليميّة، والبطاقات المصوّرة، والأناشيد الموجّهة، بهدف تنشيط الذاكرة وتعزيز الفهم لدى المتعلّمين، باختلاف أنماط تعلّمهم. فعلى سبيل المثال، خلال درس في مكوّن التراكيب حول "أنواع الجمل"، عُرض فيديو قصير يشرح الفرق بين الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة، تلاه نشاط لترتيب بطاقات مصوّرة تمثّل أمثلة من كلّ نوع، ثمّ استمع المتعلّمون إلى أنشودة تعليميّة تُرسّخ القاعدة في أذهانهم. وقد أسهم هذا التوظيف المتكامل للوسائط، في رفع مستوى التفاعل داخل الصفّ، ومكّن المتعلّمين ذوي الميول البصريّة أو السمعيّة، من استيعاب المفهوم بشكل أعمق وأكثر استدامة.
-
- العلاقة الإنسانيّة:
أكثر ما ساعدني في الحقيقة لم يكن تقنيّة بيداغوجيّة، بل بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام مع المتعلّم. حين يشعر الطفل أنّك تؤمن به على رغم عثراته، يبدأ هو نفسه في الإيمان بقدرته على التعلّم. وقد تجسّد ذلك في حالة متعلّم كان يتجنّب القراءة الجهريّة بسبب تلعثمه، إذ خصّصت له وقتًا فرديًّا للقراءة في بيئة آمنة، مع تقديم تعزيز إيجابيّ مستمرّ. بعد فترة، بادر المتعلّم إلى القراءة أمام زملائه، ما عكس تحسّنًا في ثقته بنفسه وفي مشاركته الصفّيّة.
ما لم ينجح
على الرغم من محاولاتي، فشلت في جوانب كثيرة:
- - العمل الفرديّ المرهق: كنت أحاول متابعة كلّ متعلّم على حدة، كما حدث مع تلميذ يعاني صعوبة في القراءة، إذ خصّصت له وقتًا إضافيًّا بعد الحصّة، لشرح الحروف ومتابعة النطق. لكن، مع كثرة الحالات المشابهة، وجدت نفسي غير قادر على الحفاظ على الوتيرة نفسها، ما أثّر في توازني المهنيّ.
- - غياب الدعم المؤسّسيّ: يعاني عدد من المتعلّمين مشكلات نفسيّة متفاوتة، مثل القلق المفرط، أو الخجل الشديد، أو ضعف الثقة بالنفس، وهي عوامل تؤثّر سلبًا في تحصيلهم الدراسيّ. غير أنّ غياب مختصّ نفسيّ داخل المؤسّسة أو في محيطها الجغرافيّ، جعل التعامل مع هذه الحالات يعتمد على اجتهادات شخصيّة وارتجال حلول آنيّة، مثل منح المتعلّم أدوارًا صغيرة لبناء ثقته، أو تخصيص لحظات حوار فرديّة للتخفيف من توتّره. إلّا أنّ محدوديّة البنية التحتيّة التربويّة، وندرة الكفاءات المؤهّلة، كلّها عوامل صعّبت وضع خطط دعم ممنهجة ومستدامة لهذه الفئة من المتعلّمين.
- - التعامل مع أولياء الأمور: شكّل التواصل مع الأسر تحدّيًا إضافيًّا، لا سيّما في ظلّ ضعف الوعي بصعوبات التعلّم، وغياب الخدمات الداعمة في المنطقة. ففي بعض الحالات، رفض أولياء الأمور الاعتراف بالمشكلة، معتبرين أنّ الأمر "مجرّد تقصير مؤقّت"، وفي حالات أخرى، عبّر الأهل عن رغبتهم في المساعدة، لكن حالت ظروفهم المعيشيّة، وانشغالهم بالأعمال الفلاحيّة، من دون توفير المتابعة اللازمة. هذه المعطيات جعلت أيّ تدخّل مدرسيّ محدود الأثر خارج جدران المؤسّسة.
الانضباط والدافعيّة: علاقة معقّدة
ما أدركته لاحقًا أنّ المتعلّم الذي يعاني صعوبات في التعلّم، غالبًا ما يُساء فهمه من طرف المعلّم، ويُصنّف "مشاغبًا" أو "كسولًا". هذا التصنيف يُدمّر دافعيّته الذاتيّة، ويقوّي لديه شعور العجز والفشل. في المقابل، حين يُمنح مساحة للفهم والتجريب والتعبير، تبدأ استجابته في التغيّر. فعلى سبيل المثال، أُسنِد إلى أحد المتعلّمين في الصفّ الخامس، والذي كان يعاني صعوبة في القراءة ويُعاقب باستمرار على سلوكيّاته الصفّيّة، دور يتمثّل في إدارة نشاط "كرسيّ القارئ"، وتشجيع زملائه أثناء القراءة. هذا التدخّل البسيط عزّز شعوره بالانتماء والأهمّيّة، وأثار لديه رغبة تدريجيّة في الانخراط الفعّال، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى انضباطه.
تُبرز هذه التجربة أنّ الانضباط لا يتحقّق بالعقوبة، بل بانخراط المتعلّم في معنى ما يقوم به. حين يرى هدفًا شخصيًّا، أو يشعر أنّه جزء من جماعة، أو أنّه موضع تقدير، يبدأ تدريجيًّا في الالتزام بقوانين الصفّ.
التأمّل الأخير: كيف نُعيد تعريف "النجاح"؟
في نهاية العام، لم يكن هؤلاء المتعلّمون قد "لحقوا" بزملائهم بالمعايير الكلاسيكيّة. بعضهم لم يقرأ بعد بطلاقة، وآخر لا يكتب جملة من دون أخطاء. لكنّهم كانوا يأتون إلى الصفّ بفرح، يشاركون ويقترحون ويبدعون بطريقتهم.
ربّما كان النجاح الحقيقيّ في هذا التحوّل الهادئ: من طفل مهمّش إلى متعلّم له صوت، وله مكان.
في ظلّ غياب سياسات مدرسيّة داعمة، تبقى تجربة المعلّم مع هؤلاء المتعلّمين مغامرة فرديّة، محفوفة بالتعب، لكنّها مليئة بالدروس الإنسانيّة العميقة.
إدارة صفّ فيه متعلّمون يعانون صعوبات تعلّميّة ليست مجرّد مسألة تقنيّة، بل موقف تربويّ وأخلاقيّ، يتطلّب شجاعة في النظر إلى الطفل لا كما نريده أن يكون، بل كما هو، بكلّ تعقيداته ونقاط قوّته الخفيّة.













 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025