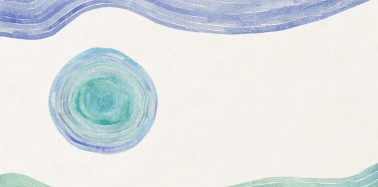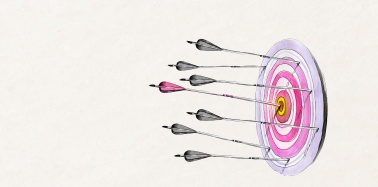هل يمكن أن نتخيّل مدرسة لا يُستثنى فيها أحد؟ مكانًا يتعلّم فيه الجميع، مهما كانت قدراتهم أو خلفيّاتهم أو احتياجاتهم؟ التعليم الشامل ليس توجّهًا حديثًا فحسب، بل فكرة إنسانيّة تُعيد تعريف معنى العدالة في المدرسة. فهو يرفض فكرة "الطالب العاديّ" بوصفها المعيار الوحيد للتعلّم، ويحتفي بالاختلاف بوصفه غنى حقيقيًّا لأيّ مجتمع تعليميّ. ومن هنا يصبح التعليم الشامل وعدًا بالمساواة، ومسؤوليّة كبيرة تقتضي العمل الجادّ لتحويل هذا الوعد إلى واقع ملموس داخل الفصول الدراسيّة.
تنبع جذور فكرة التعليم الشامل من تحوّلات كبرى في الفكرين التعليميّ والحقوقيّ منذ منتصف القرن العشرين، حين أدرك العالم أنّ الاستبعاد في التعليم – سواء أكان لأسباب جسديّة أم اجتماعيّة أم ثقافيّة – شكل من أشكال الظلم. وبعد إعلان "سالامانكا" عام 1994 الصادر عن اليونسكو، أُعيد النظر في مفهوم المدرسة العادلة، مؤكّدًا أنّ التعليم الشامل ليس رفاهيّة، بل حقّ أساسيّ لكلّ طفل.
وهكذا لم يعد السؤال: "هل نضع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة في المدارس العاديّة؟" بل أصبح السؤال الحقيقيّ: "كيف نُعيد تصميم المدرسة لتتّسع للجميع؟"
يقوم التعليم الشامل على فكرة ترى أنّ كلّ متعلّم قادر على التعلّم، ولكن بطرق مختلفة. وبدلًا من مطالبة الطلبة بالتكيّف مع نظام تعليميّ واحد، يُطلب إلى النظام أن يتكيّف مع الطلبة. وهنا يظهر الفارق بين المساواة والإنصاف: فالمساواة تعني إعطاء الجميع الشيء نفسه، بينما الإنصاف يعني منح كلّ متعلّم ما يحتاج إليه، ليصل إلى فرصة النجاح نفسها. وقد يبدو هذا الفرق تفصيلًا صغيرًا، لكنّه في الحقيقة يمثّل تحوّلًا كبيرًا في التفكير التربويّ. ففي الصفّ الشامل، لا يُقاس النجاح بمقارنة الطلبة بعضهم ببعض، بل بمقارنة كلّ طالب بتقدّمه الشخصيّ.
أكبر تحدّ في التعليم الشامل ليس قبول الفكرة، بل تحويلها إلى واقع فعليّ. فما الذي يمنع مدارسنا من أن تكون شاملة حقًّا؟ أوّل عائق يتمثّل في الفكر التقليديّ الذي يرى الطالب "الضعيف" مشكلة لا فرصة، وثانيها قلّة تدريب المعلّمين على أساليب التعليم المختلفة، وآليّات التقييم الشامل.
في عالم التعليم الحديث، يواجه النظام القائم على "الاختبارات الموحّدة" تحدّيات كبيرة، إذ يفترض أنّ جميع الطلبة يتعلّمون بالوتيرة نفسها، ويُقاسون بالمقياس ذاته، ما يثير تساؤلات حول إمكانيّة تحقيق الشموليّة في هذا السياق. فهل يمكن اعتبار هذا النظام شاملًا عندما نقيس جميع العقول بالامتحان نفسه؟ وعندما يكون الصفّ مكتظًّا بأكثر من أربعين طالبًا، كيف يمكن للمعلّم أن يُمارس التعليم الشامل من دون دعم إداريّ، أو أدوات تكنولوجيّة مناسبة؟
وعلى الرغم من هذه التحدّيات، أثبتت العديد من التجارب أنّ التعليم الشامل قابل للتحقّق، متى توفّرت رؤية واضحة واستراتيجيّات عمليّة. من بين هذه الاستراتيجيّات يبرز التعليم المتمايز الذي يقوم على تصميم أنشطة مرنة، تتناسب مع قدرات كلّ طالب. فالتعليم المتمايز لا يعني تدريس كلّ طالب على حدة، بل يعني تصميم أنشطة تسمح لكلّ طالب بالتعلّم وفق أسلوبه ووتيرته الخاصّة، مع ضمان مشاركة الجميع في نشاط مشترك يُحفّز التفاعل والتعاون.
في هذا السياق، يظهر التصميم الشامل للتعلّم (UDL) بوصفه نظامًا تعليميًّا حديثًا، يهدف إلى جعل التعليم متاحًا للجميع منذ البداية، عن طريق تنويع طرق العرض والاستجابة والتحفيز. فمثلًا، يمكن تقديم درس العلوم باستخدام الشرح اللفظيّ والعروض البصريّة والتجارب العمليّة والنصوص المكتوبة، لضمان أن يتفاعل كلّ طالب مع المحتوى بالطريقة التي تناسبه. كما يبرز التعاون بين المعلّمين عاملًا أساسيًّا في تحقيق التعليم الشامل؛ إذ يعمل معلّم المادّة مع مختصّ التربية الخاصّة على تخطيط الدروس وتنفيذها، ما يضمن استفادة جميع الطلبة من خبراتهما المتكاملة. ويمكن للمعلّمين تقسيم الصفّ إلى مجموعات صغيرة، أو تقديم دعم فرديّ أثناء العمل الجماعيّ، أو استخدام استراتيجيّات توجيه متنوّعة لكلّ طالب بحسب احتياجاته.
ولا يمكن إغفال دور التكنولوجيا المساعدة، إذ تمثّل اليوم أداة لتحقيق العدالة والإنصاف. فالتطبيقات الصوتيّة تساعد الطلبة الذين يواجهون صعوبات في القراءة، والوسائط التفاعليّة تدعم المتعلّمين البصريّين، وأدوات الترجمة الفوريّة تتيح للطلبة غير الناطقين بلغة الصفّ متابعة الدروس بسهولة. التكنولوجيا هنا لا تعمل بديلًا من المعلّم، بل وسيلة لتعزيز مشاركة كلّ طالب في التعلّم على نحو فعّال.
أمّا التقويم لغاية التعلّم، فيركّز على إدراك احتياجات الطلبة وتوجيههم نحو التحسين، بدلًا من الحكم عليهم. ويمكن للمعلّم استخدام ملفّات الإنجاز والملاحظات المستمرّة والمشاريع والعروض الشفهيّة، لتقييم تقدّم كلّ طالب وفق قدراته الخاصّة، وليس وفق معيار موحّد للجميع.
غير أنّ المدرسة الشاملة ليست مجموعة طرق فحسب، بل ثقافة مؤسّسيّة تعترف بالتنوّع، وتوفّر لكلّ طالب الأمان النفسيّ والشعور بالقبول. تُبنى بيئة التعلّم الشامل عندما يسود احترام الاختلاف، وتتحقّق المشاركة الحقيقيّة بين جميع عناصر المجتمع المدرسيّ – معلّمين وإدارة وأولياء أمور ومجتمع محلّيّ – لتصبح الصفوف نموذجًا مصغّرًا للمجتمع الإنسانيّ، تعكس تنوّعه وتُعلّم أبناءه مهارات العيش المشترك والتعاطف المتبادل.
تجارب من أرض الواقع
تمكّنت فنلندا من تحويل العدالة التعليميّة من شعار إلى حقيقة ملموسة، لتظهر اليوم نموذجًا يُحتذى به في العالم. يبدأ بناء العدالة من المعلّم نفسه، إذ يُدرّب منذ سنواته الجامعيّة الأولى على فلسفة التعليم الشامل، القائمة على احترام الفروقات الفرديّة وتقدير التنوّع. فالمعلّم الفنلنديّ ليس مجرّد منفّذ لخطّة جاهزة، بل شريك في إعداد الدروس بما يتناسب مع احتياجات طلّابه المتباينة.
كما تعتمد المدارس الفنلنديّة نظام خطط الدعم الفرديّة المستمرّ، والذي يُنفّذ بالتعاون بين المعلّمين والمختصّين وأولياء الأمور، مع تقديم ساعات دعم إضافيّة خلال اليوم الدراسيّ، لضمان تقدّم كلّ طفل وفق قدراته. ولأنّ كلّ طالب يحصل على الدعم المناسب من دون أن يشعر بالعزلة أو النقص، أصبحت الفروقات الفرديّة جزءًا من مخطّط التعلّم لا عائقًا أمامه.
وفي العالم العربيّ، يسير الأردنّ بخطوات متتابعة نحو تحقيق العدالة التعليميّة، إذ أُطلقت مبادرات نوعيّة مثل "مدارسنا صديقة لذوي الإعاقة"، والتي تسعى لتطوير البنية التحتيّة المدرسيّة، وتدريب المعلّمين على استراتيجيّات التعليم الدامج. كما حرصت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ برامج تُعزّز مفهوم التمييز الإيجابيّ في الصفوف، بما يضمن حصول كلّ طالب على الدعم الذي يستحقّه، ويعزّز تكافؤ الفرص.
وعلى مستوى الميدان، ظهرت مبادرات مدرسيّة لتفعيل الصفوف المساندة ودروس التقوية الفرديّة، مع استخدام الأدوات الرقميّة والوسائط التفاعليّة، لتسهيل التعلّم لدى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة (أصحاب الهمم). إلى جانب ذلك، يجري تطوير أساليب التقويم لتصبح أكثر مرونة وإنصافًا، ما يعكس توجّهًا نحو بناء رؤية مدرسيّة شاملة، تجعل العدالة في التعليم ثقافة تشاركيّة.
العدالة التعليميّة ليست قرارًا يُتّخذ، بل رحلة متواصلة من الوعي والممارسة. فقد تمكّنت فنلندا من إرساء ثقافة الشموليّة، ويسير الأردنّ بخطى ثابتة نحو نموذج يُوازن بين الجودة والإنصاف. يبقى التحدّي الأكبر أمام الأنظمة العربيّة اليوم جعل العدالة التعليميّة مشروعًا وطنيًّا مستدامًا، يرى في كلّ طالب فرصة للتقدّم والنماء، لا رقمًا في ملفّ التحصيل. فعندما تصبح المدرسة حاضنة للعدالة قبل التفوّق، يستعيد التعليم جوهره الحقيقيّ في بناء الإنسان الحرّ، والواعي بدوره في نهضة المجتمع والعالم من حوله.
الحديث عن العدالة في التعليم يتجاوز حدود عرض التجارب والممارسات، ويبدأ فعليًّا حين تتحوّل هذه الرؤى إلى سياسات تعليميّة مستدامة، تُنفّذ في كلّ مدرسة وكلّ صفّ دراسيّ. فاليوم، لا يكفي أن نتعلّم من تجربة فنلندا أو نحتفي بخطوات الأردنّ، بل يجب أن نتكاتف معًا من أجل تأسيس نهج عربيّ خاصّ بالعدالة التعليميّة، يستمدّ من واقعنا ويعكس تحدّياتنا. لذلك تظهر الحاجة الملحّة إلى تحليل عميق لكيفيّة تحويل الرؤية إلى سياسة، ثمّ ترجمة هذه السياسة إلى ممارسات يوميّة، تضمن ألّا يُترك أيّ طالب خارج حدود التعلّم والفرص المتاحة.
التقديمات والممارسات اللازمة لتمكين المعلّمين من التعليم الشامل
لتحقيق التعليم الشامل، لا بدّ من جهود متعدّدة تضع المعلّم في قلب العمليّة التعليميّة، بوصفه العنصر الأساسيّ في بيئة التعلّم. ولتمكينه من ممارسة التعليم الشامل بفاعليّة، ينبغي العمل على المحاور الآتية:
- 1. التدريب المهنيّ المستمرّ: بتنظيم ورش عمل دوريّة تُزوّد المعلّمين بالمعرفة التطبيقيّة، إذ يجب أن يتلقّوا تدريبات تتعلّق بالتعليم المتمايز، والتصميم الشامل للتعلّم، وأساليب التقييم البديل.
- 2. تخفيف الأعباء الإداريّة: ويتمثّل ذلك في توفير الوقت الكافي للتخطيط، إذ يجب أن يُمنح المعلّمون وقتًا مناسبًا للتخطيط التعاونيّ مع زملائهم ومختصّي الدعم التربويّ، إلى جانب توزيع المهامّ بعدالة، وتقليل الأعباء الإداريّة التي قد تؤثّر في قدرتهم على التركيز على عمليّة التعليم.
- 3. توفير أدوات التكنولوجيا المساعدة: وهي الأدوات التي تُسهّل التعلّم وتساعد في دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة، مع ضرورة تدريب المعلّمين على استخدامها بمرونة داخل الدروس.
- 4. بناء ثقافة مدرسيّة مشجّعة: أي تعزيز روح التجريب والابتكار، وخلق بيئة مدرسيّة تتيح للمعلّمين تجربة أساليب جديدة من دون الخوف من الفشل، وتوفير مجتمعات مهنيّة للتعلّم ومنصّات تتيح للمعلّمين تبادل الخبرات والتجارب.
- 5. تعزيز التعاون بين المعلّمين: وذلك بتشجيع العمل الجماعيّ، وتبادل الأفكار والاستراتيجيّات التي تدعم تعلّم الطلبة بمختلف قدراتهم، إلى جانب إشراك المعلّمين في عمليّات اتّخاذ القرار المتعلّقة بالتعليم الشامل.
ويبقى أنّ جوهر التعليم الشامل يتخطّى الطرق والأساليب، إلى رؤية أخلاقيّة ترى في كلّ طالب قيمة لا يمكن اختزالها بالدرجات أو التصنيفات. فعندما نُعلّم بإنصاف، نحن لا نمارس التدريس فحسب، بل نعيد بناء علاقتنا بالآخر المختلف. عندئذ تصبح المدرسة مكانًا للتعلّم، ونموذجًا مصغّرًا للعدالة الاجتماعيّة. فعندما يجلس الطالب في الصفّ ويشعر بأنّ جهده معترف به، وأنّ مهاراته لا تُقارن إلّا بتقدّمه الشخصيّ، يتحقّق الهدف الأسمى للتعليم، والمتمثّل في بناء الإحساس بالمسؤوليّة والانتماء. هنا يصبح التعليم الشامل أداة حقيقيّة لتشكيل مجتمع أكثر عدلًا وتعاونًا.
***
هل نحن مستعدّون للانتقال من "تعليم للجميع" إلى "تعليم من أجل الجميع"؟
هل نحن مستعدّون لتغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الاختلاف والقدرة، وجعل المدرسة مكانًا يفتح الآفاق لكلّ طالب، لا مجرّد مكان لاستكمال المناهج؟ هذا هو التحدّي الحقيقيّ للتربية والتعليم في القرن الحادي والعشرين.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026