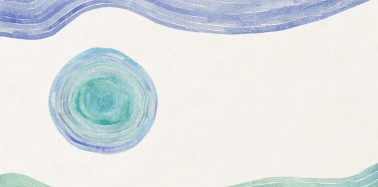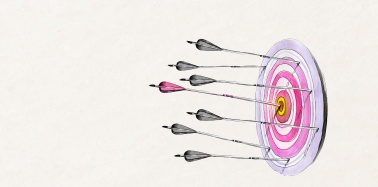إلى أيّ حدّ يمكن للتعليم أن يكون شاملًا، في عالم تتّسع فيه الفوارق الثقافيّة والاقتصاديّة، وتتشابك فيه مصادر اللا-مساواة؟ وهل تستطيع المدرسة، وهي مؤسّسة يفترض فيها أن تكون حارسة للقيم المعرفيّة والإنسانيّة، أن تحافظ على رسالتها الأخلاقيّة، حين تواجه واقعًا يعيد إنتاج الامتيازات الاجتماعيّة بدل تفكيكها؟ ثمّ، ما الأسس الفلسفيّة والتربويّة التي يمكن أن تُحوّل التعليم من مؤسّسة انتقائيّة تُميّز بين المتعلّمين، إلى مشروع إنسانيّ جامع، يضمن حقّ الجميع في الفهم والمشاركة والارتقاء؟ وأخيرًا، كيف يمكن للأدوات الرقميّة والذكاء الاصطناعيّ أن يعيدا تشكيل عمليّة التعلّم بحيث لا يُقصى فيها أحد، خصوصًا في الموادّ الإنسانيّة، مثل التاريخ والجغرافيا التي تتطلّب تمثّلًا بصريًّا وتحليليًّا عميقًا؟
تطرح هذه الأسئلة إشكالًا تربويًّا وفلسفيًّا متعدّد الأبعاد، لأنّها لا تتعلّق فقط بمحتوى الدرس أو طرق التدريس، وإنّما بطبيعة المدرسة ذاتها، وبمدى قدرتها على مقاومة العوامل التي قد تجعلها فضاءً يعمّق الفوارق بدل أن يخفّفها. فالتعليم الشامل، كما يظهر في الأدبيّات التربويّة المعاصرة، ليس فقط سياسة تقنيّة ولا تعديلًا إداريًّا، بقدر ما هو مشروع أخلاقيّ ومعرفيّ، يسعى لإعادة تعريف العلاقة بين المتعلّم والمعرفة، وبين المدرسة والمجتمع.
الأسس الفلسفيّة للتعليم الشامل
تقوم الفلسفة التربويّة الحديثة على أنّ التعليم الشامل لا يعتبر برنامجًا تقنيًّا، بقدر ما هو رؤيّة وجوديّة وأخلاقيّة. يشير الفيلسوف الأمريكي جون ديوي (1916) إلى أنّ المدرسة "ليست مكانًا للانضباط فحسب، بل حياة اجتماعيّة مُصغّرة". ومن هذا المنطلق، فالشموليّة لا تتحقّق إلّا حين تُبنى المدرسة وفق حاجات المجتمع، وبما يعكس تنوّع أفراده وتجاربهم الشخصيّة. كما إنّ المتعلّم ليس صفحة بيضاء، وإنّما كائن يحمل تاريخًا ومعنى وعوائق وإمكانات. ويقدّم المفكّر البرازيلي باولو فريري بُعدًا تحليليًّا مهمًّا، حين يميّز بين "التعليم المصرفيّ" و"التربية التحرّريّة". فالأوّل يُقصي، لأنّه يضع المتعلّم في موقع المتلقّي السلبيّ، بينما الثاني يشمل ويجمع ويحتضن، لأنّه يجعل من التعلّم حوارًا ووعيًا وإعادة إنتاج للمعرفة. يقول فريري (1970) في هذا الإطار: "التربية إمّا أن تكون ممارسة للحرّيّة أو أداة للقمع". ومن المنظور الشموليّ، فإنّ أيّ نظام تربويّ يُقصي المتعلّم من الحوار المعرفيّ، يفقد طبيعته الإنسانيّة. أمّا الفيلسوفة الأمريكيّة مارثا نوسباوم (2010)، فتطرح مفهومًا ثقافيًّا لشموليّة التعليم، قائمًا على نظريّة القدرات، مؤكّدة أنّ التعليم العادل "يبني في المتعلّم القدرة على التفكير النقديّ والخيال الأخلاقيّ". فالشمول لا يعني تعميم المناهج، وإنّما تعميم القدرة على الاستفادة منها، على الرغم من التفاوت الاقتصاديّ والاجتماعيّ.
التعليم في البيئات الثقافيّة والاقتصاديّة المتباينة
تبيّن الدراسات الحديثة أنّ الفوارق الاقتصاديّة تُعدّ أحد أهمّ عوامل الإقصاء التعليميّ. لأنّ المتعلّم الذي يعيش في بيئة هشّة اقتصاديًّا، غالبًا ما يفتقر إلى موارد رقميّة، أو فضاءات مناسبة للتعلّم، أو دعم أسريّ معرفيّ. وفي البيئات التقليديّة أو الريفيّة، يتراجع التعليم أحيانًا أمام هيمنة الثقافة الشعبيّة التي لا تهتمّ بالتعليم، أو ضعف حضور الكتب، أو محدوديّة التجهيزات المدرسيّة. وتؤكّد منظّمة اليونسكو (2020) أنّ التعليم الشامل يتأسّس على "تهيئة منظومة متعدّدة المستويات للدعم"، أي إنّ المدرسة مطالبة بتوفير استراتيجيّات مختلفة، تناسب التعدّد الداخليّ للقسم الواحد. فمن الخطأ التعامل مع القسم باعتباره كتلة متجانسة، خصوصًا في الموادّ التي تتطلّب تحليلًا وتمثّلًا بصريًّا، مثل التاريخ والجغرافيا. ويشير الفليلسوف الأمريكي أمارتيـا سِن (1999)، إلى أنّ العدالة لا تتحقّق بتوفير الموارد وحدها، وإنّما بتمكين الأفراد من تحويل تلك الموارد إلى قدرات فعليّة. وانطلاقًا من هذا المفهوم، يمكن القول إنّ الشموليّة التعليميّة تتحقّق فقط حين تُترجم الإمكانات التربويّة، إلى قدرة لدى المتعلّم على الفهم والتحليل والمشاركة.
نماذج دوليّة للتعليم الشامل
على المستوى العمليّ، قدّمت عدّة دول نماذج رائدة في التعليم الشامل. ففنلندا طوّرت تجربة تربويّة حوّلت المدرسة إلى فضاء يراعي الفوارق الفرديّة، ويمنح الدعم التربويّ داخل القسم وخارجه، من دون وصم أو تمييز. وتركّز التجربة الفنلنديّة على جعل التعلّم خبرة شخصيّة، على يد فريق تربويّ يتدخّل في اللحظة المناسبة. كما تعتمد على حذف الامتحانات الانتقائيّة، وتطوير أنشطة تجعل كلّ متعلّم قادرًا على بناء تجربته الخاصّة في التعلّم. أمّا كندا، وخصوصًا مقاطعة أونتاريو، فقد طوّرت نموذجًا يدعم التعليم متعدّد الثقافات، ويؤسّس لسياسات احتضان الاختلاف اللغويّ والدينيّ، بوصفه عنصرًا للقوّة التعليميّة. وفي كوريا الجنوبيّة، وعلى الرغم من صرامة المنظومة، أُدخلت برامج واسعة للتعليم الرقميّ التفاعليّ، مكّنت الفئات محدودة الدخل من الوصول إلى محتوى تعليميّ عالي الجودة، عن طريق منصّات حكوميّة ومجتمعيّة. في ضوء هذه النماذج، يتبيّن أنّ القاسم المشترك الذي يجب أن يتمحور حوله التعليم الشامل، يتمثّل في منح المتعلّم القدرة على الفهم والتحليل. والفهم هنا ليس فقط استيعاب المعلومة، وإنّما القدرة على ربط المعرفة بسياق الحياة، وتحويلها إلى أداة للوعي. والفهم، أيضًا، يمثّل المجال الذي تتساوى فيه الفرص أكثر ممّا تتساوى في الامتحانات أو الإمكانات الاقتصاديّة، لأنّه يعتمد على تنظيم عمليّات التفكير، لا على امتلاك الموارد.
تجربتي الشخصيّة في تدريس التاريخ والجغرافيا باستخدام الذكاء الاصطناعيّ
تُجسّد تجربتي الشخصيّة المتواضعة مثالًا على كيفيّة انتقال الفلسفة التربويّة من مستوى التنظير، إلى مستوى الممارسة الفعليّة داخل القسم وخارجه، إذ تتحوّل الشموليّة من مفهوم تجريديّ إلى بنية تعليميّة، تتكامل فيها الأدوات الرقميّة، وتتناغم فيها أدوار المدرّس والمتعلّم، ويتوسّع فيها فضاء التعلّم ليشمل المجالَين الواقعيّ والافتراضيّ. وقد اعتمدتُ على أدوات الذكاء الاصطناعيّ لإنتاج محتوى تعليميّ مبتكر، يقوم على خمس مكوّنات رئيسة:
1. إنتاج الدروس التفاعليّة: استخدمتُ أدوات الذكاء الاصطناعيّ، مثل برنامج Canva، لتوليد دروس تعتمد على الخرائط الذكيّة، والمحاكاة الرقميّة، والأسئلة التنبّؤيّة، والمعالجة البصريّة للمفاهيم الجغرافيّة والتاريخيّة. وهذا جعل الدرس قابلًا للفهم لدى مختلف أنماط المتعلّمين: البصريّين والسمعيّين، والمتعلّمين عبر المشاركة. وهذه بعض النماذج:
-
- مادّة التاريخ: التحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة في أوروبّا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي، https://bit.ly/4qUMbDE.
-
- مادّة الجغرافيا: المجموعات البنيويّة الكبرى في الأرض، https://bit.ly/43UWZbh.
-
- تقويم تشخيصيّ للمتعلّمين: https://bit.ly/3LOx1zI.
2. نقل الدرس خارج جدران القسم: لم يعد الدرس حدثًا مغلقًا داخل المؤسّسة، وإنّما أصبح تجربة ممتدّة عبر قناة واتسآب عامّة (https://bit.ly/4oN3HZd). مكّن هذا التحوّل التلاميذ من: إعادة مشاهدة الدروس، والتفاعل عن طريق أسئلة وأنشطة، وتلقّي محتوى إضافيّ، ومتابعة ما فاتهم من دروس داخل المدرسة. وقد أدّى ذلك إلى تقليص شعور الإقصاء لدى الفئات التي تعاني بُعد المسافة، وضعف الإمكانيّات، والظروف العائليّة المعقّدة، وصعوبات في الاستيعاب داخل القسم.
3. دمقرطة الوصول إلى المعرفة: جعل استخدام وسيلة بسيطة ومنتشرة مثل واتسآب، العمليّة التعليميّة ديمقراطيّة. لا حاجة إلى حواسيب أو اشتراك إنترنت قويّ، فأغلب التلاميذ يمكنهم التفاعل باستخدام هواتفهم المتاحة. وبذلك تحقّقت الفكرة التي تحدّث عنها فريري: تحويل المعرفة إلى ممارسة تحرّر المتعلّم من الحواجز الطبقيّة والثقافيّة.
4. من المدرّس الناقل إلى المدرّس المُنشئ (إعادة تعريف الدور البيداغوجيّ): بهذه التجربة، يتغيّر دور المدرّس من "ملقّن" إلى مصمّم معرفيّ (instructional designer)، وهو الدور الذي بدأ يفرض نفسه في التربية المعاصرة. فالمدرّس لا يعتبر فقط وسيطًا بين الكتاب والطالب، بقدر ما هو: مُنشئ للمحتوى، ومُنسّق للخبرات، ومُوجّه لحركيّة التعلّم، ومُيسّر لحوار نقديّ بين المتعلّمين. هذا التحوّل ينسجم مع رؤيّة ديوي الذي يعتبر المدرسة "مجتمعًا صغيرًا"، ومع فريري الذي يرى أنّ المدرّس محفّز للوعي، ومع سِن الذي يعتبر التعليم عمليّة توسيع لقدرة الفرد على الفعل في العالم.
5. الأثر في المتعلّم (بناء ذات قادرة على الفهم والتحليل): بالوصول المفتوح إلى المحتوى والتفاعل المستمرّ معه، يتحوّل المتعلّم من مستهلك للمعلومة إلى فاعل تعليميّ. والنتيجة: ارتفاع المشاركة، وتقلّص شعور الفئات الهشّة بالإقصاء، وتحسّن القدرة على التحليل في التاريخ والجغرافيا، وبناء علاقة جديدة بين المتعلّم والمعرفة، تتّسم بكونها علاقة فضول لا علاقة خوف. بهذا، تصبح تجربتي تطبيقًا عمليًّا لما يدعو إليه فلاسفة التربية: جعل المعرفة وسيلة للتحرّر، لا وسيلة للانتقاء أو الإقصاء.
نحو رؤيّة عربيّة للتعليم الشامل
يواجه التعليم الشامل في السياق العربيّ تحدّيات مضاعفة: تفاوت اقتصاديّ حادّ، وبنى مدرسيّة غير متساويّة، ومناهج لا تزال في كثير من الأحيان تعتمد على الحفظ بدل الفهم. لكنّ التجارب الفرديّة، مثل تجربتي، تُظهر أنّ التحوّل ممكن، حين يُنظر إلى التكنولوجيا بوصفها فرصة لإعادة توزيع المعرفة، لا مجرّد أدوات تقنيّة. ولصياغة رؤيّة عربيّة لشموليّة تعليميّة حقيقيّة، لا بدّ من:
- - بناء سياسات تربويّة تستلهم من نظريّة القدرات والذكاءات المتعدّدة.
- - تكوين المدرّسين على إنتاج المحتوى الرقميّ التفاعليّ.
- - ربط التعلّم المدرسيّ بالحياة اليوميّة.
- - تحويل المدرسة إلى فضاء ينظر إلى الاختلاف بوصفه عنصر ثراء.
- - جعل الذكاء الاصطناعيّ رافعة لتقليص الفوارق وليس تعميقها.
***
يتّضح أنّ التعليم الشامل ليس فقط سياسة تنهجها الدول، بقدر ما هو مشروع إنسانيّ يتعلّق بكيفيّة النظر إلى المتعلّم وإمكانيّاته. وتُظهر الفلسفات التربويّة الحديثة، من ديوي إلى نوسباوم وفريري، أنّ الشموليّة تتأسّس على منح القدرة على الفهم، لا على توزيع المناهج بالتساوي. أمّا التجارب الدوليّة فتؤكّد أنّ الشموليّة ممكنة حين تُدمج السياسات بالتكنولوجيا، وتُحترم الفوارق بوصفها جزءًا من الهويّة التعليميّة. وتأتي تجربتي الشخصيّة لتكشف أنّ التحوّل لا يبدأ من المؤسّسات المركزيّة فقط، وإنّما من المدرّس ذاته، حين يقرّر أنّ المعرفة حقّ، وأنّ التكنولوجيا جسر، وأنّ التعليم فعل تحرّر. ففي عالم تتّسع فيه الفوارق، يصبح المعلّم الذي ينتج محتوى تفاعليًّا، ويعتمد الذكاء الاصطناعيّ، ويجعل المعرفة متاحة للجميع، شريكًا في بناء تعليم عربيّ أكثر عدلًا وإنسانيّة.
المراجع
- Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Macmillan.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. (M. B. Ramos, Trans.). Continuum.
- Nussbaum, M. C. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs Humanities. Princeton University Press.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.
- UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026