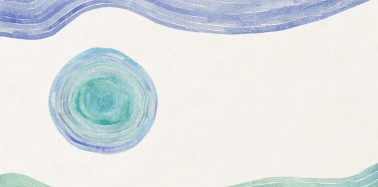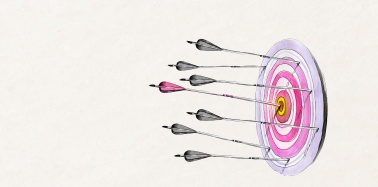يُطرح مفهوم التعليم الشامل اليوم بوصفه أفقًا طموحًا لتحقيق العدالة التربويّة، إذ يَعِد بمدرسة تتّسع للجميع من دون إقصاء، مهما تباينت قدراتهم وسياقاتهم. غير أنّ هذا الطموح الرفيع يحجب خلف لغته المتفائلة خطابًا رسميًّا، يميل إلى تبسيط التعقيد البشريّ، ويقنّن التفاوتات بدل أن يفكّكها. فحين تتحوّل فكرة "الشمول" إلى سياسة موحّدة تُطبَّق بمعايير تقنيّة صمّاء، تنقلب المقاصد إلى نقيضها: صفوف مكتظّة، ومناهج جامدة، وتوقّعات متعالية على الواقع الاجتماعيّ للمتعلّمين. من هنا يتجلّى التناقض الجوهريّ الذي يوجّه هذه المقاربة: هل يمثّل التعليم الشامل فعلًا مسارًا نحو الإنصاف التربويّ، أم يتحوّل إلى شعار لتبرير إخفاقات المنظومة، وتمرير بنى إقصاء جديدة أكثر دهاءً؟ لا تنبع مساءلة هذا المفهوم من نزعة تشكيكيّة، بل من معايشة يوميّة للميدان، حيث تُظهر التجارب الصفّيّة ومداولات المدرّسين، فجوة عميقة بين الرؤية الرسميّة والممارسة الفعليّة. ومن هذه الفجوة يتبدّى أنّ الإنسان، في تعدّده، لا يمكن اختزاله في مشروع إدماجيّ جاهز، بل يفرض إعادة تفكير جذريّة في معنى العدالة داخل المؤسّسة التعليميّة.
التعليم الشامل بوصفه خطابًا: ترويج للإنصاف وإضمار للتفاوت
عند تتبُّع الجذور الدلاليّة لمفهوم التعليم الشامل، يتّضح أنّه تبلور ضمن سياق دوليّ مدفوع بتعميم الحقّ في التعليم، خصوصًا منذ إعلان "التعليم للجميع" الذي رعته اليونسكو في تسعينيّات القرن الماضي، قبل أن يُعاد تأطيره ضمن أهداف التنمية المستدامة. تجسّد المفهوم آنذاك لفكرة تكافؤ الفرص، بوصفه حقًّا لكلّ طفل – مهما كانت ظروفه – في أن يجد مكانه داخل المدرسة النظاميّة (UNESCO, 2020). غير أنّ الخطاب الذي حمل هذا الشعار، وسوّقته المنظّمات الدوليّة الفاعلة مثل اليونسكو والبنك الدوليّ (The World Bank, 2022)، لم يكن محايدًا معرفيًّا أو سوسيولوجيًّا، إذ صوّر الكائن الإنسانيّ في هيئة مجرّدة قابلة للقياس والمعالجة التقنيّة، متجاهلًا البنى الاجتماعيّة والثقافيّة التي تنتج اللا - مساواة ذاتها، والتي يُزعَم السعي لتجاوزها.
ومع انتقال هذا الخطاب إلى السياق العربيّ، تعرّض مفهوم Inclusion إلى تأويل محدود في الترجمة والممارسة، وجرى اختزاله غالبًا في مجال "دمج ذوي الاحتياجات الخاصّة" أو "تكييف المناهج"، في حين أنّ مقصده الأصليّ أوسع بكثير، إذ يتعلّق بإعادة بناء المدرسة لتستوعب جميع المتعلّمين، في اختلافاتهم الاجتماعيّة والثقافيّة والمعرفيّة. وقد أسهم هذا التبسيط الاصطلاحيّ في إنتاج إبهام مضاعف، إذ تحوّل "التعليم الشامل" في الخطاب الرسميّ إلى شعار تقنيّ يُقاس بالمعايير الكمّيّة، لا الإنصاف الحقيقيّ (Booth & Ainscow, 2011).
يخفي خطاب التعليم الشامل، خلف مفرداته المتفائلة عن الحقّ والمساواة، توجّهًا تقنيًّا يعلي من منطق المعايير على حساب ثراء التجربة الإنسانيّة. فبدل النظر إلى الاختلاف بوصفه ثروة تتطلّب تعدّديّة مسارات، يُعاد تعريفه بوصفه "إشكالًا" ينبغي تدبيره داخل الصفّ، عن طريق استراتيجيّات معياريّة تختزل المتعلّم في متغيّر قابل للضبط، وتهمّش تموضعه الطبقيّ ورموز الهيمنة التي يواجهها داخل المدرسة. وبذلك لا يغدو التعليم الشامل مشروع عدالة فعليّة، بقدر ما يصير آليّة لإعادة إنتاج التفاوت في حلّة جديدة؛ إذ يُقاس النجاح بعدد "المُدمَجين" لا بجودة تعلّمهم أو إحساسهم بالانتماء، وتُختزل العدالة في "تساوي الفرص" داخل صفّ غير متكافئ أصلًا، فتتحوّل شعارات المشاركة والتمكين إلى ستار يغطّي لا - مساواة بنيويّة راسخة.
وحين يُفرَض على المعلّم "شمول الجميع" في فصل واحد من دون توفير شروط دعم كافية، يتحوّل الشمول إلى عبء يُفاقم الفشل بدل معالجته. ويغدو واجهة خطابيّة لتملّص المؤسّسة من مسؤوليّتها البنيويّة، إذ تُلقى الأعباء على المدرّس الذي يُطالَب بتحقيق المعجزات، داخل فضاء مكتظّ وزمن ضيّق ووسائل محدودة (Slee, 2011). وتُظهر الوقائع الميدانيّة أنّ مبدأ "احتواء الجميع في صفّ واحد"، يفترض ضمنيًّا قابليّة الفروق للذوبان داخل نظام موحّد، في حين تُعيد المدرسة صياغة الفروق الطبقيّة والمعرفيّة والنفسيّة في أشكال مستترة؛ فيواجه القادمون من بيئات فقيرة رموزًا خفيّة للوصم، تتجلّى في انخفاض توقّعات المعلّمين من قدراتهم، وفي النظرة النمطيّة التي تربط خلفيّتهم الاجتماعيّة بالضعف أو العجز عن الفهم، فضلًا عن الإقصاء اللغويّ والثقافيّ الضمنيّ الذي يظهر في نبرات الاستهجان، أو في التلميحات الساخرة حين يتحدّثون بلهجتهم أو يتقدّمون للمشاركة أمام الصفّ. ومع غياب بنية داعمة للتفريق النوعيّ، يتحوّل الشمول إلى شعار يطمس التباينات بدل أن يفكّكها.
من ثمّ، لا يُفهم التعليم الشامل إلّا بوصفه خطابًا يحمل وعودًا بالإنصاف، لكنّه يستبطن التفاوت، وينقل التناقض من مستوى النظام العامّ إلى داخل حجرة الصفّ ذاتها. فالإشكاليّة لا تكمن في الرغبة النبيلة للإدماج، بل في تحويل هذه الرغبة إلى آليّة فارغة تُدار بالمؤشّرات الإحصائيّة، بدل العدالة الاجتماعيّة المتجذّرة. لذا، فإنّ نقد هذا المفهوم لا يعني رفضه، بل يستهدف استرداد معناه الإنسانيّ الأصيل، وإعادة وصله بالسياقات الاجتماعيّة والمجاليّة التي تغذّي التهميش والحرمان، بدلًا من الاكتفاء بتزيينه بمفردات الإصلاح التربويّ.
الواقع الصفّي: تعثُّر الشمول أمام تحدّي التعدّد
يظهر الواقع التربويّ، عند رصده بعين المعلّم لا بتقرير المنظّر، بؤرة كثيفة للتناقضات. فالصفّ الواحد في مؤسّسة عموميّة قد يضمّ تلاميذ متباينين عمريًّا واجتماعيًّا، بعضهم يحمل أعباء الانقطاع والهشاشة، وبعضهم ينتمي إلى عائلات ميسورة. في هذه التوليفة بالغة التباين، يتجاوز الصفّ دوره بوصفه وحدة تعليميّة، ليصبح مرآة لتصدّعات المجتمع، حيث تتجاور الفوارق العمريّة والطبقيّة والرمزيّة داخل حيّز ضيّق، يفترض أنّ الجميع يتعلّمون فيه بالإيقاع والمضمون ذاته.
تتجسّد في هذه الأقسام صعوبة تحقيق الشمول التامّ، إذ لا يمكن للمراهق الذي يصارع قلق الهويّة، أن يتعلّم بالوتيرة نفسها التي يتقدّم بها شابّ يسعى لتعويض ما فاته. كما تُلقي التباينات الطبقيّة بثقلها على لغة الجسد، والثقة بالذات، والقدرة على الانخراط في التفاعل الصفّيّ. فالمتعلّم القادم من محيط مُترف، والمحفوف برموز الامتياز الثقافيّ، يتحدّث بثقة وطلاقة، بينما يقف نظيره الآتي من أحياء شعبيّة في موقع دفاع مستمرّ، يميل إلى المراقبة أكثر من المشاركة. هنا يتسلّل الإقصاء عبر العنف الرمزيّ الذي يفرضه الحقل المدرسيّ، حين يطبّق معايير النجاح نفسها على ذوات غير متكافئة في الأساس؛ ويتفاقم هذا العنف خاصّة، مع وجود ذوي الاحتياجات الخاصّة الذين يتعرّضون إليه من دون تكييف وافٍ، إذ تتعمّق المقارنة عبر أشكال التنمّر والسخرية التي تُضاعف هشاشتهم الرمزيّة.
تتحوّل هذه الفوارق يوميًّا إلى أنماط من الإقصاء غير المعلن: فمتى طُلب إلى الجميع إنتاج الإجابة، يصبح من يعجز عن ذلك مجرّد "ظلّ تربويّ" حاضر بالجسد غائب بالفعل. يتعلّم هؤلاء سريعًا آليّة الانسحاب غير المصرّح به، وتتحوّل المدرسة إلى مسرح لتكرار تجربة الفشل. وضمن هذا المشهد المتكرّر، يجد المعلّم نفسه أمام معضلة مستحيلة: أن يدرّس لمستويات اجتماعيّة وثقافيّة متداخلة في آن واحد، بمنهج موحّد وزمن ضيّق ووسائل محدودة. ومع كلّ محاولة للموازنة، يشعر بأنّه يستثني أحد الأطراف رغمًا عنه، لأنّ "الشمول" المُعلن لا يمتلك الإمكانات البنيويّة اللازمة لتحقيق الإنصاف الفعليّ.
يتفاقم هذا الإحساس أكثر عند النظر إلى المشهد الرمزيّ داخل الصفّ، حيث تتفاوت أصوات الحضور، وتمتلئ النظرات بحدّة الاختلاف الطبقيّ، وتتباين تمثّلات المعرفة الواحدة. فالمعرفة هنا ليست مادّة محايدة، بل مؤشّر إلى المكانة والاعتراف. وحين يتبنّى النظام التربويّ نموذجًا تعليميًّا واحدًا للجميع، فإنّه يرسّخ اللا - مساواة؛ فالمتعلّم الذي يجيد لغة المدرسة يُكافأ بالتقدير، بينما يُهمَّش من لا يملك رأسمال لغويًّا أو ثقافيًّا مماثلًا. وهكذا، يُنتج الصفّ تراتبيّة داخليّة، تُعيد توزيع الأدوار بين "المستحقّين" و"المتعثّرين"، ليتحوّل الشمول من مشروع دمج شامل إلى نظام دقيق للفرز الناعم.
ومن قلب الميدان، وفي قاعات الأساتذة بعد الحصص، تتكرّر هذه المفارقات بنبرة تجمع بين السخرية والإرهاق المهنيّ: "كيف أشرح النصّ ذاته لتلميذ في الخامسة عشرة وآخر في العشرين؟ وكيف أوازن بين من لم يطّلع على كتاب في حياته، ومن يتلقّى الدروس الخصوصيّة في ثلاث موادّ؟" ليست هذه التساؤلات شكوى فرديّة، بل تعبير عن وعي مهنيّ جمعيّ بقصور النموذج الرسميّ. فالمعلّم، وهو في مواجهة تعدّد غير مُؤطَّر ولا مدعوم، يدرك أنّ الشمول في صيغته المعلنة، مطالبة له بإنجاز ما تعجز المنظومة عن تحقيقه: دمج التناقضات ضمن زمن ضيّق ومنهج واحد وعتاد بيداغوجيّ متهالك.
ولا يقتصر الفشل هنا على حدود التعلّم، بل يمتدّ إلى العلاقات الرمزيّة داخل الفصل. فعندما يعجز النظام عن الاعتراف الصريح بالفروق، يخلق طبقات غير مرئيّة: "المجتهد" الذي يُمثّل القدوة، و"الضعيف" الذي يُنظر إليه على أنّه عبء إضافيّ، و"المشاكس" الذي يُختزل في صورة المتمرّد. هذه التصنيفات، وإن لم تُدوَّن رسميًّا، تُمارَس بقوّة في الحياة اليوميّة المدرسيّة، وتتحوّل مع مرور الوقت إلى جزء من اللغة الرمزيّة للفصل. وبدلًا من أن يعمل التعليم الشامل على تفكيكها، يعيد إنتاجها ضمن إطار "الدمج الشكليّ"، حيث يجلس الجميع في المكان ذاته، لكنّهم لا يتشاركون المعنى نفسه للتعلّم.
هكذا يتكشّف الانفصال بين الرؤية والممارسة: فبينما يرفع الخطاب الرسميّ شعار "تمكين الجميع"، يجد المعلّم نفسه في قلب منظومة تضعه خارج التمكين ذاته. وحين يُطالَب بتطبيق الشمول من دون دعم بنيويّ فعليّ، يتحوّل إلى منفّذ لعقد أخلاقيّ مستحيل؛ فيستبدل الإنجاز الحقيقيّ بالتبرير، والشمول الفعليّ بالاحتواء الرمزيّ، والتعليم الجوهريّ بالترقيع. وهنا تتجلّى المفارقة الكبرى: فالمشروع الذي رُفع لإعادة الاعتبار للإنسان، أصبح سببًا إضافيًّا في إنهاكه، داخل مؤسّسة تستهلك المثال لتبرير العجز. وبذلك، يبدو الصفّ الشامل بصيغته المقدّمة في السياسات، مجرّد بناء رمزيّ هشّ يُخفي وراءه أزمة بنيويّة أعمق.
نحو إعادة تعريف التعليم الشامل: العدالة بوصفها إنصافًا
يقتضي تجاوز مأزق التعليم الشامل إعادة تعريفه جذريًّا، لا باعتباره آليّة لاحتواء الجميع ضمن قالب موحّد، بل مشروعًا لإعادة تكييف البنية التربويّة، بما يتلاءم مع التعدّد البشريّ والاجتماعيّ. فالشمول الحقيقيّ لا يتحقّق بتوسيع الصفّ ليضمّ الأفراد المختلفين، بل بإعادة هيكلة المدرسة لتتيح لكلّ منهم التعلّم وفق إيقاعه الخاصّ، وتقدير اختلافه بوصفه قيمة مضافة لا عائقًا (Florian & Black-Hawkins, 2011). بذلك، يتحوّل جوهر السؤال من "كيف ندمج الجميع في النظام الحاليّ؟" إلى "أيّ نظام تعليميّ يحتاج إليه الجميع ليجدوا فيه مكانهم ونجاحهم؟"
في هذا الأفق، تستعيد العدالة معناها السوسيولوجيّ الأصيل، لا بوصفها مساواة شكليّة بين متعلّمين غير متكافئين، بل بوصفها إنصافًا يمنح كلّ فرد ما يلائمه تحديدًا، ليتعلّم ويشارك ويحقّق نجاحه الخاصّ. فالإنصاف يقوم على توزيع غير متماثل للموارد والدعم والاهتمام، لكنّه أكثر عدلًا في جوهره، لأنّه يعترف بالفروق الواقعيّة التي يتجاهلها الخطاب الرسميّ. هنا يصبح معيار جودة التعليم الشامل غير مرتبط بعدد المدمَجين في الصفّ، بل بمدى قدرة النظام على تحويل الاختلاف إلى مورد تربويّ مثمر، وعلى بناء علاقات تعليميّة قائمة على الاعتراف المتبادل، وقبول التنوّع بدل السعي للتماثل القسريّ.
من ثمّ، لا يمكن تحقيق هذا التحوّل من دون سياسات تربويّة، تستند إلى خصوصيّة الواقع الاجتماعيّ المحلّيّ بدل استنساخ الإملاءات الخارجيّة أو الشعارات المعلّبة. فالتعليم الشامل لن يصير مشروعًا راسخًا للإنصاف، إلّا إذا انتقل من كونه خطابًا فوقيًّا، إلى ممارسة قاعديّة تُصغي بإنصات حقيقيّ إلى صوت الميدان، وتمنح المعلّم سلطة المبادرة والقرار المهنيّ، بدل تقييده بالمعايير الجاهزة. عندها فقط تستعيد المدرسة وظيفتها الأخلاقيّة والمعرفيّة بوصفها فضاءً للاعتراف المتبادل، لا مختبرًا لتجريب مفاهيم مُستوردة بعيدة عن واقع المتعلّم.
المراجع
- UNESCO. (2020). Rapport mondial de suivi de l’éducation 2020 : Inclusion et éducation – Tous, sans exception.
- The World Bank. (2022). Inclusive Education.
- The World Bank. (2022). Inclusive Education. The World Bank. https://cutt.us/VELnU
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools (3rd ed.). Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813–828.
- Slee, R. (2011). The Irregular School: Exclusion, schooling and inclusive education. Routledge.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026