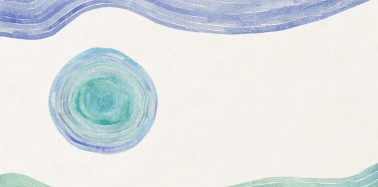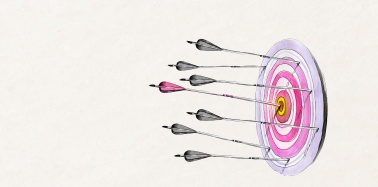فجأة، وجدت نفسي معلّمة لمادّة اللغة العربيّة لصفوف المرحلة الابتدائيّة، في مدرسة دوليّة تجمع مئات الطلبة من مختلف المشارب والبلدان. أقول فجأة لأنّني ذهبت لاستطلاع إمكانيّة التوظيف، فوجدت نفسي موظّفة في يومي الأوّل!
لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة في ذلك اليوم الحافل، فحين دخلت الصفّ تلو الصفّ وجدت طلّابي خليطًا من الألوان والألسن، من ماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان والفلبّين والصين، ومن مصر والأردنّ وفلسطين واليمن والسعوديّة وسوريا والإمارات والعراق، ومن بريطانيا وكندا والولايات المتّحدة، وحتّى من أستراليا، ويبدو أنّ القارّة الوحيدة التي غابت عن صفوفي كانت القارّة المتجمّدة.
نعم، غابت القارّة المتجمّدة عن الصفّ، لكنّ التجمّد حضر في عروقي وأنا أطالع وجوه طلبة بعضهم لا يفهم حتّى التحيّة باللغة العربيّة، وما زال يستطلع أولى خطواته على طريق أحرفها، فيما البعض الآخر يدرج بين الكلمات مثل عصفور كناريّ لا يكفّ عن التغريد. وبين هذا وذاك وجدت إدارة المدرسة تخوّلني بفعل ما أشاء، المهمّ أن تمضي حصّة اللغة العربيّة، وأن يكتسب الطلبة مفردات يرطنون بها أمام ذويهم، فتنال المدرسة، وأنا طبعًا، شيئًا من الإطراء والزهوّ.
انتبه من فضلك: أمامك منعطف حادّ!
هذا التخويل كان فخًّا ولا ريب، فخياراتي محدودة، والجدول الدراسيّ يطبق على عنقي وعنق الطلبة على السواء، بينما لا يجمع بين طلبتي جامع سوى أنّني معلّمتهم للعربيّة لهذا العام. لكنّني، وبعد مداولات مع رئيسة القسم، وإلحاح على معلّم اللغة الفرنسيّة – وهو مستجدّ مثلي ولديه بين طلبته ما لديّ من انعدام التجانس اللغويّ – ارتأينا تقسيم الطلبة إلى فئتين: في الأولى نبدأ العربيّة من الصفر، وفي الثانية نبدأها من التذوّق. وكذا الحال في الفرنسيّة، فيُصار لأستاذ الفرانكفونيّة أن يخصّص وقتًا للفئة الأولى، بينما أنشغل أنا بالفئة الثانية، وهكذا.
بعد التقسيم الذي اضطررنا إلى تغييره مرّات تحت وطأة ضغط الأهل وتقييمهم الشخصيّ لأبنائهم – لأنّ المدارس الدوليّة تُدار عادة برضى وليّ الأمر لا برضى المعلّم – عمدت إلى المنهاج. حملت كتبتي وأدواتي وأقلامي إلى قسم رياض الأطفال في المدرسة، ثمّ غزوت قسم اللغة العربيّة، مشفوعة بجهلي الذي تعاطفت معه المعلّمة المناوبة. فأنا مستجدّة، وليس لديّ علم مسبق بالحدود الدوليّة الفاصلة بين الأقسام الدراسيّة، فغنمت من البطاقات الملوّنة، والصور واللوحات الكبيرة، والمكعّبات الخشبيّة، وألعاب الفكّ والتركيب التي تتقافز حروف العربيّة بينها، الكثير الكثير، حتّى أمسكت بي مديرة القسم بالجرم المشهود.
الشاهد أنّ تلك اللحظة كانت حاسمة ومصيريّة في وظيفتي، فالمديرة التي اتّسعت عيناها هلعًا من غنائمي، لم تلبث أن تعاطفت مع أهدافي النبيلة في تقديم العربيّة إلى طلّابي، بما يتناسب مع مستواهم لا ما يتناسب مع المنهاج. ثمّ إنّها أسبغت عليّ من تجربتها التعليميّة ونصائحها الكثير، وودّعتني داعيةً إيّاي إلى زيارتها دائمًا، والسطو على ما أحببت من وسائل تعليميّة وإثرائيّة.
وهكذا انطلقت مع الفئة الأولى، وأطلقنا عليها "المجموعة الخضراء"، من الصفر. والصفر بالنسبة إلى طلّاب متمرّسين بالكتابة بالإنجليزيّة، يبدأ من اتّجاه كتابة اللغة العربيّة وقراءتها، وليس من الحرف الأوّل. واعتمدنا في أوّل خمس دقائق من الحصّة الاستماع إلى أنشودة عن أحرف العربيّة، والتفاعل معها بالرقص والحركة، مع مراعاة ضرورة سيرنا بسرعة، بما يؤهّلنا لتجاوز الحروف والحركات إلى المدود، فالكلمات فالجمل.
أمّا الفئة الثانية، وأطلقنا عليها "الفئة الزرقاء"، فقد كانت تملك رصيدًا من القراءة لا الفهم، وقدرة على الكتابة لا الضبط، فالتزمت معها بالنزر اليسير من المنهاج، وخصوصًا الجزء المتعلّق بالقراءة، وما يتلوه من فهم واستيعاب. ثمّ أرفقت المنهاج بقصائد شعريّة قصيرة الأبيات، طريفة المعنى، خفيفة الاستذكار، بهدف تأسيس ذاكرة لغويّة مرتبطة بالعربيّة ومفرداتها، ونحت ما استطعت من ضبط الحركة وتجاوز اللحن، حتّى تطوّر الأمر بنا إلى مسابقة مطارحة شعريّة بين ما حُفظ من قصائد، وكثيرًا ما تخلّلتها الهفوات المضحكة والمساجلة العرجاء.
الشمول لا يفسد عذوبة العربيّة
في الواقع، الآن وبعد مرور سنوات على هذه التجربة، يبدو الحديث عنها سهلًا، لكنّها لم تكن بمثل هذه السلاسة حينها. يُدرك معلّمو اللغة العربيّة، ممّن تتلمذوا في بيئة عربيّة وعملوا في مدارس عربيّة، أنّ العمل في بيئة متنوّعة لغويًّا وثقافيًّا هائل الصعوبة كثّ التحدّيات. فبينما يجتمع عند العرب هدف إتقان العربيّة، تختلف أهداف الطلبة وأولياء أمورهم في المدارس الدوليّة؛ فهناك من يريد لابنه أن يُرتّل القرآن كأنّه السُّديس في صحن الحرم المكّيّ، وهناك من تقف القاف عنده عالقة عند الكاف، أو الضاد عند الدال، أو الذال عند الظاء والعكس. وهناك من يفتقد العربيّة والإنجليزيّة، فتجد نفسك أمامه مضطرًّا إلى لغة الإشارات. وهناك من ينطلق في النطق ولا ينطلق في الفهم.
ليس ذلك فحسب، بل هناك أيضًا منهاج إمّا عربيّ خالص معتمد من إحدى الدول العربيّة (يمنيّ، سعوديّ، فلسطينيّ، أردنيّ)، أو منهاج لغير الناطقين بالعربيّة، أخرجه وأنتجه ناطقون بها، يطلب فيه من المعلّم، خلال خمس حصص أسبوعيّة، تطوير مهارات الاستماع والتحدّث والقراءة والكتابة، وما تحت السواهي والدواهي من تمييز الأصوات، وفهم المنطوق، وتحليل التراكيب اللغويّة، والتعبير الشفهيّ، والتواصل والمحادثة، والضبط والخطّ والإملاء والهمزات وغيرها الكثير. ما يجعل أيّ معلّم يتساءل: "كيف يمكن أن تتّسع العربيّة لتكون لغة للجميع؟"
لكلّ طريقه وطريقته
وعلى الرغم من تقسيم الطلبة إلى فئتين، ظلّ التباين داخل كلّ فئة واضحًا وحاضرًا، الأمر الذي استدعى تدخّلات وأساليب تدريس مختلفة. وسرعان ما تحوّلت الدروس إلى سلّم موسيقيّ يتحرّك صعودًا ونزولًا، بين الحسّيّ والسمعيّ والمرئيّ والتفاعليّ، في مسارات متعدّدة للتعلّم يجمعها هدف واحد: أن يصل كلّ طالب إلى العربيّة بطريقته. هنا بدأ جوهر التعليم الشامل بالظهور، بوصفه عدالة في الوصول إلى المعرفة، قبل أن يكون التزامًا حرفيًّا بخطّة المنهاج.
لم يكن المسار مستقيمًا، بل خضع لتعديل مستمرّ وفق مستويات الطلبة، وحتّى مزاجهم اليوميّ؛ فتحوّلت القراءة إلى قصيدة، والكتابة إلى تشكيل بالمعجون، ليشارك الجميع بلا خوف من الخطأ أو ضغط الدرس، وليكتشف كلّ طالب لحظته الخاصّة مع اللغة، ويتنقّل في مستويات مختلفة من التحدّيات تناسب قدراته وشخصيّته، وتترك له مساحة تتحوّل فيها البيئة التعليميّة إلى بيئة أمان نفسيّ، وتبادل معرفيّ في اتّجاهات مختلفة.
ومع الوقت أدركتُ أنّ التعليم الشامل لا يعني تبسيط الدرس للفئة الأضعف، أو زيادة الواجبات للأقوى، بل يعني تصميم بيئة تعليميّة عادلة، تتيح مسارات متعدّدة للوصول إلى الهدف نفسه. فالشمول الأكاديميّ لا يكتمل من دون شمول لغويّ وثقافيّ وعاطفيّ، يشعر فيه الطالب بأنّ لغته وهويّته جزء من الصفّ، لا غريبان عنه.
يتحقّق ذلك بإفساح المجال للطالب لاستخدام لغته الأمّ أثناء التعلّم، بدءًا من تدوين المعاني بلغته الخاصّة، بما يمكّنه من العودة إلى المادّة من دون وسيط لغويّ، مرورًا بإشراكه في مقارنة المفردات والتراكيب باستخدام أسئلة مثل: "كيف تسمّي هذا في لغتك؟" أو "كيف تعبّر ثقافتك عن هذا الفعل؟"
هنا يحدث التحوّل الحقيقيّ. ينتقل المعلّم إلى مقعد الطالب، ويصبح الطالب مصدرًا للمعلومة ومعلّمًا لزملائه، فتتحوّل لغته من عائق محتمل أو دخيل غير مرغوب فيه، إلى مرجع لغويّ يحمل العربيّة إليه. هذا الأسلوب يخلق مساحة آمنة للمشاركة من دون خوف من التعثّر أو الزلل، ويحقّق أحد أهمّ مبادئ التعليم الشامل، بإتاحة مسارات متعدّدة للتعبير والفهم بما يلائم جميع اللغات والثقافات.
لذلك، عندما احترمتُ "لغة الطالب" قبل "قواعد اللغة"، تحوّلت العربيّة من مادّة تُدرّس إلى مساحة انتماء. وهنا فقط يبدأ التعليم الحقيقيّ: عندما يشعر الطفل أنّه مرئيّ ومسموع، وأنّ وجوده لا يقلق الصفّ بل يُغنيه. وهذا ما تؤكّده مبادئ "التصميم الشامل للتعلّم (UDL)" التي تبنّتها اليونسكو (2023)، والتي تدعو إلى تنويع طرق تمثيل المعرفة والتعبير والمشاركة داخل الصفّ.
العربيّة بيتنا
أذكر أنّ منهاج اللغة العربيّة في بلادي كان يحمل اسم "العربيّة لغتنا". حسنًا، لا يمكن لي أن أستولي على حقوق اسم المنهاج، فالعربيّة ليست اللغة التي أملك امتياز وصفها بـ"لغتنا"، لكنّني استطعت الالتفاف على القانون لتصبح العربيّة بيتنا. أقدمت على ذلك باستراتيجيّات مختلفة، منها إخضاع النصوص لهيمنة اللغة الأمّ، وخصوصًا حين يكون الطالب مدركًا معنى الكلمات، لكنّه فاقد القدرة على التعبير عنها بالعربيّة. هنا تركت لهم المجال للتعبير بلغتهم الأمّ، ثمّ احتضنتها واحتضنتهم بالعربيّة.
هناك أيضًا المشاريع الجماعيّة، ومسابقات الصورة والكلمة، والحرف والصورة، وتمثيل المفردات من دون نطق، والأداء المسرحيّ للقصائد والقصص، والبحث عن الكلمات المفقودة في خريطة الكنز حول المدرسة، والأنشطة الخارجيّة مثل زيارة المسجد والمتحف، والتعاون مع مادّة التربية الإسلاميّة في إحياء المناسبات الدينيّة باللغة العربيّة، بالنشيد والأعمال الفنّيّة، ومع قسم رياض الأطفال في مسابقات السرعة والكفاءة، ومع إدارة المدرسة في يوم الثقافات واللغات. وجميعها أدوات أو استراتيجيّات يستخدمها المعلّم متى شاء وكيفما شاء، ليؤسّس لمبدأ واحد: التعليم الشامل لا يتحقّق بالمنهاج فقط، بل حين يشعر كلّ طالب أنّ اللغة تتّسع لصوته الشخصيّ وهويّته الذاتيّة.
انتهى الفصل الدراسيّ – يخطئ عدد من طلّابي بين كلمتي الفصل والصفّ – لكنّني خرجت بمحصول ذهبيّ حين استطاع طلّابي في المجموعة الخضراء الانطلاق على طريق القراءة، بعد إتمام المدود والمقاطع والحركات، بينما أصبح طلّابي في المجموعة الزرقاء يترنّمون في لحظات صفائهم بإحدى القصائد الطريفة. أذكر الآن أنّ أحدهم كان يستطيب تكرار قصيدة بشّار بن بُرد لخادمته ربابة:
"ربابةُ ربّةُ البيتِ تصبّ الخلَّ في الزيتِ
لها عشرُ دجاجاتٍ وديكٌ حسنُ الصوتِ"
وكان يجد فيها أعذب ما يجد المتذوّق في العربيّة. فيما كان آخر يستبدل مجموعته الزرقاء بالصفراء في قول أبي نوّاس:
"صفراءُ لا تنزلُ الأحزانَ ساحتَها لو مسَّها حجرٌ مستهُ سرّاءُ"، في إشارة طريفة إلى مجموعته الزرقاء.
كانت هذه حصيلتي، وربّما مدّخراتي النفيسة في ذلك العام. فقد تجاوزت العربيّة بالنسبة إليّ نطاق اللغة الخاضعة للمدارسة، إلى فضاء للتعليم الشامل، يُعاد فيه تعريف الصفّ بوصفه مجتمعًا صغيرًا يحتضن التنوّع بدل أن يخافه، ويستفيد من لحظة لقاء الهويّات لتحقيق عدالة لغويّة وثقافيّة، تحضر فيها العربيّة جنبًا إلى جنب مع لغة الطالب وثقافته، فيما يصبح دور المعلّم بناء "جسور الفهم" لا "جدران التصحيح"، ويتحوّل المنهاج إلى مساحة انتماء في صفوف متعدّدة الثقافات.
***
تنتهي تجربتي هنا، ليس فيها التمام الذي قال فيه أبو البقاء الرنديّ: "لكلّ شيءٍ إذا ما تمّ نقصان"، ذلك لأنّها مرحلة في حياة طلّابي الأكاديميّة، ومرحلة في حياتي المهنيّة. لكنّ فيها من الشمول ما يجعلني بهيّة بما قدّمت، وفخورة بطلّابي المثابرين للوصول، ومدركة لكمّ التحدّيات التي يواجهها معلّمو اللغة العربيّة في غير بلادها ولغير الناطقين بها، اليوم وغدًا وكلّ يوم... كان الله في عونهم.
المراجع
UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education – A tool on whose terms? .







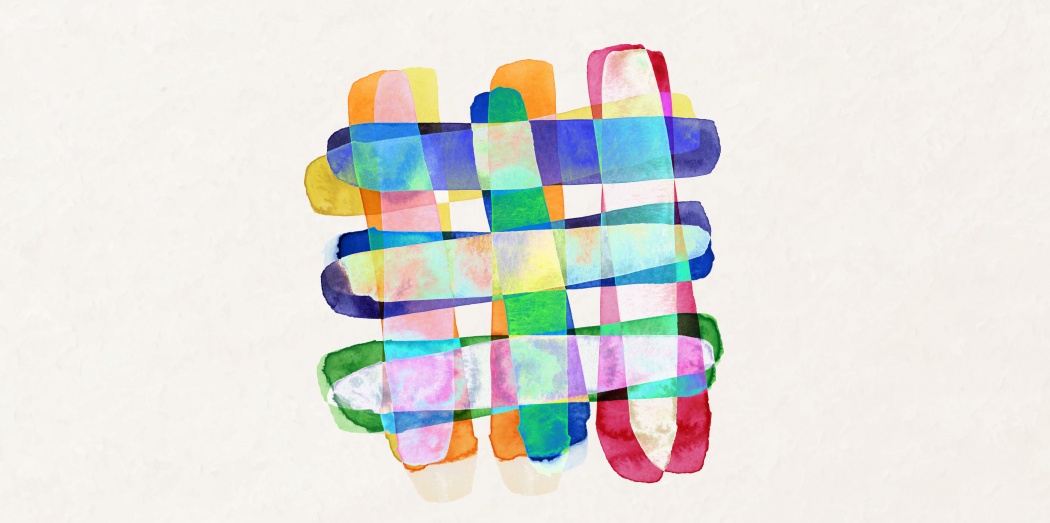





 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026