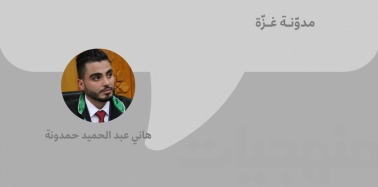كنت في الصفّ الخامس الابتدائيّ، عندما اشترى لي والدي كتابًا صغيرًا عنوانه "قاموس الجيب" يحتوي على كلّ ما أحتاج إليه آنذاك من مفردات وتصريفات للأفعال في اللغة الفرنسيّة. أذكر جيدًا أنّني شعرت بالطمأنينة والزهو عندما وضعته في حقيبتي المدرسيّة كمن يحمل كنزًا صغيرًا. اليوم، أهديتُ ابني الصغير " آيباد " فأصبح الكوكب كلّه في جيبه. ولكنّي لم ألحظ عنده المشاعر ذاتها؛ فالطمأنينة غابت، ومعها غاب الفضول العلميّ وفرحة الوصول إلى المعرفة. عندها حضرني قول عن المدرسة الحديثة هو: "كأنها ليمونادة، فيها لون الليمون، ورائحة الليمون، ولكنّها ليست من الليمون في شيء".
ووجدت نفسي أطرح تساؤلاتٍ مشروعة: ما سبب غياب لذّة المعرفة؟ إلى أين نحن ذاهبون في ظلّ التحوّل الرقميّ الجارف؟ هل يجب أن تحلّ الأجهزة اللوحيّة محلّ الكتب المدرسيّة؟ هل هناك خطر وجوديّ على الكتاب الورقيّ؟ والسؤال الأهمّ هل يمكن للمعرفة أن تستغني عن الكتاب؟
من الناحية التاريخيّة، نعم. فقد كانت المعرفة تُنقل شفهيًّا لآلاف السنين قبل اختراع الكتابة. وقد ظهرت أولى أشكال الكتابة على ألواح الطين، والبرديّ، والخيزران، والجلود... وصولًا إلى الورق الذي اخترعه الصينيّون في القرن الأول الميلاديّ، وانتقل إلى أوروبا لاحقًا. ومنذ ذلك الوقت أثبت الكتاب قيمته في حفظ الذاكرة الإنسانيّة، وبناء التراكم المعرفيّ. وأصبح الكتاب المدرسيّ حجر الأساس في المنظومة التعليميّة. فقد وُضع ليكون مرجعًا ثابتًا، منظّمًا، يخضع لرقابة، ويشكّل وحدة معرفيّة موحّدة بين التلاميذ والمعلّمين. بفضله، كانت الدروس تُبنى، والامتحانات تُعدّ، والأهداف تُضبط. يقول عالم التربية جون ديوي:" الكتاب المدرسيّ هو البوصلة التي تهدي الطالب في بحر المعرفة".
غير أنّ هذا النموذج بدأ يواجه تحدّيات حقيقيّة في ظلّ الثورة الرقميّة التي اجتاحت المدارس حول العالم. فالتعليم لم يعد يقتصر على الصفوف التقليديّة، والمعرفة لم تعد حبيسة الورق. دخلت التكنولوجيا الفصل الدراسيّ بقوّة، وأصبحت الأجهزة اللوحيّة، والألواح الذكيّة، ومنصّات التعلّم التفاعليّ جزءًا من يوميّات المتعلّمين. وهنا بدأت مكانة الكتاب المدرسيّ تهتز فعليًّا. فعلى سبيل المثال تحوّل معظم الناشرين التربويّين الفرنسيّين إلى الرقمنة؛ فدارا "بوردا" و"ناتان" تعرضان مجموعات كاملة من الكتب الرقميّة المدعّمة بمحتويات متعدّدة الوسائط، متاحة للمعلّمين والعائلات منذ سنة 2013، على الحواسيب والأجهزة اللوحيّة، بأسعار تقلّ عن النسخة الورقيّة.
وتقول صوفي بين، الأستاذة في جامعة باريس – ديكارت: "الطلّاب اليوم يريدون موارد تعليميّة قابلة للاستخدام على الهواتف الذكيّة، تجمع بين النصّ والصوت والفيديو". لكنّ المفارقة أنّه في الوقت الذي تتطوّر فيه هذه الموارد، تُسنُّ قوانين لمنع الهواتف المحمولة في الصفوف، كما في فرنسا، خوفًا من التشتّت وضعف التركيز.
إذًا المعركة لم تُحسم بعد!
ففي الولايات المتحدة، بلد التكنولوجيا، لا تزال دور النشر الكبرى مثل بيرسون، ماكغرو-هيل، سينغاج، هاشيت، تقاوم "أمأزنة" التعليم، دفاعًا عن نموذج معرفيّ أكثر استقرارًا وعُمقًا.
وفي المقابل، تشهد سويسرا، إحدى أكثر الدول تقدّمًا في التعليم، مفارقة مثيرة: بعد تجربة إدخال الأجهزة اللوحيّة على نطاق واسع في بعض المدارس، قرّرت السلطات التربويّة فيها العودة إلى الكتاب الورقيّ، بسبب تراجع مهارات التلاميذ في الفهم والقراءة والتركيز.
أمّا في العالم العربيّ، فقد جاءت محاولة الرقمنة غالبًا على نحو سطحيّ، يركّز على الشّكل لا المضمون. ففي إحدى الدول العربيّة مثلًا، وُزّع التابلت على طلّاب المرحلة الثانويّة في سنة 2013 ضمن مشروع طَموح لتحديث التعليم. لكن من دون بنية تحتيّة رقميّة متكاملة، أو تدريب كافٍ للمعلّمين، ما أدّى إلى فشل جزئيّ في تحقيق الأهداف. أمّا في لبنان، فإنّ محاولات إدخال التكنولوجيا، خلال جائحة كورونا، اصطدمت بأزمات اقتصاديّة وانقطاع الكهرباء والإنترنت، ما جعل العودة إلى الكتاب الورقيّ أمرًا واقعًا لا نقاش فيه. إذ أثبت أنّه الرفيق الذي لا يتغيّر وجهه مع كلّ إشعار، ولا تتبدّل صفحاته بتحديث عابر، يطويه الطالب بين يديه كما يطوي فصلًا من يومه، ويضع فيه أسراره ورسوماته الصغيرة كأنّه دفتر خاصّ. لا يخذله انقطاع الإنترنت، ولا يعجز عن العمل في غياب الكهرباء.
بناء على ما سبق، يبدو أنّه لا خوف على الكتاب الورقيّ في المدى القريب. فلنكفّ عن إضاعة الوقت في أيّهما أفضل: الكتاب أم الشاشة، ولنركّز جهودنا للإجابة عن تساؤلات أكثر إلحاحًا: كيف يمكن للتعليم المعاصر أن يوفّق بين الورقيّ والرقميّ لصالح تربية أكثر شمولًا وفاعليّة؟ كيف نعيد تشكيل المناهج لتواكب العصر من دون أن تفقد قيمتها؟ كيف ندرّب المعلّمين ليكونوا مرشدين لا ملقّنين؟ وكيف نربّي المتعلّم على الانتباه والعمق والفضول، في زمن يقدّم كلّ شيء جاهزًا وسريعًا؟
في الواقع وفّرت لنا الأجهزة اللوحيّة سهولة الوصول إلى المعلومات، لكنّها قلّلت من جهد البحث، ومن إحساس الاكتشاف، ومن طقوس التعلّم المتدرّج. لم يعد الطالب ينتظر بفارغ الصبر درسًا جديدًا، ولا يفرح بفتح كتاب لأوّل مرّة، بل يتنقّل بين الشاشات بسرعة تُضعف التركيز وتشتّت الانتباه.
أضف إلى ذلك مشكلة موثوقيّة المصادر الرقميّة، وتفاوت جودة المحتوى، وعدم قدرة جميع الأنظمة التربويّة على دمج التكنولوجيا بكفاءة متساوية، ما يزيد من التفاوت بين المتعلّمين.
أما بالنسبة إلى المعلّم، فعليهِ أن يدرك أنّ دوره لم يعد ناقلًا للمعلومة فحسب، بل صار موجّهًا، ومرافقًا في رحلة التعلّم. يساعد الطالب على التنقّل بين المصادر، وتقييمها، وفهمها. ففي عصر تغمرنا فيه المعلومات، تكون الحاجة إلى المرشد البشريّ (لا الآلي) أكبر من أيّ وقت مضى. ولأنّنا نعيش اليوم في زمن وفرة معلوماتيّة بلا حدود، نواجه أزمة في المعنى: فالطلّاب يعرفون كيف يصلون إلى المعلومة، لكنّهم يجهلون كيف يبنون عليها، أو يشكّلون منها فهمًا نقديًّا. هنا تتجلّى خطورة التعليم الرقميّ إذا لم يكن جزءًا من تصوّر تربويّ متكامل يعيد الإنسان إلى مركز العمليّة التعليميّة.
أخيرًا، مستقبل التعليم يجب ألّا يُبنى على استبعاد الكتاب أو تمجيد التكنولوجيا، بل على التكامل بينهما. الورق واللوح ليسا ضدّين، بل جناحين لطائر واحد. والحداثة الحقيقيّة ليست في تبديل الورق بشاشة، بل في إعادة الاعتبار إلى المعرفة العميقة، المتدرّجة، المتصّلة بالقيم والواقع.
باختصار، ليست المشكلة في أن يكون "الكون في جيب طفل"، بل في أن نعلّمه كيف يقرأ هذا الكون، ويفهمه، وينتقي منه ما يغذّي فكره وروحه. علينا أن نُربّي أبناءنا على أنّ المعرفة ليست فقط في ما يُعرَض على الشّاشة، بل أيضًا في دفّتي كتاب، أو في فكرة تُبنى بصبر في عقولهم ووجدانهم.
وبين دفتي الكتاب ونقرات" الآيباد"، يجب أن تظلّ البوصلة هي الإنسان، الباحث عن الفهم لا عن المعلومة وحسب؛ الإنسان الذي يشعر ويتعاطف ويقيّم ويقدّر الجمال ويتعامل بوعي وأخلاق وضمير، حتّى لا ندمّر أنفسنا بأنفسنا كما حذّر الكاتب الفرنسيّ فرانسوا رابليه في القرن السادس عشر:
"العلم من دون ضمير لا يؤدّي إلا إلى دمار النفس".