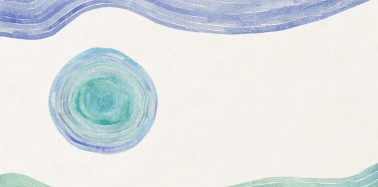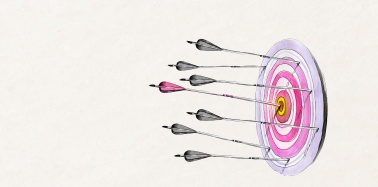يشهد التعليم المعاصر تحوّلًا متسارعًا نحو مفهومات الشمول والإنصاف التعليميّ، والتي تسعى لاحتضان جميع المتعلّمين على اختلاف خلفيّاتهم وقدراتهم. غير أنّ هذا التوجّه غالبًا ما يصطدم بواقع المناهج الدراسيّة الصارمة، والتي تفرض محتوى موحّدًا ومعايير تقييم ثابتة على فصول دراسيّة تتّسم بتنوّعها واختلافها الجوهريّ. وفي ظلّ هذا التباين، يواجه المعلّمون تحدّيًا يوميًّا، يتمثّل في تحقيق تعليم شامل ضمن بيئات صفّيّة متعدّدة الثقافات، متفاوتة في الكفاءة اللغويّة والخلفيّات المعرفيّة، مع ضرورة الالتزام الصارم بمتطلّبات المناهج ونتائج التعلّم المحدّدة مسبقًا.
ينطلق هذا المقال من تجربة ميدانيّة لمعلّم يسعى لتحقيق توازن دقيق بين متطلّبات منهج وطنيّ صارم، وواقع صفّ دراسيّ متنوّع ثقافيًّا. ويهدف إلى استكشاف آليّات تطبيق مبادئ التعليم الشامل، ضمن أنظمة تعليميّة مركزيّة تحدّ من مرونة المحتوى والتقويم. ويتناول التحليل هذه الإشكاليّة من منظور الممارسة الصفّيّة، باستعراض الفجوة القائمة بين الخطاب التربويّ الذي يروّج للشمول والإنصاف، وبين البُنى المنهجيّة التي تعيق تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
فلسفة التعليم الشامل وحدود التطبيق
يقوم التعليم الشامل على مبدأ جوهريّ مفاده أنّ لجميع المتعلّمين، بغضّ النظر عن خلفيّاتهم اللغويّة أو الثقافيّة أو الاجتماعيّة، حقًّا أصيلًا في فرص تعلّم متكافئة ضمن بيئة صفّيّة موحّدة. ويشمل هذا المفهوم جميع أشكال التنوّع بين المتعلّمين العاديّين وذوي الاحتياجات الخاصّة، بما في ذلك التنوّع الثقافيّ واللغويّ. ويستدعي من المعلّمين مرونة في تكييف المحتوى واستراتيجيّات التدريس، بما يضمن أن يكون التعلّم ذا معنى وصلة بجميع الطلّاب.
غير أنّ هذا المبدأ غالبًا ما يتعارض مع واقع المناهج المركزيّة، والتي تفترض أنّ المحتوى الموحّد صالح لجميع المتعلّمين، متجاهلة الفروق الفرديّة. تحدّ المناهج المبنيّة على أهداف ومعايير محدّدة مسبقًا من استقلاليّة المعلّم، وتحوّل المنهج من أداة تمكينيّة إلى نظام مغلق يتطلّب تطبيقًا حرفيًّا. وفي الفصول الدراسيّة المتعدّدة الثقافات، تسهم هذه الصرامة المنهجيّة – عن غير قصد – في تهميش الطلّاب الذين يفتقرون إلى الخلفيّة اللغويّة أو الثقافيّة للنصوص المقرّرة. وهكذا، تظهر المفارقة التربويّة الجوهريّة؛ إذ يدعو الخطاب الرسميّ إلى الشمول والإنصاف، في حين تفرض البنى المنهجيّة قيودًا تجعل من تحقيق تلك المبادئ تحدّيًا يوميًّا في الممارسة الصفّيّة. ومن هذه المفارقة تنبثق التجربة الحاليّة، بوصفها محاولة للتوفيق بين الالتزام بالمنهج الرسميّ، وتطبيق مبادئ الشمول في بيئات تعليميّة متعدّدة الثقافات.
تعدّد الخلفيّات ووحدة المحتوى
في بيئات صفّيّة متعدّدة الجنسيّات، يتحوّل المعلّم إلى محور رئيس في شبكة من التفاعلات المعقّدة التي تتطلّب حساسيّة ثقافيّة، ومرونة تربويّة، ووعيًا مهنيًّا متقدّمًا. يتمثّل أوّل هذه التحدّيات في التواصل اللغويّ والمعرفيّ؛ إذ قد تتحوّل اللغة – وهي الأداة الجوهريّة للتدريس – إلى حاجز بدلًا من أنّ تكون جسرًا للتعلّم، خصوصًا عندما تتفاوت مستويات إتقان الطلّاب لغة التدريس تفاوتًا ملحوظًا. ويؤدّي هذا التفاوت إلى إبطاء إيقاع الدرس، ما يفرض على المعلّم مهمّة دقيقة، تتمثّل في الموازنة بين احتياجات الطلّاب المتقدّمين الذين يتطلّبون الإثراء، وأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة الشرح والتوضيح، مع الحفاظ على تماسك الدرس ومشاركة جميع المتعلّمين في الوقت ذاته.
أمّا التحدّي الثاني، فيظهر في التنوّع الثقافيّ وتباين الأطر المرجعيّة للمعرفة. فالمفهومات التاريخيّة والاجتماعيّة لا تُفهم بمعزل عن الخلفيّة الثقافيّة التي تشكّل إدراك المتعلّم للعالم. فعلى سبيل المثال، قد يفسّر الطالب حدثًا تاريخيًّا تفسيرًا مختلفًا تمامًا، تبعًا للرواية الوطنيّة أو العائليّة التي يتلقّاها، ما يلزم المعلّم بإعادة تقديم المحتوى بعناية، لتجنّب الانحياز الثقافيّ أو الاختزال المفرط، الأمر الذي يتطلّب درجة عالية من الوعي الثقافيّ، ومهارة في إدارة الحوار داخل الفصل، من دون السماح له بالتحوّل إلى نقاش قائم على الانتماءات والهويّات.
ويتعقّد الأمر أكثر حينما يتقاطع هذا التنوّع مع صرامة المنهج الدراسيّ الذي يحدّ من قدرة المعلّم على تكييف المحتوى، أو تعديل استراتيجيّات التدريس. فالمعلّم مقيّد بخطط دراسيّة محدّدة ونتائج تعلّم موحّدة، مع إدراكه أنّ هذه النتائج قد لا تعكس واقع الفصل غير المتجانس. وهنا تظهر مفارقة تربويّة عميقة؛ فكلّما حاول المعلّم تطبيق مبادئ الشمول والإنصاف، وجد نفسه أبعد عن الالتزام بالنموذج الرسميّ الذي يفرضه النظام التعليميّ.
كما تُضاف إلى ذلك تحدّيات نفسيّة وعاطفيّة تفرضها طبيعة هذا الدور المعقّد. فإدارة فصل متنوّع ثقافيًّا تتطلّب جهدًا معرفيًّا وانفعاليًّا مستمرًّا، إذ يكون المعلّم وسيطًا ثقافيًّا يسعى لبناء بيئة صفّيّة آمنة، يشعر فيها جميع الطلّاب بالقبول والانتماء. غير أنّ هذا الدور التفاعليّ قد يكون مرهقًا في ظلّ محدوديّة الدعم المؤسّسيّ، وغياب التدريب المتخصّص في إدارة التنوّع الثقافيّ واللغويّ.
التكيّف التربويّ مدخلًا لتحقيق الشمول في الصفّ
تمحورت الاستراتيجيّة الأولى حول إعادة تصميم طرائق عرض المحتوى التعليميّ، من دون الإخلال بجوهر المنهج الرسميّ وأهدافه الرئيسة. فقد انطلقتُ من قناعة بأنّ الشكل الذي يُقدَّم به المحتوى لا يقلّ أهمّيّة عن المحتوى نفسه، وأنّ إعادة صياغة بيئة التعلّم، يمكن أن تُعيد الحياة إلى المادّة الدراسيّة وتمنحها بعدًا إنسانيًّا جديدًا. فعلى سبيل المثال، بدل أن يظلّ الدرس التاريخيّ نصًّا جامدًا على السبّورة، سَعيتُ لتحويله إلى تجربة حسّيّة شاملة، تُخاطب البصر والسمع والتفكير التأمّليّ معًا، بحيث يصبح المتعلّم فاعلًا ومشاركًا في بناء المعرفة. استخدمتُ الخرائط الذهنيّة لتوضيح العلاقات السببيّة والزمنيّة بين الأحداث، والعروض المرئيّة لتجسيد الوقائع التاريخيّة، والمقاطع التعليميّة القصيرة لربط الماضي بالحاضر. وقد ساعد هذا التنويع في جعل تدريس المادّة تجربة مُعاشة، يتفاعل معها المتعلّمون شعوريًّا وذاتيًّا، بوصفهم باحثين صغارًا عن المعنى. وحين بدأ الطلّاب يروون قصصًا من ثقافاتهم تشبه ما درسناه، شعرتُ أنّ التاريخ تحوّل من مادّة دراسيّة جامدة إلى جسر إنسانيّ نابض. كما اعتمدتُ على المقارنات بين الثقافات، بوصفها أداة تفسيريّة لفهم الأحداث التاريخيّة من منظور متعدّد الأصوات، ما أتاح لهم رؤية انعكاس خلفيّاتهم الثقافيّة في المادّة الدراسيّة، بدلًا من الشعور بالإقصاء أو الاغتراب المعرفيّ.
تمثّلت الاستراتيجيّة الثانية في تنويع أنماط التعلّم داخل الصفّ، لضمان العدالة في فرص المشاركة. لم أعد أكتفي بالمناقشة اللفظيّة التي تفضّل الطلّاب المتحدّثين بطلاقة، فصمّمتُ أنشطة جماعيّة متوازنة، تتوزّع فيها الأدوار وفق قدرات الطلبة المختلفة. أسندتُ إلى أصحاب الكفاءة اللغويّة مهمّة العرض الشفهيّ، وإلى ذوي المهارات التنظيميّة مسؤوليّة إعداد الوسائط البصريّة، بينما تولّى أصحاب الخبرات الحياتيّة ذات الصلة إثراء النقاش بالأمثلة الواقعيّة. وقد أسهم هذا التنظيم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المتكافئة، فشعر كلّ طالب أنّ له مكانًا مؤثّرًا في عمليّة التعلّم. ومع مرور الوقت، تحوّلت المجموعات إلى وحدات تعلّم مصغّرة تتفاعل بانسجام، يتبادل أفرادها الخبرات ويتعلّمون من بعضهم بعضًا. كان ذلك التحوّل جليًّا في ملامحهم؛ في عيون تلمع بالإنجاز، وأصوات تعبّر بثقة عن أفكارها. لقد أدركتُ حينها أنّ بناء بيئة تعلّميّة عادلة، يتحقّق بإتاحة المساحة أمام كلّ صوت ليُسمع، ولكلّ مهارة أن تُقدَّر.
أمّا الاستراتيجيّة الثالثة، فتمثّلت في بناء لغة صفّيّة موحّدة، تتّسم بالوضوح والإيجاز والتكرار المقصود. جاء ذلك استجابةً لتحدّي التنوّع اللغويّ في الصفّ، وضمانًا ألّا يشكّل ضعف الكفاءة اللغويّة حاجزًا أمام التعلّم أو المشاركة. وقد اعتمدتُ في ذلك على إعادة الصياغة التوضيحيّة، واستخدام الإشارات البصريّة الداعمة للمفردات، وكتابة المصطلحات الأساسيّة على السبّورة بلغات متعدّدة عند الحاجة، بما يعزّز قيم التسامح اللغويّ والاحترام المتبادل. ومع مرور الوقت، تحوّلت اللغة في الصفّ من أداة تقييم إلى أداة تواصل إنسانيّ، حين رأيتُ أحد الطلّاب يصحّح نطق زميله بلطف من دون أن يحرجه. عندها أدركتُ أنّ اللغة الصفّيّة فضاء لبناء الانتماء والتفاهم، ومساحة تسمح بتجلّي التنوّع بدل أن تكرّس التفاوت.
تأمّلات في نهاية مفتوحة
في ختام هذه التجربة، لا يمكن الادّعاء بوجود حلول نهائيّة، أو نماذج جاهزة لمعالجة قضايا التنوّع في الفصول الدراسيّة متعدّدة الثقافات. الطريق نحو التعليم الشامل لا ينتهي، فهو مسار دائم من التأمّل والتكيّف، وإعادة اكتشاف المعنى في كلّ ممارسة تربويّة، إذ يمتلك كلّ فصل دراسيّ خصوصيّته، وتكشف كلّ مجموعة من المتعلّمين عن وجه جديد من وجوه العدالة التعليميّة. وتكمن القيمة الحقيقيّة لهذه التجربة في إعادة تعريف دور المعلّم، بوصفه فاعلًا تربويًّا يسعى لتحقيق العدالة التعليميّة في سياقات متغيّرة باستمرار.
لقد أظهرت هذه الممارسة الحاجة إلى بناء ثقافة تعليميّة جديدة تعيد النظر في طبيعة المنهج، وفي مفهوم النجاح ذاته. وعلى الرغم من أنّ هذه الرؤية تبدو بديهيّة، إلّا أنّها تظلّ بعيدة المنال في الأنظمة التي تمنح التجانس أولويّة على حساب التنوّع. ومع ذلك، فإنّ لحظات التعلّم العفويّة - حين يعبّر طالب ذو كفاءة لغويّة محدودة عن فكرة عميقة بلغته الخاصّة، أو حين يكتشف آخر أوجه تشابه غير متوقّعة بين ثقافته وثقافة زميله - تذكّر المعلّم بأنّ التعليم الشامل تجربة واقعيّة ممكنة، ولو جزئيًّا.
لا تقدّم هذه التجربة إجابات نهائيّة، بقدر ما تفتح الباب أمام تساؤلات ضروريّة من قبيل: كيف يمكن للتعليم أن يحتضن التنوّع من دون أن يفقد تماسكه؟ وما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسّسات التعليميّة في تمكين هذا التحوّل؟ قد لا يمتلك المعلّم وحده الإجابات، لكنّه يظلّ نقطة الانطلاق الأساسيّة لطرح الأسئلة الصحيحة، والتي تذكّرنا بأنّ التعليم الشامل ممارسة متجدّدة، نتعلّمها يومًا بعد يوم داخل الفصول الدراسيّة.













 نشر في عدد (23) شتاء 2026
نشر في عدد (23) شتاء 2026