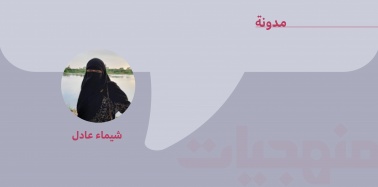على رغم الخطابات المتكرّرة حول التعليم الشامل والدمج الكامل للطلّاب ذوي الإعاقة، يبدو الواقع مختلفًا تمامًا؛ حيث تسود الفجوة بين السياسات المعلنة والتطبيق الفعليّ. في كثير من الأنظمة التعليميّة، يتحوّل دمج ذوي الإعاقة إلى شعار فارغ، يُرفع في المؤتمرات والفعّاليّات من دون أن يجد صدًى حقيقيًّا داخل الفصول الدراسيّة.
مناهج لا تلبّي الاحتياجات
لا يزال تطوير المناهج الدراسيّة الذي يُفترض أن يكون أداة رئيسة في دعم الطلّاب ذوي الإعاقة، يتخبّط في دوائر البيروقراطيّة. المناهج الحاليّة غالبًا ما تُبنى على افتراضات خاطئة تتجاهل الفروق الفرديّة، وتُقدّم محتوىً نمطيًّا غير مرن، لا يراعي احتياجات الطلّاب الذين يعانون إعاقات حسّيّة أو ذهنيّة أو حركيّة.
النتيجة هي استبعاد غير مباشر: إذ يُترك الطلّاب يواجهون صعوبات كبيرة في فهم الموادّ الدراسيّة، في غياب أيّ أدوات دعم حقيقيّة، مثل الكتب المطبوعة بطريقة برايل – كيف ننتظر طباعة مثل هذه الكتب في حين أن الكتب الورقيّة العاديّة بالكاد تُطبع للطلّاب الآخرين، تحت ذريعة نقص التمويل؟ – أو التقنيّات المعزّزة للصوت، ناهيك عن ندرة الموارد التعليميّة الرقميّة المتاحة بتنسيقات مخصّصة.
بنية تحتيّة غير مهيّأة
في كثير من المدارس، تظلّ البنية التحتيّة عاجزة عن توفير بيئة ملائمة للطلّاب ذوي الإعاقة، السلالم العالية، غياب المصاعد، ضيق الممّرات، وعدم توفّر المرافق الصحّيّة المناسبة، كلّها أمور تعكس إهمالًا مزمنًا. المدارس التي تُعلن عن جاهزيّتها للدمج غالبًا ما تفتقر إلى أساسيّات الوصول، ما يضع الطلّاب وأسرهم أمام معضلة يوميّة. هذا الواقع يُظهر التناقض بين الخطط المُعلنة والبيئة الفعليّة التي لا تحتضن هؤلاء الطلّاب، بل تُقصيهم.
المعلّم بين غياب التدريب وافتقار الدعم
يمثّل المعلّمون خطّ الدفاع الأوّل في عمليّة الدمج، لكنّهم غالبًا ما يُتركون وحدهم لمواجهة التحدّيات. في غياب برامج تدريبيّة متخصّصة، يُطلب إلى المعلّمين التعامل مع طلّاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة من دون أيّ توجيه أو أدوات منهجيّة.
المعلّم الذي يفتقر إلى المعرفة بكيفيّة إدارة فصل متنوّع، وإنشاء أنشطة تعليميّة ملائمة، يجد نفسه في مأزق مستمرّ بين محاولات الدمج والإخفاقات اليوميّة. والأسوأ من ذلك، أنّ النظام التعليميّ ذاته لا يوفّر دعمًا نفسيًّا أو لوجستيًّا للمعلّمين، ما يجعلهم يشعرون بالإرهاق والإحباط.
سياسات رمزيّة وغياب تمويل
يتطلّب الدمج الحقيقيّ استثمارات كبيرة في التدريب والبنية التحتيّة والموارد التعليميّة، لكنّ الإنفاق الحكوميّ على التعليم الشامل يبقى محدودًا. ما يحدث في الواقع هو اعتماد مبادرات شكليّة بهدف تحسين الصورة العامّة من دون إحداث تغيير جوهريّ. تلك السياسات الرمزيّة تُركّز على الإعلان عن افتتاح "مدارس دامجة" من دون توفير الميزانيّات اللازمة لدعمها. يقتصر الأمر على طلاء واجهات المؤسّسات التعليميّة بشعارات الدمج، بينما تُترك الفصول خاوية من الدعم المطلوب.
في ظلّ هذا الواقع، يُصبح أولياء الأمور الطرف الذي يتحمّل العبء الأكبر. مَن يحلمون بمستقبل تعليميّ أفضل لأطفالهم يجدون أنفسهم في رحلة شاقّة للبحث عن مدارس ملائمة، ومراكز دعم خارجيّ؛ بل وغالبًا ما يضطرّون إلى تحمّل تكاليف باهظة لتوفير احتياجات تعليميّة خاصّة، ما يُعمّق الفوارق الاجتماعيّة. وبدلًا من أن يكون التعليم وسيلة للارتقاء الاجتماعيّ، يتحوّل إلى عبء إضافيّ، خصوصًا على أولياء الأمور ذوي الدخل المحدود، والذين لا يستطيعون تحمّل التكاليف المتزايدة.
المجتمع بين التهميش والوصم
إلى جانب التحدّيات المادّيّة والبنيويّة، يواجه الطلّاب ذوو الإعاقة تمييزًا مجتمعيًّا متجذّرًا، يتجلّى في النظرة السائدة إليهم باعتبارهم عبئًا أو استثناءً. هذا التمييز لا يقف عند حدود النظرة، بل يمتدّ إلى سلوكيّات يوميّة مؤذية داخل المدارس؛ إذ يتعرّضون إلى التنمّر والإقصاء من قبل بعض زملائهم "العاديّين"، ما يفاقم شعورهم بالعزلة، ويؤدّي إلى تدهور حالتهم النفسيّة.
تتراوح تلك السلوكيّات العدوانيّة بين السخرية اللفظيّة والاستهزاء بإعاقاتهم، إلى المضايقات الجسديّة والتجاهل المتعمّد داخل الفصول. غياب الوعي المجتمعيّ حول أهمّيّة الدمج وفوائده على الجميع، إلى جانب ضعف إجراءات الحماية في المدارس، لا يضرّ بالطلّاب ذوي الإعاقة فحسب، بل يعيق تطوّر المجتمع بأسره؛ إذ يُكرّس ثقافة التمييز، ويحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ما الخطوات اللازمة للتغيير؟
يتطلّب الخروج من هذا المأزق تحرّكًا حقيقيًّا وشاملًا على عدّة مستويات. تجب إعادة صياغة المناهج لتكون أكثر مرونة وقابلة للتكيّف مع احتياجات جميع الطلّاب، بما يضمن لهم حقّ التعلّم من دون عوائق. كما إنّ تأهيل المعلّمين ببرامج تدريبيّة مستمرّة، يُعد خطوة أساسيّة لتمكينهم من التعامل مع الفروق الفرديّة داخل الفصول الدراسيّة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطوير البنية التحتيّة لضمان سهولة الوصول والتنقّل داخل المدارس، بما يشمل توفير مرافق مناسبة لجميع الطلّاب. ولا يمكن تحقيق هذا من غير زيادة التمويل المخصّص لتوفير الموارد اللازمة للتعليم الشامل. وأخيرًا، لا بد من نشر الوعي المجتمعيّ بأهمية الدمج باعتباره حقًّا أساسيًّا لكلّ فرد، وليس مجرّد امتياز تُمنحه قلّة محظوظة.
***
في الختام، يبقى الحديث عن دمج الطلّاب ذوي الإعاقة حبيس قاعات المؤتمرات والتقارير الرسميّة، فيما يُترك الواقع غارقًا في العجز والتجاهل. الشعارات الرنّانة وحدها لا تصنع تعليمًا شاملًا، ولا تضمن عدالة بين الطلّاب. الإصرار على تزيين الاخفاق بعبارات برّاقة هو في حدّ ذاته إقصاء جديد، وإن كان مستترًا خلف قناع «الدمج».
ما لم يتحوّل هذا الملفّ من بند شكليّ على أجندات المسؤولين إلى قضيّة جوهريّة تستحق استثمارًا جادًا وتخطيطًا حقيقيًّا، سيظلّ النظام التعليميّ مجرّد مسرح لتكرار الوعود الجوفاء. الدمج ليس منّة ولا خيارًا مرفّهًا. هو اختبار أخلاقيّ لمدى صدق المجتمعات في التزامها بمبادئ العدالة والمساواة. وفي غياب هذا الصدق، سيظلّ الطلّاب ذوو الإعاقة ضحايا نظام يرفض الاعتراف بهم، ويكتفي بمنحهم مقعدًا خلفيًّا في مشهد تعليميّ عقيم. وحتّى ذلك الحين، سيبقى الدمج مجرّد حلم مؤجّل، وشعارًا يفوق الواقع بكثير.