يرى المعلّمون أنّ ما يظهر من مشكلات داخل الصفّ، يُعدّ معوّقًا لمسار عمليّة التعليم والتعلّم، فهو يعوق المعلّم عن تأدية واجباته، ويمنع التلاميذ الآخرين من متابعة تعلّمهم. وعندما يسيء التلاميذ التصرّف، فمن الطبيعيّ بالنسبة إلى المعلّمين أن يشعروا بالانزعاج والغضب. فبالرغم من كلّ شيء، هذا يُشتّت انتباههم عن العمل، كما تصبح الثقة بالقدرة على الحفاظ على صفّ منظّم مهدّدة، والطريقة التي يتعاملون بها مع هذه المشاعر، وردّهم على السلوك غير المقبول، تؤثّر إلى حدّ كبير في ما سيفعله التلاميذ لاحقًا.
في حين أنّنا لا نستطيع أن نضبط التلاميذ أو غيرهم للتصرّف بطرق معيّنة، إلّا أنّنا يمكن أن نضبط أنفسنا وتصرّفاتنا، ومن المهمّ أن نبقى غير متأثّرين، ونتبنّى موقفًا جدّيًّا عندما نواجه سلوكًا غير مقبول. فهدوؤنا، ولغة جسمنا الدالّة على الاسترخاء مع نبرة صوتنا الواثقة، تنقل رسالة إلى الطلّاب مفادها أنّنا نتحمّل مسؤوليّة أنفسنا والموقف الحاصل، وتظهر كفاية المعلّم بوضوح عندما يهتمّ بمشكلات التلاميذ الذين يرعاهم. فالمعلّم الجيّد لا يقتصر دوره داخل الصفّ فقط، وإنّما يكون بمثابة قناة التواصل والاتّصال بين المجتمع والمنزل والمدرسة، لذا يكون من المهمّ أن تنال مشكلات التلاميذ موضعًا مميّزًا في طريقة اهتماماته.
يقدم بعض المعلّمين على حلّ مشكلات التلاميذ داخل الصفّ بأنفسهم، والبعض الآخر يدفع بهم إلى إدارة المدرسة، أو استدعاء وليّ الأمر. في هذه الحالة، يكون المعلّم قد تخلّى عن أحد مقوّمات شخصيّته باعتباره صاحب مهنة، فاقترابه من التلميذ، وفهمه للموقف بصورة أفضل، وسعيه إلى اكتساب ثقته، يُعدّ الأسلوب الأمثل لحلّ المشكلة، ومساعدة المتعلّم في التعلّم الفعّال.
ولكن، يشعر المعلّمون أحيانًا بالعجز عن تحديد الأسباب التي تقف وراء المشكلات السلوكيّة التي يقوم بها التلميذ داخل الصفّ. وعادة ما يذكر هؤلاء المعلّمون بأنّ هذه الأسباب تعود إلى عدّة عوامل، أهمّها:
صعوبة التكيّف: وهي الحالات التي تشكّل عائقًا أمام إقامة الاتّصالات مع التلاميذ، وهي على النحو الآتي:
-
- الميل إلى العُصاب: جميع أنواع العُصاب لها خصائص مشتركة في المجال النفسيّ، يُعبّر فيها عن الاضطراب العاطفيّ، الواعي أو اللاواعي، إمّا بانفعاليّة داخليّة وطفيليّة مفرطة (القلق، الانفعال)، أو بسوداويّة مؤلمة (وسواس المرض)، أو موضوعيًّا بتشكيل أمراض كاذبة (الهستيريا).
ويلاحظ أيضًا سلوك عدم التكيّف مع الواقع ومع الوسط الاجماليّ، باستحالة الانفصال عن الاهتمام بالذات، من أجل تكريس النشاط لأهداف الوجود العمليّ.
-
- العُظامون: هم إحدى فئات المرضى الذهانيّين. ويتّسم التكوين العُظاميّ بأربعة دلائل:
-
الإفراط المرضيّ في تقدير الأنا والكبرياء، أو الادّعاء المموّه، أحيانًا بتواضع متصنّع، والذي يمكن أن يتراوح بين الاكتفاء البسيط، والأفكار الغريبة المعبّرة عن جنون العظمة.
-
التشكيك: وهو مقدّمة لأفكار الاضطهاد المولّدة للقلق وتوجيه الاتّهامات، وتؤدّي غالبًا للميل إلى العزلة، ما يدفع العُظاميّ إلى أنّ يعتبر نفسه ضحيّة.
-
الخطأ في الحكم: فالعُظاميّ يبرّر كلّ أرائه وصولًا إلى المحال، مع عناد لا يلين، ويملك استعدادًا كبيرًا للتفسير الهذيانيّ. والعُظاميّ لا يستطيع أن يستجيب للثقة المتبادلة الضروريّة بين المعلّم والتلميذ.
-
عدم القابليّة إلى التكيّف: والذي يمكن أن يتحدّد بعدم القدرة على الخضوع لنظام اجتماعيّ.
-
- المزاج الفصاميّ المعلن: بقدر ما يتوافق الفصام مع قصور في الاتّصال مع العالم الخارجيّ، وبالانطواء على الذات، فإنّه يكون غالبًا غير متوافق مع وظيفة المربّي.
-
- العدوانيّة التكوينيّة: التي لا تسهّل الاتّصال مع المسبّبات، والتي تسبّب عدوانيّة مقابلة تأتي بمثابة ردّ فعل. فالمراهقون حسّاسون جدًّا لعدوانيّة البالغ، لأنّهم أنفسهم يعيشون في مرحلة يكون فيها توازنهم النفسيّ مضطربًا.
-
- القلق: المعلّم القلق يعكس قلقه على تلاميذه، ويضعهم في وضع مسبّب للصدمة.
الأساليب غير المناسبة التي يجب على المعلّم عدم ممارستها: يستخدم المعلّمون الكثير من الأساليب والممارسات غير المناسبة لمعالجة بعض المشكلات الصفّيّة، وهي كالآتي:
-
- الممارسات المهدّدة والمعاقبة: من أشكال هذه الممارسات استخدام العقاب أو القوّة في طرد التلميذ أو قمعه، أو استخدام التهديدات أو السخرية أو الاستهزاء، أو تعمّد عقابه ليكون مثلًا للآخرين، أو إجباره على الاعتذار.
-
- الممارسات المشتّتة أو المتجاهلة: في هذه الممارسات يحاول المعلّم أن يشتّت انتباه التلاميذ عن السلوك غير المرغوب فيه، إمّا بالتغاضي عنه وعدم القيام بأيّ إجراء نحوه، أو بتغيير تكوين الجماعة باستبعاد بعض الأفراد، أو التحوّل من نشاط إلى آخر لتجاهل السلوك.
-
- الممارسات المسيطرة أو الضاغطة: وتتّضح في محاولة المعلّم استخدام أساليب متنوّعة للضغط على التلاميذ، وفرض سيطرته عليهم، مثل لوم الجماعة وتوبيخها، أو التعبير عن عدم الرضا بالكلمات أو النظرات، أو تحديد أفراد بعينهم والتعبير عن عدم الموافقة على سلوكهم، مقابل استخدام الثناء على مجموعة أخرى. هذه الأنواع من الممارسات كثيرًا ما تؤدّي إلى تغيّر مؤقّت في السلوك الظاهر، ولكنّها تولّد الإحباط والحقد لدى التلاميذ.
وهناك مجموعة أخرى من الأساليب التي قد يلجأ إليها المعلّمون في معالجة السلوكيّات السلبيّة، والتي على المعلّم تجنّبها:
- - لا توبّخ التلميذ أمام الآخرين.
- - عندما تلوم التلميذ لا ترفع صوتك.
- - تأكّد دائمًا من أنّ التلميذ مُدان قبل أن تعاقبه.
- - كن حازمًا ومنصفًا في التعامل مع التلاميذ، ولا تُدخِل المجاملات عند معاقبتهم.
- - تجنّب التهديدات الهائلة، وابتعد عن الاصطدام المباشر.
- - العقاب المناسب للتلميذ على السلوك غير السويّ يطبّق بالتدريج.
المراجع
أبو خليل، فاديا. (2011). إدارة الصفّ وتعديل السلوك الصفّيّ. دار النهضة العربيّة.







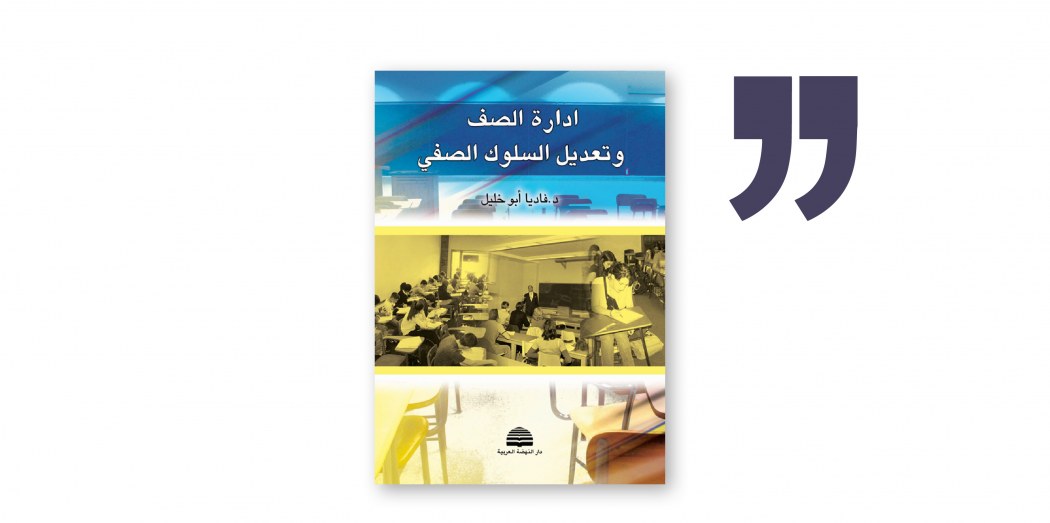





 نشر في عدد (22) خريف 2025
نشر في عدد (22) خريف 2025