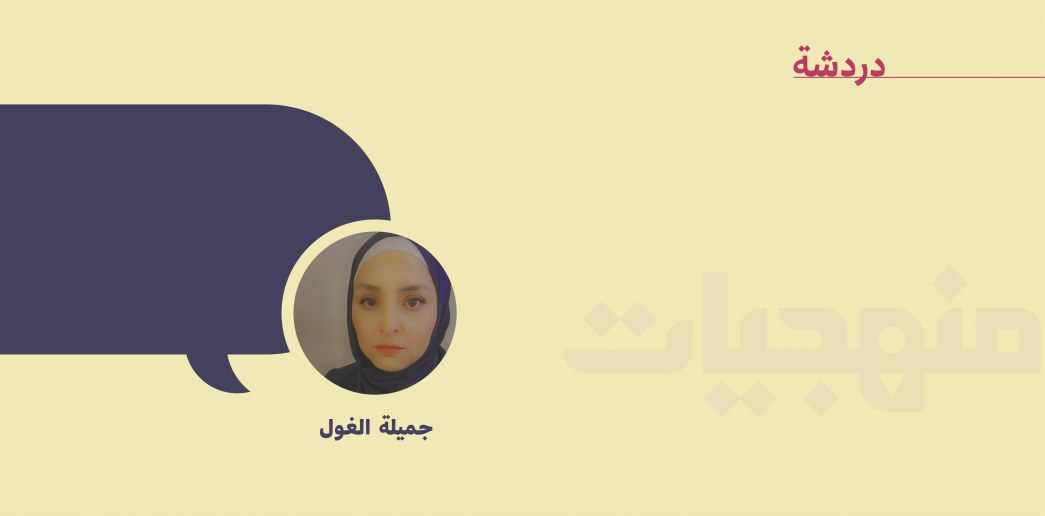ما الذي غيّرته الحروب والأزمات المُختلفة في العالم العربيّ، في نظرتكِ إلى التعليم؟
أثّرت هذه التجارب بشكلٍ عميق في فهمي لدور التعليم وأولويّاته، إذ كشفت عن جوانب مهمّة كانت مغيّبة في أنظمتنا التعليميّة. أصبح واضحًا أنّ التعليم ليس مجرّد نقلٍ للمعرفة الأكاديميّة، بل هو أداة حيويّة لبناء الهويّة والانتماء والصمود. فعندما نرى أطفالًا في مخيّمات اللاجئين يتشبّثون بكتبهم المدرسيّة، أو معلّمين يواصلون التدريس تحت القصف، ندرك أنّ التعليم يمثّل الأمل والاستمراريّة في وجه الدمار. لقد علّمتنا هذه التجارب أنّ التعليم الجيّد يجب أن يكون شاملًا ومتاحًا للجميع، وأنّ العدالة التعليميّة ليست رفاهيّة، بل ضرورة لبناء مجتمعات مستقرّة. كما جعلتني هذه الأزمات أؤمن أكثر بأنّ التعليم هو الاستثمار الأهمّ والأطول أمدًا في المستقبل، وأنّ إصلاحه يجب أن يكون أولويّة قصوى في أيّ خطّة للنهوض والتعافي.
ما الذي تتمنّين لو يعرفهُ صنّاع القرار عن واقع المعلّمين اليوم؟ ولماذا؟
أتمنّى لو يدرك صنّاع القرار أنّ المعلّم اليوم يواجه أزمة حقيقيّة تهدّد جوهر العمليّة التعليميّة، من ضغطٍ ماليّ واجتماعيّ يجبره على العمل في وظيفةٍ أخرى بعد الدوام المدرسيّ لإعالة أسرته، إلى تراكم الأعباء عليه بشكلٍ متزايد. فالمعلّم اليوم ليس ناقلًا للمعرفة فحسب، بل هو مربٍّ، وإداريّ، وأحيانًا والدٌ بديل. نحمله مسؤوليّاتٍ كثيرة، لكن للأسف، لا يتوافر له دعم تقنيّ كافٍ، ولا تدريب مستمرّ، ولا مصادر تعليميّة حديثة، ولا تقدير مجتمعيّ حقيقيّ لما يقوم به. أتمنّى من صنّاع القرار أن يدركوا أنّ الاستثمار في المعلّم ليس مجرّد رفعٍ للراتب، بل هو استثمارٌ في مستقبل الأمّة. فعندما نُكرّم المعلّم ونوفّر له بيئةَ عملٍ محترمةً وأدواتٍ فعّالة، سنرى انعكاس ذلك مباشرةً على جودة التعليم وأجيال المستقبل. المعلّم الذي يشعر بالتقدير والأمان المهنيّ والماليّ، سينقل هذا الشعور الإيجابيّ إلى طلّابه، ويُلهمهم للتعلّم والإبداع.
هل ما زال الكتاب المدرسيّ مصدرًا أساسيًّا للتعليم في صفّك؟
من خلال عملي اختصاصيّة اجتماعيّة، لا أستخدم الكتاب المدرسيّ، ولكن في جلساتي الإرشاديّة والأنشطة التي أقوم بها مع الطلاب أعتمد على مراجع علميّة وكتب متنوّعة، وأحيانًا يكون هناك "دليل" أستخدمهُ. ولتوصيل معلومات "الدليل" التربويّة، أستخدم الأساليب التفاعليّة والتجارب العمليّة التي أجدها أقرب إلى الطلّاب. كما أحاول التشجيع على القراءة من خلال "زاوية القراءة" لترسيخ مفهوم القراءة وتعزيز مكانة الكتاب لدى الطلّاب.
هل سبق وفكّرتِ بالاستقالة من المهنة؟ ما الذي جعلكِ تبقين؟
هناك فترات صعبة جدًّا، وأحيانًا كنت أشعر بالإحباط من كثرة الأعباء الإداريّة التي تبعدني عن عملي الأساسيّ مع الطلّاب، لكنّي لم أفكّر أبدًا في الاستقالة. ما جعلني أبقى كان تلك اللحظات التي أرى فيها تغييرًا حقيقيًّا في حياة طالب. عندما يأتيني طالب عانى مشاكلَ سلوكيّة أو نفسيّة ويشكرني لأنّي ساعدته، أشعرُ بأنّ كلّ التعب يستحق العناء، وأزداد إيمانًا بأنّ هذا العمل رسالة قبل أن يكون مهنة. أدرك أنّي في موقع يمكنني به أن أصنع فرقًا حقيقيًّا في حياة الطلّاب وأسرهم. كما إنّ تعاون الأهل ومشاركتهم، وكلمات الشكر والثناء منهم، ومن زملائي المعلّمين والإداريّين الذين يقفون معي ويساندونني، يمنحني دعمًا معنويًّا كبيرًا وقوّة للاستمرار.
ما هي أهمّ المهارات التي يجب أن نُدرّب المتعلّم عليها في عصر الذكاء الاصطناعيّ؟
من واقع عملي اختصاصيّة اجتماعيّة وتعاملي المباشر مع الطلّاب، أرى أنّ هناك مهارات حيويّة يجب أن نركّز عليها، وهي المهارات الإنسانيّة والعاطفيّة، مثل التعاطف والتواصل الفعّال، لأنّها المهارات التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعيّ تقليدها بعمق. كذلك إدارة المشاعر والذكاء العاطفيّ، خصوصًا في عالم رقميّ يفتقر إلى التفاعل الإنسانيّ الحقيقيّ، إضافةً إلى العمل الجماعيّ والقيادة. كما تبرز أهمّيّة التفكير النقديّ والإبداعيّ، أي القدرة على تحليل المعلومات وتقييم مصداقيتها، وطرح الأسئلة الصحيحة، والتفكير خارج الصندوق، وحلّ المشكلات بطرق مبتكرة. إلى جانب ذلك، تأتي المرونة والتكيّف، أي القدرة على التعلّم المستمرّ وإعادة تعلّم مهارات جديدة، والتكيّف مع التغيير السريع، وفهم كيفيّة عمل الذكاء الاصطناعيّ والتعامل معه أداةً لا بديلًا.
ولا تقلّ أهمّيّة عن ذلك مهارة الأمان الرقميّ وحماية الخصوصيّة، والقيم والأخلاق في اتّخاذ قرارات أخلاقيّة مدروسة، خصوصًا في عالم تتزايد فيه الخيارات المعقّدة. أؤمن أنّ دوري، اختصاصيّة اجتماعيّة، أصبح أكثر أهمّيّة في تنمية هذه المهارات، لأنّها تتطلّب تفاعلًا إنسانيًّا حقيقيًّا وتجارب عمليّة لا يمكن للتكنولوجيا وحدها أن توفّرها.
ما أهمّ استراتيجيّاتكِ في شدّ انتباه المتعلّمين؟
من خلال تجربتي العمليّة اختصاصيّةً اجتماعيّة، طوّرتُ عدّة استراتيجيّات فعّالة. أبدأ دائمًا بـ "البداية القويّة" بقصّة قصيرة، أو سؤال مثير للاهتمام يربط الموضوع بحياتهم. أراقب لغة جسدهم وألاحظ جيّدًا تعابير وجوههم وحركاتهم. وأتحرّك في المكان، وأعبّر بوجهي وأغيّر نبرة صوتي. أعتمد على "التفاعل المستمرّ" بطرح أسئلة قصيرة وطلب مشاركة تجاربهم. وأحرص على "ربط المحتوى بعالمهم"، فأستخدم أمثلة من ألعابهم المفضّلة، أو مواقف حدثت في المدرسة، وأتابع ما يثير اهتمامهم وأدمجه في نقاشاتنا.
كما أنوّع في الأنشطة، وأُشركهم في اتّخاذ القرارات، وأهتمّ بهم على المستوى الشخصيّ، فأتذكّر أسماءهم واهتماماتهم. وأحرص على أن أكون صادقة ومتحمّسة في ما أقدّمه، لأنّ الحماس الحقيقيّ ينتقل إليهم بشكل طبيعيّ.
هل ما زال تعبير "ضبط الصفّ" مناسبًا برأيكِ؟
أشعر أنّ تعبير "ضبط الصفّ" أصبح مفهومًا قديمًا لا ينسجم مع فلسفة التعليم الحديثة. فعندما نقول "ضبط الصفّ"، نتحدّث عن السيطرة والتحكّم، وهذا المفهوم يخلق علاقة عدائيّة بيني وبين الطلّاب، وهو عكس ما أسعى له بوصفي اختصاصيّة اجتماعيّة. بدلًا من "ضبط الصفّ"، أفضّل استخدام مفهوم "إدارة البيئة الصفّيّة"، أي خلق جوّ من الاحترام المتبادل، ووضع قواعد واضحة نتّفق عليها معًا وليس فرضها من طرف واحد.
كما أحرص على فهم أسباب السلوك المزعج بدلًا من مجرّد قمعه، وتوجيه طاقة الطلّاب نحو أنشطة إيجابيّة بدلًا من منعها. أعتقد أنّنا نحتاج إلى تغيير المصطلحات التي نستخدمها، لأنّها تعكس طريقة تفكيرنا. فعندما نغيّر اللغة، نغيّر الممارسة تلقائيًّا. الهدف ليس "ضبط" الطلّاب، بل مساعدتهم على تعلّم احترام الآخرين وإدارة سلوكهم بأنفسهم، وهذا ما يسهم في بناء شخصيّات مسؤولة.
ما الذي يجعلك تضحكين في المدرسة على الرغم من الضغوط؟ ولماذا؟
المواقف المختلفة، مثل اعترافات الطلّاب الصادقة، ومحاولات الإقناع المضحكة، والتبريرات الطريفة، تجعلني أبتسم دائمًا. الضحك يذكّرني أنّ خلف كلّ "مشكلة سلوكيّة" طفلًا طبيعيًّا يفكّر بطريقة بريئة ومنطقيّة من وجهة نظره. كما يخفّف عنّي ضغط العمل والمسؤوليّات الثقيلة. بدلًا من أن أحبط من تصرّفاتهم، أجد في براءتهم طاقة إيجابيّة تشحنني للاستمرار. عندما أضحك مع الطلاب (وليس عليهم)، أبني معهم علاقة أقرب وأكثر ثقة، وهذا يساعدني في عملي الإرشاديّ. هذه اللحظات المرحة هي التي تجعلني أحبّ مهنتي على الرغم من كلّ التحديات، وتذكّرني دائمًا لماذا اخترت العمل مع الأطفال من الأساس.
أكثر مقال تربويّ أعجبك قرأتِه في صفّحات مجلّة منهجيّات أو غيرها، ولماذا أعجبك؟
التعليم التحرريّ لباولو فريري غيّر نظرتي تمامًا لدوري اختصاصيّة اجتماعيّة في المدرسة. أعجبني جدًّا مفهوم فريري عن "التعليم المصرفيّ"، كيف أنّنا أحيانًا نتعامل مع الطلّاب كحسابات مصرفيّة فارغة نملأها بالمعلومات، بدلًا من اعتبارهم شركاء في عمليّة التعلّم. أصبحت أفكر بطريقة مختلفة: بدلًا من أن أجلس كخبيرة وأعطي نصائح من طرف واحد، أطرح أسئلة أكثر، وأجعل الطلّاب يحلّلون مشاكلهم بأنفسهم ويجدون الحلول. أستخدم أسلوب الحوار بدلًا من المحاضرة، وأحترم خبراتهم. أدركت أنّ كلّ طالب يأتي بخبرات حياتيّة مهمّة، حتّى لو كان في الصفّ الأوّل. خبرتهم في البيت، في الحيّ، مع أصدقائهم، كلّها مصادر تعلّم نبني عليها. فهمت أنّ دوري ليس "إصلاح" الطلّاب، بل مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وإيجاد صوتهم. أصبحت أرى نفسي ميسّرةً لا صاحبة سلطة. هذا المقال علّمني أنّ التعليم الحقيقيّ يحدث عندما نتعلّم جميعًا من بعضنا: أنا من الطلّاب، وهم منّي، وهم من بعضهم. كلّ جلسة إرشاديّة أصبحت تجربة تعلّم متبادلة، وهذا ما جعل عملي أكثر متعة وتأثيرًا.
إذا كتبتِ يومًا كِتابًا عن تجربتك في التعليم، ماذا سيكون عنوانه؟ ولماذا؟
عنوان كتابي سيكون: قلوب تبحث عن أمل.
اكتشفت خلال سنوات عملي أنّ كلّ طالب يأتي إلى مكتبي يحمل قصّة، وكلّ قصّة تحتاج إلى من يستمع إليها. الطلّاب لديهم مشاعر عميقة وأفكار مهمّة، لكنّهم غالبًا لا يجدون من يأخذهم بجدّيّة. عملي يدور حول المشاعر والعلاقات الإنسانيّة أكثر من الكتب والدرجات، وأدركت أنّ دوري الأساسّ مساعدة كلّ طالب على اكتشاف ذاته، وإيجاد الطريقة المناسبة للتعبير عن نفسه. كلّ سلوك "مزعج" أو "غريب" في المدرسة هو صرخة طفل يحاول أن يقول شيئًا مهمًّا. أريد أن أظهر الوجه الإنسانيّ للتعليم، بعيدًا عن الإحصائيّات والتقارير. نحن لا نعلّم الأطفال فقط، بل نساعدهم على اكتشاف أنفسهم وإيجاد طريقهم في الحياة.