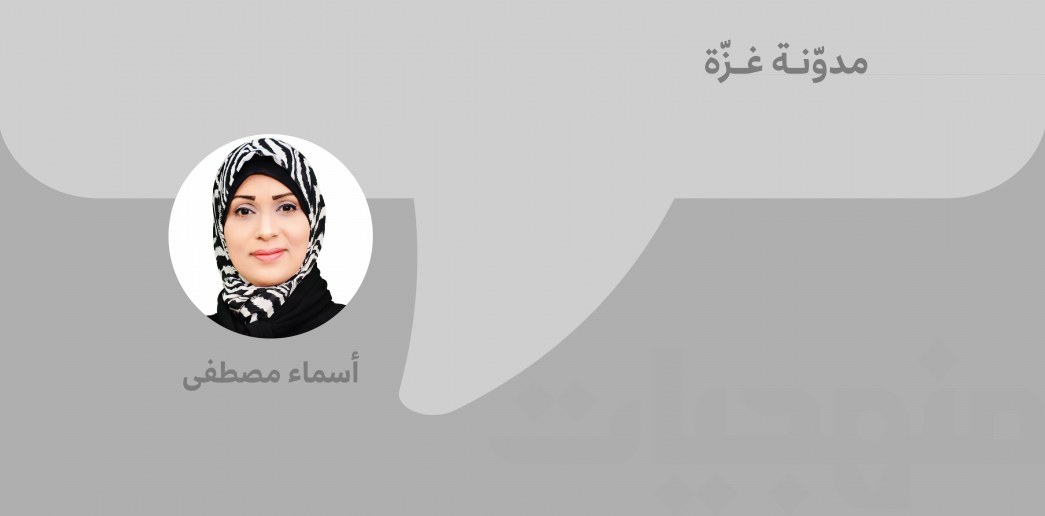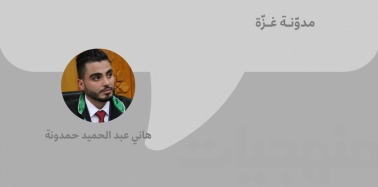أحيانًا، لا أجد ملجأ من قسوة اللحظة سوى الهروب إلى دماغي، والقيام بنزهة هادئة بين الممرّات التي عرفتها قبل أن يتحوّل العالم إلى ساحة رماد. أغمض عينيّ، وأسمح لذاكرتي أن تفتح أبوابها واحدًا تلو الآخر: فتستقبلني مدرستي القديمة، مدرسة حليمة السعديّة الأساسيّة للبنات، كما لو كانت ما تزال شامخة، لم تلمسها الحرب بعد، ولم تتحوّل إلى مركز إيواء للنازحين، ولم تقصف عشرات المرّات بعد، ولم تُسوّ بالأرض منذ أسابيع قليلة.
أدخل عبر البوابة الحديديّة التي لطالما أزعجني صوتها وهي تصدر صريرًا عند الفتح. لكنّه اليوم يبدو لحنًا جميلًا، لأنّه يعيدني إلى مكان كنت أتنفّس فيه حياةً. في الساحة، أرى الطالبات متأنّقات بزيّهنّ المدرسيّ الموحّد، مصطفّات بانتظام في الطابور الصباحيّ. أسمع أصواتهنّ وهي ترتفع بالأناشيد الوطنيّة "بلادي يا أرضي يا أرض الجدود"، تختلط بضحكات صغيرة متسرّبة من بين الصفوف، كأنّها أسرار لا يعرفها إلّا هنّ وحدهنّ. أتنقّل بينهم بعينيّ، وأكاد ألمس براءة الوجوه التي تلمع مع أولى خيوط الشمس.
أتقدّم نحو الصفوف، يدي تحمل دفتر تحضير الدروس وعلبة الطباشير. تختلط رائحة الطباشير البيضاء برائحة الورق الجديد في ذاكرتي، وكأنّني أتنقل في الصفوف أشمّ رائحة دفاترهنّ الملوّنة وأقلامهنّ التي يحرسنها كما لو كانت كنوزًا. كم كنت أحبّ أن أرسم على السبورة الخضراء كلمات جديدة باللغة الإنجليزيّة، وأن أراقب شغفهنّ وهنّ يتهجّين الحروف كلمةً كلمة، كمن يقطف ثمرة لأوّل مرّة.
في كلّ فصل، كانت لي ألف حكاية وحكاية. تلك الطالبة التي كانت تُصرّ على الجلوس في الصفّ الأوّل لتجيب عن كلّ سؤال، مع أنّها لم تكن تعرف دائمًا الإجابات، ولكنّها لا تتنازل عن المقعد الأوّل في الفصل. وتلك الطالبة الأنيقة التي تخبّئ وردة صغيرة كلّ صباح لتضعها على مكتبي، فتجعل قلبي يزهر مثلها. هناك مَن كانت تحلم أن تصبح طبيبة، ومَن كانت تكتب في دفترها "أريد أن أكون معلّمة مثل معلّمتي أسماء". تلك الأحلام كانت نوافذ صغيرة نفتحها جميعًا لنطلّ منها على مستقبل أجمل. كانت مدرستي في أجمل صورها عندما ألتقي طالباتي في حدائق ساحة المدرسة، والتي تتوسّطها نافورة ماء عذب، كانت نافذة من الحبّ والأمل، أكاد أسمع صوتها جيّدًا كأنّني أجلس بجوارها تمامًا كما كنت أفعل.
أتابع النزهة داخل دماغي. أتنقّل من مشهد إلى آخر كما لو كنت أتجوّل في معرض صورٍ حيّ. أرى وجوهًا كثيرة، أسمع أصواتًا متشابكة، أسمع في دماغي حقًّا أصوات أسئلتهنّ ودهشتهنّ، وصدى ضحكاتهنّ التي تملأ الممرّات. مشاهدٌ تمرّ في دماغي في غرفة المعلّمات، حيث كانت لنا طقوس صغيرة: نتبادل التهاني في مناسبات الزميلات الاجتماعيّة، نضحك على مواقف طالباتنا الطريفة، نتشارك الخبز والشاي، ونرسم خططًا كبيرة لتعليم أكبر من حدود الجدران.
وبينما أتمشّى في هذه الذاكرة، يتسرّب ظلّ الحرب؛ في زاوية الساحة، أرى مقعدًا فارغًا من الطالبات، يجلس عليه مسنّ نازح قد لجأ للاحتماء بالمدرسة عندما تحوّلت إلى مركز إيواء. غابت طالباتي ذات يوم عن هذا المكان، ولم يعدن إليه حتّى اللحظة، وطال الغياب كثيرًا. في أحد الفصول، يختفي صوت ضحكة كنت أسمعها دائمًا ليحلّ محلّها صمتٌ ثقيل. أفتح نافذةً في ذاكرتي، فتطلّ على مشهد زجاج مكسور، وُضعت مكانه قطع من البلاستيك والنايلون كي تحمي النازحين من شدّة البرد والمطر. لم يبق من الفصل سوى جدار متصدّع، وطفلة تحمل حقيبتها التي تحمل ملابسها، تصبح الحقيبة درعًا تحمي به قلبها الصغير.
ألوان الصور في دماغي تتغيّر. كانت زاهية، فأصبحت فجأة رماديّة. الضحكات تتحوّل إلى همهمات حزينة. أسمع صدى بعيدًا لانفجار، يدخل الذاكرة ضيفًا غير مرغوب به، فيكسر صفاء المشهد. حتّى صوت الجرس لم يعد يرنّ بنغمة النظام المدرسيّ، بل صار يشبه صفير صاروخ قادم.
أحاول أن أتمسّك بالنزهة، أحاول البقاء بين دفاتر طالباتي وأحلامهنّ الصغيرة، لكنّ الحرب تعرف كيف تقتحم الدماغ بلا استئذان. أحاول أن أستعيد وجوههنّ، مقاعدهنّ، دفاترهنّ، إلّا أنّي أجد نفسي أمام لائحة طويلة من أسماء شهيدات من داخل فصولي الدراسيّة، وأمام صور صديقات شابّات صغيرات لن يعدْنَ إلى مقاعدهنّ أبدًا.
وأنا أتجوّل بين الصور، أرى نفسي التي أتوق إلى رؤيتها كما كانت. أراها كما كنتُ أحبّ أن تكون: معلّمة تكتب على السبّورة بحبٍّ، وتؤمن أنّ التعليم حياة، وأنّ بناء العقول حصنٌ في وجه الاحتلال. ثمّ أراها كما أصبحت: نازحة تحمل دفتر أحلامها في حقيبة صغيرة، وتبحث عن فسحة لتعلّم أطفالًا وسط الخيام.
فجأة، يهتزّ الدماغ كلّه. ترتجف الصور وتختلط الأصوات. أفتح عيني، فإذا بي لست في المدرسة، ولا بين الأطفال. أنا في غرفة صغيرة من بيتٍ آيل للسقوط، وصوت القصف يهدر قريبًا وحشًا جائعًا يلتهم كلّ ما ومن يقترب منه.
أدرك تمامًا الآن أنّ النزهة انتهت، فقد كانت محاولةً يائسة لأمسك بخيط ذاكرة قبل أن يبتلعه الركام. كنتُ أمشي بين الألوان، لكنّي استيقظت على رماد. كنتُ أحلم أنّي معلّمة في مدرسة، لكنّي أفتح عيني الآن على حقيقة أنّي شاهدة على حرب إبادة جماعيّة شاملة للإبادة التعليميّة وإبادة الشجر والحجر.
تلك النزهة العصيّة على القصف هي صوت الأمل في قلبي، رحلوا وقُصفت مدرستي، بل سوّيت بالأرض تمامًا. لكن، تبقى أصوات طالباتي وأناشيد الطابور ودفاتر الأحلام حيّة في دماغي، كحديقة سرّية لا تصل إليها الصواريخ. قد يُسقطون جدران مدرستي، لكنّهم لن يسقطوا حقّي في أن أتمشّى بين ذكرياتي، ولن يسرقوا منّي يقيني أن التعليم سيظلّ بذرةً تنبت حتّى في أعتى الظلمات.
ختامًا، يظلّ التعليم في جوهره فعل مقاومة ضدّ محاولات الطمس والاقتلاع، وقوّة إنسانيّة مُتجدّدة تُعيد للإنسان كرامته وحقّه في الاستمرار. فالأمل هنا لا يُختزل في شعور عابر، بل هو بنية متجذّرة في عقول الأطفال وقلوب المعلّمين، تمنحهم القدرة على تجاوز محنة الحاضر وتخيّل غدٍ يتّسع للحياة والعلم معًا. المستقبل، مهما بدا بعيدًا أو مثقلًا بالتحدّيات، يظلّ فضاءً تمكن إعادة تشكيله؛ فضاء تُبنى فيه المدارس من جديد، وتعود أصوات الأجراس وأناشيد الصباح لتعلن عن دورة حياة لا تنكسر. وهكذا يصبح التعليم بذرةً عنيدة، قادرة على الإنبات حتّى في أكثر البيئات قسوة، شاهدة على أنّ المعرفة لا تُهزم، وأنّ الأمل سيظلّ المسار الذي يقودنا نحو غدٍ أكثر عدلًا وترعًا بالكرامة الإنسانيّة.