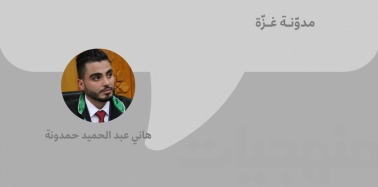في كتابه المعنون بـِ "من أجل ثورة ثقافيّة بالمغرب" (مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الصادر سنة 2018)، ينكبُّ حسن أوريد على معالجة قضيّة النهضة التربويّة محاولًا تقديم رؤيته وتصوّره لها بالاطّلاع على بعض الأدبيّات التربويّة، والاستناد إلى تجربته في التدريس والتدبير. بُني الكتاب على خمسة أبواب، يضمُّ كلّ باب عدّة فصول بالإضافة إلى توطئة وختم. في توطئة الكتاب، حديث عن دور التربية في نهضة الأمم واقتحام الآفاق، والأخذ بأساليب التحديث والقيام بنهضة تربويّة. "إذ لا بد من رؤية، أو من مشروع مجتمعيّ، أو من طموح جماعيّ، وهو الشرط الأساس الذي يؤثّر في عمليّات التعليم كلّها ومكوّناتها كلّها"، كما يشير أوريد في الكِتاب في صفحته العاشرة.
يتأسّسُ الكتاب على ضرورة قيام الإصلاح على طموح جماعيّ ورؤية وتصوّر واضحين تُحدَّدُ فيهما الغايات الكبرى، ثمّ يُبحث في الوسائل. ويرفض الإصلاحات المتتالية التي ركّزت على الجوانب التقنيّة والتنظيميّة، لذلك لم تنجح ولم تصلّ إلى نتيجة. يعالج الكتاب الحالة المغربيّة بشكل خاصّ، لكن نظرًا إلى التقارب الثقافيّ والوشائج بين المغرب وبعض البلدان العربيّة، مثل تونس وموريتانيا والجزائر، يصبح من الممكن تعميم بعض منطلقات الكتاب وخلاصاته، خصوصًا ما هو مرتبط بمسألة اللغة والمناهج.
يقدّم المؤلّف رؤيته للنهضة التربويّة من خلال العناصر الآتية:
أوّلًا: أسئلة وجوديّة
لن نعرف ما نريد إلّا عبر المرور بمعرفة من نحن؛ أي معرفة شخصيّتنا وما تحمله من نبوغ وعبقريّة وتفاعل بين مكوّناتها، ثمّ ما نريده، وهو أن نطبع التجربة الكونيّة ونكون جزءًا منها، فنكون بمنظومتنا التربويّة جزءًا من التجربة الإنسانيّة. يجب أن تكون المدرسة قاطرة طموحنا الجماعيّ، ففيها تنعكس وحدة المكوّنات وأهدافها وانسجامها وتدبير الاختلافات، فتتيح فرص النجاح لمن استحقّ وأبان عن انضباط. فنحن نعيش في عالم جديد يجب أن تعكسه مدرستنا، ولا ينبغي لنا أن ننسخ تجارب غيرنا، بل يجب أن تخرج من بيئتنا، وأن تأخذ بالاعتبار التغيّرات الممكنة.
ثانيًا: الأُسُسُ
حلّل الكاتب في هذا الباب خمسة فصول. أوّلها مسألة القيم وما ينبغي أن تقوم عليه من انضباط يشمل المتعلّم والمعلّم والمسؤول، ثمّ مسألة الحرّيّة التي هي أساس المعرفة. إضافة إلى قيمة التضامن التي تتجاوز تضامن المتعلّمين في ما بينهم، إلى تضامن مكوّنات الشخصيّة المغربيّة التي تنقلها المدرسة إلى المتعلّمين من دون ميل إلى بُعد أو اتّجاه. ثاني هذه الأسس وسائل الارتقاء، والمقصود بها التمييز بين المعتقدات والأفكار الماهدة والتقنيّات. أمّا ثالثها فمسألة التربية المدنيّة التي يدافع عنها الكاتب، وهي في تصوّره تتنافى مع كلّ تأويل خطأ للأفكار، فالمدرسة جامعة وضدّ كلّ نزعة. ويُعرّج على الوحدة والتنوّع أساسًا رابعًا، أي إنّ دور المدرسة ترسيخ مفهوم الأمّة وتدبير الخصوصيّات الثقافيّة. وأخيرًا مسألة التعليم والجودة، والتي يؤكّد الكاتب بها على أولويّة التعليم وضرورة جعله مشتل النخبة ومخرِّج الأطر الوطنيّة التي تتولّى التسيير.
ثالثًا: مقوّمات الإصلاح
ينقسم إلى خمسة فصول. يحلّل الأوّل الانتقال من مفهوم التعليم إلى ما هو أشمل، أي التربية التي تتجاوز المعارف والمضامين إلى تحويل الفرد غايةً لينجح ويرتقي بمجتمعه. أمّا الفصل الثاني، فخُصّص لمراحل التدريس: المرحلة الأولى سمّاها التعليم ما قبل المدرسيّ، ويقصد به التعليم الأوّليّ، وما ينبغي تقديمه إلى الطفل من حرّيّة وتعليم واستئناس بالمدرسة. ثمّ يأتي التعليم الابتدائيّ، والذي يعلّم الانضباط، وحيث تدرس المعارف والأخلاق فالوطنيّة، ثمّ التوازن البدنيّ والنفسيّ. أمّا التعليم الإعداديّ، فيقوم على المواكبة وجعل المتعلّم يتحمّل المسؤوليّة، حيث يدرس في هذا الطور الآداب والعلوم ومداخل الاقتصاد. أمّا المرحلة الثانويّة، فهي تُحضّر من سيتحمّل مسؤوليّته في وطنه، وعليه أن يكون أتقن بعض اللغات وانفتح على الحضارة الإنسانيّة.
ويشير المؤلّف في نقاشه مسألة اللغة في الفصل الثالث، إلى ضرورة الحسم في لغة التدريس. ويناقشها بنوع من الحيطة والحذر، فهو يُقر بالوضع الاعتباري للعربيّة، ولكن لا يميل إلى اعتبارها لغة للعلم. ويكرّر ما قيل عن الفرنسيّة بأنّها لغة المستعمر وغنيمة حرب. ويدعو إلى الانتقال إلى التدريس بالإنجليزيّة. فلقد جرّبنا التدريس بالفرنسيّة، ولم نحقّق ما نصبو إليه. فهل بالقفز عن العربيّة والاعتماد على الإنجليزيّة سنحقّق ما عجزنا عنه؟
أمّا الفصل الرابع، فيعالج الشخصيّة المغربيّة. يدعو الكاتب إلى ضرورة إنشاء المتعلّم على معرفة بعناصر الشخصيّة المغربيّة، وأوجه الثقافة الوطنيّة. أمّا الفصل الخامس، فخُصّص للحضارة الإنسانيّة. بعد التعرّف إلى الشخصيّة المغربيّة، ينبغي الانتقال إلى ما هو كونيّ؛ أي الانفتاح على الحضارة الكونيّة بجانبيها المشرق والمظلم.
رابعًا: الإصلاح الجذريّ
تحدّث هنا عن النموذج الأعلى الذي نأمله، وما نريده من مدرستنا المغربيّة.
جاء هذا الباب ضامًّا عشرة فصول. الثلاثة الأولى تعالج المثلث البيداغوجيّ المشهور، وكيفيّة تنزيله في نظامنا التعليميّ، بمعرفة المتعلّم وحاجاته قصد تحويله، وإعادة الاعتبار إلى المدرّس واعتباره أحد حلقات بناء الثورة الثقافيّة والنهضة التربويّة. أمّا المدرسة، فيؤكّد على ضرورة العناية بها بتدريس قيم المواطنة والقيم الكونيّة ثم الحسّ النقديّ. الفصلان الرابع والخامس خُصّصا للبرنامج الدراسيّ والمنهاج، فيحثّ المؤلّف على ضرورة اعتماد برنامج إجباريّ للجميع، يكون توجيهيًّا في ما يخصّ الأنشطة الموازية، ويتيح للمدرِّس إمكانيّة التصرّف. أمّا المنهاج، كونه روح التعليم، فينبغي أن يواكب المستجدّات ويساير السياقات. كما خصّص فصلًا للتدبير الإداريّ وترشيد الموارد، أي الحكامة في التدبير. بعد ذلك، تحدّث عن التقييم، أي الفارق بين الإمكانيّات المرصودة والنتائج المحقّقة. ويشمل التقييم التلميذ أوّلًا، ثم المدرّس، وبعده المادّة فالبرنامج ثمّ المنهاج. كما ينبغي تقييم الجوانب الماليّة والإداريّة ودور الأسرة وكذا المجتمع، بمعنى الإيمان بالعمليّة التربويّة وأهمّيّتها، والمساعدة على التحصيل. بالنسبة إلى المجتمع، فهو تضافر جهود الجميع، من تقدير للتلميذ والمدرّس، وتغيير السلوكيّات تجاه المدرسة. كما عنون الفصل الأخير بالقطيعة، بمعنى الدعوة إلى القطع مع الأساليب المعتمدة في الإصلاح التربويّ، والتي أدّت إلى عدّة إخفاقات، وقد تحيل القطيعة إلى الصدمة حسب المؤلّف.
الباب الخامس: الهيئات المسؤولة والفاعلون
هنا ضرورة تدخّل عدّة أطراف إلى جانب وزارة التربية، ومنها:
- مؤسّسات الدولة، أي التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الأوقاف ثمّ وزارة الثقافة والإدارة الترابيّة ومؤسّسات الجالية المغربيّة في الخارج. تنسيق من أجل البرامج والتجهيز والمعارض....
- القطاع الخاصّ وشبه الخاصّ والبعثات الأجنبيّة. وهو ضرورة تدخّل الدولة وتنظيم هذا الجانب، وأن يتكامل مع التعليم العموميّ لا أن يحقّق الجودة بمعزل عنه. وأن يُستثمر استثمارًا إيجابيًّا فيه ويسدّ النقص.
- المجتمع المدنيّ ودوره في الاقتراح والتصوّر، مع فتح أبواب المؤسّسات أمام الجمعيّات في إطار احترام الضوابط والقوانين.
- التربية الموازية، لما لها من دور في التأطير، سواء في المساجد أو عبر التلفاز دروسًا لمحاربة الأمّيّة. وينبغي تجاوز هدف التركيز على محاربة الأمّيّة إلى أهداف أعمق.
- المجلس الأعلى للتربية ودوره الاستشاريّ والرقابيّ والاقتراحيّ، وكذا تفكيره في قضايا التربية.
يؤكّد المؤلّف بأنّ كتابه أرضيّة للنقاش حول قضيّة التربية، على أن تُطرح الأفكار والتصوّرات للنهوض بالمدرسة المغربيّة من خلال ثورة ثقافيّة. وأن تتجاوز ما فشل من إصلاحات كونها كانت حبيسة تصوّر جاهز، أو تنزيل لمقاربات نجحت في بيئات أخرى. فكما يقول الجابري في كتابه أضواء على مشكلة التعليم بالمغرب، صفحة 122، قيمة كلّ إصلاح في ميدان التعليم لا تتحدّد "إلّا من خلال تأثيره المباشر، وانعكاساته القريبة والبعيدة على الحياة العامّة بمختلف مرافقها، حاضرًا ومستقبلًا".
النهضة التربويّة يجب أن يُؤسّس لها وتصاغ انطلاقًا من خلق تصوّر جماعيّ لقضيّة التربية، ثمّ انخراط جميع الأطراف. وإن لم يكن هذا، فسيأتي إصلاح ينسف الذي قبله. ونختم مقالنا هُنا بتكرار ما قيل قبل قرنين من الزمن، حين صرخ الفيلسوف الألماني فيخته صرخته المشهورة، بعد هزيمة بروسيا أمام جنود نابليون سنة 1812: "فقدنا كلّ شيء ولم يبق لنا إلّا التربية".