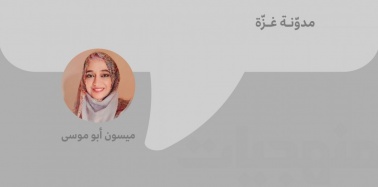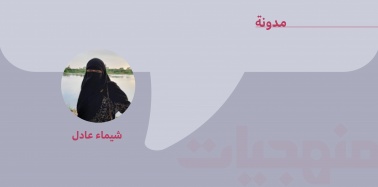ينطلق مبدأ التعليم التفريقيّ من جذر فلسفيّ عميق، يتعلّق بالاعتراف بالذات الإنسانيّة في تنوّعها الأنطولوجيّ بوصفه علمًا للكائنات. هو ليس مجرّد أسلوب تدريسيّ تعلّميّ، بل موقف أخلاقيّ تجاه "الآخر" في سياقه الوجوديّ الفريد. يستند هذا المبدأ إلى فكرة أساسيّة، مفادها أنّ الفرديّة ليست حادثًا عارضًا، أو صدفة ما، في مسيرة التعلّم الدقيقة؛ بل هي جوهره الذي لا يتجزّأ، متأثّرًا بأفكار أرسطو حول "الاستعداد" و"الفعليّة" الكامنة في كلّ إنسان متعلّم.
يتحدّى التعليم التفريقيّ النموذج " المونولوجيّ" للتعليم التقليديّ، والذي يسعى لصبّ الجميع في قالب واحد كاستنساخ، لصالح حوار تربويّ "ديالوجيّ" (على نهج باختين) يعترف بالتعدّديّة الأبستمولوجيّة – أيّ الطرق المختلفة لاكتساب المعرفة وفهم العالم – والتنوّع السوسيولوجيّ للمتعلّمين.
يمثّل هذا المبدأ تجسيدًا لفكرة "العدالة التوزيعيّة" في الفلسفة الأخلاقيّة، حيث لا تعني المساواة تقديم الشيء نفسه للجميع، بل تقديم ما يناسب حاجة كلّ فرد لتحقيق إمكاناته القصوى. وهو ما يقتضي من المُربّي القيام بدور "القابلة" السقراطيّ ليسهّل عمليّة "ولادة" المعرفة الذاتيّة لدى كلّ متعلّم، بطريقته الخاصّة في إنتاج المعرفة. هذا يتطلّب فهمًا (ظاهراتيًّا) للتجربة التعليميّة من منظور المتعلّم ذاته، وليس فقط من منظور مركزيّة المنهج أو المعلّم.
تطبيق هذه الفلسفة التربويّة في واقع التعليم الفلسطينيّ، يواجه فجوة هائلة بين النظريّة والممارسة. فالبيئة الصفّيّة الفلسطينيّة تعاني غالبًا الاكتظاظَ الشديد، ما يحوّل الفصل إلى فضاء " فوكووي " تسوده آليّات المراقبة والضبط الجماعيّ، يصعب فيه تحقيق الفردانيّة المنشودة. كما إنّ شحّ الموارد المادّيّة – من كتب متنوّعة، وأدوات تعليميّة، وتقنيّات – يُعيق القدرة على تقديم مسارات تعلّم متعدّدة وموادّ غنيّة، تلبّي الاهتمامات والقدرات المتباينة. تضاف إلى ذلك تحدّيات بنيويّة عميقة، مثل المناهج المركزيّة الصارمة التي قد لا تراعي التنوّع المحلّيّ، ونقص التدريب الكافي والمستمرّ للمعلّمين على استراتيجيّات التفريق الفعّالة التي تتجاوز مجرد تقسيم المهامّ حسب المستوى.
يتعقّد المشهد أكثر بسبب السياق السياسيّ الفلسطينيّ الفريد تحت الاحتلال وهمجيّته، حيث تتحوّل المدرسة في كثير من الأحيان إلى ملاذ مادّي نفسيّ واجتماعيّ، أكثر من كونها حيّزًا للتفريق الأكاديميّ الدقيق. انقطاعات الكهرباء، وصعوبات التنقّل بسبب الحواجز والجدار، والعنف السياسيّ المباشر أو غير المباشر، كلّها عوامل خارجيّة ماركسيّة البنية، تُنتج إكراهات مادّيّة ونفسيّة تُضعف قدرة النظام التعليميّ بأكمله - بما فيه المعلّمون - على التركيز على التفريد الدقيق. قد يظهر التفريق في بعض الأحيان استجابةً طارئة للفروق الصارخة في مستوى التحصيل الناتجة عن هذه الظروف القاسية، أكثر من كونه فلسفة تربويّة شاملة وممنهجة.
على رغم هذه العقبات الجسام، تبرز محاولات فرديّة وجماعيّة لـ"توطين" فلسفة التعليم التفريقيّ. معلّمون مبدعون يمارسون "البرجماتيّة" التربويّة، مستخدمين ما هو متاح من موادّ، ويبتكرون أنشطة مرنة. ويستثمرون العلاقات الإنسانيّة القويّة داخل الفصل، لخلق مساحات صغيرة للاعتراف بفردانيّة بعض الطلّاب. تعكس هذه المحاولات "إرادة الحياة" الفلسطينيّة وقدرتها على خلق معنى تربويّ، حتّى في أحلك الظروف. غير أنّ تحقيق الرؤية الفلسطينيّة الحقيقيّة للتعليم التفريقيّ – تعبيرًا عن حقّ أساسيّ في الاعتراف بالهويّة الفرديّة والجماعيّة في إطار التحرّر – يبقى رهنًا بتذليل العقبات البنيويّة والسياسيّة، وبناء نظام تربويّ قادر على تحويل المبدأ الفلسفيّ الأخلاقيّ إلى واقع ملموس للجميع.