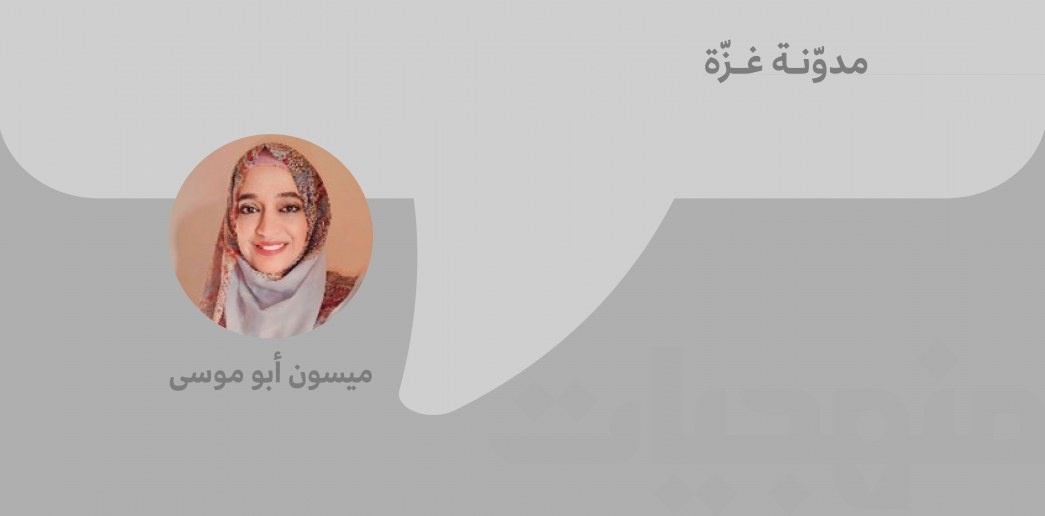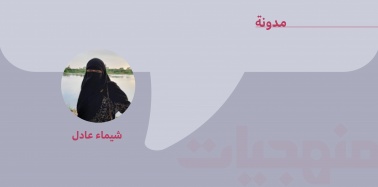كثيرًا ماكنت أسأل نفسي: أيّ شيء هذا الذي يستحقّ أن يجتمع الأطفال لأجله في خيمة تفتقد معالم الرفاهيّة في سنة 2026؟
ما الذي يمنح هؤلاء الأطفال الأمان إلى الحدّ الذي يستسلمون فيه للوقت في داخلها؟
كانت التجربة هي الإجابة العميقة على تلك الأسئلة. عندما دخلت خيمتي التعليميّة لم أكن أمتلك سبّورة ولا مقعدًا ولا قلمًا ولا حتّى دفتر. المكان هنا وكأنّه يُبعث من جديد. لم أكن أمتلك القوّة لأبدأ من مرحلة العدم.
بداية العام الدراسيّ الجديد أنظر بحذر إلى أطفال فقدوا حقوق الطفولة ومقوّماتها .
اتّفقت في بداية الأمر مع طالباتي، ووضعنا بنودًا لعقدٍ كنت أنا الطرف الأوّل بموجبه، وكانوا هم الطرف الثاني. واشتمل على حقوق لي ولهم وواجبات على كلينا. كان من أهمّ البنود أن أسعى جاهدة لتطوير قدراتهم ونسج خيوط معرفتهم؛ لنثبت للعالم أنّ العقل لا يُحاصر كما المكان، وأنّ أقفال الجهل تُكسر بالعلم والتجربة. في كلّ حصّة كانت تجمعنا كنا نُذكّر بعضنا بذلك الاتّفاق، فنعود إلى الالتزام معًا.
عندما كنت أعود إلى المنزل، كنت دائمة التفكير في استراتيجيّات التعلّم والألعاب التي أودّ استخدامها في الحصّة المُقبلة. طبقتُ استراتيجيّة الحكواتيّ، والتي تعتمد على تحويل المحتوى (معلومة ودرس وقيمة ومهارة ) إلى قصّة ذات حبكة وشخصيّات وأحداث. بحيث يتفاعل المتلقّي عاطفيًّا وعقليًّا مع الفكرة، فيتذكّرها ويفهمها بشكل أعمق؛ سردنا قصّة (قطّورة الماء) عندما شرحت دورة الماء في الطبيعة، وذكرنا قصّة (التفّاحة الشجاعة) عندما رسمنا الجهاز الهضميّ؛ وتحدّثنا أيضًا على قصّة (رحلة نسمة الهواء) عندما ذكرنا مكوّنات الجهاز التنفسيّ.
كنت أتقمّص شخصيّة خياليّة لعدسةٍ متنقّلة تُدعى العدسة زووم، تتنقّل عبر الفضاء وتُبحر في أعماق البحار، وتدخل في أجسام الكائنات الحيّة. كانت زووم كفيلة بسرقة أذهان طالباتي ولفت انتباههن للتحليق في عالم الخيال. كنت أشعر وأنا أسرد القصّة، بنظرات طالباتي تُربّتُ على كتفي وتشدّ على يدي لتهمس في أذني: "رائع استمرّي".
لم ينته الأمر عند هذا، فقد جمعت القصص في برنامج، وأسميته: (مغامرات العدسة زووم في العلوم). حقّقت هذه السلسلة نجاحًا من وجهة نظري، وكأنّها حلقات المحقّق كونان. وهذا كفيل بأن يُشعرني بالفخر بالتقدّم واكتشاف المزيد.
أجواء مدينة غزّة ما زالت حزينة، وما زال الأطفال فيها يشقّون طريقهم نحو الحياة بصعوبة منقطعة النظير. وكلّما نظرت إلى وجوه طلّابي وقد أنهكتهم حياة النزوح والتشرّد، تذكّرت ذلك البند في اتّفاقيّتنا، والذي يؤكّد استمراريّة الاستحواذ على عقولهم وقلوبهم معًا. وشعرت أنّ رفاهيّة التعلّم غير موجودة ونحن نعيش في سجن غزّة الكبير . وأنّ الطفل في ظلّ انقطاع التيّار الكهربائيّ لا يستطيع متابعة برامج الكرتون المُحبّبة لديه، ولا يستطيع الذهاب الى الملاهي والحدائق العامّة التي تضرّرت وهُدمت بسبب الحرب. ولا يستطيع أيضًا ممارسة اللعب بالألعاب بسبب إغلاق المعابر وعدم إدخالها، الأمر الذي جعلني أفكّر في وسيلة تعلّم تحمل قدرًا من الرفاهيّة والشغف، لينال الطالب قدرًا أكبر من المتعة. حاولت الربط بين التكنولوجيا والألحان والشعر لأصنع نموذجًا بسيطًا مع طالباتي، يُستخدم وسيلةً ومصدرَ تعلّم لهن وللطلّاب في المدارس المجاورة القريبة والبعيدة. وعلى الفور قمت بصياغة المفاهيم العلميّة في أناشيد تعليميّة، واخترت من طالباتي من تمتلك موهبة الغناء بصوت جميل، ودرّبتهنّ على الأنشودة بلحن مستعار. ومن ثمّ قمت بدمج الصوت مع صور منتقاة بطريقة طفوليّة في فيديو لطيف، لا تتجاوز مدّته ثلاثة دقائق. ثمّ عرضت تجربتي على الطالبات، وتفاجأت بذلك الفرح والاندماج مع أناشيدي، والتصفيق الحارّ لها بعدما فتحت سماعة (MP3) وقمنا بترديد الأنشودة التي استعرنا لحنها من أغنية الملهمة فيروز. ردّدنا:
تك تك يا أم سليمان *** نحن الخلايا نوعان
تك تك نحن اثنتان *** للنبات والحيوان
غلاف وسائل و نواة *** معًا ننشأ الأكوان
نحن نحن الخلايا *** لنا عجائب وأسرار
تك تك يا أم سليمان *** نحن الخلايا نوعان
وأنا خلية النبات *** حولي جدار كالبنيان
وحويصلاتي كبيرة. *** جدّا جدّا كالخزّان
وأمّا خليّة الحيوان. *** بها الأجسام تزدان
ليس لها أي جدار *** وحويصلاتي كثيرة
تك تك يا أم سليمان. *** نحن الخلايا نوعان
تك تك نحن اثنتان *** للنبات والحيوان
كانت تلك الأنشودة تقارن بين الخليّة النباتيّة والحيوانيّة بطريقة بسيطة وجذّابة، هكذا ندرّس ونُغنّي ونفرح، ونتحدّى العالم داخل خيمتنا. لم تكن خيمة في مهبّ الريح ولا صفًّا من غير جدران، لقد كانت وطنًا يُقاوم بعنفوان أمّةٍ مناضلة.