-
نودّ بدايةً أن نتحدث عن مشاريع ومبادرات ومؤسسات كان لك دور رئيس فيها، الهيئة اللبنانيّة للعلوم التربويّة وشبكة المعلومات العربيّة التربويّة "شمعة". أين هذه المبادرات اليوم ممّا أردتم لها حين انطلقت؟ وما هو أثرها على العمليّة التعليميّة؟
في الهيئة اللبنانية للعلوم التربويّة نحن نسعى لتطوير المعرفة حول التعليم، والتي هي برأينا متأخّرة عربيًّا. انطلقت الهيئة من فكرة تطوير معرفتنا حول التعليم، لأنّ ما نعرفه في الغالب، هو معرفة قادمة من الخارج أو مستمدة من الكلام الشائع. وهذا أمر خطير معرفيًّا، لسنا نتحدث هنا عن علوم طبيعية مثلًا حيث المعرفة بشأنها كونيّة، بل تعليم وتربية لا يصلح نقله أو استدخاله مباشرةً من سياقات أخرى بشروط مختلفة. لذلك اشتغلنا على إنتاج المعرفة حول التعليم، علّه يكون لهذا التطوير على المعرفة حول التعليم أثر على كلّ المهتمّين بالشأن التعليميّ.
وأعتقد أنّنا أحدثنا فرقًا في طريقة التعاطي مع المعرفة عن التعليم، لصالح التفكير في التعليم باستخدام الأدلّة والقرائن والمنطق، لا الانطباعات. وهذا بالمحصّلة يصل إلى المعلّمين. شهدنا في نشاطاتنا حضورًا كبيرًا للمعلّمين، وصل في أحد المؤتمرات إلى سبعمئة معلّم. صحيح أنّنا نواجه تحديات من طرف الجهات الرسميّة، تصل في بعض الأحيان لمواجهة مع الوزارة، خاصّة حين نعمل على مشاريع للوزارة ونحاول إثارة نقاش عام حولها، ولكن الأثر موجود، وهذه هي البيئة التي نعمل فيها.
بدأت "شمعة" في 2010 واليوم بعد عشر سنوات لدينا ما يقارب 56 ألف دراسة تربويّة من الدول العربيّة في قاعدة البيانات
بالنسبة لـ "شمعة" فقد بدأت ضمن أنشطة الهيئة. انطلاقًا من حقيقة أن الباحث يحتاج لقاعدة بيانات (Database) في التربية والتعليم، يوجد فيها كلّ ما يُكتّب بحثيًّا في المجال عربيًّا، لتخدمه وتخدم المفكّرين وعلماء الاجتماع وكلّ مهتمّ، وأيضًا المعلّمين الذين يريدون تطوير معرفتهم بما ينتج عربيًّا ليستفيدوا منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذلك نحن نخاطب الفاعلين والباحثين التربويّين من مدخل وسياق معرفيّين.
بدأت "شمعة" في 2010 واليوم بعد عشر سنوات لدينا ما يقارب 56 ألف دراسة تربويّة من الدول العربيّة في قاعدة البيانات، ولدينا عدد ضخم من المستفيدين والمستخدمين لقاعدة البيانات هذه من الدول العربيّة كلّها. ونلاحظ ارتفاع أعدادهم في مواسم إعداد الرسائل الجامعيّة والبحوث، ما يعني أنّهم طلّاب دراسات عليا، وما يشير إلى أنّ العمل يصل إلى جزء أساسيّ ممّن يحاول التواصل معهم.
يمكن القول: إنّ الأثر قد لا يكون ظاهرًا الآن، ولكنّ عمل "شمعة" هو خدمة نبيلة للبحث والتفكير والمعرفة، خدمة للباحث ليعرف ماذا يكتب زملاؤه عربيًّا، وأين وصلوا.
-
لننتقل إلى الراهن المباشر، وشاغل الجميع في العمليّة التربويّة والتعليميّة اليوم، إلى أزمة كورونا. إلى أيّ مدى أظهرت كورونا أزمات التعليم في بلادنا؟ وهل حملت من وجهة نظرك أيّة إشارات إيجابيّة؟
الحضور للمدارس وصعوبته، هو أزمة عالميّة، والعالم كلّه ارتبك حيالها، كلّ الأنظمة التعليميّة وكلّ الدول. ولكنّني أشير إلى مجالين أساسيّين في المشهد التعليميّ في ظلّ كورونا:
- الفرق بين الدول والنظم التعليميّة من ناحية العلاقة مع التكنولوجيا واستخدامها: وذلك من ناحية توفّر أدوات أو بنيّة تكنولوجيّة جيّدة أصلًا، وكذلك من ناحية استخدامها ما قبل الجائحة، واستدخالها في العمليّة التعليميّة. فالمؤسّسات التعليميّة التي لديها إمكانيّات تكنولوجيّة، وكانت تستخدمها إلى حدّ كبير قبل الأزمة، امتلكت قدرةً أكبر وأسرع على التكيّف. في حين واجهت الصعوبات الأكبر وعانت من الأزمة بصورة أعمق المؤسّساتُ التي لم تكن تستخدم التكنولوجيا، وتركّز على العلاقة الحضوريّة وعلى الورق والتواصل الماديّ.
- تغيّر علاقة العائلة والأهل مع العمليّة التعليميّة: صارت مسؤولية العائلة، وانخراطها في العمليّة التعليميّة للأبناء أكبر بكثير، وتحوّل البيت إلى مكان لهذا التعليم. فبرزت أزمة عدم الجهوزيّة في البيت للتعليم عن بعد أو للتعليم الإلكترونيّ. وفي حالتنا لا يوجد تجهيز من إنترنت أو حتى كهرباء لكلّ بيوت الطلّاب، بالإضافة إلى مشكلة الخصوصيّة أو بيئة البيت التي تعيق التعليم الإلكترونيّ، خاصّة مع ضيق مكان السكن وكثرة عدد أفراد الأسرة، وكلّهم في الإغلاق موجودون في هذا الحيّز الفيزيائيّ المشبع بالحاجات والقلق من الأزمة، وفوقها متطلّبات التعليم والحياة.
وبلا شكّ عانى كلّ طرف من أطراف العمليّة التعليميّة من الأزمة بطرق مختلفة. وقد تعرّض الإداريّون في المؤسّسات التربويّة والوزارات لضغوط شديدة، فهم مسؤولون عن متابعة الجميع، التأكّد من تدريب المعلّمين وجهوزيّتهم وانتظامهم في ترتيبات الدوام، والتأكد من حضور الطلّاب ومتابعتهم، والمساعدة في تأمين العناصر الرئيسة لهذا النمط من التعليم. وفي حالات كثيرة لم يكونوا قادرين على تحمّل كلّ هذا الضغط في حيّز زمنيّ ضيّق، فحصلت حالات انهيار نفسيّ، وعدم قدرة على ممارسة الأعمال الاعتياديّة. وعلى الجهة الأخرى كانت المؤسّسات الأليفة مع التكنولوجيا واستدخالها في العمليّة التعليميّة ولو على مستوى إداريّ، تتعامل مع الأزمة بمرونة وارتياح أكبر.
غياب الجهوزيّة من ناحية تكنولوجيّة، ومن ناحية إداريّة، تجعل قدرتنا على مواءمة المناهج وأساليب التدريس مع التعليم عن بعد أو التعليم الإلكترونيّ، غير موجودة أو ضعيفة. زد على ذلك أن المعلّمين أنفسهم في السياق العام ذاته غير الأليف مع التكنولوجيا، غير المجهّز بأدواتها الأساسيّة، عانوا ضغوط التفاوت بين المطلوب والممكن. لذلك بدا وكأنّ الجائحة وضعت جميع المعنيّين بالتعليم أمام التحدّي.
كورونا فرصة للبشريّة للتفكير في البدائل، تعليميًّا صار لدينا عدة مسارات للتعليم: حضوريّ، وعن بعد، ومُدمج
-
وسط هذا المشهد الذي يمكن عدّه "قاتمًا"، ألا يمكن النظر إلى الأزمة كفرصة للتطوير ولو البسيط، أي الخروج بمكسب إيجابيّ؟
كورونا فرصة للبشريّة للتفكير في البدائل، تعليميًّا صار لدينا عدة مسارات للتعليم: حضوريّ، وعن بعد، ومُدمج. وبالآتي، الجيل القادم في التعليم لديه جهوزيّة للتعلّم عن بعد، والمناهج تصبح هجينةً لتتلاءم مع التعلّم عن بعد والتعلّم غير المباشر.
التعليم الإلكترونيّ أعطانا فرصة للتفكير بالمادّة التعليميّة لتكون بصيغة رقميّة، أي فرصةً لإعادة تجهيز المادّة التعليميّة بطريقة تجعل المعلّم يظل قادرًا على التعليم حتّى لو غاب هو عن الصف أو غاب الطلّاب أو جزء منهم. هنا إمكانيات هائلة، لو توفّرت الموارد التكنولوجيّة للجميع وتحديدًا في المناطق المهمّشة والبعيدة. بالضرورة، هذا يحتاج تعاونًا لمنح الجميع فرصة الوصول إلى التكنولوجيا.
التعليم الإلكترونيّ أعطانا فرصة لإعادة تجهيز المادّة التعليميّة بطريقة تجعل المعلّم يظل قادرًا على التعليم حتّى لو غاب هو عن الصف أو غاب الطلّاب أو جزء منهم
إن وجود هذه البدائل مفيد جدًّا، ويعطي فرصة للتفاعل المختلف. بالتأكيد لا يمكننا إنكار أنّ الخسارة الكبرى التي تواجهنا في الوضع الجديد هي غياب الاتصال البشريّ بين أطراف العمليّة التعليميّة، بما يشمله من تفاعل وتحديدًا تفاعل الطلّاب مع بعضهم، ونحن نعلم أهمية التعلم من الأقران في نشأة الأطفال والطلّاب، وتكوينهم عمومًا.
-
لو نظرنا إلى المشهد العربيّ العامّ، أين نحن اليوم من مشروع تربويّ عربيّ؟
بداية لا بدّ من التسليم أنّ لكلّ دولة عربيّة مشروعها وأسئلتها وواقعها الخاصّ وتحدّياتها. الاختلافات كبيرة بين دولة وأخرى، ولكنّ التحدّيات في الشأن التعليميّ والتربويّ مشتركةٌ عربيًّا، ويمكن اختصارها من وجهة نظري بمشكلتين:
- نوعيّة التعليم: إذ برهنت الاختبارات الدوليّة المعتمدة عالميًّا عن وجود مشكلة كبيرة في مستوى التعليم ونوعيّته عربيًّا، وهذا في مراحل التعليم كلّها. ويمكن ملاحظة ذلك في مختلف التقارير الدوليّة عن جودة التعليم ونوعيّته، فتصنيف الدول العربيّة لواقع التعليم فيها متأخّر. وينسحب الأمر على التعليم العالي، فلو نظرنا إلى أيّ تصنيف للجامعات لوجدنا غيابًا عربيًّا، أو حضورًا لجامعات لا يتعدّى عددها أصابع اليد الواحدة، وثمة تشكيك في نزاهة تصنيفها.
- المناخ التربويّ.
-
سنأتي على نقاش فكرتكم عن المناخ التربويّ السائد عربيًّا، ولكن ألا ترى إمكانيةً لعمل عربيّ مشترك؟ لماذا لا نرى مبادرات عربيّة مشتركة في مجال التربية والتعليم؟
التجربة جعلتني أتعامل بحذر مع هذه التصوّرات العربيّة الشاملة، وأخشى من وجود ادّعاءات خطابيّة في هذا السياق، فنحن نشهد كلامًا سطحيًّا في العموم في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات العربيّة وتحديدًا الرسميّة. وأقترح هنا النظر في الحالة الأوروبيّة، أي أوروبا كمجموعة. لم تضع هذه الدول خططًا مشتركة أو استراتيجيّات عابرة للدول، ولكنها اتفقت على نقاط محددة، منها: تنظيم الاعتراف بالشهادات العليا، وتكييف نظام التعليم العالي لتمكين الطلّاب من معادلة شهاداتهم بين دولة وأخرى. أي أنّ الاتفاق هو على معايير مشتركة في هذا الجانب. في حين يعمل كل طرف في سياقه المحليّ والوطنيّ وفق خططه وبرامجه الأنسب له.
عربيًّا أرى ضرورة التواضع عند الطرح العام أو العمل المشترك والحذر من المبالغة لأن الواقع متباين. ويحضرني مثال على محاولة دول مجلس التعاون الخليجيّ توحيدَ المناهج، فبعد الاتفاق على الموضوع بعدّة سنوات من العمل لم يوحّد إلّا منهاج الرياضيّات، ثمّ ألغي. أي أنّ الرؤية الرسميّة في كلّ دولة تصل حتى مسألة الرياضيات وطريقة طرحها، ففي النهاية، ومن وجهة نظر النظام الرسميّ، المسألة الحسابيّة البسيطة تحمل قصّة، والقصة تريد الدولة روايتها بطريقة تناسبها هي.
-
بالحديث عن التباينات بين الدول العربية، كيف ترى السياسات التعليميّة والتربويّة في الدول العربيّة المختلفة؟ وما مدى التفاوت فيما بينها؟
السياسات من طرف الدول أو الحكومات يمكن رؤيتها باختصار كموقف رسميّ تجاه قضيّة محدّدة، وتُخصّص موارد لتنفيذ هذا الموقف وتطبيقه. لذلك كل دولة عربيّة لها سياساتها الخاصّة، بصرف النظر هل هي معلنة أو غير معلنة، هي موجودة في النهاية. المشكلة في السمة العامّة لمناخ تطبيق هذه السياسات، وهو ما أشرتُ إليه في البداية. في الدول العربيّة المناخ التربويّ "امتثاليّ" جدًّا، ويأتي ضمن تصوّرات محافظة جدًّا.
في الدول العربيّة المناخ التربويّ "امتثاليّ" جدًّا، ويأتي ضمن تصوّرات محافظة جدًّا.
يراد من الطالب أن يمتثل للمعلّم، وللمعلّم أن يمتثل للمدير، والمدير بدوره يمتثل للوزارة أو الحكومة أو السلطة عمومًا. بسبب هذا المناخ الامتثاليّ، بيئة التعليم تلقينيّة تريد من الطالب أن يكون مطيعًا. هذا المناخ يسوده غالبًا الخوف من الانتقاد سواءً في المجال العامّ أو داخل المؤسّسة، وأستثني حالات محدودة. لا يمكن للمعلّم انتقاد المدير أو النظام التعليميّ، ولا يمكنه كتابة رأيه في صحيفة، أو إعلانه في وسيلة إعلام في المجال العامّ، لأنّ للانتقاد تبعات، والمناخ السائد لا يريد منه إلّا الامتثال والطاعة ونقل هذا لطلّابه، وهذا هو المتوقّع منه بوصفه معلّمًا.
وبفهمي للمشهد العام أجد ترابطًا حتميًّا بين النوعيّة والمناخ، بل إنّ كلًّا منهما يفسر الآخر. هذا هو التحدّي الكبير برأيي.
فلننظر إلى المعلّم الذي يُعِدُّه النظام التربويّ لدينا، هل هو معلّم متسائل؟ هل هو معلّم متقصٍّ يثير الأسئلة، ويبحث عن إجابات ويفكّر نقديًّا؟ المعلّم الذي نُعِدُّه لا يطرح أسئلة، بل نُجهّزه بأسئلة وبإجابات جاهزة. التقصّي مفقود، وسؤال الكيفيّة غير مطروح. إذا كان هو كذلك، فكيف سيعلّم التفكير الناقد؟
هذا يعيدني دومًا إلى مناخ الامتثال وثقافته، وما ينتجه من غياب للنقاش والمراجعة والحوار. لا تتطوّر لدينا ديناميكيّة جيّدة بين الطلّاب والمعلّمين، وبين أطراف العمليّة التعليميّة جميعها. في حالتنا، نرى كيف أنّ التفاعل بين أفراد المجموعة التعليميّة ضعيف خاصّة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة.
-
ذكرت في حديثك التقارير الدوليّة والتقييمات لواقع التربية والتعليم في الدول العربيّة، كيف برأيك جرى التفاعل مع هذه التقارير ونتائجها عربيًّا؟
في لبنان مثلًا لم يحدث أيّ نقاش عامّ عن نتائج لبنان في هذه التقارير. في بعض دول الخليج حدث نقاش عامّ وخرجت توصيات. أجريت تحسينات في بعض الدول العربيّة الأقلّ من جهة عدد السكان، والأكثر وفرةً بالموارد الماليّة، ولكنّ الدول الكبيرة مثل مصر والمغرب مثلًا، لم يحدث فيها تغيير. وأعود مرّة أخرى لأؤكّد على أنّ مناخ الامتثال والطاعة يمنع وجود نقاش عامّ حقيقيّ ناقد صريح يقود لتغيير، وهذا الغياب ينعكس على النوعيّة.
-
دعنا نختم بسؤال على سبيل الافتراض، لو توفّرت لك موارد غير محدودة للعمل في الشأن التربويّ التعليميّ على مستوى عربيّ، ما هو المجال الذي ستشتغل عليه وضمن أيّة رؤية عامّة؟
أعتقد أنّ الإصلاح يجب أن يبدأ بالتعليم العالي، حيث تُنتَج النخب والموارد البشريّة، وتُنتَج الأفكار والمعارف. وإذا أتيحت موارد كافية لمشروع عربيّ محدّد، فأقترح إنشاء جامعة إقليميّة تعمل بمعايير دوليّة، يكون موقعها في بلد تحترم فيه الحريّات الأكاديميّة مثل تونس أو لبنان. وأنا أميْلُ إلى حصرها في الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، مع كثافة الأبحاث والمؤتمرات العالية، لتصبح بؤرة علميّة جامعيّة عربيّة يمكن أن تقيم شبكةً من العلاقات الأكاديميّة مع عدد من الجامعات العربيّة والأجنبيّة.








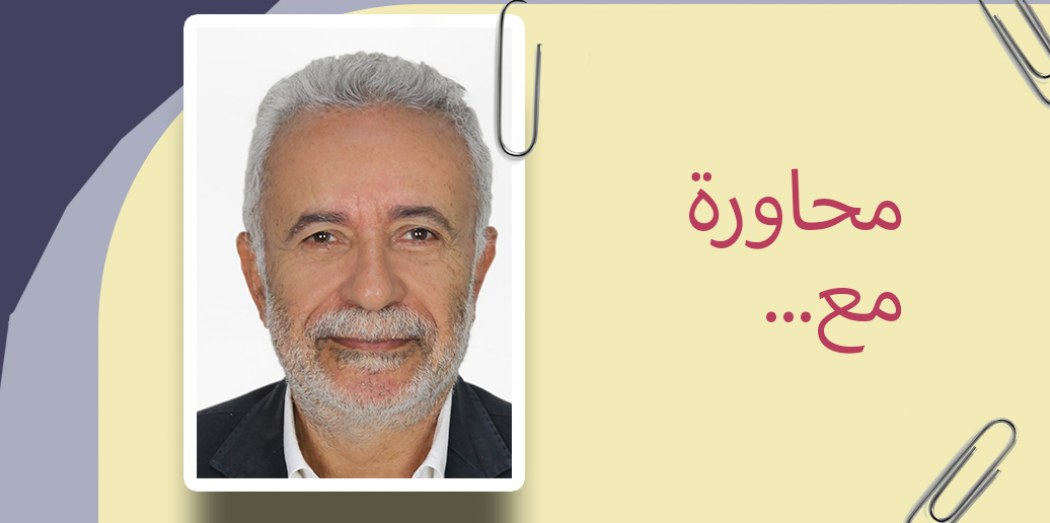





 نشر في عدد (1) خريف 2020
نشر في عدد (1) خريف 2020