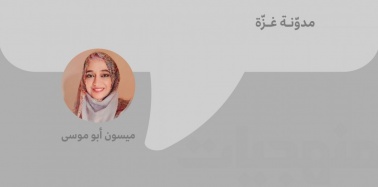في غزّة، لا تُقاس الحصّة بعدد الوسائل التعليميّة ولا بجاهزيّة الصفّ، بل بقدرة المعلّم والطالب على خلق معنى وسط نقص الإمكانات. حين تغيب الكهرباء، وتقلّ الكتب، وتختفي الوسائل، يصبح السؤال أحد آخر الأدوات المتاحة للتعلّم. في هذا السياق، لا يُعدّ السؤال ترفًا فلسفيًّا، بل ممارسة تربويّة أساسيّة تعيد إلى التعليم جوهره الأوّل، ألا وهو التفكير.
النظام التعليميّ التقليديّ بُني على وفرة الأدوات، وعلى افتراض الاستقرار. لكن حين ينهار هذا الافتراض، كما في واقع غزّة، تتكشّف هشاشة التعليم القائم على التلقين. في صفوف كثيرة لم يعد بالإمكان الاعتماد على كتاب مكتمل أو شرح متواصل، ومع ذلك لم يتوقّف التعلّم. ما تبقّى فعلًا هو الحوار والسؤال، والقدرة على التفكير المشترك.
في إحدى الحصص، بلا سبّورة ولا كتاب، طُرح سؤال بسيط: "كيف نتعلّم عندما لا تتوفّر المدرسة كما نعرفها؟" لم يكن السؤال مدخلًا للدرس، بل كان الدرس ذاته. بدأ الطلّاب يربطون بين التعلّم والخبرة، بين المعرفة والحياة، وتحوّل الصفّ إلى مساحة تفكير جماعيّ لا تحتاج إلى أكثر من صوت وحضور.
العودة إلى السؤال في هذا السياق عودة إلى الجذور الفلسفيّة للتعليم، الفلسفة لم تنشأ في قاعات مجهّزة، بل في ساحات مفتوحة، وفي حوارات إنسانيّة تبحث عن المعنى. السؤال الفلسفيّ لا يحتاج إلى وسيلة، بل يحتاج إلى بيئة آمنة تسمح بالدهشة. في غزّة حيث يعيش الطالب واقعًا معقّدًا، يصبح السؤال أداة لفهم الذات والعالم، لا مجرّد تمرين ذهنيّ.
كثير من الطلبة تعلّموا أنّ المعرفة هي الإجابة الصحيحة، وأنّ الخطأ فشل. لكن في الصفوف التي افتقرت إلى الإمكانات، تغيّرت هذه المعادلة، حين سأل أحد الطلّاب: "هل يجوز أن نختلف في الإجابة؟" لم يكن السؤال حول المحتوى، بل حول طبيعة التعلّم نفسه هنا، تحوّل الصفّ إلى مختبر تفكير، لا قاعة اختبار.
في الممارسة الصفّيّة في غزّة، لم يعد السؤال أداة تقويم، بل وسيلة بقاء تربويّ، حين يسأل المعلّم: "ما رأيكم؟" أو "كيف نفهم هذا مع واقعنا؟" يمنح الطالب دورًا فاعلًا في بناء المعرفة. أحد الطلّاب قال بعد نقاش مفتوح: "أوّل مرة أحسّ إنّو رأيي مهم"، هذه الجملة وحدها تكشف ما يمكن أن يفعله السؤال حين تُسحب منه سلطة الحكم المسبق.
غياب الإمكانات فرض على المعلّم أن يعيد التفكير في دوره؛ لم يعد ناقلًا للمحتوى، بل منسّقًا للتفكير. الصمت في الصفّ أو الخيمة لم يعد فراغًا، بل مساحة للتأمّل. التردّد لم يعد ضعفًا، بل خطوة نحو الفهم. بهذه الطريقة عاد التعليم إلى جوهره الإنسانيّ، بعيدًا عن السبّورة والوسيلة، وقريبًا من العقل واللغة.
يصبح سؤال "كيف نفكّر؟" أكثر إلحاحًا من سؤال "ماذا نحفظ؟" لأنّ التفكير هو ما يمنح الطالب قدرة على التكيّف، وعلى قراءة الواقع، وعلى عدم الاستسلام للتفسير الواحد. السؤال هنا ليس أداة تعليميّة فقط، بل فعل مقاومة معرفيّة ضدّ التلقين وضدّ فقدان المعنى.
العودة إلى السؤال في ظلّ انعدام الإمكانات ليست حلًّا مؤقّتًا، بل اكتشافًا تربويًّا. كشفت الأزمة أنّ التعليم لا يبدأ من الوسيلة، بل من العلاقة بين المعلّم والمتعلّم، ومن الثقة بالعقل الإنسانيّ وقدرته على الفهم حتّى في أقسى الظروف.
لعلّ ما تعلّمناه اليوم هو أنّ التعليم الحقيقيّ لا يُقاس بما نملكه من أدوات، بل بما نملكه من أسئلة. وحين يصبح السؤال أهمّ من الإجابة، نكون قد عدنا من دون أن نشعر إلى جذور الفلسفة الأولى؛ حيث التعلّم فعل إنسانيّ حيّ لا نظامًا جامدًا. قد تغيب المدرسة بصورتها التقليديّة، لكن ما دام السؤال حاضرًا، فإنّ التعليم لم يغب بعد.