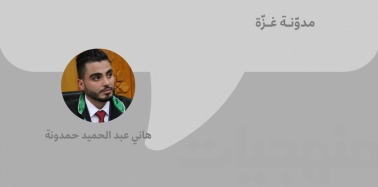دخل زميلنا قاعة المحاضرين متضجّرًا، رمى حقيبته على الطاولة، وقال في أسفٍ: "مشكلتنا أنّنا نعلّم اللغة العربيّة لأبنائها وكأنّهم ناطقون بغيرها، فلا المناهج تساعد، ولا الطرائق تجدي". قلت له: "على رسلك، إنّهم وارثوها. ومهمّتنا أن نحافظ على هذا الإرث. وهُنا تكمن صعوبة مهمّتنا".
إشكاليّة التعريف
يواجه معلّمو اللغة العربيّة تحدّيًا مزدوجًا يتمثّل في التعامل مع فئتين مختلفتين من المتعلّمين: الناطقون بغيرها الذين يكتسبونها من الصفر، ووارثوها الذين ينشؤون في بيئات عربيّة أو غير عربيّة، لكنّهم يعانون ضعفًا في امتلاك مهاراتها الأساسيّة. وبينما تُبنى المناهج الخاصّة بالناطقين بغير العربيّة على أسس تعليم اللغات الأجنبيّة وفق تسلسل واضح ومنهجيّ، نجد أنّ مناهج العربيّة لأبنائها لا تأخذ بعين الاعتبار الفجوة المتزايدة بين الفصحى والعامّيّة، ما يُضعف صلة الوارثين بلغتهم الأصليّة.
أحيانا يكون مستوى وارث اللغة ضعيفًا جدًّا: فقر في المفردات، عجز عن التحدّث، ضعف أمام حروف اللغة. ويلاحظ التربويّون في المدارس ذلك، فيكون القرار بتحويله من صفوف متعلّمي اللغة الأمّ، إلى صفوف الناطقين بغيرها. وهُنا تكمن الفجوة.
الناطقون بغير العربيّة: رحلة الاكتساب المنظّمة
يتعلّم الناطقون بغير العربيّة اللغة في إطار منظّم يعتمّد على التدرّج في المهارات الأربع: الاستماع، التحدّث، القراءة، الكتابة. تُبنى هذه المناهج على مبادئ علميّة تضمن تعلّمًا متماسكًا، مدعّمًا بالتكرار والممارسة المستمرّة. كما تُستخدم استراتيجيّات تعليميّة، مثل التراكيب المبسّطة والأنشطة التفاعليّة، والاعتماد على المفردات الأساسيّة قبل الانتقال إلى البنية النحويّة المعقّدة.
ولكن، في المقابل، نجدُ أنّ تعليم العربيّة للوارثين يعتمد على افتراض أنّهم يتقنونها تلقائيًّا، لمجرّد أنّهم يسمعونها منذ الصغر، وهو افتراض غير دقيق. فبسبب غلبة العامّيّات، وضعف القراءة، وغياب بيئات تعزّز التفاعل مع الفصحى، وربما بسبب ظروف اجتماعيّة، أو اغتراب طويل، يواجه هؤلاء الطلّاب صعوبة في الكتابة الصحيحة، وفهم النصوص، والتعبير الفصيح.
وارثو اللغة: أزمة في الاكتساب أم ضعف في المناهج؟
على الرغم من أنّ وارثي اللغة العربيّة يملكون ميزة الانغماس اللغويّ، إلّا أنّهم يعانون مشكلات عدّة، منها:
- - هيمنة العامّيّة: ما يجعل الانتقال إلى الفصحى تحدّيًا صعبًا.
- - نقص القراءة الحرّة: حيث يقتصر تفاعلهم مع الفصحى على الكتب المدرسيّة، التي غالبًا ما تكون جامدة وغير جاذبة.
- - طرائق التدريس التقليديّة: التي تعتمد على حفظ القواعد من دون سياق تطبيقيّ، ما يجعلهم يشعرون بأنّ العربيّة مادّة منفصلة عن حياتهم اليوميّة.
- - ضعف الكتابة: بسبب التركيز على النحو من دون تدريبات حقيقيّة على التعبير والإنشاء.
من هنا، من الصعب وضع منهج موحّد يناسب الفئتين، لأنّ لكلّ فئة احتياجاتها الخاصّة. فبينما يحتاج الناطقون بغير العربيّة إلى طريقة ممنهجة تبدأ من الأساسيّات، يحتاج الوارثون إلى تعزيز ما لديهم من مهارات، مع تصحيح الأخطاء وتقوية مهارات القراءة والكتابة والتحدّث بالفصحى بطلاقة.
لكن يمكننا الاستفادة من بعض الأساليب المستخدمة مع الناطقين بغيرها، لجعل تعلّم العربيّة أكثر فاعليّة للوارثين، مثل:
- - التركيز على الوظائف اللغويّة بدل تقديم القواعد في شكل نظريّ مجرّد.
- - استخدام المحتوى المشوّق، مثل القصص القصيرة، والمسرحيّات، والأناشيد لجذب التلاميذ إلى الفصحى.
- - الاعتماد على التكنولوجيا من خلال التطبيقات التفاعليّة والمنصّات الرقميّة التي تسهم في تعزيز مهارات الكتابة والتحدّث.
- - تشجيع القراءة الحرّة عبر إنشاء نوادٍ قرائيّة تناسب اهتمامات الطلّاب، وتدعم بناء علاقة طبيعيّة مع الفصحى.
وللتغلّب على هذا التحدّي، ينبغي أن تتبنّى المناهج التعليميّة مقاربة أكثر تكامليّة تأخذ في الاعتبار خصوصيّة كلّ فئة، ومن أبرز الحلول التي يمكن تطبيقها:
- - تصميم مناهج مخصّصة لوارثي العربيّة تعالج نقاط ضعفهم بطريقة تراعي أنّهم يتحدثونها لكنّهم لا يحسنون استخدامها أكاديميًّا.
- - تعزيز دور المهارات التطبيقيّة عبر تقديم دروس الكتابة والتعبير الشفهيّ جزءًا أساسيًّا من المنهج.
- - دمج وسائل الإعلام والوسائط الحديثة لجعل اللغة الفصحى جزءًا من الحياة اليوميّة.
- - إشراك الأسرة والمجتمع في دعم الأطفال على استخدام الفصحى في مواقف مختلفة.
تعليم اللغة العربيّة ليس مجرّد مهمّة أكاديميّة، بل هو مسؤوليّة ثقافيّة تستوجب جهودًا مضاعفة لضمان أن يكون وارثوها قادرين على حمل هذا الإرث. لا يكفي أن نعلّمها لهم كما تُعلَّم للناطقين بغيرها، بل يجب أن نعيد النظر في المناهج وطرق التدريس بحيث تتناسب مع حاجاتهم الحقيقيّة. وبينما نحاول تحقيق ذلك، علينا أن نتذكّر أنّ اللغة ليست مجرّد قواعد ومفردات، بل هي هويّة وثقافة ينبغي أن نرعاها ونحميها. فكلّ إرث قابل للضياع والنفاد كما هو قابل للنماء والازدياد.