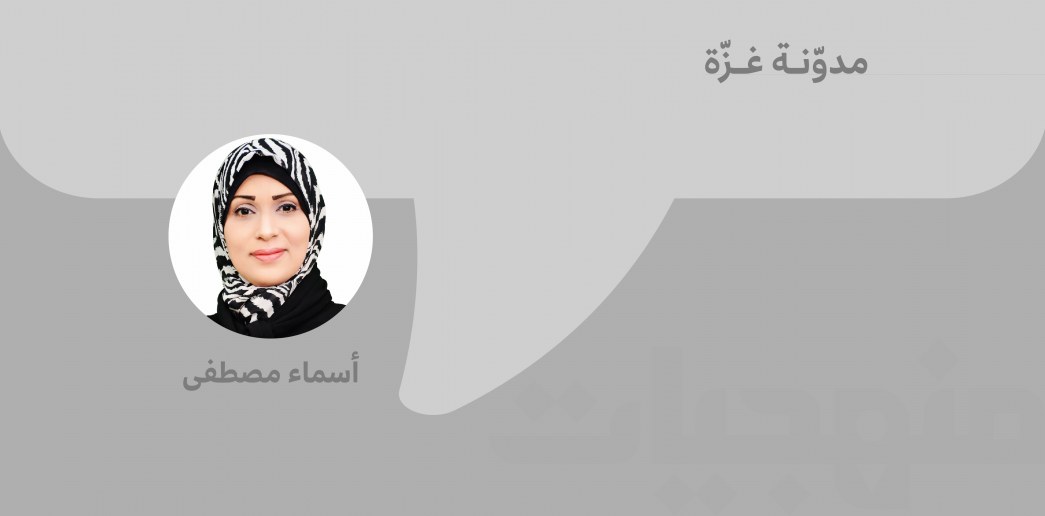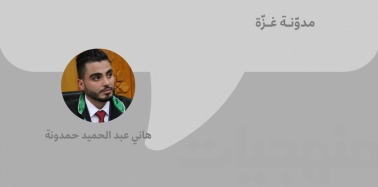ذات يومٍ كنتُ أتجوّل بين صفوف صغيرة، ليست من الطاولات المصقولة ولا الجدران الملوّنة ولا السبّورات الذكيّة. إنّها النقاط التعليميّة المؤقّتة: قطع من القماش والخيام تستر شتات المكان، أو زوايا في مدارس إيواء أرهقها النزوح. هناك يصطفّ الأطفال على حصائر بالية، وأمامهم دفاتر أقلّ من أن تسدّ نهمهم للكتابة والتعلّم. سألت الأطفال سؤالًا بابتسامة متعبة تخفي قلقًا أكبر من قدرتي على احتمال سماع إجاباتهم: "كيف الحال؟" يرتفع صدى السؤال في الهواء، وكأنّه يمتحن أرواحًا صغيرة عاشت ما لم يعشه الكبار.
يجيب أحد التلاميذ بصوت خافت:
"أنا مشتاق يا معلّمتي لمدرستي… لما أجت الحرب كنت بصف خامس. كان في شجرة كبيرة بحديقة مدرستي، كنت ألعب أنا وأصحابي تحتها". وتسقط دمعة من عينيه، فيمسحها بسرعة كأنّه يخجل من حزنه.
تجيب طفلة أخرى:
"أنا مشتاقة لصحبتي مريم… كانت كلّ يوم جنبي على الطاولة نفسها، بس استشهدت لما قصفوا بيتهم في الشمال".
يصمت المكان. الأطفال يعرفون معنى الغياب جيّدًا، ويفهمون أنّ مقاعد الصفوف ليست مجرد خشب ومسامير، بل ذاكرة أصدقاء صاروا أسماءً في دفاتر الشهداء.
افتقاد المعلّمين
يعلو صوت طالب ثالث:
"اشتقت إلى الأستاذ أشرف… بيتي قصفوه مع أهله، كان نفسي نرجع للمدرسة عشان أشوفه".
أصوات صغيرة لكنها تحمل ثِقَل الخسارة. المعلّم بالنسبة إليهم ليس مجرد من يشرح الدروس، بل هو سندٌ وأمان، وجهٌ مألوف في عالم تبدّل وجهه إلى دخان ورماد.
غياب الفسحة المدرسيّة
تتذكّر المعلّمة وقت الفسحة في المدارس، أصوات الصراخ البريء، الحبل يتمايل في أيدي البنات، كرة تركض بين الفتيات، ضحكات تتسابق مع الجري.
تقول طفلة:
"يا معلّمتي هنا ما في وقت فسحة زي زمان، طول الوقت قاعدين، ما في سندويشة وعصير، ما في مقصف".
كيف يمكن لطفلة أنّ تستوعب أنّ "اللعب والطعام والترفيه" أصبحت رفاهية مفقودة، بينما كانت حقًّا يوميًّا بسيطًا في المدرسة؟
الحاسوب والمختبر
يرفع طفل آخر يده ليجيب:
"أنا بحب حصّة الكمبيوتر… كنت أتعلّم بسرعة وأكتب بسرعة وأتعلّم برامج جديدة، هلأ ما في كهربا ولا أجهزة".
ويضيف آخر:
"والمختبر؟ كنت بحب ألبس المعطف الأبيض أعمل تجارب مع استاذي… كنت أحس حالي عالِم!"
يقول طالب آخر بعَبرةٍ تخنقه.
اليوم، أقصى ما يمكنهم تجربته هو التحديق في الظلام عند انقطاع الكهرباء، والتفكير بأسئلة بلا أجوبة.
حصّة الرياضة
صوت آخر، فيه حنين مكسور:
"يا مسّ، أنا نفسي أرجع ألعب كورة، كنت بطل وكنت أستنّى حصّة الرياضة على أحرّ من الجمر".
حصّة الرياضة كانت فسحة للحياة، للتنفّس، للتخفيف من ضغط الدراسة. أصبحت من المحرّمات على أطفال غزّة، حيث الافتقار إلى المساحات الواسعة لممارسة الرياضة، وتحوّل المدارس الى مراكز إيواء تكتظّ أفنيتها بخيام النازحين. ناهيك عن احتماليّة انهمار القذائف في أيّ لحظة، قد يسقط السقف، وتضيع الأحلام.
المخيّمات الصيفيّة والرحلات
يتنهّد أحدهم قائلًا:
"أنا كنت بستنّى المخيّم الصيفيّ كلّ سنة… أغني وأرسم وألعب ألعاب كبيرة، وأنشد في فريق الكورال وأتعلّم أعزف على الجيتار وأغنّي لفلسطين".
ويردّ آخر:
"أنا كنت نفسي أطلع رحلة عالبحر مع المدرسة. البحر قريب، بس أجت الحرب وما رحنا. حتّى المدرسة راحت".
ويعلو صوت ثالث، يحمل أمنية أبعد:
"كان نفسي أشارك برحلة خارج فلسطين، أتعلّم وأشوف العالم… نفسي يا مسّ أروح ع اليابان وأصير مخترع".
لكنّ الحدود مغلقة، والعالم بعيد، والطفولة محاصرة في شريط ضيّق يضيق أكثر بالحرب.
غزّة… مدرسة مفتوحة على الجرح
نظرتُ في عيونهم وأدركت أنّ سؤالي البسيط "كيف الحال؟" تحوّل إلى مرآة تعكس خسارات لا تُحصى. هؤلاء الأطفال فقدوا بيوتهم ومدارسهم وزملاءهم ومعلّميهم، فقدوا الألوان والمختبرات، ألعابهم الرياضة والرحلات. وحتّى اللحظات الصغيرة، ضحكاتهم في الفسحة أو تبادل سندويشات الإفطار صارت ذكرى تُروى لا تجربة تُعاش.
لكنّ المدهش أنّ هؤلاء الصغار ما زالوا يرفعون أيديهم للإجابة، وكأنّ الدرس لم يتوقّف، وكأنهم يُصرّون على أن يبقوا طلابًا على الرغم من كلّ شيء.
تأمّلت ابتساماتهم الخجولة، رسوماتهم على هوامش الدفاتر، كتاباتهم المليئة بالأخطاء لكنّها ممتلئة شغفًا. هؤلاء الأطفال لا يريدون أن يُهزموا. فبين أنقاض الحرب، يصرّون على تعلّم حرف جديد، على حفظ بيت شعر، على حلّ مسألة رياضيّة. التعليم بالنسبة إليهم ليس رفاهيّة، بل صمود في وجه المحو.
وحين غادرتُ النقطة التعليميّة آخر النهار، ظلّ صدى كلماتهم يرافقني. أدركت أنّ الحرب سرقت مدارسهم ومدرستي، لكنّها لم تستطع أن تسرق إصرارهم على أن يكونوا طلّابًا، وإصراري على أن أعلّمهم ما دمت على قيد الحياة. ومع ذلك، يبقى السؤال الكبير معلّقًا: كيف يمكن لعالم يدّعي التحضّر أن يسمح بأن تُمحى طفولة كاملة بهذا الشكل؟
كيف الحال؟
الجواب في غزّة لا يحتاج إلى كلمات كثيرة. يكفي أن تنظر في عيون هؤلاء الأطفال لتعرف أنّ الحال خراب، لكن في أعماقهم شظايا نور تصرّ أن تبقى مشتعلة، لعلّها تجد يومًا فضاءً رحبًا يليق بأحلامهم.